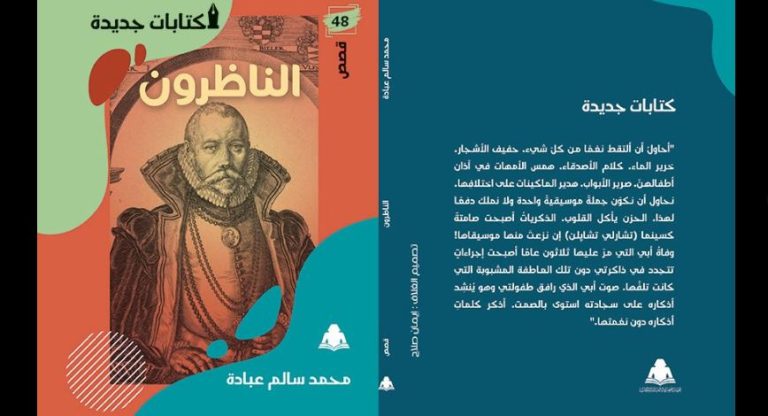كنتُ جالسا بالعربة وكل انتباهى موجه لكتاب صغير عن سارتر بين يدى، وعلى بعد خطوتين صغيرتين كانت هناك منى، تقف فى ثياب سوداء، وكأنها قد استعدت سلفا لحادثة انتحار الشاب.
مهلا.. ماذا عن الليلة السابقة للقائى الأول بها؟ فى تلك الليلة ساءت حالة قرحة معدتى، وحاولت أن أنام. ضبطت منبه المحمول، ثم أغلقته ووضعته جانبا، حشرته حشرا بين الكتب، فى أبعد نقطة ممكنة عن الفراش، حتى أضطر للنهوض من الفراش صباحا لأكتم صراخه المفزع، ثم أعاود النوم من جديد لساعة أو بعض ساعة. أدرت الراديو فانبعث صوت الشيخ محمود على البنا دافئا ودسما، بآيات من سورة يوسف. أطفأت نور الغرفة وتكورت تحت البطانية وتناهى إلى مسمعى القرآن طمأنينة وسلاما، وما لبثت أن نمت. ما هى إلا ساعة تقريبا وصحوت بعينين مبللتين وكأننى بكيت فى نومى، نزعت بدنى من دفء الغطاء، واندفعت مترنحا بين أشباح عتمة خمسين عاما تتربص بى. ولا أدرى كيف وجدتنى أمام حوض الحمام أتقيأ بعض ماء أصفر غليظ القوام، فيه خيوط حمراء لا تكاد تلحظها العين، ثم رفعت نحو المرآة وجها طمست معالمه الدموع وخيوط العرق وضباب الحلم. ولكن بماذا حلمت إذن؟ ماذا رأيت؟ ما الذى نبهنى لدموعى ولضرورة التقيؤ؟
لو أن عندى أجوبة شافية لأسئلتى لما أجهشت بالبكاء فى منامى أصلا، ولما أصبت بقرحة المعدة من سن الثلاثين. لو عندى إجابة واحدة شافية لما استيقظت من نومى على كلمة باترة، هتف بها هاتفٌ غامض، فى حلمى المنسى. تلاشت الكلمة نفسها فى الفراغ دون أن أتمكن من الإمساك بها، لكنها تركت أثرا، فترامى صداها يرج أعصابى ويحرك ما بمعدتى من بقايا عشاء هزيل.
اغسل وجهك أيها الحالم لتعود إليك تجاعيدك آمنة مطمئنة، والأشواك البيضاء الصغيرة المتناثرة من حول فمك المزموم بشدة. وددت لو أسأل المرآة: أين وجهى يا مرآتى القديمة؟ لكننى لم أفعل.
لو أن عندى جوابا واحدا لسؤال مرآتى لما لملمت ظلى حولى، ووضعت على جسدى الروب الذى ورثته عن أبى وأكرهه لكنه يدفئنى، ولما تلفعت بكوفية لم أرثها وأحب لونها الأحمر، ولما خرجت فى حماية كل هذا الصوف إلى شرفتى، فى قلب ليل يناير الجميل القاسى. هكذا وقفت أدخن منتظرا طلوع النهار، متفقدا ألوان السماء، أو المزقة المستطيلة التى تبين منها على الأقل، بعينين محميتين أيضا وراء عدستين يزيد الزمن سمكهما بالتدريج.
شعرت حينها أننى أعرف حقا من أنا، وترامى إلى نداء فيلسوف إيطالى من عصر النهضة يصيح بى مستفزا وجودى الهش: “اعرف نفسك، أيا سليل الأرباب المتوارى فى حلة فانية”. شكرا يا عم! إننى أعرف من أنا، أنا مجرد وهم، خيال، شبح، أو لنعبر عن الأمر ببساطة فإننى لست سوى شخصية فى حكاية مختلقة لا رأس لها ولا ذيل.
وفى الصباح التالى كنت بالعربة، معى سارتر وظلى، ولم أصرح حتى لنفسى برغبتى الوحيدة؛ أن أتمكن من الاعتراف بما حدث لأى شخص، أن أقول به بكل اعتيادية: “قضيت ليلة سيئة، ولم أكد أنام حتى هاجمتنى قرب الفجر قرحة المعدة مثل لص وغد، ويهيأ إلى أننى سمعت كلمة فى حلمى، لكننى فشلت فى تذكرها، وما زاد الطين بلة إننى أبكى فى أحلامى.” ولم أقل هذا لأى شخص، لأننى ببساطة لم يكن لدى أى شخص، وربما لو وجد لاستنكفت ببساطة عن هذا الإدلاء بهذا التصريح الصباحى المبتذل.
أنا أفسد روايتى بنفسى، لم أبدأ حكايتى مع منى بعد وها هى مشاعرى وعواطفى البدائية الخشنة تقطع علىّ طريقى، منداحة على هواها. أفسد روايتى كما سبق وأن أفسدت حياتى بكل ما أوتيت من عزم وإرادة. لم يكد المنتحر المسكين يعتلى خشبة السرد حتى أزحته بكتفى بعيدا، كما يفعل المتزاحمون عند دخولهم عربات المترو فى محطته الأولى، لضمان الفوز بمقعد. المترو! يا لها من فكرة نيرة! فلم لا تدور الرواية كلها فى أجواء المترو، ومن الجيد أن اللقاء الأول بينى وبين منى جرى هناك، ويمكننى أن أختلق أيضا لقاءات أخرى فى أجوائه. لقد سبق أن سجلت بالفعل بعض المشاهد التى تتعلق جميعها، بمشاهداتى وملاحظاتى – وربما كوابيسى – حول مترو الأنفاق، وهكذا يمكننى أن أبدا بلقاء منى، ثم أروح أبحث عنها مثل عاشق متيم، فى عرباته لأيام وأسابيع، ثم أنسج فى هذا كله القصاصات الصغيرة الخاصة بعالم ما تحت الأرض المدهش ذلك، العالم نفسه الذى سجن فيه سدنى أور بطل روايته دون أن يملك القدرة على إطلاق سراحه منه، ولكنه فى هذه الحالة سيكون سجنا جماعيا، ينزل إليه الناس بإرادتهم، لقضاء مشاويرهم أو للانتحار أو للبحث عن حبيبة مجهولة تشبه سعاد حسنى وهى مازالت طفلة برية.
أبحث عنك، أبحث عن حكاية حياتى لأرويها لك، أشتاق إلى صورتى المكتملة حتى أقدمها لك على طبق من كلمات، ولو كان فى ذلك نهاية حياتى، ومن يدرى فربما خرجتُ من متاهتى عند ذاك.
رُوىأن العزيزي قد رأى المجنون مهموماً، ينخل التراب في الطريق، فقال: أيها المجنون، عم تبحث هنا؟ قال: أبحث عن ليلى هاهنا، فقال العزيزي: و أنّى لكَ أن تجدها في التراب؟ و متى كان الدر الطاهر كامناً في تراب الطريق؟ قال المجنون: إنني أبحث عن ليلى في كل مكان.
لعل الشاب الذى اتخذ قرار إنهاء حياته بعد أن تناول طعام الإفطار – عادى جدا – مباشرة، قد فوّت أكثر من قطار حاذى رصيف المحطة، ثم راح يفتش حوله عن مصادفة ما، مثل تلك التى تنسج حبائلها حولى كل يوم بطريقة جديدة، كلا، بل شئ أقل هشاشة من مصادفة وأوهى من بيت عنكبوت، أخف وطأة وأوهن حبكة، فإن استطاعت مصادفات هذا الشيخ القارئ فى المترو أن تمنحه فى نهاية الأمر رواية مفككة الأوصال، فبالكاد كان يمكن لمصادفة هذا الشاب أن تقدم له قصة قصيرة.
ولكن تلك القصة لم تكتب مع الأسف، ولأسباب جمالية بكل تأكيد، كما لم تظهر أى علامة أمامه تثنيه عما انتوى. لم تتعطل قطارات المترو، ولم يظهر حصانٌ أسود من حيث لا يدرى أحد وأخذ يركض على طول القضبان الكهربائية، وبالطبع لم تتجل السيدة العذراء أمام أعين الركاب المنتظرين على رصيف روض الفرج. كلا، كلا، قلنا ونكرر إنه كان ينشد مصادفة أقل تواضعا بكثير، كان سيكفيه مثلا أن يلحق به أبوه، منقطع الأنفاس، لأن ابنه نسى مثلا الملف الأنيق الذى يحفظ به وثائق ضرورية من أجل التقدم لأى وظيفة. غير أنه لم ينس الملف، فها هو معه، شهادة الميلاد وشهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية وشهادة المؤهل الجامعى، أيا كانت الكلية التى تخرج منها، بتقدير جيد، وربما أيضا الفيش والتشبيه وبها رسمت أطراف أنامل الشاب بهباب أسود، مرتين فى صفحتين، عشر أصابع فى كل صفحة، تأكيدا على أن صحيفة سوابقه طاهرة، ويمكنه دخول جنة الوظيفة من أوسع أبوابها.
ولكن كفى، لقد استهنتُ كثيرا بإرادة هذا الفتى، وقد اتخذ قراره بالفعل، ولن يحول دون تنفيذه أى شئ، لا مصادفة ولا علامة ولا حتى لو اتجهت إليه فتاة تتحدث إليه، حلوة وتشبه سعاد حسنى فى الزوجة الثانية أو القاهرة 30، واسمها منى مثلا، تقول له: “أنا أيضا أود الانتحار منذ أن مات زوجى وحبيبى، محترقا فى احتفال جماعى بالنيران”، لم يرد عليها، لا لأنه ساهٍ بمصيره الخاص، ولكن لأنها لم تره أصلا، ولعلها لم تركب من روض الفرج، والواقع يقول إنها كانت معى بالفعل فى العربة عندما ألقى بنفسه أمام القاطرة.
أتخيله الآن، أنا الشيخ الوحيد، المحاط بالكتب والأوراق، مثل أسير قلعة ورقية، أُعدت للمجانين والمتمردين فقط. أتخيله شابا أسمر البشرة، ممشوق القوام، عريض الصدر، نحيف الخصر، عضلاته مرسومة ومقسمة، لن يجدوا نموذجا خيرا منه إذا أرادوا نحت تمثال يعكس الإنسان المصرى الأصيل، المكافح العظيم، بانى الأهرامات وعابر خط بارليف، والذى لم يستحق مع هذا قصة قصيرة لأسباب جمالية بحتة، منها ابتذال فكرة أن شابا عاطلا عن العمل يلقى بنفسه أمام المترو، كمادة خام لعمل أدبى مميز. هذا الشاب اعتاد ولا شك الصحيان من النجمة، من زمان وأبوه يردد: قم تنفس هواء الصبح العليل، قبل أن يفسده الخبثاء بأنفاسهم!
وبصفتى الشيخ، راوى الحكاية التى دخلها هذا الشاب الميت من أشد أبوابها ضيقا، لا أدرى بأى وجه حق، يمكننى القول صراحة إننى أستمتع الآن، وحدى بالطبع، فى غرفتى هذه، بإعادته إلى الحياة، لا لشئ إلا ليموت من جديد، ولسوف يصحو من موته، مع كل قارئ محتمل يضئ بنور عينيه هذه السطور، ثم سيعود للموت من جديد – الشاب، لا القارئ والحمد لله – فى آخر الفقرة، وهكذا تمتعنا اللعبة.
وبصفتى شيخا تجاوز الخمسين وفى طريقه إلى محطة الستين المخيفة بكل عزم وإصرار، كثيرا ما كنت ألحظ، من بين ما ألحظه عندما لا أدس أنفى العجوز بين صفحات كتاب، الشباب.
ألحظ الشباب بالذات، أو الشباب على وجه الخصوص، يلفتون نظرى دون عداهم من الأطفال أو كبار السن، تلك الدائرة النارية البديعة التى تتحرك من الثامنة عشر حتى مشارف الثلاثين، الصبيان منهم والبنات، ألحظهم بعين تستعين على الشك فى قدراتها بنظارة تزعم لها يقينا إلهيا، فأتساءل، وهم من أمامى ومن ورائى، يركضون ويلهثون حتى على سلالم المترو الكهربائية تطلع أو تنزل بهم، أتساءل، بنبرة غريبة على يقين الآلهة: “ما بالهم يسرعون بخطوات واثقة ومتقدة؟ نحو أى هدف غامض وبديع يا ترى؟” ولماذا أُفرط أنا المتسائل إلى هذا الحد فى الاستعانة بالنعوت، بعد كل اسم تقريبا؟ كان بمقدروى أن أقول مثلا: “نحو أى هدف يسعون؟ غير أن الهدف سيبقى مع ذلك غامضا على، وبالتالى فهو بديع شأن كل غامض. أما الخطوات فهى بالنسبة لمشيتى المترددة المتوانية يحق لها أن تنال كل أوسمة الحماس والثقة والاتقاد الموجودة فى الدنيا.
لو أعرف أجوبة شافية لما تحدثت بنبرة شيخ يحسد الشباب، يحسد فتوته وتعجله، ولما أدركت، مع مطلع ذلك الفجر نفسه، بيقين لا ينال منه حتى الآلهة على قمم الأولمب، ومهما تشككتْ النظرة أو احترزت العبارة وترددت النعوت، أننى لست أكثر من شخصية فى حكاية يتم التلاعب بها من قبل صاحب القلم، والقلم نفسه، هذا إذا وضعنا جانبا الكلمات نفسها والحروف، وعلامات الترقيم، واحتمالات لا متناهية تؤدى إليها أخطاء الجمع والطباعة وكل ما قد ينجم عن السهو والغفلة والنسيان.
فلأحاول من جديد أن أعبر دون تعقيدات عن حالى ليلتها ونهارها: كنت أتوق لأن أقول لأحدهم إننى نمت نوما سيئا ليلة أمس، وصحوت مفزوعا قبيل الفجر على نداء عجيب. كنت أود لو أشكو لشخص ما، ولو كان أصم وأبكم وأعمى، لكننى كنت وحدى، وكانت منى لا زالت فكرة فى رحم الغيب، بعيدة عنى كل البعد. ومن يستهين بخطوتين تفصلان بيننا، فليعرف أنه سيلزم تجاوزهما موت شاب مصرى أصيل، نبت من تراب هذا الوطن ولعنه من كل قلبه حيا وميتا.
آه، الشاب، لقد نسيته مرة ثانية، فلنرو عنه ما يتيسر ثم نفرغ تماما لحكايتى مع منى، حكاية الحب التى مازلتُ مصرا على أنها طوق النجاة الوحيد من شبح الدفاتر البرتغالية. ولنقل مثلا إن رجفة سرت بأطرافه، قبل أن تتحول إلى انتفاض يستبد بجسمه كله، ولنقل أيضا إن عرقا باردا يتفصد من مسام جلده رغم يناير الذى نعتناه من قبل بالجميل القاسى، ثم يداهمه عطش لم يجرب من قبله عطشا فى مثل شدته وإلحاحه. من جانبى يُهيأ لى أن كل شئ سوف يسبق لحظاتنا الأخيرة، فى قيد الحياة، سيكون تجربة غير مسبوقة، سيكون فريدا، ومكتوبا بعناية مذهلة، مثل فقرة أخيرة، تسبق كلمة “تمت” مباشرة، فى رواية مفردة، بلا سوابق أو لواحق، لشيخ مستوحش كمجنون حبيس قبو من عشرات السنين، نسى الكلام ونسيته المعانى. الواحد على أى حال لا يموت كل يوم، لا يسعى للانتحار كلما غلبه السأم، فهل أسمح له بالتراجع الآن، دون أى معجزة أو مصادفة، لمجرد أن يروى عطشه الفريد، كلا، سيموت كافرا أصلا، فليمت ظمآنا بالمرة!
هذه هى إذن متعة كتابة الروايات، المتعة التى تسرى فى أوصال من يكتبنى، المتعة الخبيثة الشريرة التى ورثناها عن أسلافنا – حسب الإيطالى القديم – ممن عاشوا – ويعيشون – أبديتهم فى القاعات الرخامية للأوليمب، الآلهة اللعوب. متعة اللعب بحياة البشر ومصائرهم، حتى ولو كانوا بشرا من حبر أسود على دفتر مصفوف بالمربعات الصغيرة، مثل تشابك قضبان سياج فى سجن، هكذا أراها الآن، وكأننى أنظر من وراء تلك السطور المتعامدة رأسيا وأفقيا، أنظر من الناحية الأخرى للمرآة، امنحنينى وجه الإله يا مرآتى القديمة!
أصرخ أنا الأسير الجميل، والصفة الأخيرة محض مجاملة ذاتية، على سبيل العزاء والسلوان، فمن يستطيع منكم الاستغناء عن النعوت فليلقها بحجر.
كنت أوشك، عند تأملى لهؤلاء الشباب، أن أستوقف واحدا منهم، مثل هذا الولد الذى أراه حاضرا فى محبسى الآن، بعد أن مات وشبع موتا، واحد من هؤلاء المتعجلين والمفعمين بالفتوة واللهفة، فأهمس له بالسر المقدس لسكان الأوليمب، وكأننى قد اطلعتُ عليه فى عزلتى بوصفة سحرية ما:
تمهل فلا أحد يسبق الزمن يا بنى، تمهل، وتذوق نبيذ عنفوانك قطرة قطرة، لا تسفحه هكذا – حرام، هذا نعمة! – بلا ضرورة، على أرصفة اللهاث والمواعيد الخاوية والذهاب والمجئ.
ليكن، سوف أستعيد هذا الشاب ولو على الورق، إنها روايتى الأولى ولى مطلق الحرية فى ارتكاب كل الأخطاء الأدبية التى سجلها تاريخ الكتابة ويحفظها النقاد المتربصون بالمرصاد.
لم يكن بوسع ذلك الشاب، بسمرته النيلية المعروفة فى أرجاء العالم كله، حتى فى يومه الأخير على كوكبنا هذا، أن يتكاسل فى فراشه لبعض الوقت، لقليل من الوقت، ليحلم حلما حارا وفاضحا، فيصحو فى حال غير الحال. فقد اعتاد الاستيقاظ مع النداء؛ الصلاة خير من النوم.
أين ذهبت طرواة أنفاس الصبح؟ يبدو أن الخبثاء يستيقظون مبكرا للغاية هذه الأيام يا أبى، أو أنهم لا ينامون أصلا. لا جدوى من التردد ومراوغة الوقت، لكل شئ نهاية مهما تحايلنا على كلمة الختام. تناول ملف أوراقه واتجه نحو محطة المترو.
أى بنى تمهل فلا داعٍ للعجلة، لأن كل آت قريب، وفى العجلة الندامة. أى بنى، اسمع، اسمعنى، أتعرف؟ لقد قضيت ليلة سيئة، ولم أكد أنام وقرحة المعدة هاجمتنى قرب الفجر مثل لص وغد، ويهيأ لى أننى سمعت كلمة فى حلمى، لكننى فشلت فى تذكرها، وما زاد الطين بلة أننى أبكى فى أحلامى. أى بنى، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تمهل، قبل أن تنزل إلى محطة المترو، قبل أن تسجن نفسك للأبد فى عالم ما تحت الأرض، لن يفتح لك الباب أحد، ليعيدك إلى النور والهواء، مهما كتبوا عنك القصص والروايات، وما هم بفاعلين، فلن يعيدوك إلى الحياة هؤلاء الشيوخ الكذبة، وأنا منهم. نحتوا تمثالك وقتلوك وانتهى الأمر.
أى بنى، امسح على جلدك – الآن، هنا – بقروش الشمس الذهبية والمبذولة فى سخاء لا يصدق، حتى فى صباح من يناير، وشد خيوط الهواء الحريرى عميقا إلى داخل جوفك، حتى لتنتفخ بطنك، المشدودة هذه، من الشبع والرضا. النور والهواء كافيان لأن تنتعش أنت، فتنتعش بدورها القطة السوداء التى تسكننا ونسكنها، ولها ألف اسم، وإن كان أشهر أسماءها هو الروح. ماذا ترجو أكثر من ذلك؟ ماذا يمكننى أن أفعل لك حتى أثنيك عن عزمك؟ لديك كل شئ كان عندى، الشباب والعافية والضوء والأكسجين؟ ماذا تريد؟ وظيفة، السجون كثيرة. أتكفر بالنعمة؟ أليس الوجود، مجرد الوجود، الوجود وحده، الوجود وحسب، الوجود فقط، الوجود المحض، الوجود الحاف، الوجود الخالص، الوجود لذاته وفى ذاته وبذاته، الوجود نعمة، ومن يرفسها أعمى؟
أعرف كيف انتحر هذا الشاب، ولكننى لا أدرى كيف انتحر، تدريجيا وقطرة قطرة ذلك الشاب الآخر. أيهما كنت أحاول أن أستعيد وأستمهل قبل قليل؟ الشاب الذى كنت أراه، على صفحة مرآتى، فى زمان مضى وانقضى ولم يتبق منه غير فتات الصور والذكريات التى تشبه الأساطير. رأيته كثيرا، كل يوم تقريبا من حياتى الخالية، حتى ظننت أنه باق إلى الأبد، وكأنه يعيش حقا فى خلود مستحيل: غدا سأفعل وأفعل – المستقبل مازال بعيدا فى علم الغيب – من حقى أن أخطئ كأى شاب. لم ينتحر، ولكنه اختفى كأن لم يكن، تركته محبوسا ليتغذى على الكتب والكلمات، وذهبت أنا للوظيفة، بين الكتب والكلمات أيضا، وخيط لا يُرى يربط بيننا.
ثم تولد منى، لا مثلما تولد الحكايات والأساطير، تدريجيا وكلمة بعد كلمة، تكتمل وتتخذ سمتها جيلا بعد جيل، بل مثلما تولد المصادفات فجأة من قلب النظام المتوقع الرتيب. تولد المصادفات فننتبه قليلا، أو كثيرا، لتلك الروح الخفية المجنونة باللعب، بنا أو معنا، لا يهم، فهى هنا، قد تختفى ولكنها لا تغيب تماما، لا تكل ولا تمل من إلقاء رسائلها الملغزة فى البريد المسجل، على عناويننا الشخصية، وبالاسم الثلاثى: يلتقى أحمد رجائى عبد المتعال دنيا بفتاة خمرية بديعة الجمال، بين قوسى موت، بل انتحار. يعثر على صورته شابا بين طيات كتاب دينى من كتب أبيه القديمة، لم يفتحه منذ أكثر من عشرين عاما.
أيتها القطة السوداء الكبرى، يا أم هذا العالم، يا ذات العشرة آلاف روح والعشرة آلاف اسم والعشرة آلاف وجه، لماذا تصرين على معابثتى ومشاكستى، لماذا أنا؟ لماذا لم تتركينى نسيا منسيا فى عتمة بئرى؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* فصل من رواية بعنوان ” رجوع الشيخ ” للكاتب تصدر قريبا
* روائي مصري
خاص الكتابة