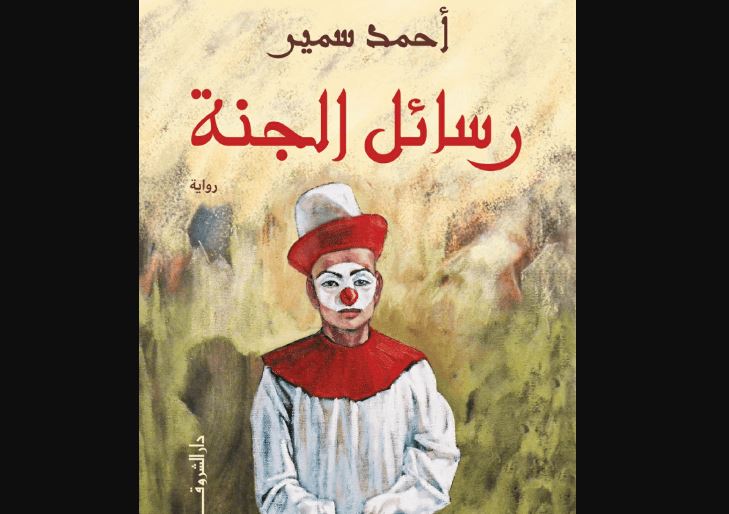الحقيقة أن اختيار عمار على حسن الفنى بأن يكون السرد بأكمله على لسان الأب المحامى ، وبأن يكون كلامه موجها للابن السلفى المارق الغائب، وبأن تنبنى الحبكة بأكملها على نبوءة من الشيخة زينب، كل ذلك أوقعه فى عدة مآزق فنية تضاف الى المباشرة التعليمية، والغياب شبه الكامل لشخصية الابن المحورية، فقد بدت فكرة النبوءة كما لو كانت قدرا مقدورا لا فكاك منه، وكأن الابن السلفى ينفذ مشيئة لا راد لها صدرت قبل مولده، وكلها أشياء غير مقصودة بالطبع من المؤلف، ولكن هذا ما يمكن أن يصل إليك بشكل واضح، تكاد تذكّرنا شخصية الشيخة بالعرافة فى التراجيديات الإغريقية، قبل أن يولد الابن المارق تنبأت الشيخة فقالت عن طفل سيصبح هو الأب فيما بعد :”سيكون له ابن يعصيه، ويجعل أيامه نكدا فى نكد، ينجرح النجم العالى ويسيل دم وتسقط دموع زى الجمر، وتنفتح أرض كلها رمال وصخور، تصفر فيها الريح، وينعق بوم كثير، وتتساقط أزهار يانعة أمام النحل الجائع”، نبوءة مثل هذه منحت تجربة السلفى الإرهابى بعدا أسطوريا وجبريا غير مقصود بالمرة، بينما كان المقصود مجرد حيلة فنية تضفى على الأحداث غموضا وجلالا، وتفتح المجال لنبوءة أخرى بأن يقوم الأب برحلة الى إحدى وعشرين عتبة من منازل القرية، مستعيدا مع ابنه حكايات سلف الأب (لا الابن) الذين كانوا أكثر بساطة وفطرية فى فهم الدين كسلوك فى المقام الأول، هذه العتبات/ الرحلة ستكون وسيلة الأب وأمله الأخير فى استعادة الابن الذى لن يعود.
لم تنجح هذه الصنعة الفنية فى تحقيق هدفها، فلا رحلة العتبات والحكايات نجحت فى استعادة الابن( بل إنها بدت موجهة الى القارىء مباشرة لتذكيره بصحيح الدين وجوهره)، ولا الأب المكلوم بدا قادرا على أن يحمل الفكرة، إذ سنعرف فى نهاية الرواية أنه هائم بمفرده بين طرقات القرية ومنازلها، وأنه يكلم ابنا افتراضيا، ولا عرفنا جدوى أن تحكى لابن لا نعرف أصلا كيف كان ضلاله، وهو بالتأكيد يرفض منطق النبوءة، ناهيك بالطبع عن جدوى إنقاذ رجل عرف الدماء، وقتل ” من أعدائه خمسة وعشرين، يصطادهم من بين عيونهم، فيخرّون بلا حراك، وتسقى دماؤهم حصى الصحراء، ثم يطارد البقية، والشمس تقف منكسرة على سن الجبل، وبعدها تسقط خلفه، ويحل ظلام دامس”. هذا كلام الأب عن ابنه الذى يمكن وصفه بالسفاح، ابن كهذا يحتاج من والده المحامى الى مرافعة قانونية، وليست روحية، لتخفيف الحكم عليه، وآخر ما يفيده ذكريات من زمن قديم عن أشخاص فهموا جوهر الدين بشكل أفضل.
“السلفى” بذلك لم تصبح رواية عن الابن الضال الذى بعث خطابا يكفّر فيه والده، ولكنها أصبحت رواية عن الأب الضائع بعد أن فقد ابنه بنبوءة، ويريد الآن أن يستعيده بنبوءة أخرى، شىء أقرب الى لعبة قدرية، وليست مأساة واقعية لها حيثياتها النفسية والعقلية والإجتماعية والسلوكية، ظاهرة التاسلم الإرهابى معقدة بكل المقاييس، ولا أثر فى الرواية لهذا التعقيد، وبسبب هذا التبسيط انتهينا الى تبسيط الحبكة الى حواديت عن أشخاص آخرين، أصبح بكاء الأب على سفاح قاتل طاف العالم حاملا جنونه من السودان الى تورا بورا وليبيا نوعا من الترف المستفز، وأصبح بناء الرواية عن أب هائم يريد استعادة ابنه السفاح الضال الى أحضانه مستدعيا حكايات أشخاص آخرين، وبناء على نبوءة عجوز جعلت من ضلال الابن قدرا مقدورا حتى عندما كان الأب طفلا.
عند نقطة معينة من السرد الذى يتوالى فى شكل عتبات/ حكايات عن نساء ورجال القرية، تنبه عمار على حسن الى أمرين: الأول هو أنه قد يفقد اهتمام القارىء الذى لم يذهب بالتأكيد الى تورا بورا، مما يتطلب أن يوجد خيطا يعيدنا من جديد الى شىء ما يبل الريق عن الابن الذى تنهمر عليه الحكايات، هنا لم يستطع الراوى سوى أن يقدم شذرات متباعدة، بل لعلك قد تنسى أن الابن تخرج فى كلية الهندسة وسط زحام القصص التى تنتهى كل منها بالتماس العبرة والعظة على طريقة حكايات كليلة ودمنة، وأقصى تشويق سمح به الخيال هو حكاية خطاب أرسله الابن لأبيه، لنكتشف أن هذا السفاح وجد وقتا لكى يتهم أباه بالكفر فى خطاب مكتوب، وكأنه يسجل شهادته للتاريخ، أو كأنه يضيف كافرا جديدا الى قائمة من قام بتكفيرهم.
أما الأمر الثانى الذى تنبه إليه المؤلف محاولا ضبطه بلا جدوى فهو أن كل قصة من القصص ( وبعضها جيد فعلا) يمكن أن تسرد فى سياق آخر ولأى شخص غير ابن عاق وهارب وقاتل، إنها ببساطة حكايات إنسانية عن بشر عاديين ، مسلمين ومسيحيين، والتماس العبرة فى اتجاه وعظ الابن أضر بعض القصص من الناحية الفنية، بل وأفسد معناها المطلق المفتوح، خذ مثلا حكاية حب الجد العجوز قديما للفتاة المسيحية روزالين، وقصة الخفير متولى الذى لم يغفر لنفسه أبدا أنهم سرقوا بندقيته، هذه قصص يفسدها الشرح والتفسير والتماس العبرة والعظة، لأن لها جمالها الفنى الذى لا يجب أن يظله سقف أو يحيطه جدار، بل إن هذه القصص عن البسطاء لا تلائمها على الإطلاق تلك المقدمات المتنبئة الملغزة القادمة من فم الشيخة زينب، الحقيقة أننى كنت أذهب الى الحكايات مباشرة، وأعود الى النبوءة فأبتسم لأنها تفسد بساطة وبكارة الحدوتة، وتوحى إليك بأن يدا تدخّلت فتفلسفت فقللت من طزاجة الحواديت، وفطرية الشخصيات، هذه مثلا مقدمة حكاية سلوى الذى غادرها زوجها الى العراق ولم يعد أبدا، لقد تحولت الى سطور يصعب أن تصدر عن شاعر نحرير، فما بالك لو كانت صادرة عن الشيخة زينب الفقيرة القاطنة فى صهريج الماء الفارغ ؟!، إليك عبارات العتبة السادسة عن سلوى :” حاملة الأفراح والأتراح النائمة فوق سطور تعانق الأبيض الفارغ، تعبر سريعا، فى غفلة من الزمن، قنطرة هشة بين الصبا والكهولة، لتمضى حياتها قاسية فوق أرض بور، منتظرة العابر الذى فقد منها عذريتها فى لحظة وهرب بعيدا، ولم يرسل لها سوى جمرات من عظمه المتفحم راحت تتساقط، بلا رحمة، على وجهها الذى قددته الأيام العصيبة” .
لا يحاول الأب أن يجيب عن سؤال طرحه فى بداية الرواية وهو : كيف أصبح الابن هكذا على غفلة منه؟، وفى ثنايا الرواية يكاد يوحى الأب بأن المتطرفين تعمدوا تجنيد ابنه نكاية فى الأب المحامى المستنير الذى يدافع عن الكتاب والفنانين، والذى يؤيد فكرة الزواج المدنى، كل ما فعله هو أن يحكى لكى يعرف ابنه كيف أصبح والده هكذا، إنه يدعو الابن المارق أن يعيش ما عاشه الأب، وهو فرض مستحيل لاختلاف الأجيال والظروف، إنه ينصح ولده ولكن فى الوقت الضائع، بعد أن تخضبت يداه بالدماء، مشكلة رواية “السلفى” فى أن الفن لم يسعف الفكر، وفى أن ذكريات الأب وتعاليمه فات وقتها، لا الجيل الأكبر قادر عن أن يفسر الحاضر، ولا الجيل المارق يقبل الماضى الذى تمرد عليه، إنها فى الحقيقة مشكلة المجتمع والرواية معا.