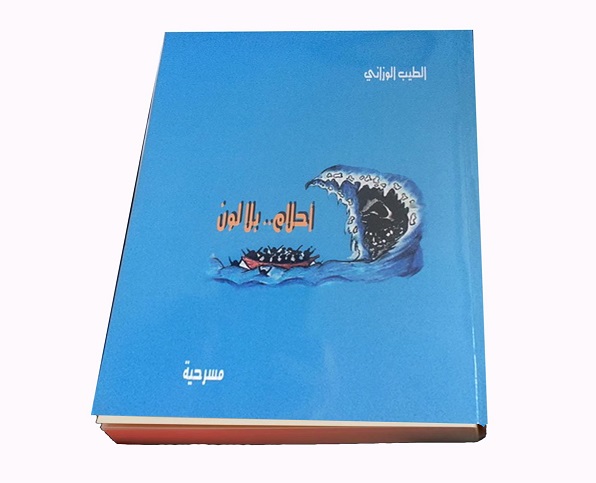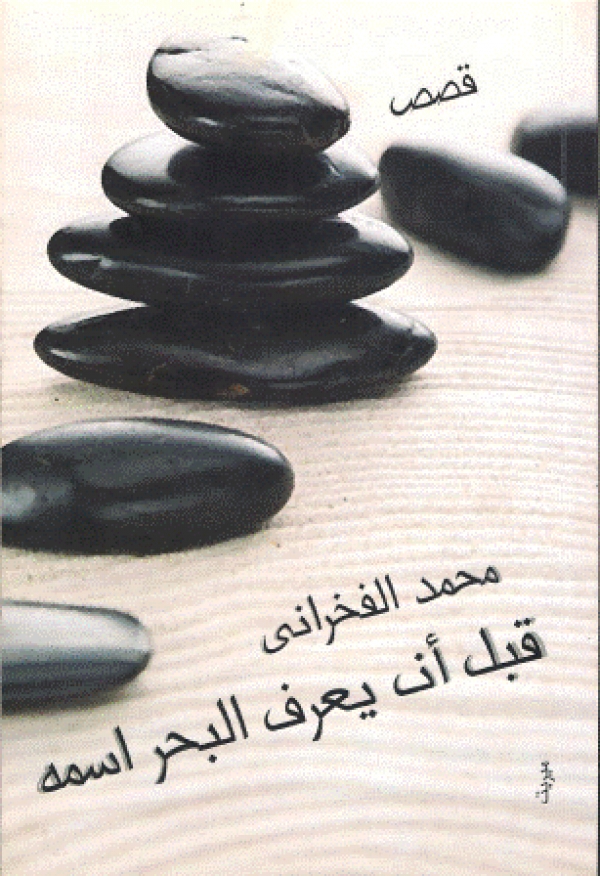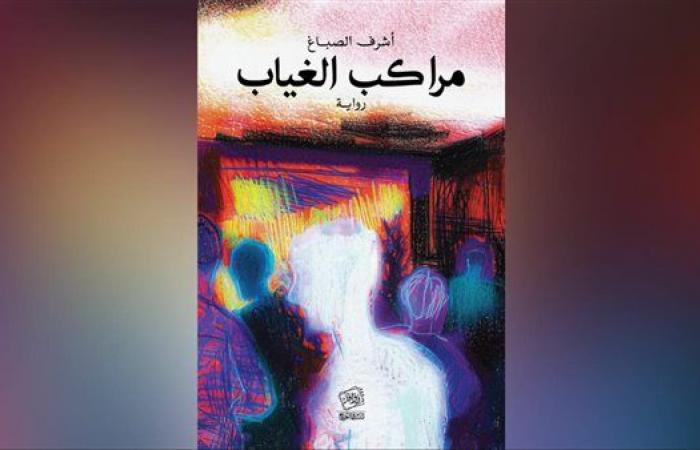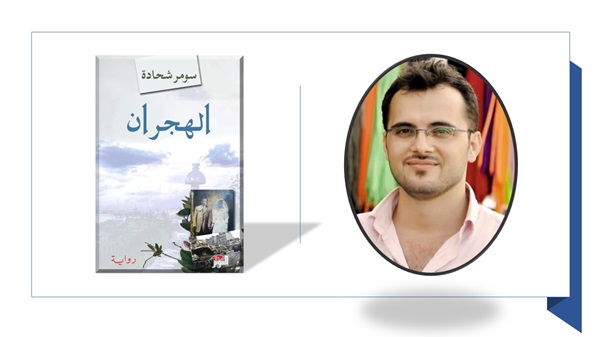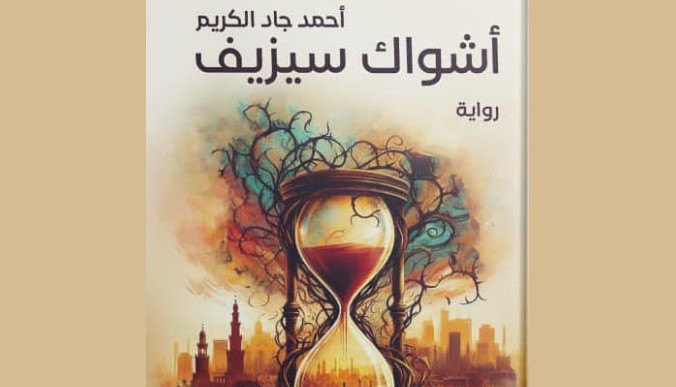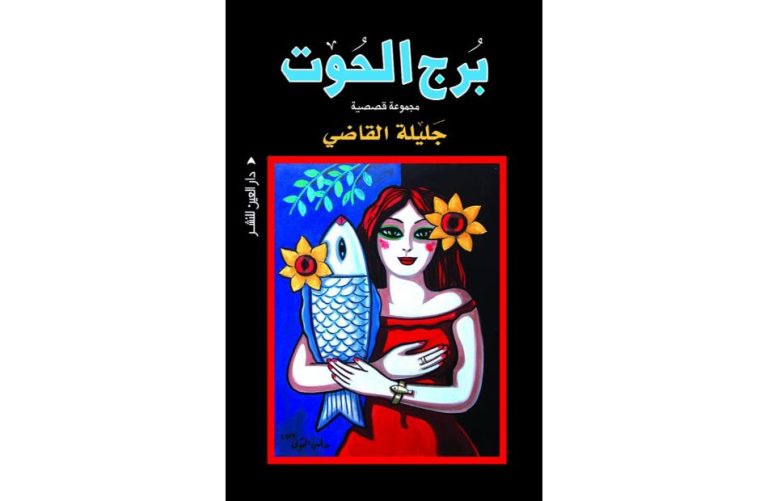عمار علي حسن
فرضت تجربة السجن نفسها على الأدب العربي منذ قديم الزمان، فقد جسد شعراء العرب في الجاهلية والإسلام أشكال التعذيب في السجون ومراحله وأساليبه في قصائدهم، ورسموا صورا واضحة المعالم لشخصيات السجانين ومعاناة السجناء وعذابهم، ولحظات ضعفهم وصمودهم، وهواجسهم وأحلامهم وأفكارهم، وقد تصدى لتناول هذه التجربة الإنسانية القاسية عدد وافر من الشعراء ودبجوا فيها قصائد تقطر ألما، لكن أغلبها فقد، لأسباب عديدة، أهمها الخوف من السلطة.[1] وكان لتجربة السجن، على مساوئها، أثر بعيد متأصل في لغة وصور شعراء العرب، في الجاهلية وبعد الإسلام.
ويرصد الباحث عبد العزيز الحلفي في كتابه “أدباء السجون” تجربة عدد من شعراء العرب الذين ألقت بهم السلطة في غياهب السجن، لأسباب متعددة، ودبجوا في محابسهم قصائد تتسم بالقوة، وتموج بتفاصيل حياة قاسية مفعمة بالتوق إلى الحرية.[2] لكن موسوعة “العذاب” التي وضعها الباحث العراقي عبود الشالجي، ركزت على زاوية مهمة في هذا المضمار حين أسهبت في شرح كافة أشكال التعذيب الجسدي التي مورست في تاريخ العرب، والتي تعبر عن بشاعة ما كان يحدث للسجناء، والمعارضين للسلطان، منطلقا من تحديد أنواع السجون لينتقل إلى شرح العديد من أساليب التعذيب في موسوعته ذات المجلدات السبعة. ومن بين هذه الأساليب، الركل واللطم واللكم واللكز والرجم والوطء بالأقدام والنطح والتعليق من اليدين أو من يد واحدة أو من الساق أو الإبط أو الثدي، والتعليق بالكلاليب، ونتف اللحى وشعر الرأس والبدن، والخصاء وعصر الأعضاء الجنسية، والخوزقة، وقطع الأطراف والسمل وجدع الأنف وسل اللسان وقلع الأسنان وقرض لحم الجسد بالمقاريض، وبقر البطن وقصف الظهر ودق المسامير في اليدين والأذنين، والتعذيب بالنار والماء المغلي أو البارد، والتجويع والتعطيش أو إطعام ما لا يؤكل أو الإجبار على شرب سائل غير مستساغ … إلخ.[3]
وجاء حراس سلاطين العرب المحدثين، شأنهم في ذلك شأن غيرهم ممن يعتمدون القمع وسيلة لتثبيت حكم ظالم ومستبد، ليتفننوا في إضافة أساليب جديدة للتعذيب، بحيث يمكن إضافة مجلدات أخرى إلى هذه الموسوعة.
ومع تواصل القمع صار السجن السياسي أحد الموضوعات الرئيسية للأدب العربي المعاصر، خاصة الرواية السياسية. ومن هنا نجد أنه لا تكاد تخلو رواية من الروايات العشرين، التي تمثل عينة هذه الدراسة من التطرق ، بدرجات متفاوتة، لموضوع السجن السياسي، بدءا من الأسباب التي تلقي بصاحبها إلى هذا المصير المرير، وانتهاء بما يحدث داخل الأقبية والزنزانات المعدة لتعذيب السجناء، مرورا بالمراحل المرتبطة بدخول السجن، ومنها الترويع والملاحقة والاعتقال والحجز، وهو ما تم تناوله في النقاط السابقة.
ويعود اهتمام الرواية العربية بقضية السجن السياسي إلى عدة عوامل، أولها: أن الأدب ينزع بطبيعته إلى الحرية ـ وهو ما ذكر تفصيلا في ثنايا الفصل الثاني ـ ولذا فإن السجن السياسي يمثل تحديا للمبدع لا بد له من أن يجابهه، مسلحا بالكلمة. وإذا كانت هناك دلالة بدهية للروايات التي جسدت السجن، سواء حين كانت البلدان العربية ترزح تحت نير الاستعمار أم بعد نيلها الاستقلال، فهي بقاء الإنسان العربي دائم الشوق إلى الشعور بالحرية في وطنه،[4] باعتبارها ضرورة لا بد من وجـودها.
ويرتبط العامل الثاني بطبيعة الحياة السياسية في العالم العربي، حيث أصبحت البقعة الجغرافية، التي تمتد من الخليج شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، من أكثر مناطق العالم خرقا لحقوق الإنسان، وصارت أنظمتها الحاكمة هي الأشد استبدادا وتعسفا في معاملة المواطن العربي، إذ بات القمع هو أساس التعامل بين السلطة والجماهير، وتجلت مظاهره في جميع مناحي الحياة، كما أن أساليبه تطرأ عليها تطورات مستمرة، تسعى في اتجاه إغلاق الطريق أمام أي محاولة لإحداث ثغرة في جدار الاستبداد،[5]الذي جعل السجون هي المكان الأول الذي يلتقي فيه من بيدهم السلطة بمن يعارضونهم، إذ يلعب الطرف الأول دور السجان، بينما الطرف الثاني هو السجين.
أما العامل الثالث فيتعلق بخلفية العديد من الأدباء الذين أنتجوا الروايات، محل الدراسة هنا، حيث نجد أن “السياسة” موجودة في صميم حياتهم بأشكال ودرجات متفاوتة، ولذا فإنهم مروا بتجربة السجن أو كانوا قريبي الصلة بمن مر بها، أو مورست ضدهم أشكال مختلفة من القمع والقهر.
وقد عالجت الرواية كافة أشكال القمع التي تمارس ضد السجناء السياسيين، ومن بينها تعمد سلطات السجن إهانتهم نفسيا، وتعذيبهم جسديا بقسوة بالغة، تجعل الكثيرين منهم يتمنون الموت، في حين تتم تصفية العنيدين منهم جسديا، وهم الذين يرفضون الاعتراف بتهم ربما لم يرتكبوها ويأبون الإدلاء بأي معلومات تفيد السلطة في القبض على رفاقهم أو معرفة خطط التنظيم الذي ينتمون إليه.
وفي المقابل رصدت الرواية أساليب المقاومة التي ينتهجها السجناء السياسيون من أجل نيل حقوقهم البسيطة داخل السجن، والتي توفرها لهم القوانين المحلية والدولية، وكيف كانت في بعض الأحيان تثمر أشياء، وإن كانت ضئيلة، وأحيانا أخرى، لا تفيد أمام سلطات غاشمة، تصل في قمع الإنسان إلى أقصى حد ممكن. وتؤكد الرواية العربية أن وضع مرتكبي الجرائم في السجون أفضل بكثير من وضع السجناء السياسيين، وهذا إن دل على شئ إنما يدل على أن السلطات الحاكمة في عالمنا العربي لا يهمهما تحقيق الأمن الاجتماعي، بقدر ما تهتم بتأمين كراسي الحكم وحماية مناصب ومصالح فئات بعينها.
وتبرهن هذه المعالجة على أن ما يحدث في السجون العربية أمر متشابه، لا يختلف في الجوهر، وكأن سلطات السجون في تلك البقعة الممتدة من الخليج العربي حتى المحيط الأطلسي، قد اتفقت على أسلوب واحد في التنكيل بالسجناء السياسيين، رغم اختلاف بعض المسميات المرتبطة بجغرافية السجن، كأن يسمى المكان الذي يجمع عددا كبيرا من السجناء في مصر “عنبر” وفي بلاد الشام “مهجع” وفي العراق “سرداب”، أو يطلق على الأماكن الضيقة المعدة للحبس الانفرادي في بعض الأقطار العربية “زنزانة” وفي بعضها الآخر “قبو”، وخلافه.
وقد حدا هذا الأمر بعبد الرحمن منيف، الذي تعد تجربة السجن إحدى المحاور الرئيسية لأعماله الروائية، إلى القول: “إن الفارق بين مكان وآخر في المنطقة العربية، فارق نسبي، وليس نوعيا .. فالسجن السياسي مثلا في أي بقعة عربية لا يختلف عن بقعة أخرى”[6]. وهذا التشابه يمتد حتى من مجرد التصميم المعماري للسجون إلى أسلوب معاملة السجناء داخل الأقبية والزنزانات، مرورا بتفاصيل الحياة اليومية لهم، والتي تدور في مجملها حول الخوف والحرمان والألم.
أما حيدر حيدر، فقد جسد هذا التشابه، بشكل أكثر حدة، على لسان مهدي جواد بطل رواية “وليمة لأعشاب البحر”، حين قال وهو يتحدث إلى والدة فتاته آسيا الأخضر، في معرض مناقشة حول مدى اختلاف الأوضاع في المغرب العربي عنها في المشرق: “في العراق وسوريا ومصر وسائر بلاد العرب، لا يوجد غير النهب والقتل والأكاذيب”[7].
وتبين رواية “رحلة إلى الله” كيف كان السجناء يتعرضون لإهانات شديدة، فهاهو عطوة الملواني مدير السجن يؤكد أن كلبته أهم لديه من مائة سجين، إذ يقول لأحدهم: “توسكا برقبتك ورقبة مائة من أمثالك”[8]، وحين تعافت تلك الكلبة من مرض شديد ألم بها، أمر الملواني من يقرضون الشعر من السجناء أن يدبجوا القصائد في مدحها، وكافأ الطبيب الذي عالجها من بينهم، بأن يعيش مع كلاب السجن، يداوي مرضاها، مقابل أن يأكل مما تأكله، فبات أحسن السجناء حظا، كما تقول الرواية.[9] وهذا بالطبع يبرهن على مدى الإذلال الذي يكابده السجناء، إذ أن الكيلاني يتحدث في مذكراته الشخصية بما يؤكد أن هذا الموقف ليس من صنع خياله، إنما قد حدث بالفعل أمامه في السجن الحربي، وبما يفيد أيضا بأن عطوة الملواني، قد يكون هو المعادل الروائي لحمزة البسيوني، قائد السجن الحربي، في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر[10]
وإذا كان الملواني يعتبر أن كلبته أهم من سجنائه فإن “آمر السجن” في رواية “السرداب رقم 2” للأديب العراقي يوسف الصائغ، له الرأي نفسه، إذ يقول للسجناء: “أنتم أقل من الحيوانات”[11]، وحين يشكون من رداءة الطعام، يصرخ فيهم: “هذا الطعام الذي تستحقونه، وستأكلونه رغما عنكم”[12]. ومن خلال سرد الرواية لبعض الحوارات التي تجري بين الأحد عشر سجينا سياسيا، والتي أفردت لكل منهم فصلا يتحدث فيه عن تجربته، يتضح أن السجناء أنفسهم، وبعد فترة من التعذيب والمهانة، يشعرون بأن الحيوانات أفضل منهم حالا، وأنها لا تتحمل الوضع الذي انتهوا إليه.
وفي أحد هذه الحوارات تفيد الرواية أنه حين شعر أحد السجناء وهو حسين الشكرجي بألم حاد في بطنه، طلب السجناء من رفيق زنزانتهم الطبيب إحسان أن يعالجه، فقال لهم بإصرار: “أنا لست طبيبا” فرد عليه الشكرجي: “ماذا أنت إذن”، فيقول له إحسان “حمار .. صدقوني أنا الآن لا أختلف عن الحمار في الطب والتطبيب .. يجيء أحدكم ويقول أنا مريض، حسنا .. لكننا جميعا مرضى، ما إن يعتقل الإنسان، حتى يغدو مريضا .. ولا علاج له إلا أن تعاد إليه حريته، كيف لا تدركون ذلك؟ وانظروا أنتم أنفسكم .. نحن جميعا نعاني من سوء التغذية، ومن سوء التهوية، ومن سوء المعاملة، فكيف يراد مني أن أعالج كل هذا السوء .. ولا علاج إلا بأن نعود إلى الحياة، إلا بأن نخرج من هذا القبر، أليس غريبا أن يعيش إنسان كما نعيش ولا يوجعه كيانه بأسره؟ جربوا، هاتوا أي حيوان تريدون ..كلبا .. قطة .. وضعوه في هذا السرداب، واجعلوه يعيش كما نعيش وسترون ما الذي سيحل به”[13]. وتؤكد رواية “الآن .. هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى” الوضع ذاته من خلال الحوار الذي يدور بين الطبيب والنقيب مدحت عثمان ضابط السجن، فالطبيب يقول له: “الشروط غير صحية، التغذية سيئة، النظافة معدومة”، فيرد عليه النقيب ساخرا: “هذا سجن يا حكيم، هذا مكان للتأديب يا أفندي، هذا ما هو مصيف، ولا فندق خمس نجوم”[14].
وتنطلق الرواية من اعتبار السجن في حد ذاته إهانة للإنسان، خاصة ذلك الذي لا ذنب له سوى أنه يحب وطنه ويتمسك برؤية معينة لإصلاح شأنه. وتقدم الرواية هذا الموقف على لسان الطبيب ميلان وهو يتحدث عن طالع العريفي قائلا: “هذا المريض كان مصمما على الموت، لأنه يعتبر الموت وحده هو الرد على الإهانة التي وجهت إليه”[15]، في حين يصف الخالدي السجن وما يحدث فيه بأنه عار، فهاهو يبوح، خلال تصفحه للأوراق التي تركها العريفي قبل أن يموت وسجل فيها تجربته القاسية داخل سجون موران: “كنت وأنا أتوغل في ذلك العالم المجنون أزداد مرارة وحقدا، وأزداد اقتناعا أيضا أن هذا العار، الذي حملناه فترة طويلة، السجن، يجب أن ينتهي، أن يزول”[16]. ويؤكد الخالدي وجهة نظره هذه في موضع آخر من الرواية، حين كان يتحدث للطبيب ميلان حول مذكرات العريفي، حيث قال له: “كيف نستطيع أن نتحدث عن الأمور الأخرى ما دام السجن هو عارنا”[17].
لكن العار الأكبر لحق بعبد الله أحد أبطال رواية “السرداب رقم 2″، وهو عامل بناء بسيط، لم يثنه التعذيب الجسدي عن رفض الاعتراف على رفاقه، فأتوا بزوجته واغتصبوها أمامه، فانتابته حالة من الاكتئاب الشديد، وامتنع عن الطعام، ولم يجد حلا للهرب من عاره سوى الفرار من السجن، فانتهى به الأمر إلى الموت، حين سقط من فوق مرحاض السجن إلى الأرض التي كان يظنها ستطيع قدميه وهما تسرعان هربا.[18] وقد امتدت حالته لترعب رفاقه المسجونين معه، إذ كلما كان أحدهم يراه، كان يخشى أن يجد نفسه يوما ما في مواجهة المأساة التي تعرض لها عبد الله. ولم تكن زينب دياب بطلة رواية “الكرنك” أحسن حالا من زوجة عبد الله، كما سبق التناول.
لكن الأخيرة، لم تكن المقصودة من هذه الواقعة البشعة، إنما كان الغرض هو إخضاع زوجها، على العكس من حالة الأولى. وما جرى لزوجة عبد الله كاد أن يجري على سلوى إحدى شخصيات رواية “رحلة إلى الله”، فهاهي تقول لنبيلة وهما قابعتان في زنزانة واحدة: “تصوري .. حاولوا هتك عرضي .. في أي قانون؟ .. في أي شريعة هذا؟”[19]
وعود على بدء هناك سؤال يطرح نفسه في هذا المقام هو: لماذا اعتبر الخالدي أن السجن عار، يجب التخلص منه؟… إن الإجابة التي تأتي للوهلة الأولى هي أن ما يحدث داخل السجون العربية أمر لا يجب أن يواجهه، على الإطلاق، أي آدمي، ففضلا عن الإهانة النفسية، التي سبق شرح بعض صورها، يأتي التعذيب الجسدي، الذي يفوق قدرة أي إنسان على التحمل، في مكان لا يصلح حتى لمعيشة الحيوانات. وتفضح رواية “الآن .. هنا” جانبا من هذه المكان حين تصف إحدى المهاجع “الزنزانات” التي يقضي فيها السجناء سنوات طويلة قائلة: “مع انفتاح الباب هفت رائحة من الداخل لا يمكن أن تجد وصفا أو اسما يحددها أو يقربها، فهي مزيج من العفونة والرطوبة ورائحة البول وروث الدواب والمطهرات القاسية والفطائس ولا أعرف أي شئ آخر”[20].
وفي موضع آخر توضح الرواية كيف كان يتم حجز السجناء أحيانا في مرابط الدواب.[21] وينطبق هذا الوضع الكريه على السرداب الذي كان أبطال رواية “السرداب رقم 2” يقضون فيه فترة سجنهم، فهو في نظرهم “قبر كبير”، ينتظرون كل يوم بفارغ الصبر أن يخرجوا منه، حتى لو كان الثمن هو لهيب سوط الحارس، الذي يضرب أجسادهم أثناء ذهابهم فجرا إلى المرحاض.[22]
وداخل هذه الأمكنة، التي تعافها الحيوانات، يواجه السجناء العزل أناسا يمثلون سلطة غاشمة، مدججين بكافة أدوات وآلات التعذيب، بعضهم يحملون بين جوانحهم نفوسا مريضة، تتلذذ بتعذيب الآدمين. وتصف لنا رواية “الجذوة” ملمحا من ملامح هذا التعذيب في عبارة على لسان شاهين فرج الشماس، الذي قاده النضال النقابي إلى السجن، إذ يقول: “هذه العصا التي تنهال على ظهورنا بلا رحمة حتى ننحني في شكل القوس وصورته، من الأرض إلى الأرض، كنا في الطفولة نزحف ورجعنا في الشيخوخة نزحف”[23]، وتبتعد رواية “رحلة إلى الله” عن هذه الرمزية التي تقف على أكتاف فعل واقعي بغيض، لتدخل مباشرة إلى تصوير بعض مشاهد التعذيب، فتقول: “تجري طوابير السجناء الأذلاء، حليقي الرؤوس، والسياط العنيفة تهوي على أجسادهم ووجوههم وهاماتهم .. وحتى مرضى القلب والضغط والشلل وذوي العاهات، يجبرون على الجري والسياط تلهب ظهورهم”[24].
ويتكرر المشهد، بحذافيره، في رواية “الآن .. هنا”، حيث يقول عادل الخالدي، الذي ظل سجينا لمدة عشر سنوات: “ما كدنا نقع بين الصفين، حتى بدأت تنهال علينا الضربات من كل مكان بالعصي، بأعقاب البنادق، بالأحزمة العسكرية، بالأرجل، كانت تنهال كالأمطار، كالشهب، على الرؤوس، على الأكتاف، على قصبات الأرجل، على الظهور”[25].
ومع هذا الوضع كان من الطبيعي أن يصبح الخالدي، مع توالي التعذيب، “كومة من اللحم المعجون بالدماء[26]“. أما صديقه طالع العريفي، الذي قضى في السجن خمس سنوات، فيعبر عن مدى قسوة التعذيب في جمل قصيرة مثل: ” لن تتاح لهم الفرصة، مرة أخرى، لكي يمارسوا على أي نوع من العذاب، إلا إذا كانوا يمارسون التعذيب أيضا مع الموتى” و”حاولت أن أعدل تلك الكومة من الأعضاء التي كنتها” و”مثل دودة عمياء مشيت وراءه” و”لا أعرف كم من الأيام مر وأنا في وضع أقرب إلى الغياب”، ثم جاء الطبيب ليلخص، في جملة قصيرة، ما قاله طالع ـ وهو يضمد الجراح التي خلفها التعذيب في جسده ـ في جملة قصيرة، حين قال مستاء : “حتى الوحوش لا تصل إلى هذه الدرجة من القسوة”[27].
واللافت للانتباه أن أبطال كافة الروايات العربية، موضع الدراسة هنا، الذين ألقت بهم السياسة إلى غياهب السجون، يعتبرون الموت أفضل بكثير من حياة الزنازين والسراديب المعتمة، حيث الهوان والتعذيب. فهم، في البداية، يعتبرون موتهم قضية محسومة، نظرا لشدة التعذيب ووحشيته، من ناحية، ونظرا لأن السجان لا يعتد بموتهم، ويشعرهم كل لحظة أن حياتهم لا تساوي عنده أي ثمن، من ناحية ثانية.
وقد لخص طالع العريفي هذا الوضع برمته في جملة جاءت في ثنايا مذكراته، هي: “في لحظات كثيرة افترضت أن الغاية أو النتيجة المؤكدة لهذا الضرب أن أموت”[28]، وهو ما يؤكده زميله عادل الخالدي، في عبارة، استهل بها عبد الرحمن منيف روايته، تربط السجن بالموت، مفادها: “حين بدا موتي وشيكا .. أطلقوا سراحي .. لم يكونوا راغبين أن أموت عندهم، رغم أنهم لم يكفوا عن التأكيد، خاصة خلال الفترة الأولى من الاعتقال على أني لن أخرج من هنا إلا إلى القبر”[29]. وإذا كان هذا هو إحساس ورأي سجينين، فإن هناك سجانا يؤكد أنهما لا يكذبان، وهو عطوة الملواني مدير السجن الحربي في رواية “رحلة إلى الله” الذي يقول : “عندي تصريح بالتخلص من كل عنيد”[30].
وبالفعل تقدم الرواية العربية نماذج لكثيرين ماتوا في السجون تحت وطأة التعذيب الوحشي، فمحمود صقر، أحد شخصيات رواية “رحلة إلى الله” فارق الحياة وهو يئن من فرط الضرب والتنكيل، ثم ادعت إدارة السجن أنه هرب، وحلمي حمادة، أحد أبطال رواية “الكرنك” لم يتحمل الضرب المبرح الذي لاقاه حين دافع عن نفسه في حجرة التحقيق، فانقضى أجله، وكاكا كريم هو واحد من أحد عشر سجينا، يمثلون أبطال رواية “السرداب رقم 2” فارق الحياة، جراء الهوان والتعذيب “سحلوه وأخذوه إلى زنزانة منفردة، وهناك صبوا عليه البول، وتركوه ليلتين في البرد دون طعام ولا غطاء”[31].
وهناك حالة أكثر بشاعة، رصدتها رواية “وليمة لأعشاب البحر”، تتعلق بالمناضل الجزائري على بومنجل، الذي ألقى بنفسه من شرفة عالية وسقط ميتا حتى ينجو من تعذيب الفرنسيين، الذين كانوا لا يتورعون في فعل أي شيء للتنكيل بالمناضلين، وهو ما أوضحته الرواية فيما بعد وهي تسرد ما حدث لعمر يحياوي، وكأنها تبرر ما فعله بومنجل، فالفرنسيون عذبوا يحياوي حتى الجنون، ولدرجة أنه فقد عينه اليسرى، وفي واقعة من وقائع تعذيبه المستمر، أصيب بحالة هياج، فكسر نافذة زجاجية وراح يطعن نفسه، وهو يصيح: “الله أكبر .. اشهدي يا جزائر .. اشهدي”[32]. ومن خلال كافة هذه الحكايات، يتضح، مرة أخرى، ما يؤكد أن ما حدث لبعض المعارضين السياسيين قبل استقلال الدول العربية، تكرر في حقبة ما بعد الاستقلال، وكأن شيئا لم يتغير.
وتبين رواية “الآن .. هنا” أن القتل يكون أحيانا جماعيا ” الذين قتلوا بعد أن قضوا فترة قصيرة في سجن العبيد كثيرون، والذين ماتوا كمدا، أو بالسم الذي يوضع لهم في الطعام، لا يحصى عددهم، أما الذين قدر لهم أن يخرجوا من السجن فقد صدف أن ماتوا بعد فترة قصيرة”[33]. وتبرز الرواية ثلاث حالات لأشخاص ماتوا بسبب التنكيل والتعذيب، الأول هو عثمان المصلح الذي “استمروا في تعذيبه ثلاثة أيام بلياليها، ولكنه لم يعترف، وكل يوم تعذيب إضافي، يجعله أكثر إصرارا أو عنادا، وفي اليوم الثالث، عند الغروب، مات”[34].
والثاني والثالث هما حامد زيدان وصادق الداودي، اللذان كانا من السجناء العموميين، حيث استدرجهما حراس السجن، بحجة وجود حريق بمطبخ السجن وأنهم يحتاجون مساعدتهما، ولما دخلا المطبخ، أغلقوا عليهما الباب، وانهالوا على حامد زيدان ضربا، ثأرا لزميلهم خليل خيرو الذي كان زيدان قد ضربه ذات يوم، بعد أن ضاق ذرعا بمعاملته الفظة، وحين اشتبك الداودي معهما ليخلص صاحبه، ألقوا بهما معا من المكان المرتفع الذي تلقى منه القمامة، ولأن السجن فوق قمة تل، سقطا ميتين.[35] وكما فعل عطوة الملواني في التعمية على موت محمود صقر، تصرف مدحت عثمان في موت زيدان والداودي، حيث أعد تقريرا، عزا فيه موتهما إلى مشادة وقعت بين السجناء السياسيين والسجناء العموميين.
عند هذا الحد نجد أن هناك تساؤلا يفرض نفسه وهو: هل كان السجناء يستسلمون للإهانة والتعذيب الذي أفضى ببعضهم إلى الموت، أم أنهم كانوا يقاومون السجن والسجان؟.. تنبئنا الرواية العربية ــ في حدود العينة موضع البحث ـ أن بعض السجناء كانوا سلبيين في مواجهة ما يحدث لهم وبعضهم كان يفكر ويخطط بطريقة إيجابية، والجميع كانوا يتقلبون بين السلب والإيجاب، في بعض الأحيان، وحسب ظروف السجن ومعاملة السجان، وهناك من تحول موقفه السلبي، بعد أن تعمق إحساسه بالظلم والإهانة، إلى فعل إيجابي.
والموقف السلبي كان أحيانا لا يفارق حدود تمني انهيار السجون أو تمني الموت، فهاهو شاهين فرج الشماس بطل رواية “الجذوة” يقول وهو يرى عنتر السجان يهيم بالمطرقة التي يضرب بها السجناء: “متى تسقط كل القيود؟ .. متى لا يكون هناك في العالم غير الحدائق والمنتزهات، وتكون السجون متاحف مثيرة للدهشة، متى تسقط المطرقة من يد الشيخ عنتر”[36].
لكن هناك من تردوا في السلبية إلى درجة أقل من مجرد الحلم بالحرية للجميع، ولم يتعد ما تمنوه حدود الرغبة في الموت، ففي رواية “رحلة إلى الله” نجد محمود صقر يتوجه إلى الله ويخاطبه سبحانه وتعالى قائلا: “خذني إليك فأنا لا أرهب الموت .. لم يعد في الحياة شيء يستحق الحياة”[37]، وتئن نبيلة، بطلة الرواية، وهي ملقاة في ركن الزنزانة وتقول “ليتني أموت”[38]، وفي رواية “السرداب رقم 2” التي تبوح على لسان الرواي “ثمة ميت في هذا القبر الكبير .. أما الآخرون فينتظرون الموت”[39]، يحدث أحد السجناء وهو العجمي نفسه قائلا: “لا بأس لن ألبث أن أموت .. ولكن الموت لا يجيء”[40]، ويكرر زميله سليمان المحامي القول نفسه “ما هذه حياة .. الموت أرحم”[41].
أما الموقف الإيجابي للسجناء السياسيين فتراوح بين كتابة الشعارات المناهضة للسجن والسجان، والمحرضة على مقاومة البطش والظلم على جدران السراديب والزنازين وبين التشاجر مع حراس السجن، مرورا بمحاولة تنظيم إضراب عن الطعام، أو الهروب من السجن. ويتحدث طالع العريفي أحد أبطال رواية “الآن .. هنا” عن أن الشعارات المحفورة على جدران زنزانته، ربما بمسمار حاد، تؤكد على الصمود، وتطلب من كل جديد أن يتحمل ويتماسك، لأن السجن مهما طالت أيامه، لابد أن ينتهي.[42]
وقد تغلغلت هذه الكلمات المكتوبة في نفس طالع، وساهمت في تجلده، وإيمانه بقضيته، ويلخص هو هذا الصمود في عبارة أثيرة، يقول فيها “من العار بعد هذا الإذلال أن أقدم لهم لحمي عشاء شهيا، يتمتعون به، ثم إني أدافع عن قضية عادلة وبسيطة، حقي وحق الآخرين في الحياة والحرية، وهم يدافعون عن امتيازاتهم، وعن السلاطين والشيوخ الفاسدين، ولذلك يجب أن أكون أقوى منهم، لأن قضيتي هي المشروعة”[43].
أما محاولة الإضراب فقد أشارت إليها روايتا “السرداب رقم 2″، و”الآن .. هنا”، وفي الرواية الأولى كان الداعي للإضراب هو الطبيب إحسان أحد السجناء، الذي كان يربط دائما بين سوء المعاملة والتغذية والتهوية وبين الأمراض التي تصيب المساجين من آن لآخر، ولذا كان يصرخ فيهم دائما: “افعلوا شيئا من أجل تحسين الطعام .. من حقنا أن نرفض طعاما يؤدي بنا إلى التسمم”[44]. أما الرواية الثانية فقد تناولت بإسهاب، ومن خلال تجربة عادل الخالدي، الإضراب كورقة ضغط يستخدمها السجناء السياسيون ضد سلطات السجن كي تستجيب لمطالبهم، التي تتركز حول تحسين ظروفهم اليومية، وتحدد الرواية سبب التفكير في الإضراب على لسان الخالدي، حين يقول: “لأن الإدارة أخذت تتشدد وتحرم السجناء من أبسط الحقوق التي يتمتعون بها، حقهم في الزيارة الشهرية، وتلقي رسائل الأهل، وحقهم في الاستحمام كل أسبوع، وزيارة الطبيب عند الضرورة، ولأنها قلصت فترة التنفس إلى النصف، وساء الأكل أيضا، فقد بدأ التفكير بإعلان الإضراب عن الطعام”[45].
وتعرض الرواية، كيف لم يكن كافة السجناء متفقين على الإضراب، إذ أن البعض منهم شكك في جدواه، في بلاد لا يمثل الإنسان بالنسبة للسلطة فيها أي قيمة، ولذا فإنه من الممكن أن يبدأ إضرابا عن الطعام ينتهي بموته دون أن يسأل أحد في مطالبه، واقترح بعض السجناء أساليب بديلة مثل مخاطبة إدارة السجن بشكل ودي، أو الصدام المباشر معها، وضرورة إشراك السجناء العاديين في الإضراب. وينتهي الجدل على عدم اتفاق على تنظيم الإضراب، فيلجأ بعض السجناء إلى أساليب إيجابية أخرى.
ومن بين هذه الأساليب، الهروب من السجن، أو حتى التفكير فيه، فإبراهيم أحد أبطال رواية “السرداب رقم 2” طالما حدث زملائه بنيته في الهرب، الذي كان يعتبره “أحسن من الموت بالجنون .. أو ارتكاب جريمة”[46]، وحين يقول له الراوي، مستدعيا في ذلك تجربة عبد الله الذي سقط ميتا حين كان يقفز هاربا من فوق سور السجن: “وإذا سقطت ومت”[47] فيرد إبراهيم ” الموت هكذا أحسن .. منذ سنة ونحن في هذا السرداب، هل أطلق سراح أحد منا .. سأطلق سراحي بنفسي، لأنني إن لم أفعل فسأفقد صوابي”[48].
ولم يكن إبراهيم يريد الهروب لأنه يتعرض للتعذيب والمضايقة في السجن فقط، بل كان يريد أن يجيب على تساؤل طالما أرقه عن زوجته التي تدبر معيشتها وتلبي احتياجات أبنائها رغم أن أهلها يقاطعونها، لأنها تزوجت شابا يعمل بالسياسة، ورغم أن إبراهيم لم يترك لها أي مال قبل اعتقاله. لكن أمر إبراهيم تسرب إلى إدارة السجن، ففوجئ قبل أن يشرع في الهروب، باستدعائه، ليختفي بعدها عن زملائه، ولا يعرفون ما حدث له بالضبط.
أما سامي أيوب أحد شخصيات رواية “الآن ..هنا” فقد تمكن من الهرب من سجن عمورية، وهو الذي يحمل على كتفيه حكمين بالإعدام، وكان مثل المشجب، تعلق عليه، وتنسب إليه، مسؤولية الكثير من القضايا، باعتباره غائبا، وانتهى به الحال إلى باريس، ليسكن، وزوجته وأولاده الخمسة، غرفة واحدة في إحدى الضواحي الفقيرة للعاصمة الفرنسية، وصارت لديه مشكلات لا يقوى على حملها عدة رجال.[49] وهرب كذلك، محي الدين الأحدب، وهو من الشخصيات الثانوية في الرواية،[50] وتسبب هروبه في مزيد من التعذيب لزملائه على يد مدير سجن القليعة، النقيب مدحت عثمان.
ويبلغ العمل الإيجابي ذروته، حين يصطدم حامد زيدان بالمساعد خليل خيرو، في رواية “الآن ..هنا” ، بعد أن نفد صبره من معاملة المساعد الخشنة له، ولزملائه من السجناء، فقد تطورت مشادة كلامية بينهما، لتنتهي إلى معركة حامية الوطيس، بين السجناء والحراس، تصفها الرواية بقولها: “وخلال دقائق قليلة اشتعل المهجع، تحول إلى كتلة من الجمر، وخلال دقائق لاحقة اشتعل السجن، هرب الذين مع المساعد، وتحول المساعد ذاته إلى فأر، تنهال عليه الصفعات وتدوسه الأرجل”[51]. وقد دفع حامد زيدان حياته، بعد ذلك، ثمنا لهذا الموقف الشجاع.
……..………………..
[1] لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع أنظر: د. واضح الصمد، “السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي”، (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع)، الطبعة الأولى، 1995.
[2] لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع أنظر: عبد العزيز الحلفي، “أدباء السجون”، دار الكاتب العربي، الطبعة الثانية، د. ت.
[3] عبود الشالجي، “موسوعة العذاب”، (بيروت: الدار العربية للموسوعات)، د. ت.
[4]د. سمر روحي الفيصل، “السجن السياسي في الرواية العربية”، (دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب)، الطبعة الأولى، 1983، ص: 19.
[5] عبد الرحمن منيف، “بين الثقافة والسياسة”، (الدار البيضاء/ بيروت: المركز الثقافي العربي)، الطبعة الأولى، 1983، ص: 162/163.
[6] أنظر: حوار مع عبد الرحمن منيف، أجراه سعيد الشحات، ونشرته مجلة القاهرة، بعددها الصادر في فبراير/ مارس 1997، تحت عنوان “دكتاتورية المؤسسة السياسية”، ص: 162.
[7] حيدر حيدر، “وليمة لأعشاب البحر .. نشيد الموت”، (بيروت: دار أمواج للطباعة والنشر والتوزيع)، 1998، ص: 86.
[8] نجيب الكيلاني “رحلة إلى الله”، الطبعة الأولى، 1979، د ، ص: 116.
[9] المصدر السابق، ص: 120.
[10] حول هذه التجربة كاملة أنظر: نجيب الكيلاني، “لمحات من حياتي”، (بيروت: مؤسسة الرسالة)، الطبعة الأولى، 1985، ص: 189/ 245.
[11] يوسف الصائغ، “السرداب رقم 2″، (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة)، سلسلة آفاق الكتابة، الطبعة الأولى، مايو 1997، ص:78.
[12] المصدر السابق، ص: 88.
[13] نفسه، ص: 70.
[14] عبد الرحمن منيف “الآن … هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى”، (نيقوسيا: مؤسسة عيبال للدراسات والنشر)، الطبعة الأولى، 1990، ص: 437.
[15] المصدر السابق، ص: 66.
[16] نفسه، ص: 63.
[17] نفسه، ص: 71.
[18] السرداب رقم 2، ص: 9/ 30.
[19] رحلة إلى الله، ص: 77.
[20] نفسه، ص: 334.
[21] الآن .. هنا، ص: 419.
[22] السرداب رقم 2، ص: 28.
[23] محمد عبد الملك “الجذوة”، (بيروت: دار الفارابي)، الطبعة الأولى، 1981، ص: 77.
[24] رحلة إلى الله، ص: 7، وص: 135.
[25] الآن .. هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى، ص: 371.
[26] المرجع السابق، ص: 96.
[27] نفسه، صفحات: 215 و216 و218 و249 و277 على التوالي.
[28] نفسه، ص: 168.
[29] نفسه، ص: 7.
[30] رحلة إلى الله، ص: : 35.
[31] السرداب رقد 2، ص: 95.
[32] وليمة لأعشاب البحر، ص: 59 ، ص: 267/ 269.
[33] الآن ..هنا، ص: 207.
[34] المصدر السابق، ص: 190.
[35] نفسه، ص: 537.
[36] الجذوة، ص: 74.
[37] رحلة إلى الله، ص: 35.
[38] المصدر نفسه، ص: 75.
[39] السرداب رقم 2، ص: 100.
[40] المصدر السابق، ص: 124.
[41] نفسه، ص: 101.
[42] الآن .. هنا، ص: 181.
[43] المصدر السابق، ص: 228.
[44] السرداب رقم 2، ص: 73، ص: 80.
[45] الآن .. هنا، ص: 363.
[46] السرداب رقم 2، ص: 58.
[47] المصدر السابق، الصفحة نفسها.
[48] نفسه، ص: 61.
[49] الآن .. هنا، ص: 152.
[50] المصدر السابق، ص: 463.
[51] نفسه، ص: 477.