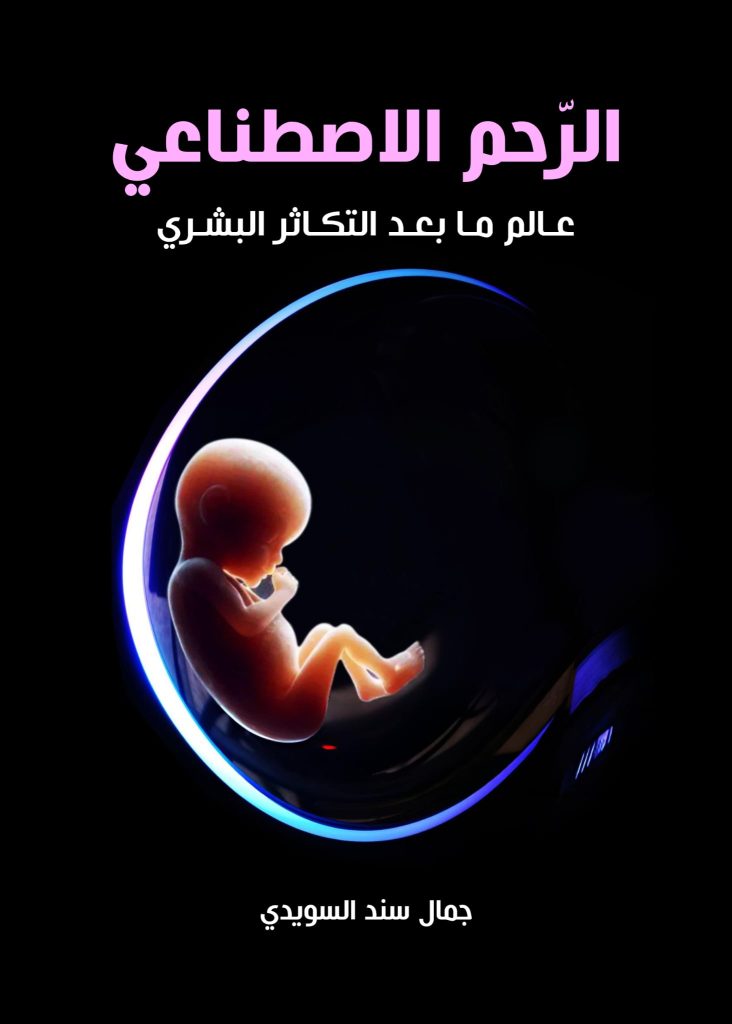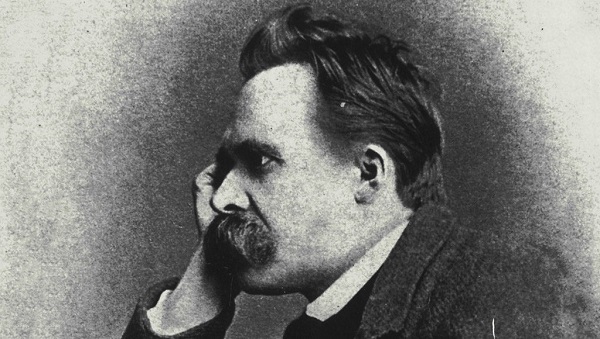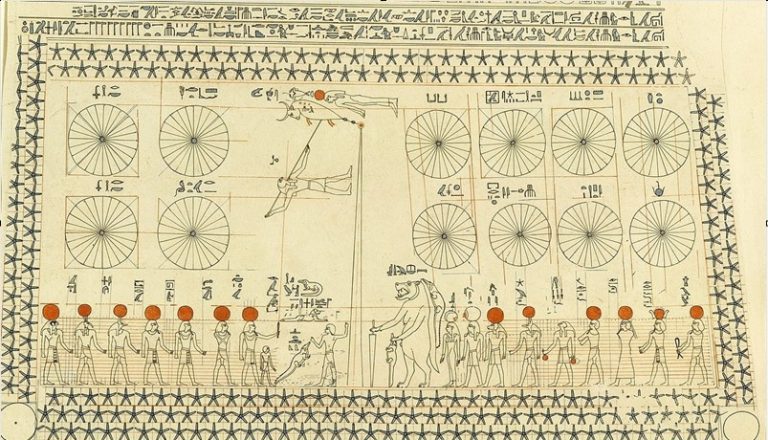عمار علي حسن
في روايته “عالم جديد شجاع”، التي صدرت عام 1932 توقع الكاتب الإنجليزي ألدوس ليونارد هكسلي، نمو الأجنة من نطفة إلى علقة فمضغة تصير عظامًا تُكسى لحمًا في قوارير زجاجية، وليس في أرحام النساء.
وعملًا بالقاعدة التي أؤمن بها دومًا، وهي أن الأدب يسبق العلم بقرن من الزمن على الأقل، فها هم العلماء يسعون إلى ما اعتبره الناس وقت صدور الرواية ضربًا من الخيال الجامح، مع أن العالم المسلم ابن النفيس (ت 1288 م) قد تحدث عن التوالد الذاتي، أي التخلق دون التقاء ذكر بأنثى، في كتابه “الرسالة الكاملية في السيرة النبوية”.
منذ آدم وحواء وحتى وقت قريب لم يعرف البشر من وسيلة للتكاثر إلا بزواج الرجال من النساء، ولا يعرفون مكانًا تستقر به الأجنة إثر تخصيب حيوان منوي ذكري لبيوضة أنثوية إلا رحم المرأة، لكن ها هي الأبحاث العلمية الجديدة تسابق الزمن في سبيل حدوث حمل كامل خارج الجسد الأثنوي، أي خارج الرحم الطبيعي للمرأة.
من قبل، مررنا بمسار في الإنجاب لم يحدث جدلًا عارمًا مثلل “الحقن المجهري”، وهو أحد تقنيات التلقيح الصناعي، تقوم على حقن حيوان منوي واحد داخل بويضة ناضجة في المختبر، ثم زراعة البويضة المخصبة في رحم الزوجة لمحاولة تحقيق الحمل. وجاء مسار يسمى “الأم البديلة” وهي سيدة يتم تأجير رحمها لزراعة جنين تم إنشاؤه من بويضة وحيوان منوي لزوجين أو متبرعين، وذلك للتغلب على صعوبات طبية عند الزوجة تحول دون تلبية رغبة الزوجين في الإنجاب.
تتعدى الأرحام الاصطناعية أيضًا مسألة البحث عن “الإنسان الكامل” وفق ما كتبه الصوفي المسلم عبد الكريم الجيلي، إذ كان يريد للإنسان الطبيعي أن يرتقي أخلاقيًا، ويسمو روحيًا ليبلغ الكمال الإنساني، كما يتعدى ما تصوره الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشة عن “السوبرمان”، الذي أراده إنسانًا طبيعيًا لكنه كامل القوة وكأنه إله على الأرض، وهي الفكرة التي آمنت بها النازية ولذا سعت إلى التخلص من المعاقين، وكل من توهمت في خلقتهم نقصًا من المنتمين إلي أعراق أخرى.
كل هذا يختلف عن “الرحم الاصطناعي”، الذي تجري عليه الآن بحوث فائقة التقنية، ورغم أنها في مراحلها الأولى، وتجري على الحيوانات، وتقيدها قواعد أخلاقية، فإن التقدم المذهل في هذا المجال، لاسيما مع الذكاء الاصطناعي، يفتح الباب إلى مرحلة مغايرة تمامًا من التكاثر البشري، حيث يتيح الذكاء الاصطناعي فرص قوية لتحليل البيانات البيومترية والفيزيولوجية الضخمة للجنين لتوفير بيئة مُحسنة تضمن نموه الصحي، من خلال تقنيات التعلم الآلي، ما يتيح إمكانية التنبؤ بالمخاطر الصحية واتخاذ تدابير استباقية لحماية الأجنة.
ويثير هذا التطور تساؤلات حقيقية حول النوايا الكامنة وراءه، لاسيما أن التجارب التي تجري في هذا المضمار تحيطها السرية والكتمان، بما يجعل من الصعب، الآن على الأقل، التحقق من مدى التقدم الذي بلغته هذه التقنية الرهيبة.
وفي حين ينقسم أهل الاختصاص بين مؤيدين يشجعون هذه التقنية ويرون فيها تقدمًا طبيًا غير مسبوق وبين معارضين يحذرون من تداعياتها السلبية، يأتي التقدم السريع في علم زراعة الأعضاء والتكنولوجيا الحيوية، ليرجح احتمال إضفاء الشرعية على هذه الممارسات في المستقبل القريب، لاسيما مع دخول بعض المؤسسات البحثية، مثل معهد “ماكس بلانك” في ألمانيا وجامعة “ليدن” في هولندا، في تجارب متقدمة، على هذا الدرب.
فهذه التقنية شهدت تطورات متسارعة، بدأت بتجارب علمية في الثمانينات والتسعينيات، ثم اندفعت في قفزة نوعية مع تطوير كيس حيوي يحاكي السائل الأمنيوسي في عام 2017، ووصولًا إلى مشروع “إكتو لايف”، الذي يُتيح تصميم الأطفال وراثيًًا، تلبي رغبات الأهل باستخدام تقنية “كريسبر كاس 9”.
وإذ تندرج ضمن الموجة التكنولوجية الحيوية الحديثة التي تمزج بين الذكاء الاصطناعي والتقدم في مجالات الهندسة الوراثية وزراعة الخلايا، تتطور الأبحاث المتعلقة بالأرحام الاصطناعية وفق ثلاثة نماذج رئيسية: نموذج يُحاكي تطور الجنين في الحيوانات، ونموذج مبكر يهدف إلى تعويض الرّحم الطبيعي في المراحل الأولى من النمو، ونموذج متأخر يسعى إلى توفير بيئة أمنيوسية اصطناعية لدعم تطور الأجنّة في مراحل الحمل المتقدمة، ما يعيد تعريف مفاهيم الإنجاب والولادة، بل مفهوم الإنسان نفسه، ويفتح الباب أمام أسئلة جوهرية حول مستقبل التكاثر البشري.
ويخبرنا كتاب “الرحم الاصطناعي.. عالم ما بعد التكاثر البشري” للكاتب والأكاديمي البارز د. جمال سند السويدي، الذي صدر مؤخرا، بالتأثيرات العميقة والجارحة لتقنية الرحم الاصطناعي على مستقبل البشر، معتبرًا إياها ثورة في الطب، سواء بجوانبها السلبية أم الإيجابية.
لا تخلو هذه التقنية من فوائد، حين توفّر حلًا عمليًا للأزواج الذين يعانون من العقم، بالإضافة إلى تمكين النساء غير القادرات على الحمل لأسباب صحية أو جراحية من إنجاب أطفالهن البيولوجيين. كما قد يسهم الرّحم الاصطناعي في خفض معدلات الإجهاض والإملاص (موت الجنين في رحم الأم قبل الولادة)، وإنقاذ حياة النساء اللواتي يواجهن مضاعفات الحمل القاتلة، فضلًا عن دور هذه التقنية في توفير بيئة آمنة للجنين تحميه من العدوى والملوثات، وكذلك التدخلات الجينية لعلاج الأمراض الوراثية ومنع انتقالها، حيث تُستخدم هذه التقنية لضبط الصفات الوراثية للأجنّة، مستفيدةً من آلية بيولوجية اكتُشفت لدى البكتيريا، ما يتيح التحكم في الجينات، وإزالة العيوب الوراثية، بل تحسين القدرات البشرية.
على الوجه الآخر، تجرح هذه التقنية الأخلاق الإنسانية، حين يتم تحويل الأشخاص المُصنّعين إلى سلع يتم التلاعب بها واحتكارها، ما يؤثر سلبًا على منظومة القيم المرتبطة بحرية الإنسان وكرامته وإرادته، بل يؤدي إلى تعريف جديد للإنسان، يختلف عن المستقر في الأذهان والوجدان.
ولم يكن هذا بعيدًا عن ذهن مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، حين أكد أن هذه الابتكارات تواجه تحديات غير مسبوقة على المستويات التنظيمية والاجتماعية والتقنية، الأمر الذي يجعل تقييمها قضية متعددة الأبعاد تتطلب مشاركة العلماء ورجال القانون والدين. أما الكاتب فيرى أن ” الرّحم الاصطناعي ليس مجرد إنجاز طبي، بل هو أداة قد تعيد تشكيل بنية المجتمعات بطرق لم يكن من الممكن تصورها من قبل.”
فهذه التقنية تلقي في طريق الناس مشكلات اجتماعية، لم تكن مطروحة في السابق على هذا النحو، حيث يؤدي التحكم الجيني في الصفات الوراثية إلى خلق مجتمع غير متكافئ، تسيطر فيه النخب العلمية والاقتصادية على ما عداها، وتتحكم في مسار التطور البشري.
فانتشار الأرحام الاصطناعية سيقود إلى تفاقم الفجوة بين الشمال والجنوب، وفق التقسيم المعتاد، والفجوة الطبقية داخل المجتمع الواحد بما في ذلك الدول المصنفة نامية وفقيرة، فالتكلفة المرتفعة، لهذه التقنية، تجعلها في متناول أيدي الأثرياء فقط، ما يعني عدم المساواة في فرص الإنجاب بين مختلف الشرائح والفئات والطبقات، وبذا تصبح أداة تمييز اجتماعي، حيث يتمكن الأثرياء من إنجاب أطفال بخصائص بيولوجية محسّنة بينما يظل الفقراء خارج هذا التطور، ما يؤدي إلى تحولات ديموغرافية واجتماعية عميقة داخل المجتمعات البشرية، وإلى تمهيد طريق أوسع أمام عملية الإتجار بالبشر.
علاوة على ذلك تعيد الأرحام الاصطناعية تشكيل أدوار الأسرة والعلاقات البيولوجية التقليدية. فبينما يرى البعض أن هذه التقنية قد تعزّز المساواة بين الرجل والمرأة من خلال تقليل الأعباء الصحية للحمل، هُناك مخاوف من أنها قد تسهم في تهميش دور المرأة في الإنجاب، مما يغيّر من طبيعة الأدوار الأسرية، ويثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الأبوين والطفل. كما أن التقنية تطرح تحديات قانونية، مثل ضرورة وضع أطر تشريعية لمنع الاستغلال غير الأخلاقي لها.
ويمكن لمنتج الأرحام الاجتماعية أن يخلق تحولات في عالم الجريمة حين “يفاجأ أحد المجتمعات أو إحدى الدول بمجرمين لهم مواصفات وطبائع خاصة، سواء من حيث القدرات الجسمانية أو الذكاء”، الأمر الذي يفرض قوات شرطية تتمتع بالقدرات ذاتها، أو قدرات أعلى، وهذا يستوجب إنفاق أموال طائلة على الضبط الاجتماعي، وتحقيق الأمن.
وتفتح هذه التقنية أيضًا الباب واسعًا أمام إنتاج أجيال معدلة جينيًا، يمكن استغلالها عسكريًا أو استخباراتيًا، ما يعمق الفجوة التكنولوجية بين الدول، ويخل بتوازن القوى على مستوى العالم أجمع. فقد تشهد الحروب والصراعات تحولات غير مسبوقة، حيث تمتلك بعض الدول جنودًا بقدرات فائقة، بينما تبقى أخرى عاجزة عن مجاراة هذا التطور، ومن ثم يُفرض عليها الاستسلام لنزعة استعمارية جديدة، تصاحب إنتاج ملايين من الجنود، لا يخضعون لقواعد الحرب التي تم التعارف عليها طيلة التاريخ البشري، وتقوم على الحفاظ على روح الفرد المقاتل.
وهنا يؤدي إنتاج بشر وفق هذه التقنية إلى تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، بصورة أكثر فداحة مما يجري الآن، كما قد تقع في أيدي الأفراد المخلقين في المعامل أسلحة فتاكة يستخدمونها في إبادة البشر.
سيتعدى الأمر كثيرًا ما رأيناه في فيلم “رجل الجوزاء” الذي تم إنتاجه في هيولود عام 2019 بعد عشرين سنة من كتابة المسودة الأولى للسيناريو، حكاية قناص متقاعد من سلاح مشاة البحرية الأمريكية يستهدف من قبل قناص مستنسخ منه أصغر سنًا، أثناء هروبه من مطاردة شركة عسكرية خاصة فاسدة. فالأرحام الاصطناعية تتجاوز الاستنساخ كثيرا.
يتناول الكتاب أيضًا، المعضلات القانونية الخاصة بحقوق الأجنة، حيث التحديات التي ستفرض حول مفهوم الشخصية القانونية للجنين المولود بهذه الطريقة، ما يفتح باب أسئلة من قبيل: هل يُعامل المولود بهذه الطريقة كإنسان له حقوق قانونية؟ أم يُعتبر مجرد مادة حيوية يمكن التصرف فيها، أي مجرد منتج بيولوجي يخضع لقواعد السوق؟ وما إمكانية فتح الطريق أمام بيع الأجنة؟ وكيف تصاغ حقوق الأبوة والأمومة في ظل وضع لا يكون فيه الحمل مرتبطًا بجسد المرأة؟ وكيف توزع المواريث؟ وكيف تحدد قضايا النسب؟
وهناك أيضًا جدل ديني تثيره هذه المسألة حتمًا، مثلما سبق لقضايا الاستنساخ، والهندسة الوراثية، والإجهاض، والقتل الرحيم، والمثلية، والتجاذب الخاص بقضايا السكان.
ويلفت الكاتب إلى أن ذلك الانقسام يُبرز الحاجة إلى تطوير رؤية جديدة للتعاليم الدينية تأخذ في الاعتبار المستجدات العلمية، وتدرس انعكاساتها ضمن إطار الشريعة دون الوقوع في الأحكام المسبقة، موضحًا أن تجارب الكنيسة الكاثوليكية مع التلقيح الاصطناعي تُظهر أن الجدل الديني حول هذا الموضوع ليس محصورًا في الإسلام، ولا مقتصرًا عليه، بل يمتّد ليشمل ديانات ومعتقدات أخرى.
هنا يقول الكاتب إن الرّحم الاصطناعي يُعيد الجدل حول مفهوم الإنجاب في ضوء الشريعة الإسلامية وغيرها من الديانات السماوية وغيرها، ثم يطرح الاختلاف بين علماء الدين الذين يرفضون هذه التقنية باعتبارها انتهاكًا للطبيعة البشرية، وبين الآخرين منهم الذين يرون أنها قد تكون مقبولة إذا حققت مصلحة للبشر.
في الوقت نفسه، قد يتحول الرّحم الاصطناعي إلى أداة للهيمنة والتلاعب بالتركيبة السكانية، وهذا من شأنه خلق اختلالات غير مسبوقة في التوازن البشري. فالاستخدام غير المنضبط للرّحم الاصطناعي قد يؤدي إلى أزمة ديموغرافية عالمية، حيث يمكن أن يتسبب في انفجار سكاني غير مسبوق نتيجة تسهيل عمليات التكاثر دون القيود البيولوجية التقليدية، الأمر الذي يعمّق الأزمات الاقتصادية والبيئية، ويزيد من الضغوط على الموارد الطبيعية، خاصة في الدول التي تعاني أصلًا من مشكلات الاكتظاظ السكاني.
ويُحسب للكاتب أنه لم يكتف بعرض قضية “الأرحام الاصطناعية” وتبيان تطورها، والإتيان على ذكر سلبياتها وإيجابياتها، بل انخرط في تقييمها، حين يتناول الجدل المثار حول الجوانب الأخلاقية لها، فيربطه بنموذجين رئيسيين: الأول يتعلق بتطور الفكر الأخلاقي الذي سمح للعلم بالتوغل في مناطق حسّاسة تمس جوهر الإنسان، والثاني يخصّ الحدود التي تفرضها القيم المجتمعية على البحث العلمي، وهنا يشرح المواقف الأخلاقية تجاه هذه التقنية تتباين وفقًا للخلفيات الثقافية والفلسفية المختلفة، بسبب التنافس بل الصراع العالمي على التمكن العلمي والتقني.
ويعوّل الكاتب على المؤسسات البحثية كي تلعب دورًا في تطوير هذه التقنية، وإمكانية إقرار تشريعات دولية لتنظيمها، من منطلق إيمانه بضرورة وضع ضوابط صارمة لضمان استخدامها الأخلاقي، بما يمنع تحويلها إلى أداة للتلاعب بالبشرية، وإعادة تشكيل المجتمعات بطرق غير متوقعة.
هنا يرى الكاتب أن التفكير في المستقبل الذي قد تجلبه هذه التكنولوجيا يجب ألا يقتصر على إمكاناتها الطبية، بل ينبغي أن يمتد ليشمل تأثيراتها على القيم الإنسانية والمجتمعات، محذرًا من أن التلاعب بالطبيعة البشرية قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن التنبؤ بها، خاصةً إذا استُخدمت هذه التقنية بشكل يخالف المبادئ الأخلاقية.
من هنا، يصبح من الضروري أن يترافق أي تقدم علمي في هذا المجال مع ضوابط قانونية وأخلاقية صارمة، تضمن عدم تحوّل الرّحم الاصطناعي من أداة للإنقاذ إلى وسيلة للسيطرة والتجارب التي تهدد وجود الإنسان على الأرض.
ويقترح الكاتب إقامة حوار عالمي حول مستقبل التكاثر البشري، بما يضمن استخدام هذه التقنية في خدمة البشر، وذلك عبر طرح الأسئلة الجدلية المتعلقة به أمام المتخصصين في مجالات البحث المرتبطة بهذا البرنامج، وما يمكن أن نتوقعه من أخطار وتحديات مستقبلية متعلقة به؛ يجب الاستعداد لها، وتحسين فرص مواجهـة تبعاتها، بما يحول دون أن تكون سببًا في هلاك البشرية، وهذا لن يتم إلا بتوجيه هذه التقنية نحو الخير العام بدلاً من توظيفه في مسارات قد تضر بالإنسانية جمعاء.
إن هذا الكتاب، قد أراد به مؤلفه، حسبما جاء في مقدمته أن “يدق ناقوس الخطر عسى أن يستفيق العالم من غفوته، وتؤدي كل جهة ما يلزم، وما تحتمه عليها مسؤوليتها التي أنشئت لتحقيقها.” كي تتجنب البشرية كارثة محققة يخلقها الإفراط في استخدام الأرحام الاصطناعية مستقبلًا.
…………………
*نقلا عن صحيفة “الوطن” المصرية