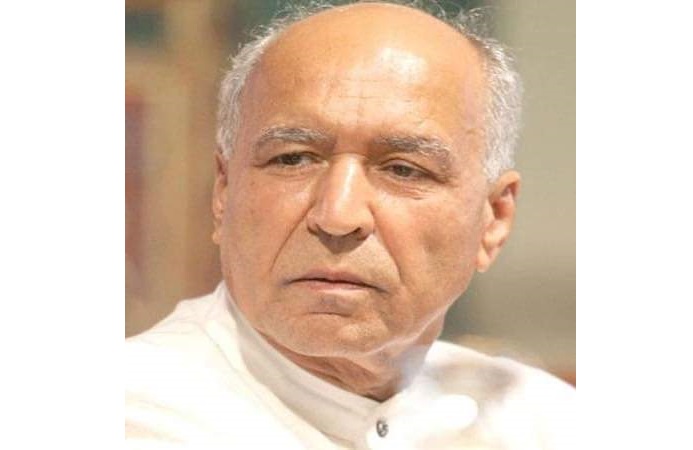أحمد المديني
مذ قبضت على وعيي، وأنا أؤلف كلماتي بأبجدية الجسد. جسدي المترعرع بين الرمضاء والنار ولا يستجير، المنضّد بين المطرقة والسندان ولا قوة تجعله يستقيم. ومذ شرعت صوري تتوالد تفور حمما من إصراري على نبذ عشرة السكينة الخرساء، وتنكب طريق العشيرة العمياء. كنا خططنا، كأنما فطرةٌ ولدت معنا، بل وجربنا، ديدنَ أجدادنا الشُّمّ، زرع فتن مفتنة في وجه صِلاف الطبع، لم نكن نبالي، لمّا كان للرجال هامات وأنفة ولا أغالي، يتقدمون هاتوا للمواجهة شجعانا لا فئرانا، فيلاقون حُجّابا وصيصانا، وهم يبغون عقبانا وأنداداً، يرسلون إلينا من بلا أسماء، سيان أو سُفهاء، مثلُهم بشرٌ سمج، سقيمُ الروح، يتناسل عقيماً ظنهم أتقياء. صُوَري أتذكرها ما أزال، فائقة الذهول، لا حاجة لرسمها، خطوطُها متعرِّجة بين الضوء وظل الأفول، يكفي خط غائر في جدار حائل أو شجرةٍ ألفية لإعلان سلالة القدم، بصيحة أنّا لم نخلق للذبول. فيما يدٌ ما تنفكّ تلوّح كالشراع في مهبّ عمرنا العاتي؛ عاتياً من قبضاتنا، عاصفاً برجفة السؤال، يبدأ ولا ينتهي العويل وامتد منّا السبيل. كنا امتطينا الشوقَ صهوة، واللهفةَ أجنحةً من رفيف، همسُه ناعم الحفيف، وله مفاتنُ ما أحبُّ في الخريف، فماذا يمكن أن يقال عن هذه المباهج، وكيف ما عاد من شغف أكاد أقول سوى” البكاء على صدر الحبيب”. لا تتسع لهذا لغة، أبلغُ إعجازاً من البلاغة، تُبكِم سحبانَ وائل، عبثاً تسعى وراءها بلا طائل، أرواحنا الشاردة!
ترددتُ طويلا، ما زلت أتردد، أسأل هل حان الوقت كي أبدأ كتابة دفتر الخسارات، وهي لعمري جمعٌ لا مفرد، وإلا لما عنتني، فالفرد شخص مُعنَّى، مغناه مثل مرثاه قصيدة. أقول، أسأل هل حان الوقت كي أطلق عِقال ما ظل مقيماً في الحشا، ثاوياً في أكناف صمت جليل، كم أخشى تلافيف خزي ذليل، معتكفا كالناسك المتعبد في سكينة المكابدة. تراني أقول حان، أخاف أن أقول فات. ذلك أن السكوت، أن الامتناع عن القول، لا يعني النسيان بتاتا، كلا، أبداً ولا الإغفال. السكوت عند من ينتمي إلى جيلي ليس علامة الرضا، لا أعرف من اخترع هذه العبارة الجوفاء، هُراء، لا شك صيغت في عهد حالك للعبودية، وهل من لسان للعبد والجارية غير الاستسلام لمالك جبّار؟! وإذن، ما العمل؟ ذاك السؤال الذي أعيا الدهاقنة ولم نعي من اللعب به، معه؟
كنا نحتفي، كما لو قلت نختفي مؤقتا في التفاؤل، يا له فسحة المترددين. كنا معذورين لا متخاذلين، بدا العالم، الحياة، الوجود طرّاً، المتاحُ من نظرٍ، لونٍ، هواءٍ، نشوةٍ واشتهاء. المتاح، فقط، لا المرادُ المرغوبُ فيه ونظيرُه ممّا ممنوع أن يباح، أي شيء اعتبرناه زادَ النفس وأوكسجين الهواء. بعد أعوام طوال، بين عبور مفازات حارقٍ رملُها وتَسلّقِ شامخاتِ الجبال، سقطت منها الرؤوس، وعُلِّقت بعدها الأجساد، واحترقت للأمهات جمرات الأكباد، وعلى مداخل المدن والأبهاء المترعة بالخشوع والانحناء؛ وخارجها، نادى المنادي بصيحات الفزع فرُبطت الحبال، قد آن يومئذ موسم القطاف، هيّا، فجيء بهم، من كانوا أمس يسمون الرجال، سُدّوا البلاد، مُدّوا البساط ودُقُّوا الأوتاد، دعوهم يحلمون هنيهة أنهم يحكمون، يرفلون في إرم ذات العماد، وسننتهي بأن نجعل لحومهم لأقدامنا المداس ومجالس سمرنا السماد. ذاك الضّنى والشجن، كلّ ما فاح في الجو من عطن، وتعطّل في لغة الكلام واخترق الجلد شقّ العظم، ثقب العين، كسّر غصن الأمل، ويَبّس الفنن؛ جمَعه كلُّه حبيبنا ذات حسرة حبيبنا وراعينا الأدبي الأول الفقيد عبد الجبار السحيمي الكاتب الرومانسي، أي الرقيق المتمرد ابن زمانه، في عبارة واحدة، جامعة مانعة هي “الممكن من المستحيل” رصّع بها قصصا قلّ أن يجود الأدب والدهر بها، فناب عنا ورحل وبعده كأنا نراوح نفس المكان والزمان، ولا نفارق المحن!
وكأني نسيت وأعود لأتذكر، هذا طوري هذه الأيام، من شدة تعاقب الأسى وتفاقم الغباء والتكرار، فأرتدي جبّة النسيان وأرتقي مدارج العدم، الوجود اختفى والعمر أحسبه انقضى؛ ليس الذي قلت، تأكّدوا يا من تترصدون متى تستيقظ الأبجدية ويبدأ الذئاب في العواء، لسبب بسيط، وهو أن نقيض الخسارة لن يكون دائما بالضرورة الربح، ولا حظ لي في التجارة مَغنَما، علمني ابن خلدون أنها نقيض الفتيا وأصحاب الكلام، أحيانا يطاوعني فأمسك بالزّمام، وطوراً يفلت اللّجام، فتراني أهذي، حتى يقال هذا لا جناح عليه، وُلد في برشيد، وترعرع في فاس ببيت قريب من” سيدي فرج”، ادعو له بالعقل والفرج، وليذهب إلى “جنان السبيل” لينصت كما تعوّد وهو طفل خالي الوفاض إلى زقزقة العصافير وشقشقة السواقي، وعبد الوهاب الدكالي يغني للمرة الأولى: “يا الغادي فالطموبيل” والعواتق يحمقن على صوته قبل محيّاه!
أستدرك ، الخاسرون والرابحون هم دائما في خصام، بينما كلاهما على خطأ ما دام كلّ طرف يعتبر نفسه صاحب الحق، فاكهون، لذا قد يكون ما أسميه خسارة ربحاً كاملا، وأنا أزايد على ذاتي، من شدة ميلي للتهويل، ونزعتي المأساوية كطبع متأصّل ربما نزق، لست أدري، ولا يعنيني إن صوابا أو خطأ، ما دمت لا أطلب جاها، إنما أهتبل هذه السانحة لأقول لمن يعنيه الأمر ولعابر سبيل القراءة، لا تطلبوا مني أن أقيم لكم مناحة حين تخسرون، ولن أحوّل حيّزي في هذا المنبر إلى حائط مبكى لأتسوّل العطفَ والتوبةَ لأيٍّ كان، حين تربحون فلأنفسكم، وإذا خسرتم ابكوا وحدكم فنحن شبعنا موتا وكمداً، لن نحزن لمن صار سقط متاع؛ اذهبوا فأنتم الطلقاء
ثم أقول صدقا لا مكابرة، أنا من جيل لم يكن له إلا ما ذهب إليه، سواء احتار أو اختار أو انتحر، لقد كان وما زال مصيرا، الكتابة ألقت علينا مسؤولية وتبعات هنا، وفي البلدان العربية جمعاء، وحيثما تهيمن التعاسة والاستبداد الكتاب والمفكرون والفنانون مطالبون بأن يكونوا رُسلا، دعاةَ رأي وأصحاب مواقف، ولا يكاد يُسمح لهم أن يعيشوا مثل سائر البشر، وفي هذا المطلب صواب كبير وللناس فيه وعلينا حق والتزام حين نعرف من نحن، لكن أين نحن اليوم مما كنا، ألسنا، أغلبنا، شبه ألسنة مبتورة، وأقلام كأنها مكسورة، ومطامح دنيئة وهمم منخورة وظلال تمشي مذعورة. طبعا، أكرر، أغلبنا لا كلنا، فهل السؤال أكبر منا؛ ياه، من نحن، إذن؟!