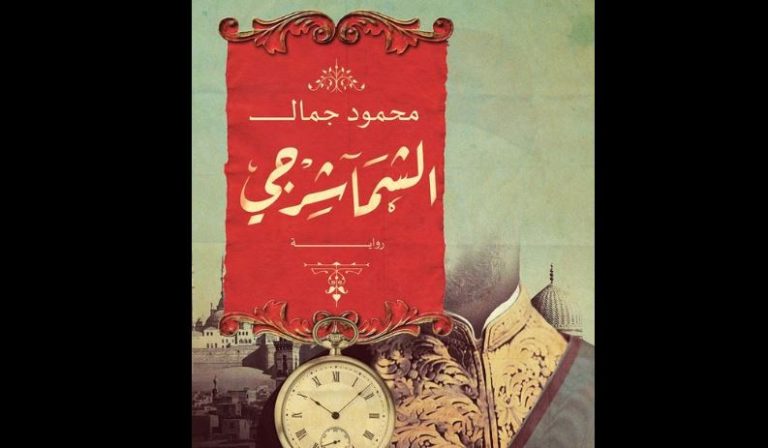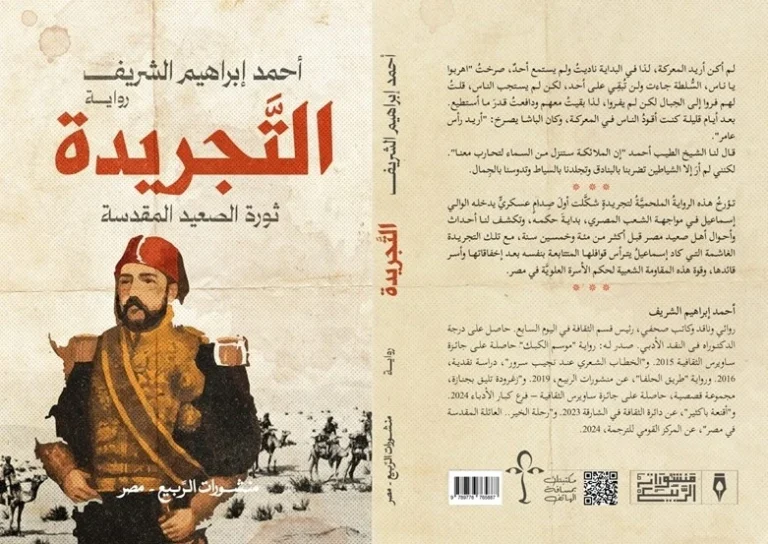محمد أبو الفتوح
في لعبة النوافذ لا تكتفي رباب كساب ببناء حكاية عن التلصص بوصفه سلوكا، بل تحوّله إلى آلية معرفية؛ طريقة يدخل بها الإنسان إلى نفسه، ويخرج بها إلى العالم، الرواية ليست عن النوافذ بقدر ما هي عن الرغبة في الرؤية، وعن التوتر بين أن تَرى وأن تُرى، بين الاقتراب من باطن الأشياء والاستسلام لسطحها.
السرد من خلال الحواس.. كتابة الحياة بدلا عن الحكي عنها
❞ لامست قدماها الأرضية الباردة في سابقة لم تفعلها من قبل، تكره الحفاء، كثيرًا ما جلست على الكنبة أو تمددت في سريرها وفي قدميها خفها المنزلي، اللمسة الباردة لقدميها كان لها فعل السحر، شعرت بانتعاش يتسرب لكل أجزاء جسمها التي تحس بتشنجها. ❝
أول ما يلفت في الرواية هو براعة السرد الحسي، النص لا يُروى بقدر ما يُعاش؛ فالحواس هنا ليست أدوات وصف، بل أدوات كشف، المشهد يُبنى تدريجيا عبر التفاصيل الصغيرة للتعاطي مع العالم، هكذا يتحول الجسد إلى وسيط معرفي؛ نعرف العالم كما تلمسه الشخصيات، لا كما يُفسَّر لنا.
هذا التأسيس الحسي يمنح الرواية قدرا مهولا من الحيوية، خصوصًا مع التبديل بين الراوي العليم والراوي المشارك في الحدث؛ التناوب بين المنظورين يخلق تأثيرًا أقرب إلى الكاميرا السينمائية، لقطة واسعة تؤطِّر الحدث كل حين، ثم اقتراب فجائي من وجه شخصية تتكلم، إلا أن كاميرا الأدب تمتاز عن كاميرا السينما بقدرتها على النفاذ إلى الداخل النفسي للشخصيات، هذا التكنيك لا يمنح النص تنوعًا فنيًا فحسب، بل يُجسد فكرة الرواية ذاتها؛ الرؤية من الخارج والرؤية من الداخل، بين المراقبة والمشاركة.
الحياة تبتكر مساراتها من بين تفاصيل الموت
نحن أمام عالم يفرض فيه المجتمع تفاصيل موت يومي على الشخصيات؛ روتين، وحدة، قلق، خواء، ومع ذلك تُصرّ الحياة على ابتكار مساراتها؛ الشخصيات تتحايل على المفروضات، تبحث عن ثغرة لممارسة فعل الوجود الحر، ليس عبر ثورة صاخبة، بل عبر انحراف بسيط؛ نظرة من شرفة، حساب فيسبوك، فضول يبدو بريئًا.
بهذا الانحراف – فعل التلصص من النوافذ الحقيقية أو الإلكترونية – تمارس الشخصيات حرية مفتقدة، حرية هي الحياة في عالم لا يملك سوى القيود، الحياة هنا ليست حدثًا كبيرًا، بل رغبة خفية في ألا نُختزل إلى وظائفنا وأدوارنا الاجتماعية.
الصدفة وامتحان الحبكة
غير أن الرواية لا تنجو تمامًا من بعض عثرات البناء، خصوصًا في توظيف الصدفة (كخط المزرعة والحاج عرفة من طنطا)، الاعتراف بالغرابة داخل النص لا يكفي دائمًا لتبرير سببية هشة؛ فالغرابة إن لم تُدعَّم بحركيَّة درامية مقتنعة، تتحول إلى حلٍّ جاهز يُضعف تماسك الحبكة.
ومع ذلك فإن هذه العثرات لا تهدم العمل بقدر ما تكشف توترًا بين رغبة النص في التقدم خدمةً للشخصيات، ورغبته في المحافظة على معقولية العالم السردي، لقد نجحت الكاتبة في الأصعب؛ وهو خلق شخصيات حقيقية ملموسة مُصدَّقة، وربما أغشى افتتانها بشخصياتها العين للحظة أو اثنتين عن ملاحظة هذه الهنات البسيطة.
الفضول المعرفي كآلية لتشكيل المعنى
تطرح الرواية سؤالًا مركزيًا: هل الفضول بريء؟
سماء تتلصص لتعرف في الآخرين ما لم تعرفه في طليقها.. بهجت يتلصص ليفهم فراغه الداخلي، ذلك الفراغ الذي يعبّر عنه بقوله:
❞ كان بداخلي دومًا فراغٌ لا يمتلئ، كأنني بحر لا ينضب ماؤه، أو أن بداخلي هوة تبتلع كل شيء ولا تشبع. ❝
الفضول هنا ليس بحثًا عن معلومة، بل عن معنى، ومع ذلك، أليس ما أطلق هذا الفضول من عقاله في المقام الأول نوعًا من الشر؟ خيانة الزوج عند سماء، وصلف المحبوبة الأولى والوحيدة عند بهجت؛ كأن الرواية تلمّح إلى أن الدفع بين البشر – احتكاك الرغبات وتصارعها – هو ما يمنع ركود العالم، ولولا هذا الدفع لفسدت الأرض.
القرب يُطفئ شهوة التلصص؟
حين اقتربت سماء وبهجت من بعضهما، خبا شغف التلصص، لم يعد الفيسبوك يثير سماء، ولم تعد الشرفة تثير بهجت، هل وجدا ما كانا يبحثان عنه؟ الحميمية؟ الاعتراف؟ كسر دائرة الوحدة؟
ربما، لكن الرواية توحي بأن الفضول أقدم من العلاقة؛ سماء كانت تتلصص منذ انتقالها من القرية إلى المدينة، وبهجت منذ شبابه، حين كان يحاول فهم حركة السوق، وكيف سيتمكن من أكل نصيبه في الكتف، إنما نشوء العلاقة كانت لحظة تهدئة، انحل فيها توتر ما قبلها، ولن يلبث أن يعود الاحتياج الأساسي للمعرفة لتسيد المشهد.
جدلية الذات والعالم
❞ ثمة شيء يتحرك هنا بقوة، على الجدران، على الأجساد نفسها، في الشارع، وعلى أسطح البيوت، خيوط غير مرئية ينسجها عنكبوت كبير، لكنه غير مرئي، شبح، تتفرع الخيوط منه، عنده المبدأ وفي يده المنتهى. ❝
عبر تتبعنا لطباع بطلة الرواية نجد مفارقة لافتة؛ كرهت سماء التلصص في القرية وأحبته في المدينة! في القرية قُبلت اجتماعيًا لكنها رفضت نظرات الآخرين، في المدينة نُبذت، فتحولت إلى مصدر للنظرات! هنا يطرح النص جدلية دقيقة؛ لكي تُقبل عليك أن تَقبل، وإن رفضت فعليك أن تدفع ثمن المسافة.
الرواية تفكك علاقة الذات بالعالم؛ وتطرح سؤالا بالغ الأهمية؛ هل الرفض حماية أم عزلة؟ وهل التلصص بعده محاولة لاستعادة السيطرة على عالم لم يعترف بك؟
آدم وحواء.. الوعي سقوطا فصعودا
يمكن قراءة سماء وبهجت كنسخة حديثة من آدم وحواء، نسخة لم تبدأ الخلق، بل هي في سعي لخلق جديد بعد صدمة الخلق الأولى، لم يكونا ليلتفتا إلى كنه الأشياء لو لم تُذلهما تجربة ما – خيانة كانت أو رفض أو خلافه – ليأكلا من شجرة المعرفة، التجربة المؤلمة هي التي تُنشئ الوعي.. لحظة الانكشاف.. رؤية السوأة.. الميلاد المعرفي.
ولكن حركة الوعي لا تتوقف عند السقوط، السقوط لا يمثل سوى اللحظة السلبية لانبثاق الوعي، أما الصعود فيأتي تاليا، متمثلا في قدرة آدم على التعلُّم، على دفع حدود الوعي لأقصى اتساع ممكن، عبر فعل إيجابي إرادي بحت، قد يكون هو الهدف الأصلي للخلق.
الاحتياج الأصيل – والمُهمَل غالبا – لأن نُرى
أحد أعمق محركات الرواية هو احتياج الإنسان لأن يُرى، ذلك التوق لأن يُنظر إلينا، حينها فقط يتأكد وجودنا لأنفسنا.
هناك من يتكلم ليُرى، من لا يتوقف عن الثرثرة طلبًا لنظرةٍ تثبت حضوره، و من يَنتهِك ليُرى، ومن يُفني عمره في العمل ليُرى، و في هذا السياق يصبح التلصص وجهًا آخر للرغبة ذاتها؛ كما أريد أن أراك لأفهمك، أريدك أن تراني لأتأكد أنني موجود.
يقودنا هذا إلى الاستعارة الكبرى في الرواية؛ النوافذ، إن النوافذ في هذه الرواية ليست مجرد فتحات في جدار بيت، إنها الشرخ في الجدار الفاصل بين الداخل والخارج، بين الذات والعالم، بين الرغبة في الاختباء والرغبة في الانكشاف.
ومن هذا الشرخ تحديدًا وُلدت الرواية.