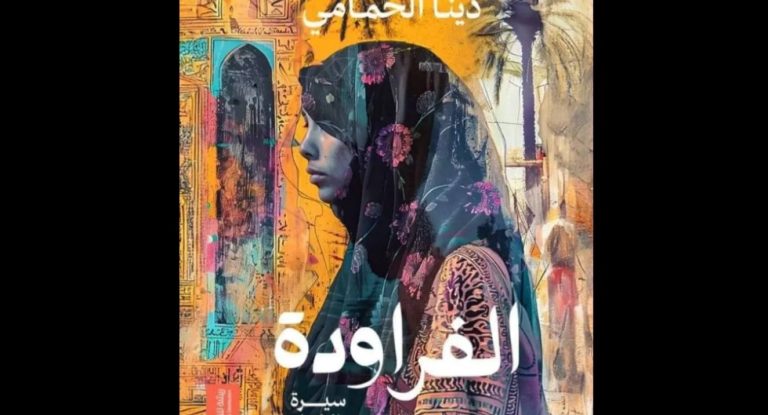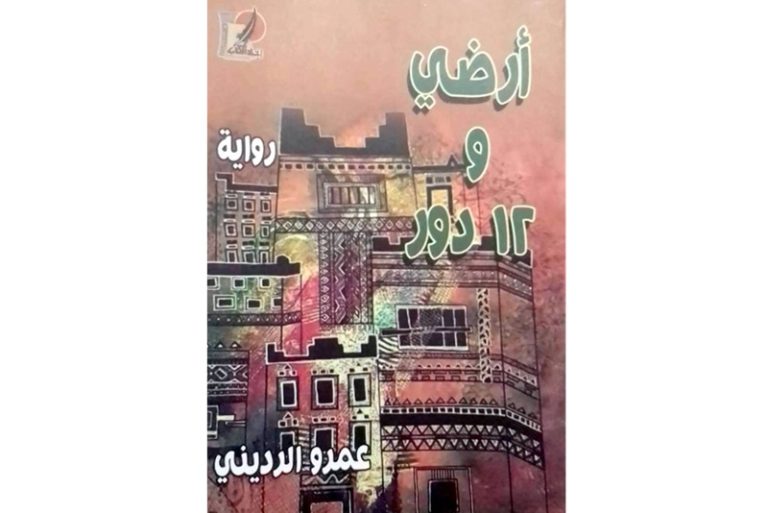حسن عبد الموجود
لا تنغلق الأفكار الخاصة بالثقافة على معانٍ مجردة، فى كتاب المفكر نبيل عبد الفتاح «الحرية والحقيقة.. تحديات الثقافة والمثقف المصرى»، لكنها تكتسب أهميتها من أن كل قارئ يجدُ فيها مرجعيةً تخصُّه، إذ يقدم الثقافة بمعناها الشامل، الثقافة التى تنفتح على السياسة والمجتمع والدين وتتأثر بها وبسجالاتها وخطاباتها، سواء كانت تخص قادة سياسيين، أو شيوخاً، أو متطرفين، أو رجال أعمال، أو بسطاء يؤمنون بالماضى ويعتنقون الخرافات الشعبية، وبالتالى أياً كانت مرجعية القارئ يمكِّنُه الكتاب من وضع قدمه على أرض صلبة، ليقرأ، ويتمعن، ويقارن، ويشعر بأن هذه الأفكار قريبة من واقعه، بل إنها تمسُّ صميم حياته، وبالتالى تدفعه إلى الإدلاء برأيه، وأفكاره، وصياغة موقفه النهائى، الذى يأخذ من هذا الكتاب ويضيف إليه فيصبح شريكاً فيه.
يوسع نبيل عبد الفتاح -فيما يطرحه دائماً- مفهوم الثقافة، ويوسِّعُ كذلك رقعتها، ويلمس حدودها القصوى وأفقها، عندما يناقشها. إحدى مشكلات الثقافة أن القائمين على المؤسسات الرسمية، والمثقفين، أسهموا فى قصْرها، أو ربطها بالمنصات، بحيث أصبحت الثقافة هى ظهور الأدباء والفنانين والنقاد (إلخ) خلف المنصات وأمام جمهور يتناقص باطراد، ليتحدثوا فتدور كلماتهم فى القاعات وتصطدم بالجدران، حتى تهتدى أخيراً إلى شباك مفتوح، قافزة منه إلى الشارع لتنضم إلى مليارات الكلمات التى تم إهدارها فى ندوات شبيهة استغرقت ساعات طويلة لا يمكن إحصاؤها. والمهم فى النهاية هو التقاط صورة للمنصة وللجالسين خلفها، وترويجها فى الصحف والمواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا، لتبدو الثقافة ومنتجوها ومتلقوها بخير. فى الأغلب لا يهتم صانعو الثقافة -باستثناءات طفيفة- بتدوين ما يُقال، أو توثيقه، أو محاولة تحقيقه، أو اختباره فى الواقع، أو حتى الدعوة لإكماله والبناء عليه. كان الوزير يوسف السباعى يؤمن بأن «الثقافة معرفة جذابة، معرفة يجد الناس فيها متعة، معلومات يتذوقونها بلذة»، وهذه النظرة الرسمية إلى الثقافة التى رعتها الدولة الناصرية واعتبرت أن أكبر أهدافها هو التسلية والاستهلاك تطورت واتخذت أشكالاً مختلفة، فقد حاول البعض أن ينعطف بها، ويُخرجُها عن قضبانها، لكنه استبدل تلك القضبان بقضبان أخرى، إذ أصبحت الثقافة فى أفضل الأحوال ثقافة كرنفالات، اهتمت بحشد الأسماء الكبيرة من مصر والعالم العربى والأكاديميا العالمية فى أفواج ومؤتمرات أكثر من اهتمامها بالاستفادة من أفكار تطرحها تلك الأسماء، وهذه المسألة أرَّقت الفنان التشكيلى عادل السيوى فقدَّم مبادرة استقلال المجلس الأعلى للثقافة عن الوزارة، بحيث يكون مسئولاً عن وضع السياسات الثقافية والأفكار لمن يرغب، لكن لم يأخذ أحد بها، وقد تبدلت الوجوه، ومعها تبدلت الاهتمامات وحجم الحماس والرغبة فى التغيير، لكن السياسات بقيت كما هى، السياسات أكبر من موظف جيد، أو من مثقف يرغب فى التغيير. الرغبة قد تكون حاضرة، لكن الجسد عاجز والعقل مكبل بالبيروقراطية وكراهية التغيير، وما ينطبق على الحالة المصرية ينطبق كذلك على الحالة العربية، إذ تحولت مهرجانات السينما والمسرح والشعر والرواية ومعارض الكتب إلى جزء من طقوس «المكياج الثقافى» ففقدت روحها.
خلال التسعينات أثناء حضور نبيل عبد الفتاح بصحبة بعض المثقفين «أيام السنونو» فى الدانمرك، فوجئ وهو يسير بصحبة الشاعر حسن طلب فى أحد الأسواق أن أحد أكبر وأشهر شعراء الدانمرك وشمال أوروبا يقف وسط السوق فوق عدد من الصناديق الخشبية الفارغة المُعدَّة لتعليب الفاكهة ليلقى شعره على المارة والمتسوقين، بينما يتلقَّى فى صندوقٍ فارغٍ ما يجود به العابرون. نبيل سأل الشاعر فى طريقهم للمسرح عن الفكرة وإن كانت تقليداً أدبياً ضمن التراث الدانمركى، فأجابه الشاعر بنعم وبأنه يحاول إحياءها كل يوم سبت. بحسب نبيل فإن الشاعر ثرى، ويسعى إلى نقل الشعر للحياة والعابرين فى الطرقات وتحويل الحياة إلى قصائد، وقد تكرر الأمر مع نبيل عبد الفتاح، فى شوارع وأحياء ومدن بعيدة. فى صفاقس حضر أمسية شعرية على عبّارة، ورأى كيف ينطلق الشعر كشرارات من أفواه الشعراء صانعاً مخيلة جديدة وملونة للمسافرين عبر البحر. فى مترو باريس قرأ بعض أبيات كبار شعراء فرنسا على جدران العربات، ليس الكبار وحدهم وإنما بعض المواهب الشابة التى تتلمس طريقها أيضاً. وبخلاف الشعر هناك أيضاً «عيد سنوى للموسيقى، فى الشوارع والأحياء، وعلى إيقاعات الحضور الإنسانى للمواطنين. تتداخل الموسيقى ونغماتها فى الأنسجة الإنسانية والمعمارية، وتخرج صادحة من بين كتل الحجارة»، وكذلك «فى بريطانيا ثمة تجارب بسيطة وجميلة، إذ تجد أشعاراً لشكسبير وت. إس. إليوت، وغيرهما على تذاكر القطارات والمركبات العامة، كما خُصصت بعض عربات القطارات لشعراء يلقون فيها قصائدهم على المسافرين»، يحرضك نبيل عبد الفتاح على البحث عن أمثلة أخرى شبيهة. فى أمريكا تفاجئك تماثيل جورج سيجال بأنها أكثر حياة منك، تقف إلى جوارك فى الميادين متحدثة بثقة وتحضر، أو تفاجئك وأنت تصعد من محطة مترو بحضور لافت وقوى، أو تجلس معك على مقاعد خشبية متأملة صفحة المحيط. بحسب نبيل عبد الفتاح فإن الإبداع لا بد أن يذهب إلى حيث يوجد الجمهور، لا سيما فى الدول والمجتمعات الجنوبية الفقيرة، واستعارة بعض التجارب مثل طباعة أجمل أبيات الشعراء على تذاكر الطيران والقطارات والمترو والأتوبيس، وبالطبع هناك نقطة يمكن البدء منها دائماً وليكن عودة بعض المؤسسات إلى أدوارها التقليدية، ومنها دور الثقافة الجماهيرية فى نشر الثقافة البسيطة والجميلة بالقرى والنجوع البعيدة، دون أن تتقيد بالسياسة الناصرية فى توجيه الثقافة سياسياً.
يفتح عبد الفتاح نافذة أسى داخل كل قارئ، يكفى أن تفكر وأنت تناقش مقترحه أن كثيراً من الكتّاب يموتون فتندثر سيرتهم تقريباً. يصبح حضورهم خافتاً فى صفحات تلاميذهم على مواقع التواصل الاجتماعى، وفى بعض أقسام الأدب بالجامعات، يكفى تذكر أسماء بقيمة وقامة إبراهيم أصلان وخيرى شلبى ومحمد البساطى وجمال الغيطانى لتأكيد خطورة النسيان والإهمال وعدم الابتكار، فهى جميعاً غول قادر على ابتلاع أدباء من الطراز الفريد، ولا يجب تذكر رموزنا فى مناسبات الميلاد والوفاة، وإنما يجب وضع تصور كامل لضمان استمرارها واستمرار إنتاجها العظيم فى الانتقال من جيل إلى جيل، حتى تصبح فى الجينات المصرية، وأن يكون ذلك التصور بعنوان «الثقافة للناس والحياة»، وتلك الثقافة ينبغى أن تصالح بين الفصحى والعامية، وهى قضية أخرى ملحة يؤصل لها نبيل عبد الفتاح، إذ أن هذه القضية لا تكاد تهدأ فى فترات حتى تعود بشكل أكثر حدة، مثلما جرى فى بداية عام 2022 بعد صدور ترجمة رواية ألبير كامو «الغريب» إلى العامية المصرية، ويصل التلاسن بين المتحمسين لها، وبين المتعصبين للفصحى، إلى حدود التخوين، وهى قضية تتعلق بـ«تدهور النظام التعليمى ومناهجه عموماً، وفى اللغة العربية وآدابها خصوصاً، على نحو مستمر، لا سيما منذ عقد الستينيات». ذهب رفاعة الطهطاوى فى كتابه «أنوار توفيق الجليل من أخبار توثيق بنى إسماعيل» إلى أن «اللغة المتداولة المسماة باللغة الدارجة التى يقع بها التفاهم فى المعاملات السائرة لا مانع أن يكون لها قواعد»، وأول القواعد التى يقصدها رفاعة انتظام العامية فى أشكال كتابية، فالناس قد يلجأون إلى العامية للتخفف من الالتزام بقواعد، ويكتبون كثيراً من المفردات بأشكال مختلفة، مما جعل هناك فوضى لغوية بالغة، فى وقت تحجرت الفصحى خاصة فى مناهج التعليم وعزلت نفسها داخل جدران من الرزانة البالغة فى دراسات الأكاديميين، لدرجة تبدو معها المسافة كبيرة بين أعمال روائية وقصصية وشعرية مكتوبة بلغة بسيطة من ناحية، ودراسات عنها شديدة التكلف من ناحية أخرى، وإن كنا نتحدث عن اللغة فلا بد أن ننعطف مع نبيل عبد الفتاح إلى سؤال مهم يخص تطورها ومدى قدرتها على استيعاب التغيرات فى المفردات والاصطلاحات الجديدة، خاصة مع تطور العلوم الهائل، وكذلك لنطرح سؤالاً آخر عن إمكانية قدرة المجتمع على مواجهة السلفية الدينية التى ترفض تحرير اللغة الدينية وتعتبرها إرثاً مقدساً يصبح الخروج عنه هرطقة، والخوف قد يمنع كاتباً من صياغة فكرة لها علاقة بحكاية دينية، تتعلق بأحد الأنبياء، أو الملائكة، أو حتى الشياطين، خوفاً من التكفير، وبالتالى إما أنه سيتجاهل الحكاية، أو سيلتف حولها بلغة مموهة لا تناسبها، ويمكن القول إن مشاكل الفصحى لا تقتصر على التعليم وإنما لها علاقة مباشرة كذلك بعصىِّ الشيوخ وخوف الأدباء وكذلك تلعثمهم وعدم اجتهادهم لخلق لغة مختلفة، و«غياب القدوة اللغوية لدى النخب السياسية والتعليمية والثقافية». بإمكانك أن ترى مدى ركاكة التعبير وفداحة أخطاء النحو فى لغة هؤلاء، وارتباك نطقهم، كأن هذه اللغة تخص قوم عاد أو ثمود، أو كأنهم لم يتلقوا تعليماً من الأساس.
اللغة هى المادة الأولى للمثقف، سيفقد جزءاً كبيراً من قوته إذا لم يسيطر عليها، ويبغى أن تكون معركته الدائمة، التى تمكّنه من التكيف مع كل شىء يحدث حوله، والتعبير عنه، ومواجهته، وتجاوزه، خاصة وأن صعوبات الحياة تزداد حوله، ومعها تزداد المخاوف فى حياة آمنة، لكن ما هو دوره الآن؟ علينا أن نحدد دور المثقف بدون التهويل فى صورته، فمثلاً نحن نجلس فى قاعة، مجموعة تشتغل بالثقافة، وتتحدث عن الثقافة وعليكم أن تسألوا أنفسكم: ما تأثيركم؟ ما تأثير المثقف؟ إننى أميل مع المفكر نبيل عبد الفتاح إلى عدم النفخ فى صورة المثقف وتحويله إلى «سوبرمان». المثقف يستطيع أن يخلق أفكاراً لكنه يُواجَه فى الأغلب بكثير من التجاهل والعنف الصامت أو المعلن. ونحن نستطيع طبعاً أن نستحضر نماذج وطنية ممتازة أدت أدواراً بارزة فى «تطوير الوعى السياسى والاجتماعى من خلال كتاباتها النقدية»، لكن هذه الصورة اختلفت حالياً، إذ أن المثقف كبير السن تيبَّس، وأصبح يشبه صورة للمثقف فى الماضى، صورة نشاهدها فى الصور الأرشيفية، وما كان يصلح فى مرحلة لا يصلح فى مرحلة أخرى، فما حاجتنا إلى إخراج أحدهم من كتاب التاريخ ليتحدث لغة قديمة؟ يقول نبيل عبد الفتاح بسخرية إن «الأسئلة القديمة حول المثقف وأدواره ومسئولياته هى أحد آثار الفجوة المتزايدة بين تكوين مثقفى الأجيال الشابة الجديدة وبعض القدامى، فقد تجاوزتهم تحولات الثقافة والفلسفة والعلوم الاجتماعية والفنون الحديثة ولا يزالون يعيدون تكرار مقولات سابقة بالية، مع استثناء فئة قليلة من المثقفين سواء الكبار أو الشباب تتابع وتستوعب التطورات المعرفية والجمالية»، وبالتالى الصورة ليست قاتمة بالكامل: «المثقف والثقافة قادران على بناء الجسور والقيم المشتركة بين الأديان والمذاهب كونياً»، لكن يجب أن نتنبه دائماً أنه علينا ترك الأساطير جانباً ونحن نتحدث عن المثقف، فهو ليس وحشاً خارقاً وإنما شخص قابل للكسر.
لا يتركنا نبيل عبد الفتاح فى صحراء، لا يتركنا فى مواجهة الأسئلة الصعبة، خاصة سؤال مستقبل الثقافة، لكنه يفتح نوافذ، وأبواباً، ويصحبنا داخل تلك الطرقات المتشابكة والصعبة، مرمماً وجوهاً باهتة أكلها النسيان، مسمياً الأشياء بأسمائها، فلا مجال لتجميل الكلام، ونحن نتحدث عن تكفير الأدباء والمفكرين والفلاسفة، أو تراجع الثقافة، أو غلو الدين والشيوخ، أو صعود السلفية، أو تغلغلها فى الشارع، أو تدهور اللغة وجمودها، أو تحول الأنشطة الثقافية إلى مهرجانات، أو تحول الثقافة إلى جيتوهات منعزلة. لا يتركنا نبيل عبد الفتاح أمام الجبل، جبل «الحرية والحقيقة» دون أن يطلعنا على خرائط الدروب والصخور والشقوق المناسبة لصعوده.
……………………..
الكتاب: «الحرية والحقيقة.. تحديات الثقافة والمثقف المصرى»
الكاتب: نبيل عبد الفتاح
الناشر: «ميريت»