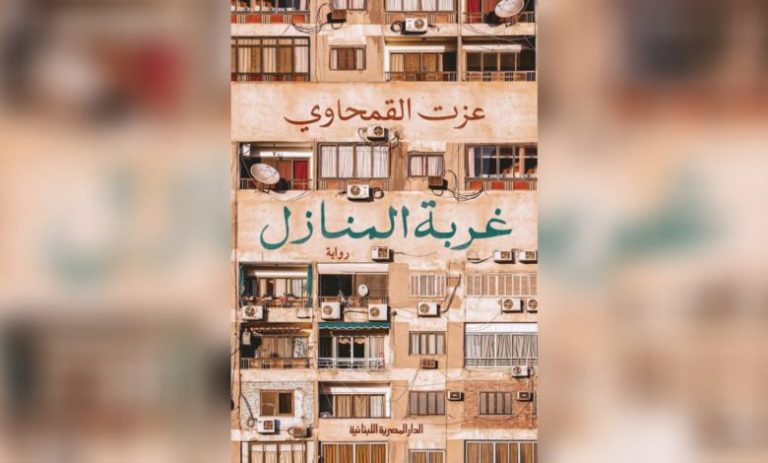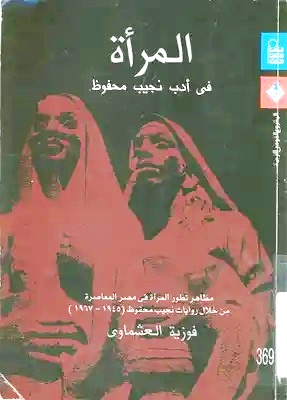ولكن باومان يرى أنه لم يكن للهولوكست أن يوجد لو لم تكن هناك حداثة. وقد يبدو أثناء القراءة الأولى للعمل أن هدف الكتاب غير واضح. ربما لأن باومان استخدم لغة المجاز مبتعدًا عن الإحصائيات والأرقام التي فشلت في تفسير الظاهرة الإنسانية عندما تعاملت معها بنفس الكيفية التي تتعامل بها مع النباتات والحيوانات، غير مستوعبة أن هذه الظاهرة أكثر تركيبًا وتعقيدًا مما كان معتقدًا بين فلاسفة وعلماء الحداثة الغربية.
يخبرنا الكاتب أن معظم من شاركوا في إبادة اليهود كانوا أناسًا عاديين. وهذا أمر يبعث على الحيرة على المستوى النظري، ويبين لنا أن عملية قتل اليهود على أيدي النازيين لم تكن نتاجًا تكنولوجيًا أفرزه العالم الصناعي فحسب، ولم تكن معتمدة بشكل أساسي على استخدام الدولة النازية للهندسة الوراثية لتبرير التطهير العرقي وفقط، فقد رأى النازيون في التطهير العرقي استئصال للمرض من المجتمع وأنه جزء من الوصول لقمة التطور العلمي، بل كان نتاجًا لما أفرزه المجتمع البيروقراطي أيضًا. أي أن الأمر لم يكن متروكًا لأيديولوجية الأفراد، بل على العكس، كان هناك حرص شديد على التخلص من كافة الأفراد ذوي الحمية الشديدة والحماس الأيديولوجي المفرط، بطردهم من دائرة العمل.
يتطرق الكاتب إلى نقطة غاية في الأهمية وهى تعاون رؤساء المجالس اليهودية مع النازيين. وللوهلة الأولى من الممكن أن يصاب القاريء بالصدمة، فكيف للضحايا أن يتعاونوا مع قاتليهم؟! لم يكن الأمر كذلك وفقط، فشيوخ المجالس اليهودية كانوا يعتقدون أن خدمتهم الدؤوبة للنازيين من الممكن أن يكون لها تأثير إيجابي.فاستخدموا المنطق العقلاني في تبرير أفعالهم، ويضرب باومان مثال:حين أرسل ربعمائة من شيوخ جيتو “أوشميانا” وأطفالهم إلى مواقع الإعدام لقتلهم بأيدي الشرطة اليهودية.
هذا الأمر جعل الجمهور يشاهد مذهولا عرضًا استثنائيًا للفكر العقلاني المجرد من الوازع الاخلاقي. فكان لسان حالة الشرطة ورؤساء المجالس اليهودية يقول: “بالتأكيد إذا تركنا الأمر للألمان سيقتلون عددًا أكبر بكثير من اليهود، وإذا رفضنا أن نتولى قيادة الأمور، سيضع الألمان في أماكننا أشخاصًا أكثر قسوة و فسادًا. نعم إنه واجب أن ألوث يداىّ بقتل عدد أقل مما سيقتله الألمان من اليهود لو كانوا في مكاني.” وفي نهاية المطاف بدا أن الحل النازي عقلاني من وجهة نظر منفذي الهولوكوست، وعقلانيًا أيضا من وجهة نظر الضحايا. وهكذا استمرت استراتيجية إنقاذ ما يمكن إنقاذه تخدم النازية، فأبرزت مدى النجاح الذي حققه النظام البيروقراطي المكرس من أجل الإبادة.
نقطة أخرى ناقشها باومان في كتابه، تبرز أهمية ابتعاد الجاني عن الضحية أثناء ممارسته للفعل الإجرامي، مما يجعل النزعة التدميرية وفعل الإبادة أكثر سهولة. حيث لا يتعرض الجاني للعذاب النفسي الذي ينجم عن المشاهدة المباشرة لعواقب أفعاله، وبهذا يهرب من تأنيب الضمير. وهكذا يمكن أن تختفي العلاقة السببية بين أفعال الجاني ومعاناة الضحية. هنا ظهرت أهمية غرف الغاز، حيث يمكن أن يرى الفاعل أفعاله على أنها أعمال تكنيكية تخدم ما قبلها وما بعدها في سلسلة أعمال ضمن مهمة واحدة. وبهذا نجد أن تقسيم العمل في المنظومة البيروقراطية قد نجح في تزييف الوعى بشكل مدهش.
يختتم زيجمونت باومان كتابه بقوله: “لو كان جورج أورويل في روايته 1984 محقًا في قوله بأن التحكم في الماضي يسمح بالتحكم في المستقبل، فمن الواجب علينا، من أجل المستقبل، ألا نسمح لهؤلاء الذين يتحكمون في الحاضر باستغلال الماضي بطريقة ربما تحول المستقبل إلى مكان موحش لا يرحب بالبشرية. ولا يخفى علينا العقدة الصهيونية في إستغلال مصطلح “معاداة السامية” لتبرير أعمالهم القذرة في حق الشعب الفلسطيني، و محاولاتهم المريضة لإنشاء دولة قومية صهيونية على نمط قومية دولة الرايخ.”
من الأشياء التي أجدها تهمنا عند قراءة هذا العمل: أن نتجاوز البعد الزمني للحادثة التي يناقشها الكتاب لنصل للدرس المستفاد الذي يساعدنا على بلورة المفاهيم وحركتها في سياق التدافع. أي أن يكون الكتاب أداة تفسيرية لما يأتي بعده. ويمكننا فعل هذا بمحاولتنا فك الارتباط بين الهولوكوست واليهود وإخراج الحالة من خصوصيتها، في محاولة لإدراك أن البشر لا يمكن ولا يصح إخضاعهم لحسابات الربح والخسارة، لأن العقل البحت دون وازع أخلاقي هو ما أنتج وسينتج في كل مرة هولوكوست جديد مهما اختلفت صوره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*كاتب ومترجم مصري
نُشر في مجلة عالم الكتاب