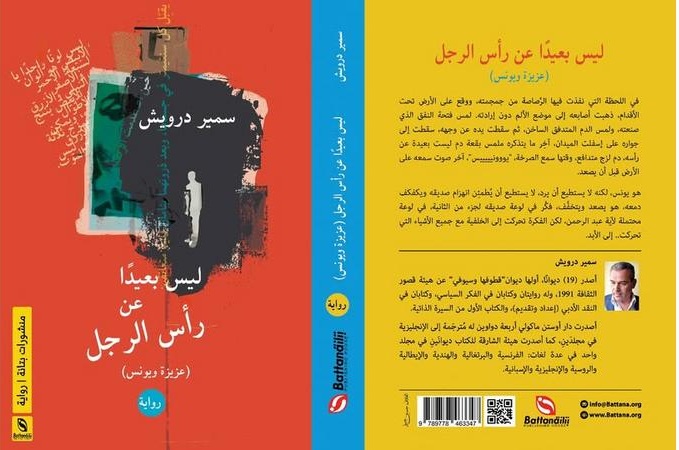أشرف الصباغ
اكتشفَ فجأة أنه يُقدِّر البلاءَ قبل وقوعه. حاول إغماض عينيه حتى يستطيع أن يعمل كعادته. تنفَّس بعمق وارتياح. استرخى جسده في هدوء. لا يعرف كم استغرق في حلم طويل، نسيه تماما عندما انتفض على دقات متوالية.
فتح الباب، فوجد أمامه الحاج أسعد. لم يلق عليه تحية الصباح. أخبره بأنه لابد أن يصحبه الآن إلى مثلث ماسبيرو. لم ينتبه إلى الغبار الذي يغطي ملابسه، ولا ملامحه الغارقة في العرق والتراب. سأله أكثر من مرة عن ما حدث. ولكنه كان يتلقى إجابة واحدة:
– سترى بنفسك.. كارثة.. مصيبة..
قطعا الحواري المتداخلة، حتى شارع 26 يوليو، عبرا الشارع بشكل أثار انتباه المارة ودفع سائقي الميكروباص وبقية السيارات إلى قذفهما بأكبر قدر من السباب واللعنات. ندب أسعد حظه ولام نفسه. راح يكلم نفسه بصوت مسموع ويتساءل: “لماذا لم أوافق على البيع؟ كان يمكن أن يكون السعر معقولا. الآن سيأخذون الأرض بسعر التراب”.
راح عاشور وأسعد يقطعان الحواري الضيقة المتداخلة، لاختصار الطريق، حتى وصلا إلى أطلال ثلاثة بيوت متجاورة، بينها بيت الحاج أسعد الذي يضم صالون عاشور الجديد. لا سيارات إسعاف أو مطافئ، ولا سيارات شرطة. كان المتجمهرون يبسملون ويحوقلون، يرفعون أياديهم ووجوههم إلى السماء ويحمدون الله. نظر إليه الحاج أسعد وقال:
– العوض على الله.
– أولادك بخير، يا حاج؟
– الحمد لله. لا توجد أي إصابات..
أخبره الحاج أسعد أن أسرته تعيش منذ أسبوع عند أقاربهم في جزيرة الورَّاق، وبقية السكان هجروا البيت منذ يومين، عندما تصدَّع فجأة. خبط بيده على رأسه، وقال في ندم إنه كان يجب أن يبيع البيت ويأخذ أمواله ويرحل من هنا. الجيران باعوا ورحلوا، وأصحاب الملك بدأوا بهدم البيتين المجاورين، فتصدَّع بيته الذي كان يستند من اليمين إلى أحدهما، ومن اليسار إلى الثاني. خبط رأسه مرة أخرى بيده، وقال إنه سيتنازل لهم وسيأخذ التعويض. سأله عاشور:
– وماذا عن المحل، يا حاج؟
– أي محل؟ البيت نفسه لم يعد له وجود..
– أنا دفعت لك ثمنه كاملا..
كادت تنشب معركة بين عاشور والحاج أسعد لولا تدخل الجيران. وبعد قليل، اتفقوا على أن يعيد الحاج جزء من المبلغ إلى عاشور، وينتهي الأمر. زعق أسعد: “لا أملك أي أموال. سأسدد عندما يأخذون الأرض ويدفعون ثمنها”.
شعر عاشور بالأرض تهتز تحت قدميه. أصابه دوار جامح كأنه في وسط دوامة. انتابه إحساس وكأن البيوت الثلاثة انهارت فوق رأسه. نظر إلى ساعته. ترك كل شيء وانطلق راكضا نحو السلم العلوي لكوبري مايو، متجها إلى الصالون في الزمالك. لم تكن الشوارع هي نفس الشوارع، ولا الوجوه هي نفس الوجوه. بدا كل شيء وكأنه مخلفات انهيار كبير ضرب الأخضر واليابس. وصل إلى الصالون متأخرا عن موعده بحوالي ساعة كاملة. دخل مسرعا ليغير ملابسه. فوجئ بوجود صاحب الصالون الذي قابله بتجهم وغضب. أخبره أمام زملائه، وأمام الزبائن، بأنه يدفع له أكبر أجر بين الجميع لا لكي يتأخر عن مواعيد عمله، ولكي لا يترك الصالون بالساعتين والثلاث ليقضي حاجاته الخاصة. صاح فيه بحدة، بأن لديه مسؤوليات وزبائن والتزامات وديون، وأنه لم يعد بحاجة إليه، وسوف يعمل الصالون على ما يرام بدونه.
لم يكن عاشور يسمع ما يقوله الرجل. كان يبحث بعينيه بين الزبائن لعله يعثر على الفتاة أو السيدة اللتين وعدتاه بالمساعدة. تراجع عن هذه الفكرة عندما تذكَّر أنه لم يعد بحاجة إلى واسطة في هيئة الكهرباء. لم يعد لديه صالون، ولن يصبح مالكا لأي شيء. حتى أمواله ضاعت، ولا يعرف هل سيعطيه الحاج أسعد بعضا من ما دفعه أم لا. انتبه فجأة إلى أن صاحب الصالون لا يستغني عنه فقط، وإنما يطرده أمام الجميع. أدرك أيضا أنه لا يعرف حتى عناوين زبائنه. فكَّر بسرعة بأنه من الممكن أن يتصل ولو حتى بالفتاة التي ستساعده في هيئة المرور. استراح لهذه الفكرة، بينما كان الرجل يقف أمامه يلوِّح بيديه ويتحدث بكلمات بدت وكأنها في حلم. فكَّر مجددا في كيف يمكن أن يرد. شعر بأن شيئا ما يقيِّد حركته، يربط لسانه تماما. حاول أن يضبط حركة جسده الذي راح يهتز وكأن زلزالا يهز الكون من حوله. غادر الرجل الصالون. انهمك كل واحد في عمله. بقى هو واقفا ينظر حوله تارة، وإليهم تارة أخرى. رأى أن لا أحد من الزبائن أو من زملائه ينظر إليه. اكتشف فجأة أنه لا يعرفهم.
قرر أن يعود إلى شقته مشيا. شعر بأن الزمالك في هذه اللحظات غريبة عنه، تركله بعيدا وفي اتجاه واحد بلا رجعة. حتى لو فكَّر في العمل لدى أي صالون آخر، فلن يفلح، لأن أصحاب الصالونات والزبائن لديهم كودهم الخاص، والأحاديث قد تنتشر قبل أن يصل إلى بولاق أبو العلا. راح ينظر إلى الشوارع التي سار فيها طوال أكثر من خمسة وعشرين عاما. كانت تلفظه، تخرج لسانها له. لا أحد ينظر إليه، ولا أحد يشعر بكل تلك المصائب التي وقعت على رأسه عليه فجأة، وكأنها ظلت تتجمع في مكان ما على الأرض أو في السماء ثم قررت أن تنهال عليه مرة واحدة.
لم يعد إلى شقته في بولاق أبو العلا، ساقته قدماه مباشرة نحو ميدان الإسعاف عَبْرَ شارع 26 يوليو. ترك نفسه يسقط في دوامة زحام الناس والسيارات والفوضى تحت كوبري 6 أكتوبر. بعد عدة خطوات وجد نفسه في دوامة فوضى ميدان الإسعاف. لم يكن هناك أي جديد في شارع رمسيس. حركة السيارات العشوائية المجنونة، وزحام المارة، والتجمعات الاعتيادية أمام نقابة المحامين. نظر طويلا إلى مبنى دار القضاء العالي، تأمَّله لأول مرة في حياته. سار كأنه منوم مغناطيسيا نحو أحد التجمعات على رأس شارع عبد الخالق ثروت. سمع هتافات متداخلة لشباب وشابات أمام نقابة الصحفيين. اختلطت الهتافات بهتافات أخرى لتجمع صغير أمام نقابة المحامين. لم يكن يُميِّز ما يقولونه. لكنه فهم أنهم يتحدثون عن المرتبات والمعاشات، وعن مساجين وانتخابات. راح يقترب من أحد التجمعات الكبيرة. لم تكن وجوه المتظاهرين تشير إلى كل هذا الشر الذي يمكنه أن يهدم البلد. كانوا يطالبون بأمور تخص مرتباتهم، والإفراج عن معتقلين لا يعرفهم. فاجأه سؤال من داخله: “هل هؤلاء الذين كانوا يريدون حرق البلد؟”.. صار في وسط الجمع الكبير، بين فتيات وشبان غاضبين، لا يمسكون بأسلحة ولا بزجاجات حارقة. وقبل أن يسأل نفسه سؤلا جديدا، كانت عربات الأمن المركزي وسيارات الشرطة قد ملأت المكان. ابتعد مسرعا. اختبأ بين الناس والباعة الجائلين والمتسكعين والنشالين. شعر لأول بإحساس غريب.
ظل يتسكع في تلك المساحة الضيقة حتى انتهت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي. أخرج هاتفه واتصل بنبيلة، فأخبرته أنها لا تزال في الوايلي، وستتوجه بعد قليل إلى بيتها في الورَّاق. دعته لركوب المترو بدلا من استعمال سيارته، اختصارا للوقت. قالت إنها ستنتظره ليذهبا معا إلى الورَّاق. لم يكد ينهي المكالمة حتى امتدت يد صغيرة مدربة واختطفت التليفون من يده. تلفَّت حوله في هلع وغضب. لم يجد إلا الزحام والمتسكعين والباعة الجائلين. تحسس جيبه بسرعة، فوجد أوراقه الشخصية لا تزال موجودة. أخرجها وأمسكها بقوة. تحسس النقود في جيبه الأمامي، فوجدها كما هي.
لم يهتم كثيرا بسرقة تليفونه المحمول. ركب عربة المترو المزدحمة، المتجهة إلى كوبري القبة. وقف في ركن بعيد، وراحت أفكاره نحو نبيلة. شعر بأن نبيلة التي يتوجه إليها الآن، ليست نبيلة التي تركها منذ أكثر من عشرين أو خمسة وعشرين عاما. لم يكن يشعر نحوها بتلك الأحاسيس، لكنه منجذب إليها، لا يريد أن يفقدها مرة أخرى. تَذَكَّر أنها قالت له إنها تتظر زوجها وابنها، وأن لديها حياة كاملة ومشاغل وأعمال. فكَّر في العودة وإنهاء كل شيء. فهي لديها أخوها في نهاية المطاف. وهو وحيد وغارق في المشاكل والإفلاس، لا زوجة ولا عمل ولا حياة ولا مستقبل. استبعد فكرة الزواج من نبيلة. وبعد قليل رأى أنها فكرة مناسبة.
راح عاشور يتأرجح بين الفكرتين حتى وصل إلى بيت نبيلة في الوايلي. لم يكن البيت موجودا. حلَّت محله أكوام ركام لا يزال بعض الغبار يتطاير منها وحولها، والناس يبسملون ويحوقلون، ويحمدون الله على أن البيت كان فارغا لحظة انهياره. لاحظ أن جداري البيتين المحيطين به قد انهارا أيضا. سأل أحد الواقفين عن نبيلة، فلم يرد عليه. سأل آخر، فقال إنه لا يعرفها. راح كالمجنون يبحث عن أي وجه يعرفه، أي ملامح ولو بالشبه يستطيع صاحبها أن يخبره ماذا حدث، وأين نبيلة الآن. وجد المعلم فهيم متكوما يبكي في ركن وهو يخبط رأسه بحجر، يرفع التراب ويهيله فوق رأسه: يردد: “حسن، يا حسن.. قلت لك تعال معي.. يا حسن، أهل خطيبتك ينتظروننا غدا، ماذا سأقول لهم، يا حبيبي”.
لم يكن في البيت وقت انهياره إلا حسن. غالبية الواقفين لا يعرفون لا فهيم ولا نبيلة ولا حسن. جاء بعضهم لتأدية واجب البسملة والحوقلة، والبعض الآخر لنقل ما يقال هنا أو هناك، والبعض الثالث أجَّلَ مصالحه لمد يد المساعدة. سأله عاشور عن نبيلة. بحلَق فهيم في وجهه وكأنه لا يعرفه. قال له باكيا إن نبيلة غادرت البيت قبل انهياره بدقائق. أخبره أنها تلقت مكالمة هاتفية من جيرانها بأن بيتها في الورَّاق قد انهار. أمسك بياقة قميصه وسأله عن حسن. فجاء صوت حسن من تحت ركام المنزل: “أنا هنا، يا بويا.. رجلي.. راسي.. أنا هنا، يا بويا”.. أطلق فهيم صرخة حرَّكت الغبار المحيط بالمكان، توجه نحو مصدر الصوت، راح يرفع الأحجار وقطع الخشب ويلقيها بعيدا. انضم إليه الواقفون. ظلوا يرفعون الركام حتى ظهرت إحدى قدمي حسن مهشمة يختلط جلدها بعضمها بلحمها، بينما الثانية لا تزال تحت حجر كبير.
كان عاشور يرفع معهم الركام، ويفكر في نبيلة. يحاول التخلص من فكرة أنها قد تكون تحت أي كومة من هذا الركام. لم يستطع أن يصبر حتى إخراج جسد حسن بالكامل. سأل فهيم عن نبيلة مرة أخرى. رد عليه بفرح وهو يتحسس الجزء الظاهر من جسد حسن: “راحت الورَّاق.. اسأل عن معروف الصياد.. الكل يعرفها هناك”. سأله عن سعد، فقال إنه لا يعرف عنه أي شيء. أكد له بفرح بأنه سيتصل به لكي يأتي. طلب منه أن يتصل بنبيلة الآن من هاتفه. لم يرد عليه فهيم. رفع جسد ابنه بين يديه، واتجه نحو المقهى الذي يبعد خطوات. راحوا يغسلون رأسه ويزيلون قطع الأخشاب والزجاج من رقبته وصدره، بينما كفه يتحسس قدمه التي تكاد تنفصل عن جسده. كان يردد مشدوها في رعب والدموع تتساقط من عينيه “أبويا.. أبويا.. رجلي.. رجلي، يا بويا، حجر على صدري”. لم يكن فيهم يسمعه.. كان يبكي في فرح، يمسح على رأسه بيد، ويبحث بصعوبة عن هاتفه المحمول حتى وجده. اتصل على رقم نبيلة وقذف لعاشور بالهاتف من بعيد.
أعطت نبيلة عنوانها لعاشور، ووصفت له كيف يصل إلى الجزيرة. أخبرته أنها وصلت للتو وتنتظر “المعدية” لتنقلها إلى الجزيرة. وأوصته بأن يبقى حتى يأتي سعد، ليساعده. لم يتلق منها أي إجابة شافية على أحوال بيتها. أعاد الهاتف لفهيم، ووقف ينظر إلى المشهد أمامه في حيرة. تأرجح بين التوجه مباشرة إلى الورَّاق وبين العودة أولا إلى شقته في بولاق أبو العلا ليأخذ بعض الأموال تحسبا لأي ظرف طارئ. وعندما تذَكَّر أنه بلا هاتف محمول، قرر أن يعود إلى شقته، على الأقل ليتمكن من شراء هاتف جديد والمرور على أي منفذ لشركة الاتصالات لاستعادة رقمه، وتسجيل بعض الأرقام المكتوبة على ورقة، ومن ضمنها رقم نبيلة.
البيوت القديمة تنهار واحدا تلو الآخر. لا ذاكرة لدى البيوت والعشش في العشوائيات، ولا حب أيضا. يقولون إن المدينة لا بد وأن تجدد جلدها، وإنَّ الواقع أقوى من الذاكرة والحب، أقوى من الناس عندما يفقدون أحلامهم وأموالهم والأسقف التي تسترهم. كتمت نبيلة صرختها عندما رأت بيتها قد تحول إلى ركام، لكن دموعها غلبتها. قالت بصوتٍ عالٍ: “ماذا أفعل؟ ماذا سأقول لمعروف وأنيس عندما يعودان؟”. جلست على أقرب كتلة طوب من بقايا بيتها. وضعت رأسها بين كفيها ودموع غزيرة تتساقط. أخرجت الهاتف من حقيبتها. بدأت في البحث عن رقم، ولكنها تراجعت على الفور. مسحت دموعها في هدوء. قال رجل من بين الواقفين:
– كان عليكِ أن تسمعي الكلام وتبيعين..
رد آخر:
– ستبيع رغما عنها، وبالخسارة.
نظرت إليهما طويلا. قامت وبصقت في وجهيهما. وقبل أن يهاجمها أحدهما، صرخت امرأة عجوز في الرجلين، وتقدمت من أحدهما بقبضة مشرعة. علت أصوات هنا وهناك، وحدث هرج ومرج. انسلت من بين الواقفين، واتجهت إلى حرف الجزيرة، حيث الشجرة الكبيرة التي كان معروف يحبها، ويحب أن يجلس إلي جوارها طويلا أثناء صيد السمك. بل وكانت قدماه تأخذانه أثناء نزهتهما في الأيام الخوالي إلى هذه الشجرة ليحكي لها عن طفولته تحتها وبين فروعها، يعيد حكايات الأم والجدة عن هذه الشجرة، وكيف جاء بها جده الأكبر فسيلة صغيرة لا تقوى على حمل طائر وليد، فبنى بيتا بجوارها وظل يرعاها هو وأولاده من بعده، إلى أن تغيرت الأحوال عندما أجبروا جده لأبيه على بيع البيت الكبير والانتقال إلى بيت أصغر.
أخرجت نبيلة الهاتف مرة أخرى، ولكنها تراجعت قبل أن تطلب رقما. نظرت إلى شاشة الهاتف طويلا، ثم ألقت به في النيل. مسحت على وجهها فجأة، مدت كفها إلى الأمام. أطلقت تنهيدة طويلة عندما رأت حبات مطر خفيفة تتساقط عليها. نظرت إلى السماء، ثم إلى عمق النهر. قالت: “مطر في الصيف! خير اللهم اجعله خير”. وغفت.
كان عاشور في هذه اللحظة، يلعن الحياة والناس وكل المحيطين به. يحاول التملص منهم للصعود الى شقته. قالت له المعلمة فريدة إنهم أخلوا البيت لأنه قد ينهار في أي لحظة. أشارت بيدها إلى ركام البيتين المجاورين، وحمدت الله أن عدد الضحايا قليل. صرخ في وجهها قائلا:
– أخذتي ذهبك ومصاغك وأموالك وأحفادك، وأنا أقف أمامك كما ولدتني أمي.
نظر إليه فرغلي وهو يحتضن ابنته، وقال موجها كلامه إلى فريدة:
– خليه يطلع، يمكن البيت ينهد فوق رأسه.
بحلق عاشور في وجه فرغلي. تقدم منه في غضب. تركت صفاء ولدها وركضت لتقف بينهما. قالت لعاشور:
– اطلع هات حاجتك، وربنا يستر.
توجه عاشور إلى مدخل البيت بإصرار وكأن أحدا يدفعه من الخلف. صعد السلالم مسرعا. دخل إلى شقته. دار بنظره مرة واثنتين وخمسة. قلَّب شفتيه، واتجه إلى الدولاب. سحب حقيبة قماشية ودس يده فيها. أخرج منها كل ما تبقى من نقود. وضعها في جيبه. جمع كل الأوراق الممكنة في الغرفة. راح يصنع منها عصافير. أحضر أكياس الألوان التي كان يستخدمها لتلوين البيض في شم النسيم.. راح يتفنن في تلوين العصافير. أطلق أول عصفور منها. دار العصفور بين جدران الحجرة، علا وهبط، حلَّق إلى أعلى وإلى أسفل، دار والتف، وفي النهاية اصطدم بالسقف، فسقط.
سمع صوت فريده تصيح عليه بأن ينزل بسرعة. تعالت صرخة صفاء بأن البيت يهتز. ابتسم عاشور وجمع عصافيره في الحقيبة القماشية. رَقَصَ أمام المرآة قبل أن يغادر الشقة. ارتدى بسمته الأصلية ونزل راكضا.
غادر البيت. خرج من حواري بولاق إلى شارع 26 يوليو. بين اللحظة والأخرى كان يتحسس الحقيبة القماشية، المعلقة على كتفه، باهتمام بالغ، وكأنها تحتوي على أشياء ثمينة أو كائنات حية. لم تفارق الابتسامة وجهه، ولكنها كانت ابتسامة بلا معنى. وقف قليلا، أسفل كوبري مايو. فكَّرَ قليلا في أي طريق يسلك إلى حديقة الأندلس: يعبر شارع الكورنيش ويصعد السلم إلى أعلى الكوبري ثم يسلك الضفة الأخرى من ناحية الزمالك، أم يعبر شارع الكورنيش ويتجه إلى كوبري قصر النيل من أمام وزارة الخارجية وماسبيرو؟ لم يطل تفكيره كثيرا. قطع الطريق فجأة غير عابئ بسباب سائقي السيارات، ولا حتى بالسيارات التي توقفت فجأة أمام حركة هذا المجنون الذي يعبر الشارع دون الالتفات إلى تلك القطع الحديدية المتهالكة التي يقودها مجانين وكسالى ومتعجلون وهو يحتضن الحقيبة. صعد السلم المؤدي إلى أعلى كوبري مايو. توقف قليلا. نظر إلى ناحية الأبراج العالية التي نبتت منذ سنوات لتخنق مبنى هيئة الكتاب. بحلَق طويلا في مجرى النيل من ناحية إمبابة. استدار ليكرر النظر إلى المجرى من ناحية كوبري قصر النيل.
المدينة عابسة. لا تعبر عن نفسها إلا بالضجيج والأصوات المرتفعة المتداخلة والدخان والغبار والسباب. فكَّر بأن عليه أن يفهم تلك المدينة الغريبة التي تعادي نفسها وتكره سكانها بقدر ما يكرهونها ويهينونها ويتبولون يوميا في وجهها، أو على الأقل يحاول أن يفهمها، ليفهم سبب قسوتها وجبروتها، وسر خنوعها وبلادتها، وربما نعومتها ودفئها وحنانها أحيانا. في هذه اللحظة فقط، أدرك أن الناس يشبهون المدن على نحو ما، والمدن تتشبه بناسها بدرجة أو بأخرى. لم يعد لديه شك، الآن فقط، في أن المجد للقبح والبلادة، في مدينة شمطاء مشوهة منحت نفسها لكائنات تأكل أمخاخ الحيوانات، وتتغدى على أمخاخ بعضها البعض. كائنات لا ترى في نفسها أي نقائص، بل تعتبر أن نقائصها في حد ذاتها حسنات ومميزات بحكم التاريخ والجغرافيا والعراقة والقِدَم والأصول النبيلة بأثر رجعي.
لم يكمل عاشور طريقه. عاد مرة أخرى إلى الحارة. ركب سيارته المتهالكة، وانطلق نحو ميدان التحرير. أوقفها في وسط الميدان بالضبط. فتح أبوابها الأربعة، صعد إلى سقفها. راح يرقص مرددا” خراء.. كلكم خراء”. وعندما اقترب عساكر المرور وآخرون في ثياب مدنية، قال لهم: “أنتم أيضا خراء”.. حاولوا الإمساك به، لكنه احتضن حقيبته، واختفى.
وصل إلى حديقة الأندلس. راح يوزِّع العصافير على الأطفال الصغار في حديقة الأندلس. وكلما قابل ولدا أو بنتا مع أبويهما، أهداهما عصفورا. تطفَّل على كل العشاق الواقفين على كوبري قصر النيل، أهدى البنات عصفورا، والصبيان ابتسامة. كانوا يضحكون، ربما لخفة عقله، وربما لخفة ظله. وقف على سور الكوبري. نظر إلى ماسبيرو، ومبنى وزارة الخارجية، والمباني الأخرى التي تقف كظلال مشوهة لفكرة ما.. التفت إلى النيل. ركَّز في رأس السهم البارز الذي يقود سفينة جزيرة الورَّاق على الخريطة وفي الواقع. شعر لوهلة أن السفينة تتحرك على الرغم من أنه لا يراها. أخرج ما تبقى من عصافيره. راح يطلقها في هدوء فوق صفحة النيل البعيدة. والعصافير تطير في كل الاتجاهات على الرغم من حرارة الطقس وانعدام الرياح، وقلة خبرة العصافير التي خرجت لتوها من شقة صغيرة في أدغال بولاق أبو العلا، مكونة من غرفة ضيقة وصالة أضيق منها.
تعالت الضحكات عندما اعتلى سور الكوبري وراح يرقص ويرفرف بذراعيه، ربما لتشجيع العصافير على التحليق لأطول فترة ممكنة قبل أن تسقط في النيل أو تصطدم بسقف من أسقف تلك المباني البعيدة العالية. كانوا يتفرجون عليه، ربما كمجنون، وربما كمهرج. كانوا يضحكون ولا يبالون بأصوات العساكر والضباط الذين يبحثون عن إرهابي بيده حقيبة بها متفجرات، ترك سيارته في وسط ميدان التحرير، وفتح أبوابها الأربعة، ثم صعد على سقفها وراح يرقص نفس رقصة ذلك الرجل الذي يوزع العصافير على الأطفال والعاشقين.
كانت أصوات العساكر وسارينات سيارات الشرطة تحاصر الناس، تحرم المكان وأطفاله وعشاقه من سكينتهم وابتسامتهم، ومن وهج رقصات الرجل الذي اختفى فجأة، وظهر ظله من بعيد وهو يركض على الكورنيش، تطارده ظلال ترتدي ملابس مدنية وعسكرية، في اتجاه لا يعلمه أحد. قال البعض بعد ذلك أنه رآه في نفس اللحظة يواصل الرقص في الميدان. وقال صبي إنه رآه يقفز وسط العصافير البيضاء ويُحَلِّق معها فوق صفحة المياه. لم يؤكد أحد أنه سقط في النيل. قال آخرون إنهم رأوه يركض بكل قوته على الكورنيش حتى وصل إلى كوبري الساحل. لم يتجه ناحية نزلة شبرا المظلات وإنما ركض قليلا حتى نزل على كورنيش الوراق. قال البعض إنه قفز إلى المعدية، وأكد البعض الآخر أنه قفز في المياه مباشرة لكي يصل إلى الجزيرة سابحا. قالت امرأة مسنة إنها رأته بعينيها، اللتين سيأكلهما الدود، يصعد من المياه إلى الجزيرة. وقال رجل عجوز إنه رأي مخبرا يطلق عليه الرصاص، ورأى جسده يسقط في النيل، وصاح طفل صغير، مؤكدا أنه رآه يسبح وسط الأسماك الصغيرة، بينما أكدت امرأة أنهم لم يطلقوا عليه النار، وأنها رأته وهو يصعد من المياه إلى طرف الجزيرة ويختفى داخل تلك الشجرة الضخمة التي تقف منذ سنوات طويلة على حافتها مباشرة.
ظل الناس يتذكرون تلك الحادثة، ويحكونها للصغار. كانت تزيد وتتغير وتطول كل مرة. وكان الصغار، في كل مرة، يكررون نفس السؤال: ولكن إلى أين ذهب عاشور؟ هل قتلوه، أم غرق، أم اختفى بداخل الشجرة الكبيرة التي نبتت إلى جوارها، بعد عدة أيام، شجيرات صغيرة خضراء؟
ظلت نبيلة تأتي وحيدة في شم النسيم من كل عام، تفرش ملاءة بيضاء إلى جانب تلك الشجيرات، تخرج البيض والفسيخ والبصل وأرغفة الخبز، تدعو المارة للأكل، وتلقي بالبيض والفسيخ إلى المراكب المارة بالقرب من حافة الجزيرة. كانت تجلس ساهمة لبعض الوقت، ثم تنتبه فجأة وتبحلق في المياه تارة وفي السماء تارة أخرى، وكثيرا ما كانت تنظر بحدة إلى أرض الجزيرة، وكأنها تنتظر شيئاً أو أحداً. وعندما لا تأتيها سوى ظلمة المساء، كانت تتدحرج بعض الدموع على خديها، فتتنهد بحرقة وتسند يدها على ركبتها، تنهض مكسورة، تلملم الملاءة والأشياء، تلقي في يأس بالملح وبقايا البيض والبصل والفسيخ في المياه، تكتم نهنهاتها وتتجه نحو عمق الجزيرة. تسير بخطوات امرأة عجوز لم تكمل الخمسين بعد، تتلاحق أنفاسها وتتعثر كمريضة بالربو. تمسح دموعها وتفكر في قسوة الانتظار الذي بدا لها في لحظة ما أنه أشد عقوبة نالتها في حياتها. كانت في كل مرة تتأكد من أن الانتظار قد يكون عقوبة مخففة، ولكنها تصبح أكثر قسوة عندما لا يأتي شيء أو أحد. وتصبح هذه العقوبة مثل الإعدام عندما تصدق هي نفسها أن لا أحد ولا شيئا قد يأتي. ومع ذلك كانت تحرص على المجئ كل عام، في شم النسيم، حتى عندما تمكنت منها خشونة الركبة، وأصبحت قدماها لا تقويان على حملها.
في المرة قبل الأخيرة، رآها الناس تزحف نحو الأشجار، تدور حولها، تمسح على لحاء سيقانها ثم تمسح بيدها على صدرها. تجمع ملئ قبضتيها بالتراب تنثره من جديد على جذوع الأشجار، في حين تتساقط الدموع عليه من بين جفنين متهدلين لا يقويان على الارتفاع قليلاً ولو حتى من أجل أن تمر من بينهما نظرة واحدة لرؤية ما يمكن، ومَنْ يمكن أن يأتي، بعد طول انتظار، من النهر أو من الفضاء أو من داخل الجزيرة أو حتى من داخل الشجرة الكبيرة.
كانت الأشجار تكبر وتنتشر فروعها لتظلل مساحات كبيرة من تحتها. صار المكان وجهة للأطفال والكبار والعشاق والمحبين. وبمرور الزمن امتدت الأرض قليلا داخل المياه، بدت وكأنها ناءت بحمل كل تلك الأجساد والأقدام وبكتلة الأشجار التي كانت تكبر بسرعة غير اعتيادية. بدت تلك القطعة الصغيرة من الأرض وكأنها تريد الانفصال عن الجزيرة التي كانت تشبه منذ سنوات سفينة برأس سهم. وحتى عندما ظهرت فرق العمال والآلات الضخمة لهدم بيوت الجزيرة وبناء أبراج سكنية وغير سكنية وناطحات سحاب وبنوك ومطاعم وكمباوندات للأثرياء، ظل الناس يذهبون إلى تلك المساحة الظليلة.
ظهرت المرأة مرة واحدة فقط بملابسها السوداء المتربة وهي معصوبة الرأس بمنديل أسود مهلهل، وكأنها غادرت للتو قبرها. حدث ذلك عندما حلت على الجزيرة وجوه غريبة مصحوبة بحرس مسلح ومعها آلات ضخمة لقطع الأشجار. يومها ضربوا الناس وطاردوهم إلى داخل الجزيرة ثم حاصروهم هناك، أخلوا المكان لكي يتمكنوا من قطع الأشجار وتكسير لسان الأرض الصغير الذي امتد في السنوات الأخيرة إلى قلب النهر، حاولوا أيام وأسابيع طويلة فصله عن الجزيرة الأم. هي نفسها لم تعرف كيف حملتها قدماها حين اتجهت وحيدة نحو الأشجار. قالوا إنها مجنونة، دفعوها بكل الطرق لإبعادها، ولكنها كانت تتعثر وتنهض، تسير من جديد وكأنها قاطرة فولاذية، أو قطة تسعى لإنقاذ أبنائها من حريق كبير، ثم ألقت بنفسها على جذع الشجرة الكبيرة.
مع الوقت، نسي الناس حكاية الرجل الذي طار مع العصافير، وتحول إلى ظل سقط في النهر، ثم خرج من المياه واختفى بداخل الشجرة الكبيرة. ظلوا يحكون عن تلك المرأة التي كانت تأتي في شم النسيم من كل عام مرتدية السواد، تطعم الناس والأسماك، وتنثر التراب على جذوع الأشجار وترويه بدموعها، لكن لا أحد يتذكر أين ذهبت. البعض قال إنه رأى البلدوزر الكبير يسحقها ويسوِّي جسدها بالأرض، والبعض الآخر أكد أن الحراس المسلحين ألقوا بها في النيل، بينما أكد آخرون أنها قفزت إلى المياه بمحض إرادتها.
امرأة واحدة فقط أقسمت أنها سمعت رعدا في عز الصيف، ورأت بعينيها، اللتين سيأكلهما الدود، برقا هز الجزيرة وارتفعت مياه النيل حتى فاضت على الأرض. رأت الشجرة تهتز بشدة، تفتح لحاءها ليخرج من ساقها الضخمة نور يكاد يعمي العيون. فتحت المرأة المرتدية السواد ذراعيها ونظرت إلى النيل طويلا لكن الشجرة الكبيرة ابتلعتها. قالت أيضا إنهم اقتلعوا بعض الأشجار الصغيرة التي نبتت خلال الأعوام الأخيرة، لكنهم فشلوا تماما في اقتلاع الشجرة الكبيرة. جربوا كل الحيل والألاعيب والبلدوزرات الضخمة، وعندما يأسوا، قرروا قطعها بمناشير كهربائية جلبوها خصيصا لهذا الغرض. قالت في جدية، وصَدَّق على كلامها رجلان وطفل صغير، إن العمال فوجئوا بسيول من الدماء الحمراء الداكنة تنطلق من جذعها الضخم وتتناثر على أجسادهم ووجوههم، فتركوها وابتعدوا. ظل المٌلَّاك الجدد وأثرياء الجزيرة وأصحاب الشركات والأبراج والمطاعم، لسنوات طويلة، يحاولون قطعها من أجل تحويل المكان إلى حديقة كبيرة لأولادهم وزبائنهم، ولكن العمال كانوا يهربون، ولا يعودون أبدا. فكفوا عن محاولاتهم معولين على أن تشيخ وينخرها الدود والعفن وتسقط من تلقاء نفسها.
أقسمت المرأة، وهي تنظر إلى الرجلين والطفل لكي يؤكدوا كلامها، بأن كل من يقترب من هذه الشجرة، يختفي، أو يغيب عن الوعي أو يصاب بالجنون حتى يموت. نظرت إلى الشجرة مبتسمة وأقسمت مجددا بأن العشاق والنساء الحوامل والأطفال فقط هم الذين يمكنهم الاقتراب منها ولمسها. يأتون إليها في الأعياد والليالي المقمرة، يدورون حولها، يتبادلون معها أحاديث طويلة، يلمسونها برفق حتى تتحرك لحاؤها وتظهر لها شفاه وعيون، تبادلهم الحديث، تبكي معهم وتفرح بهم. تنبت لها كف كبيرة تربت بها على أكتافهم، تمسح بها على صدورهم. تهمس لهم بكلمات لا يعرفها إلا هم والعصافير البيضاء التي تسكنها منذ جاء بها جد معروف الأكبر وزرعها على طرف الجزيرة.
……………………………
– صدرت رواية “كائنات الليل والنهار” عن دار “العين”، القاهرة، 2019.