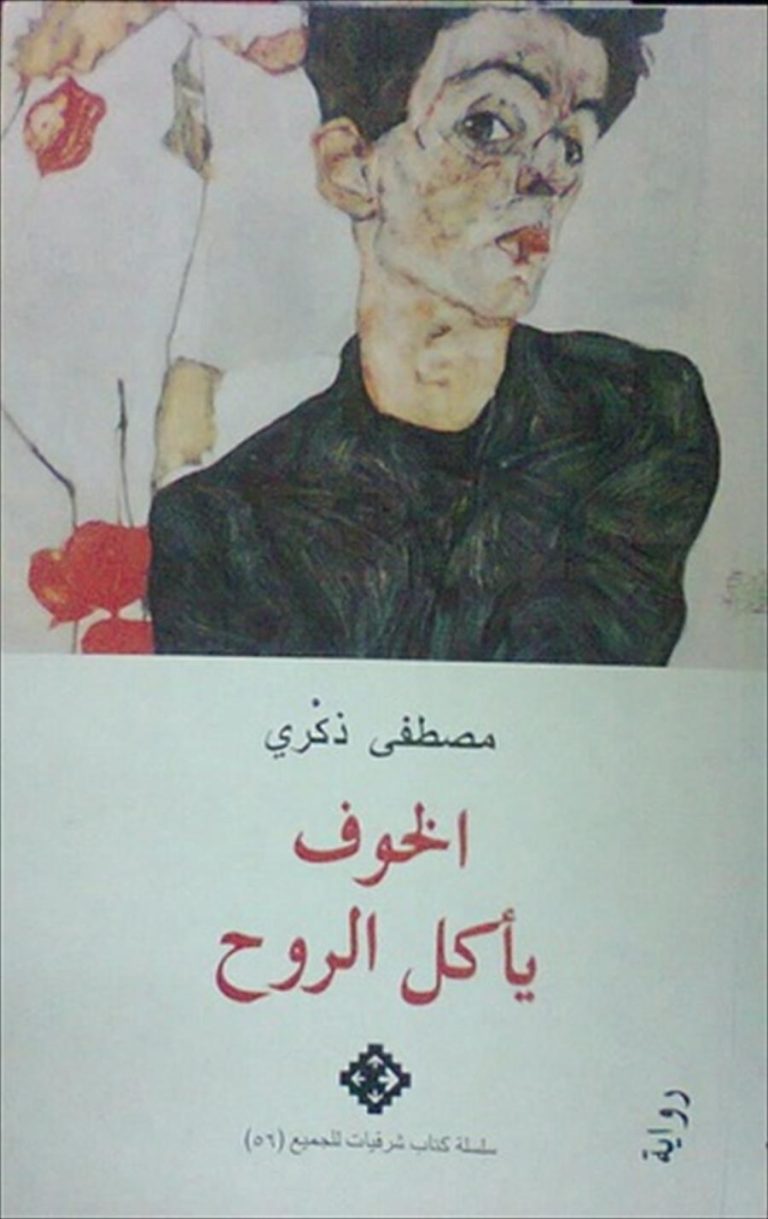محمود سليمان
(1)
بدأ الأمر بمحاولة كتابة قصيدة جيدة.
(2)
من أعلى المنحدر، بزغتْ كنسمة هواء حانية في جوٍ ملتهب.
كانت تهبط المنحدر برقة معتادة، في يديها بعض المشتريات المنزلية، متخفية في نظارة طبية ذات إطارات سميكة.
ومن أسفل المنحدر، كنتُ أتابعها بأعين حائرة في تأكيد هويتها، فأبطأتُ من سرعتي، لعلها تتعثر في وجهي وتتعرف علي، كانت تدقق النظر في كل خطوة تتخذها نحو الأسفل، وكأنها تحرص على مداهمة الزمن بمدّ وقت الخطوة، ونظرها المعلق بالأرض الترابية يكشف عن خيبة كبيرة تلتهم أملي. فاصطنعتُ احتكاكًا خشنًا بجزمتي، فبدت الجلبة في هيامها المبالغ بحصى المنحدر، دويًا فارغًا. ولما أصبحت المسافة بيني وبينها خطًا قطريًا لا يتعدى مترين، رفعتْ رأسها المحني، وقد كانت عبرتنى بخطوة.
لكنها -الخطوة- كانت كفيلة لالتقاء الأعين، وبدا من تحرج الرمش والتفات الرقاب، أثرًا واضحًا في معرفة كلًا منا للآخر.. فتوقفتُ وتوقفتْ.
“ميس جاكلين!”
ضيقتْ من عينيها، لينحسر السواد في محيطهما.
“يونس!.. إيه أخبارك؟”
أنزلت أكياسها البلاستيكية الملونة، ومددتْ يدًا أرهقتها التجاعيد المبكرة.
“أنا جميل الحمد لله يا مس جاكلين.. إيه أخبار حضرتِك؟”
لم تعد الابتسامة بنفس الانتعاشة القديمة، بسبب تلك الخطوط البارزة حول فمها.
“نحمد الرب يا يونس.. كيف هى حياتك؟”
بدا السؤال أضيق من أن يحتوي لحظة عابرة كتلك، فاهتزت شفتاي.. لا عن إجابة، إنما عن عرض بحمل أكياسها وتوصيلها للمنزل القريب، رفضتْ متعللة: “لا أريد اتعابك معى”، لكن تلك الأشواق الراكدة في بحيرة العينين، تكشف عن ما تهجس به الأنفس، فوافقتْ، ومضينا.
في خلال كل تلك الأعوام الماضية، تتخللها مقابلات قليلة لميس جاكلين، لم أتبين غير الآن، أنني أصبحت أطول منها، طولًا يجعلنى أحني رقبتي لأكلمها، بعد أن كانت في عنفوان الماضي البعيد قمة جبلية نتحلق حولها كأطفال، علنا نظفر بقبلة مسكرة، أو ربتة من يد غزلتها السماء، أو ضحكة تتراقص لها مقاعد الفصل.
“تخرجتَ من الكلية.. صحيح؟”
“من زمااان”
قلتها، وانعطفنا يمينًا داخل شارع صغير، الشارع مسدود عند نهايته، وبيتها -كما اعتدت ارتياده أيام الدروس الخصوصية- على الجانب الأيسر، ترتيبه قبل الأخير من نهاية السد.
“أنا حاليًا أشتغل”
“لا زلت تكتب الشعر؟”
كان سؤالًا مباغتًا، فحاولتُ مرواغتها لأطيل من عمر المصادفة السعيدة.
“أحيانًا.. أكتب قصائد متفرقة.. صحيح.. إيه أخبار إسحاق؟”
غابتْ في الرد، فنظرتُ ناحيتها، لأجدها تنظر لي بتركيز شديد.
“تعرف أن إسحاق يشبهك تمامًا؟”
نظرتها المركزة والمتبوعة بجملتها الأخيرة، أصابتنب بشئ من القلق. كان الشارع هادئًا نسبيًا، يكاد يخلو من الأقدام، والغسق يهبط بالمدينة إلى بئر ليلي.
“كفى.. لا أريد أن أتعبك أكثر من ذلك”
“فقط.. دعينى أحمل لكِ الأكياس حتى باب المنزل”
رسمتْ أسفًا بملاحمها، ووافقت تحت إصرار نظرتي، عبرنا المدخل المظلم، وتقدمتني ناحية الدرج إلى الطابق الثاني، كانت تصعد بثقل واضح، تستند على السور بقبضة واهنة. وكنت أتأمل شعرها القصير المصبوغ بصبغة سوداء، ثمة خيط أبيض عند مفرق الشعر ينازع لرفس آثار الصبغة، وبدأت أتسائل كيف تسرب لها هذا العجز المبكر، وهى -حسب ظنى- لم تتعدى الخامسة والأربعين عامًا.
“بعد كل ذلك التعب.. صدقني يجب أن أعزمك على كوب من الشاى”
تعللتُ بتأخرى على مشوار، في الأغلب، فقدتُ وجهته، ووافقتُ تحت إلحاح كلمة “صدقنى” الخارجة من فمها كتغريدة، ودخلتُ كالمسحور في منزل السعادة القديم. كان المنزل مظلمًا وهادئًا بشكل يتبين للناظر أنه غير مسكون ببشر، ترتيبه المنظم الدقيق أشعرني ببعض الغثيان المفاجئ، جلستُ على أقرب كنبة في الصالة، كانت بنية تقريبًا، فيما اتجهتْ ميس جاكلين لأحد الأركان، لتضئ لمبة صفراء سهاري، تستر أكثر مما تنير، وجلبتْ عودًا من البخور، أشعلته، وأخذت تردد همهات خفيضة، لم ألتقط منها سوى جملة أخيرة: (بل يكون عندك مقدسًا للرب)
“سكرك إيه؟”
“معلقة واحدة”
“خذ راحتك”
ألقتها دون حتى أن تلتفتْ لي، وولجتْ مطبخها عبر ستارة رمادية باهتة. هالني منظر الحائط أمامي: الأطر المعلقة لصور قديسين، تتوسطهم صورة للسيدة العذراء تحمل المسيح طفلًا، في الأعلى يتوج الحائط صليب خشبي كبير، مصلوبًا عليه عيسى، تسيل على جبهته وحتى قدميه بعض الدماء القانية، الشوك منغرز في رأسه. وصداع غليظ بدأ يخلخل بأسنانه الحادة رأسي أنا، والغثيان المنبعث من تلك الغيمة الزرقاء القاتمة التي حطت علي، يفرض تقيًأ طارئًا من داخل معدتي. ما هدئ روعي قليلًا، رائحة البخور تلك، المصنوعة من لبان الذكر المخلوط باللافندر، رائحة لطالما اعتدتُ على شمها في الأماكن المقدسة.
غابت “ميس جاكلين” طويلًا، ولولا سماعي لطرقعات المعلقة وإيقاع الأكواب، لظننتُ أنها نامت أو اختفت. كان انتظاري لها، كالوقوف أمام المجهول عاريًا.
“تأخرتُ عليك؟”
خرجتْ، حاملة صينية ذهبية، عليها مج أبيض، منقوش عليه (العضرا) وفوق الكلمة قلب أحمر، بجانب المج كوب شفاف من الشاى، محاطًا ببعض الصلبان حول حوافه، انحنتْ لتضع الصينية، فراعني رؤية منبت صدرها الأبيض، ما جعلنى أنتبه أنها خلعت معطفها القطني. جلستْ أمامي منهكة، كمن عادت من رحلة طويلة، عارية الذراعين، وصليبها الفضي مدلى طرفه السفلي حتى موضع انشقاق النهدين.
“لا زلتِ تعملين في المدرسة يا ميس؟”
“تركتها من زمن لا أحصيه يا يونس”
كانت تتكلم بلهاث واختناق، واستنبطتٌ أنها تعاني من ضيق تنفس أو ما شابه، وعندما حاولتُ الإشارة إليها بذلك، وجهتْ نظرها تجاه البخور المشتعل، وقالت:
“وتركت الكنيسة أيضًا”
لم أفهم مغزى قولها، فأثرتُ الصمت. اعتدلتْ في جلستها، وتناولتْ إطارًا صغيرًا موضوعًا على (كومودينة) أسفل الحائط المقدس الملئ بالصور، وناولتني إياه.
“إسحاق وهو كبير”
كانت صورة من طراز البورتريه، الوجه يملأ جوانبها. لم يكن إسحاق يشبهني أصلًا، شعره الطويل المدلى على الكتفين، وتلك الملامح الدقيقة، الطيبة، تجعلانه أقرب في الشبه للمسيح، ولكن ما جعل ميس جاكلين تشبهه بي، هى تلك الكدمة في حاجبه الأيمن، علامة مميزة مفرغة من بعض الشعيرات، اشتركنا فيها نحن الاثنين.
“تذكر؟.. كنت دائمًا أخبرك.. أنني أتمنى لو أراه مثلك”
“لكنه أجمل يا ميس”
قامتْ وأخذت مني الإطار، وراحت تضعه في نفس الموضع، وبنفس الميل واتجاه الزوايا. بدأتُ أشعر بالضيق من المكان، اتسعت الهالة االزرقاء الكئيبة، وأحسستُ أن البخور يخترق حواسي، ويذيب أطرافي المتألمة، فتجرعتُ الشاى سريعًا وسط صمت متبادل، واختلاس نظرات، لا إرادية، ناحية صدرها، وحينما قامتْ لتتناول الأكواب، قلت:
“إيه أخبار أستاذ ماجد؟”
انتبهتْ فجأة، وتسمرت مكانها، في يديها الصينية الذهبية، وفي عينيها فراغ متسع، اهتز ساعدها الأيمن، فارتعشت الصينية بإيقاع مضطرب، وقالت:
“بداخل الفازة منذ أن جلسنا”
وأشارتْ ناحية فازة موضوعة على المنضدة بجانب صورة إسحاق، ودخلتْ المطبخ. شعرتُ بالتوتر، وكدت أندفع للشارع لأطرد بلغمًا استقر في قاع صدري، لكنني بدلًا من ذلك، ذهبتُ لألقي نظرة على الفازة.
فازة رفيعة، متوسطة الحجم، يحيط بفوهتها خيط أخضر رفيع، وحول قاعدتها نفس لون الخط لكنه أحاطها بسماكة أكبر، وبين الخطين الدائريين، بعض الورود الحمراء المبعثرة حول جذع الفازة، اقتربتُ منها بحرص مبالغ، وألقيت نظرة فوق فتحتها ولم أجد سوى قطعة من زرعة صبار ميتة، استعجبتُ مكرمشًا ملامحى، وقررت مناداتها، وسؤالها عن مقصدها، وحين التفتُ، وجدتها واقفة، وقد ارتدتْ معطفها ثانية.
“كان يحب زروع الصبار كثيرًا”
لم أعرف ما يجب قوله، فتلعثمت خطواتى ناحية الباب.
“الله يرحمه.. استئذن حضرتك يا ميس جاكلين”
“تقبل مني تلك الهدية البسيطة”
قبضتْ على ظهر كفي الأيمن، وقلبته، ووضعتْ في راحتى ميدالية فضية، وأغلقتْ راحتي، ثم ضغطتْ بإبهامها على يدي مرة أخرى.
“كنت أريد إهدائك أى شئ.. أنت أول من يزورني منذ زمن.. لكن للأسف ليس عندي ما يوفي قيمتك يا يونس.. أرجوك لا ترفضها”
أومأتُ موافقًا، وودعتها، واعدًا أن أزورها في أقرب وقت ممكن، ونزلتُ الدرج في ثانية أو أقل.
كان الليل قد خيم على المنطقة، أسرعتُ الخطى بعيدًا عن الحارة الضيقة، ثم انعطفتُ ناحية الشارع، وصعدت المنحدر، عبأت صدري بنفس عميق، وطردتُ أوهام الهالة الزرقاء العالقة، وأخرجتُ من جيبي ميدالية “الميس”، كانت ميدالية صغيرة في طرفها حلقة دائرية، وفي طرفها الآخر صورة صغيرة مجلدة بورق شفاف: للسيدة مريم العذراء، حولها تلك الهالة الدائرية البيضاء، وبين راحتيها يجلس المسيح طفلًا، وحول رأسه حلقة ذهبية.
وضعتها في جيبي مجددًا، وعبثًا حاولت تذكر وجهتي، ولم أعرف، ثم قررت أن أهيم في الشوارع، ورحتُ أراجع تلك الأشياء العجيبة: وجه إسحاق وقد تبدل بوجه المسيح، الكدمة أعلى الحاجب، زرعة الصبار، المسيح ينز دمًا أسودًا، رائحة البخور بالكندر واللافندر، وتلك الضغطة الحانية على ظهر راحتي، من إبهام “ميس جاكلين” الجميلة.
(3)
نظرتٌ إلى موضع الضغطة على ظهر كفي، وقد تغير لونها للزرقة، وبعدها تمشيت بلا وجهة، محاولًا كتابة قصيدة جيدة، على الهواء.