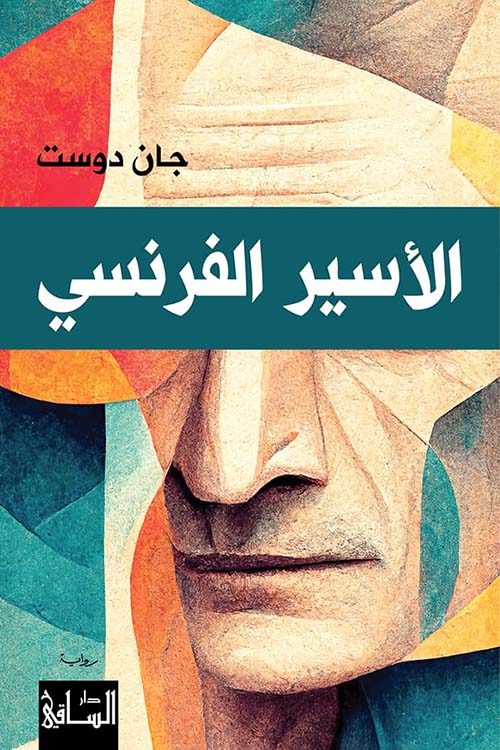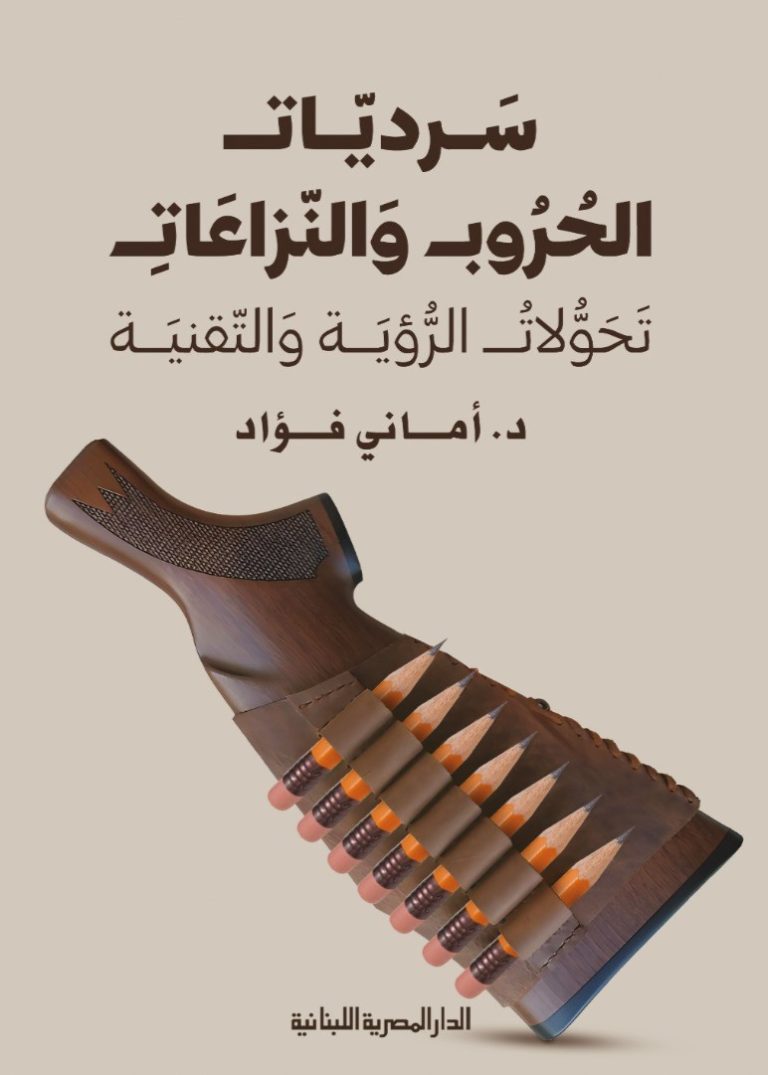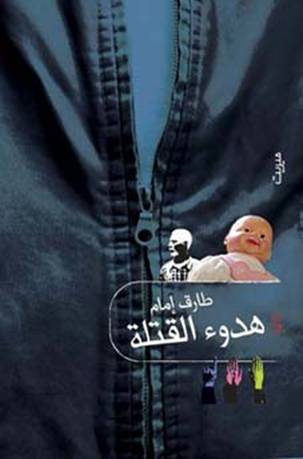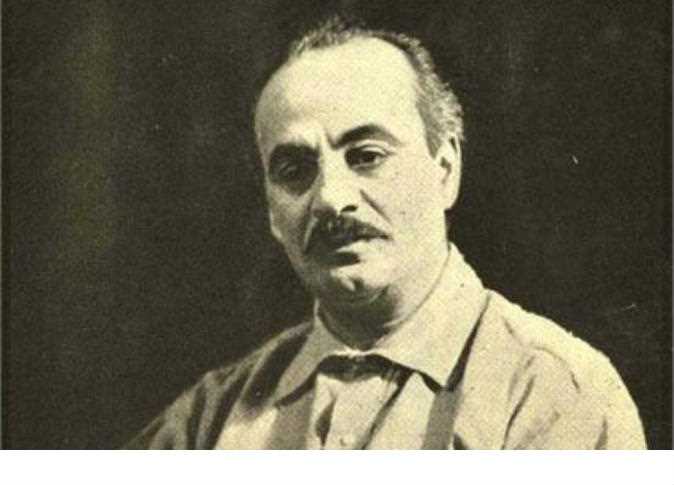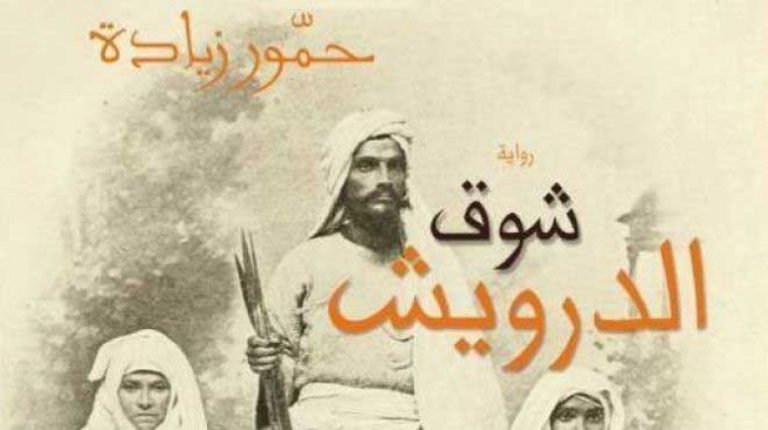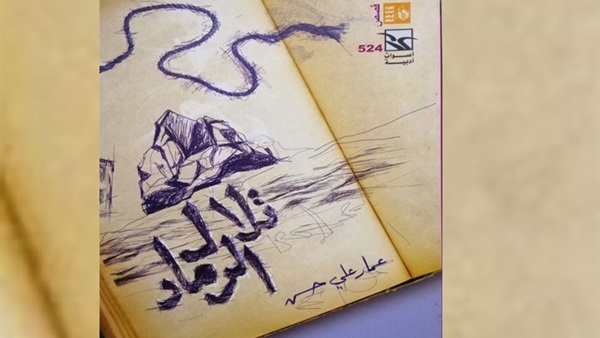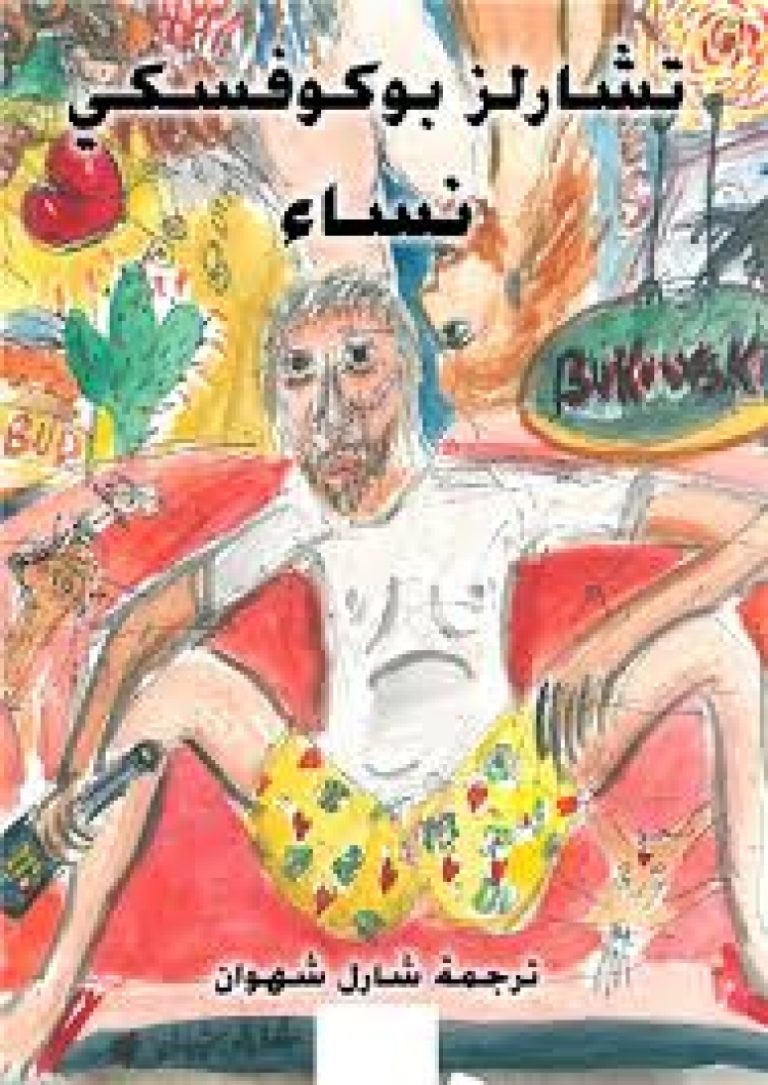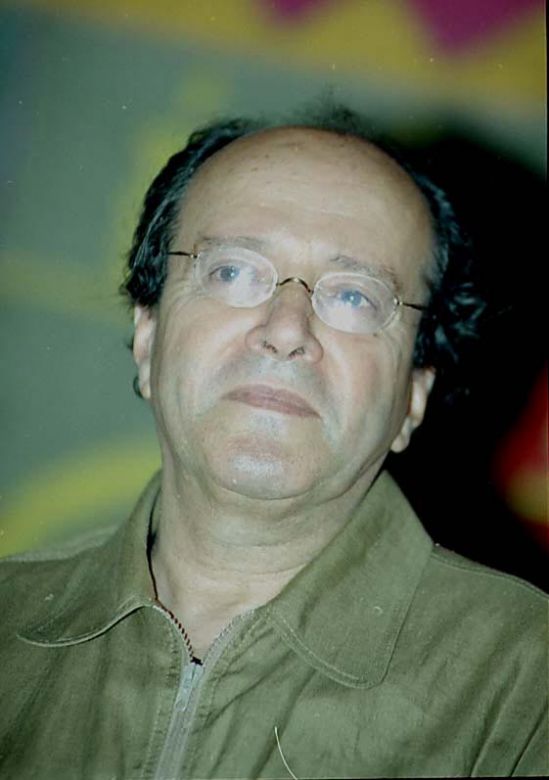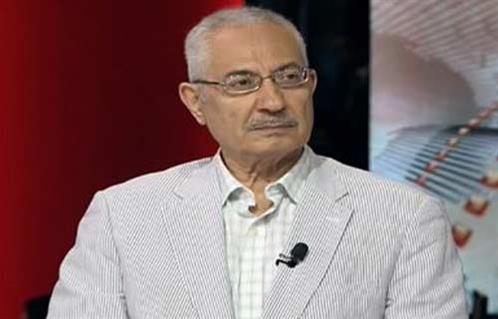عايدة جاويش
الروايةُ التاريخيةُ مغامرةٌ أدبيةٌ تتطلب شجاعةً وإبداعًا وجهدًا استثنائيًا لاستعادةِ التاريخِ من الكتبِ القديمةِ وإعادةِ صياغتِه بطريقةٍ روائيةٍ مبتكرةٍ. حيث لا يكتفي الراوي بوضعِ إطارٍ زمنيٍّ للأحداث، بل يغوص في أعماق التجربة الإنسانيةِ التي أحاطت بالأحداثِ التاريخيةِ في ذلك العصر، فيخلق حواراتٍ حيةً بين الشخصياتِ ويبتكر عوالمَ جديدةً لملء الفجواتِ في السجلاتِ التاريخية، محولًا الوقائع الجامدة إلى عوالم حيّةٍ تنبض بالصراعات الوجودية. وفي روايةُ “الأسيرِ الفرنسي” للكاتبِ السوريِ الكردي جان دوست يصبح هذا التحدي الفنيّ انعكاسًا لرحلةٍ ثقافيةٍ معقدةٍ بين الشرق والغرب, حيث ينجح الكاتب ,بتقنيةٍ سرديةٍ بارعةٍ, في تحويل وثائق تاريخية منسية إلى حكايةٍ عالميةٍ تطرح أسئلةً ملحةً عن الهوية والحرية والصراع الحضاري.
الرواية التي صدرت عن دار السواقي للطباعة والنشر عام 2023، وأُدرِجت في القائمة الطويلةِ لجائزةِ بوكر للرواية العربية لعام 2025، تأخذُ القارئ في رحلةٍ تُضفي على الوقائع التاريخية بعدًا إنسانيًا يلامس وجدان القارئ. من خلال مصادفاتٍ مثيرةٍ، يعثر الكاتب على مذكراتِ الأسير الفرنسي بيير آميدي جوبير (Pierre Amedee Jaubert) المكتوبة باللغة اللاتينية, فيعيد تشكيلَها في عمل روائي يجمع بين دقة التوثيق ودهشة الخيال. تتحول أوراق المذكراتِ إلى خريطةٍ وجوديةٍ يرسم عليها بيير, ببراعة, الخط الفاصل بين الأملِ واليأسِ، وبين الحريةِ والعبوديةِ، وبين باريس المدينة المنيرة وقعرِ الزنزانة المظلمة.
تغوص الرواية شيئًا فشيئًا في تشريح فكرة الثورة الفرنسية؛ فجوبير ابن الثورة الفرنسية التي حررت العقلَ وأسقطت التاجَ كان رافضًا لصراعِ رموزها الدموي على السلطة الذين قسَّموا المجتمعَ الفرنسي آنذاك إلى ملكيين وثوريين، وحوَّلوا شوارع باريس إلى أنهار دماء “فرنسا كانت تتغير، وتغير معها وجه أوروبا الملكي إلى الأبد.”
بعد وصول بيير وعائلته سالمين إلى باريس وسط بحرٍ من الدماء وأكوام الجثث، محاطين بغابةٍ من المقاصل وطوفانِ الثورة، عملَ بيير كمصفف حروف، ثم انضم إلى الحرس الثوري ليصبح دركيًا، وهو ما عارضته والدته قائلة: “بدل أن ترفع بندقية قاتلة، تستطيع أن تحمل القلم، فالأقلام لها قدرة على التغيير أكثر من البنادق، يا ولدي.” لينتهي به المطاف في مدرسة اللغات الشرقية، حيث تعلمَ اللغات التركية والفارسية والعربية، التي كانت تبدو له وكأنها توائم لغوية لها قاموسٌ واحد. يُرشِّحه معلمه ليكون المترجمَ الرسمي لنابليون، فيذهب بيير إلى الشرق ضمن الأسطول الحربي الفرنسي برفقةِ نابليون، محاطًا بكل الخيالات الرومانسية عن مصر. يصفها بأنها “زهرة لوتس في صحراء، غنيمة تستحق القتال من أجلها، ويجب أن تغمرها مياه الحضارة الفرنسية.” مع مرور الوقت وتعاظم الأحداث، يدركُ بيير صعوبة الحملة ومبتغاها، فحلم تمدين الشرق وتطويره قسرًا لن يتحقق، وسرعان ما اكتشف أن البنادق لا تنشئ حضارةً بل تنتج أسوارًا جديدةً للسجون.
يطرح الكاتب على لسان المترجم بيير فكرة مهمة: “لو أبحرت من فرنسا سفينة تضم العلماء والرسامين والجغرافيين وعلماء الآثار والفلك واللغويين مع المطبعة بدل الجنود، لكانت فرنسا حققت أهدافها دون أن تخسر آلافًا من أبنائها.”
أثناء الحملة الفرنسية على مصر، تم تشكيل ديوانٍ وطني بزعامةِ شيوخ الأزهر، وهناك تعرَّف على منصور الطالب الأزهري الذي ظن بيير للوهلةِ الأولى أنه سيصبح صديقه. كان منصور من بين المشايخ الذين رفضوا الانضمام إلى ديوان بونابرت، ودارت بينه وبين جوبير عدة نقاشات عن دوافعه لتعلم اللغة العربية، ليقول له: “أنت تعلمتَ اللغة العربية لأنكم بحاجة إليها في تيسيرِ غزوكم لبلادنا، ولم تتعلمها لجمالها ولا لأنك وقعتَ في غرامها.”
يصرُّ بيير جوبير بأنهم ليسوا غزاةً وجاؤوا لمساعدة أهل مصر وإنقاذهم من جور المماليك، قائلًا: “ما الذي يضرُّ لو أن رجلًا ساعدك في إطفاء نار شبت في منزلك؟ هل ستسأله عن هويته قبل أن يطفئ النار؟ هل ستسأله عن دينه وبلاده؟” هذا المنطق الأرسطي كان يرفضه طالب الأزهر منصور، ويعتبره قياسًا فاسدًا، فالانتقال من قضية جزئية إلى افتراض كلي يعطي استنتاجًا خاطئًا.
اتخذ الأسير الفرنسي موقفًا متناقضًا من الشرق، فقال عنه: “الشرق قاسٍ، ظالم، مجحف، متخلف، مخادع” بناءً على ما تعرَّض له من ظلمٍ وقهرٍ من الباشا الذي يستعرض قوته بإعدام المرافق الأرمني آرسين أمام عينيه. ومن جهة أخرى، قال: “الشرق نبلٌ، وعدلٌ، وكرم أخلاق، ومعاملةٍ طيبة تفوق الوصف”
مما رآهُ من السجان النبيل محمود آغا. هذا التضاد يجسده دوست عبر استحضار حكاية الفيل والعميان: كل شخصية تلمس جزءًا من الحقيقة وتظنها الكل، وهذا ما يمنعها من الجزم بحقيقة الشرق.
تُبرز الرواية ببراعة العلاقة المرتبة والمعقدة بين الشرق والغرب، وتستعرض تشابك الحضارتين من خلال فصولٍ متعددة من الصراع والتعارف. تقدم الرواية منظورًا غنيًا لجهود التعرف على الآخر وفهمه بعيدًا عن القوالب النمطية التي لطالما كانت سائدة.
لا تقتصر ثنائياتُ الرواية على الجغرافيا فقط، بل تمتد إلى العقلانية الأوروبية المتجسدة في شخصية العالم لابلاس الذي يرى الكونَ نظامًا محكومًا بقوانين صارمة مقابل الإيمان الشرقي بالقدر كقوةٍ روحية تُشكِّل مصير الإنسان.
يقدم دوست فلسفةً تجمع بين المنطق والروحانيات، مؤكدًا أن تقبُّل القدر جزءٌ من فهم تعقيداتِ الوجود وتناقضاته.
ومن الجدير بالذكر أن الكاتب أضفى بُعدًا إضافيًا على روايته من خلال إدراج وثائق وصور ولوحاتٍ فنية مستمدة من الأرشيف العثماني في نهاية العمل، مما يعزز مصداقية الرواية ويعمق التجربة البصرية والفكرية للقارئ.
“الأسير الفرنسي” ليست مجرد روايةٍ تاريخية، بل رحلةٌ وجودية تبحث في معنى الحرية والإنسانية عبر عصورٍ متشابكة. تقنيةٍ سردية بارعة، نجحَ دوست في تحويل الوثائق المنسية إلى حكايةٍ عالمية، تطرح أسئلةً ملحّة عن الهوية والصراع الحضاري، مذكرًا بأن التاريخ ليس أحداثًا جامدة، بل دماءٌ ودموعُ أناسٍ عاشوا تناقضات عصرهم بكلِّ ما فيه من ألَمٍ وأمل.