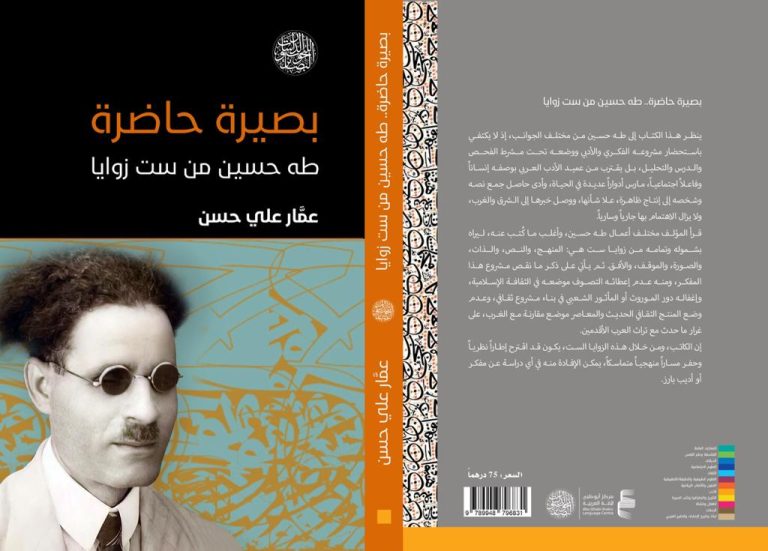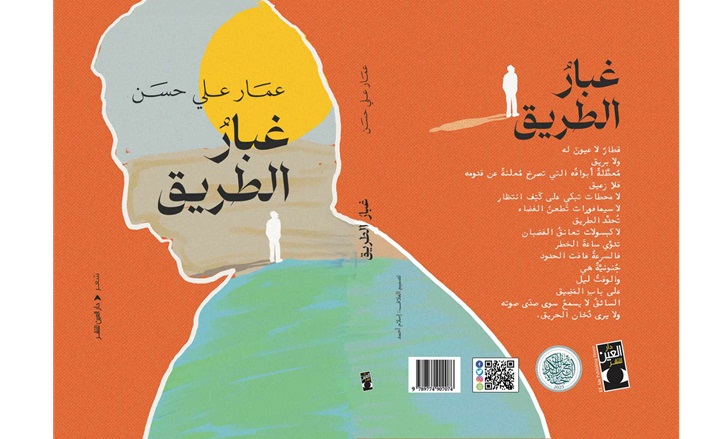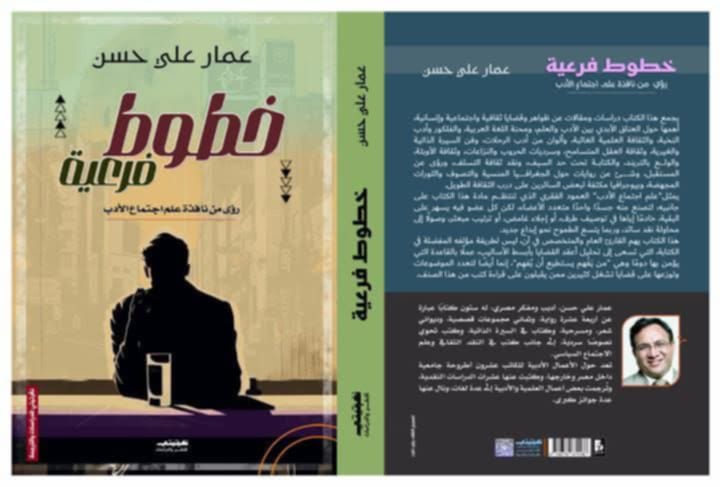صدرت قبل أيام رواية “افتح ياسمسم أبواب برلين”، للروائي العراقي المقيم في ألمانيا صلاح عبداللطيف، عن دار تأويل، وهي روايته الثالثة بعد روايتيه، نجوم آدمية، ومنشدو كولونيا.
وتحاول الرواية أن توثق لحياة شابين لبنانين، هاجرت عائلتيهما من ماردين التركية إلى لبنان قبل سنوات طويلة. ورغم مرور السنوات، لم يقبلهما مجتمعهما المحيط، بل اعتبرهما من الزوائد الضارة التي تعكر صفو المشهد الاجتماعي.
لم يتوافق الاثنان مع تلك الموجبات الاجتماعية، فهاجرا من قريتيهما إلى بيروت، بحثا عن مخارج من الحيف والفقر، فدخلا مع مرور الوقت في عالم الكواسر، عالم تجار المخدرات والجريمة المنظمة.
لكن أولئك الكواسرلم يرق لهم أن يأكل معهم على طاولة واحدة إثنان من المهمشين، فسجنا صحبة صديقهما شاكر، وتعرض الثلاثة لمحاولات ترويض كي يفهموا أنهم مجرد طفح على جلد البلاد الناصع، فمن أين لهم جسارة اختراق ميدان لا يتاح إلا لمن تسري في عروقه دماء أرزية.
يهاجر الإثنان بعد اطلاق سراحهما إلى ألمانيا الغربية، نهاية سبعينيات القرن الغابر، بعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية. وهناك أفرغا كل هياجهما المكبوت وماضيهما العصابي، بسبب هامش الحرية المتاح، فتلقفا مذاق البلاد العذب كأنه غنيمة حرب، موغلين في عالم المخدرات والدعارة والقتل وكل كأس طافحة بالمال.
الرواية محاولة لسبر أغوار النفس البشرية بنواحيها الخيرة والشريرة، ساعية أيضا لبيان أن الضحية لا يمكن أن تنجو من امكانية تحولها إلى جلاد، لمجرد أنها كانت في زمن ما ضحية، فالضحية يمكن أن تدشن عهدا جديدا، منقلبة على ماضيها بمجرد توفر جرعة زائدة من حرية لم تألفها، تتيح لها تنفيس طاقتها الذئبية وتوحشها.
قبل الدخول إلى مضافة الرواية
لسنوات طويلة أثناء اقامتي في ألمانيا، أبعدت الذكريات الأليمة عن عقلي، لأجعلها تستراح في ألبوم الصور القديمة، التي قلما فتحتها، لتبقى حياة نائمة في صناديق مغلقة. سعيت لأن أحول بعض تلك الذكريات إلى زهور ملونة، تيبست مع الأيام في رفوف ذاكرتي. لكنني في إحدى سفراتي إلى جنوب ألمانيا، وأثناء جلوسي في أحد المطاعم البحرية، يكاد يشبه قطعة فنية نادرة، توسطته نافورة ضخمة، جلست على حافاتها خابيات عامرة بالزهور الملونة، وفوقها تمددت غيوم ربيعية فاتحة الزرقة، وشمس اغتسلت منذ الصباح بنسمات البحر. رأيت وجها لم تحتج ذاكرتي إلى وقت طويل لإعادة ترميمه. تقدمت من طاولته، حيث جلس مع امرأة شقراء. سألته إن كان هو ربيع مارديني؟ نظر في وجهي مليا، ثم نطق أسمي بعد قلق مؤقت وفرح غامر، ثم طلب مني أن أجلس إلى طاولتهما، ففعلت.
في الأيام التالية صرنا نتلاقى كل يوم على الفطور، وبرفقته عشيقته الروسية. وفي المساء، صرنا نلتقي لوحدنا حتى منتصف الليل على الأقل. طلبت منه في إحدى الجلسات، أن يروي لي من جديد أيامه في ألمانيا بعد تعارفنا الأول، حين نقلته من برلين إلى ديسبورغ بجرأة أو بحماقة لم أعد أملكهما اليوم.
كان قد غادر يومها لبنان هربا من الحرب الأهلية، ليصل إلى برلين الغربية عن طريق برلين الشرقية، التي كانت مثل نهرحمل فوق أمواجه بين سهول تملؤها زهور عباد الشمس والأقحوان، آلاف اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية والجوع قبل ذلك.
أعاد لي بالتفصيل حكاياته هناك، حدثني كمن ينفض الغبار عن سجادة قديمة، بهمهة واضحة، مترحما على تلك الأيام. تدفقت روحه مثل شلال هادر، تتساقط مياهه من أمكنة صارت مجهولة بالنسبة لي، لتعود من جديد إلى رحم الأرض. بدت له تلك الأيام رغم النيران التي حاصرتها من كل صوب آنذاك، والتي أنجبت الكثير من المرارات يومها، أرحم من الأيام اللاحقة، وهو يصفها بضحك يصل إلى حافة القهقهة.
بعد عودتي إلى منزلي في كولونيا، صممت أن أدون ما رواه لي. أمضيت عامين أقلب في أوراقي القديمة، مثل جرافة لا تلتقط أنفاسها وهي تنبش كل شيء. وجدت بعض الوثائق المنسية مثل سفينة تجنح نحو الغرق، غفوت معها في نومي وقيلولاتي، واستيقظت قبلها مع نسمات المساء، لأتفرج على مغيب الشمس حين تنسحب بلونها البرتقالي، متمنية لقاربي المقلوب أن يصل إلى مقصده.