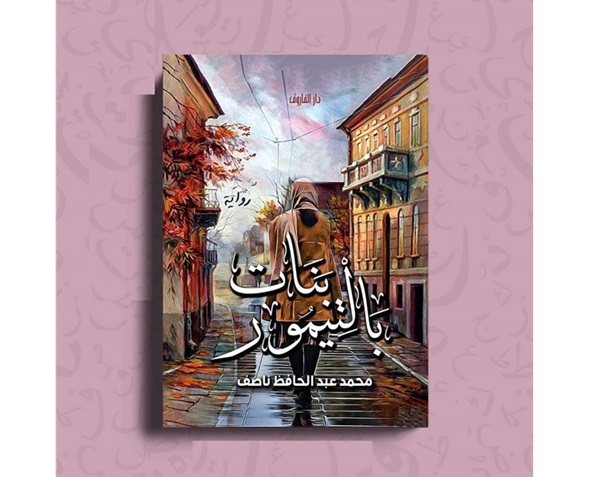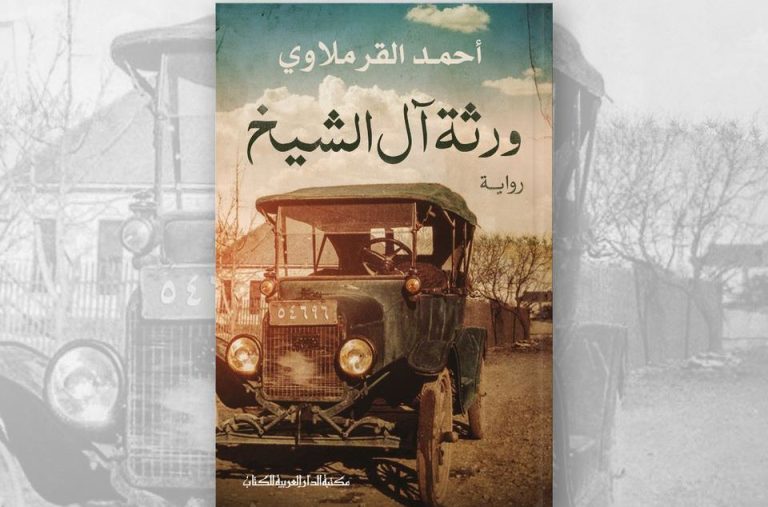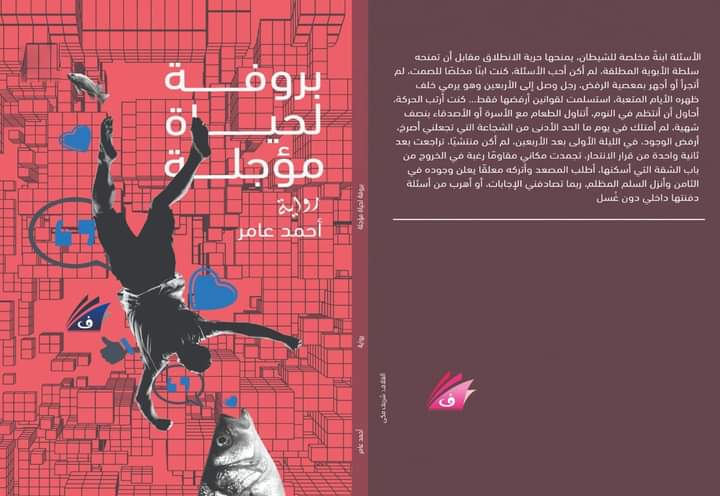سمير درويش
العائلة القرنفلية: سيرة اللعنة من “ليالي” إلى “رؤى”
العائلة القرنفلية كما تقدمها شهيرة لاشين(1) في روايتها “أسفار القرنفل”(2)، هي عائلة ملعونة بموت نسائها مبكرًا حول العام الثلاثين من العمر، قبله قليلًا أو بعده قليلًا. أصاب إناثها فقط لعنة الموت المبكر دون كل ناس العائلات الأخرى الطبيعية، وأما الرجال فيعمِّرون “ليس ثمَّة مشكلةٍ في عمرِ الذكورِ. فقد يبلغ الذَّكر منهم المائة عام، المشكلة كلها في عمر الإناث اللاتي يموت معظمهنَّ قبل الثلاثين، والأطول عمرًا بينهنَّ تصل إلى سنِّ الخامسة والثلاثين، وبالكاد قد تصل الواحدة الأوفر حظًّا منهنَّ؛ فوق الأربعين بسنةٍ أو اثنتين على أقصى تقديرٍ” (الرواية، ص103)، يمتن في عز شبابهن وجمالهن دون أمراض ولا تجاعيد، نساء هذه العائلة يتميزن بالجمال الفاتن الساحر عن سواهنَّ -هذا ضروري فينًّا في صياغة اللعنة ليكون الموت قاصمًا غادرًا-، وتتعلق بهن رائحة القرنفل، نسبة إلى شجرة القرنفل العتيقة في حديقة البيت الكبير، التي زرعتها جدتهن الأولى “ليالي”: “عمرها يصل إلى أكثرِ من ثلاثمائة عامٍ وارتفاعها يبلغ عشرين مترًا، ذات جذرٍ سميكٍ وعريضٍ، تتفرع منها شُجيراتٌ صغيرةٌ تنبتُ منها زهورٌ متعددة الألوانِ، رائحتها تشبهُ رائحة القُرنفل، حتى أصبح النَّاس يطلقون عليها اسم “شجرة القرنفل” (الرواية، ص15).
كما أن وقت موت الواحدة منهن لا يكون عاديًّا مثلما يموت الناس، فموتهن يرتبط بالصعود إلى قمة عالية، والغناء، الفتاة منهن التي قضت عمرها القصير صامتة كالخرساء، تتنزل عليها رغبة ضاغطة في الغناء المتواصل، فيعرف من يحيطهن أن الموت يحوِّم حولها. هذا الاختلاف جعل الناس ينظرون إليهن باعتبارهن من عالم آخر، لا ينتمين إليهم، لذلك -بالتدريج- لم يعد موتهن يشكل مأساة لديهم، بل بدأوا في استثماره بشكل عملي محايد خارج العواطف، فالرجل يتزوج إحداهن مستمتعًا بجمالها الفائق ونسلها الجميل، بمهر أقل من سواهن، وهو يعرف أن عمرها القصير يتيح له أن يتزوج من أخرى دون أن يضطر للتعدد وحمولاته الاجتماعية والاقتصادية.
هذه اللعنة بدأت بصدفة وانتهت بصدفة أخرى: بدأت حين أجبر الجد الأكبر “ليالي” على الزواج من ابن عمها “إمام”، مناصفة مع ابنة عمها الأخرى “حورية”، في ليلة واحدة، بغرض تعظيم نسل عائلته، فقد فشل أبناؤه الثلاثة في إنجاب آخرين غير هؤلاء الثلاثة، وفشل الجد نفسه في الإنجاب من زوجته الجديدة.. ولما رفضتْ أجبروها وقيدوها واغتصبها الشاب بعنف وقسوة، فبدأت مظاهر اللعنة: قصَّت ضفيرتيها، وصمتت عن الكلام، ولما نجحت بمساعدة أمها في الهرب بعيدًا، ماتت في عمر العشرين، بعد أن أنجبت بنتين توأمتين، ماتا في عمر قريب، وررثا الصمت أيضًا، وأورثاه لنسلهن، وقصصن ضفائرهن كذلك قبل الموت، واستسلمن للغناء!
ثمة ثلاث نسوة هنَّ الأهم في هذا السلسال: “ليالي” التي بدأت عندها اللعنة بمشهد الاغتصاب، و”مريم” التي حاولت دراستها ومعرفة أسبابها وظواهرها وطرق تجنبها، أو تخفيفها -على الأقل- بزيادة أعمار هاته النسوة أسابيع أو شهورًا، حيث أوصت بتقليل الكلام إلى حده الأدنى لأن كل كلمة تنقص العمر عامًا، وأن يرتدين ملابس تناسب ألوانها الشهور حسب “التقويم القرنفلي”، ثم “رؤى”/ الراوية الأساسية في هذه الرواية، التي ستنتهي عندها اللعنة حين تقدم قربانًا للنهر، بصدفة بحتة ليس لها دخل فيها، سآتي على ذكرها، جعلها تبدِّل قوانين اللعنة وتعيش عمرًا طبيعيًّا مثلها مثل كل الناس.
هذه اللعنة غير المفهومة تحيل مباشرة إلى الأساطير القديمة التي تناولت نفس الفكرة، وإن بمعالجات مختلفة، ففي أسطورة “بيت أتريوس” اليونانية “كانت لنيوب ابنة تانتالوس ست بنات وستة أبناء، وقد تفاخرت بنسلها أمام الإلهة ليتو التي لم تنجب سوى اثنين، أبولو وأرتميس. فغضبت ليتو وأرسلت ولديها لينتقما. أطلق أبولو سهامه على الأبناء، وأرتميس على البنات، فسقطوا جميعًا. وبقيت نيوبِ تبكيهم حتى تحجَّرت دموعها، فتحوَّلت إلى صخرة باكية على جبل سبيليس”(3).
والأدب الشعبي الياباني زاخر بفكرة الأرواح الناقمة (Onryō) التي تنتقم من أشخاص أو عائلات بأكملها وتسبب لهم الموت أو الجنون. على سبيل المثال، تحكي أسطورة (يوتسويا كايدان) عن امرأة تُدعى أويوا، تعرضت للغدر والتسميم من زوجها الذي خانها، فماتت مظلومة وتحولت روحها إلى شبح ناقم (أونريو) يطارد زوجها وعروسه الجديدة حتى قتلهما، وجلب الخراب عليهما(4).
كما تتردد بعض الأخبار الحديثة، في وقتنا هذا، عن لعنات مشابهة مثل ما يُروى عن عائلة نجم الفنون القتالية بروس لي، أن والده أغضب مجموعة من رجال الدين فلعنوه بأن يموت كل ذكر من نسله شابًّا (الذكور هنا وليس الإناث)، فقد مات بروس لي وعمره 32 سنة، وبراندون لي (ابن بروس) مات وعمره 28 سنة في حادث سيارة.
وفي الواقع والأساطير المصرية والعربية القديمة والحديثة، وفي الأدب المصري كذلك، حكايات عن موت أبناء عائلات في وقت صغير محدد، لذلك تدور الأمهات على العرافين الذين يوصون بطقوس معينة يجب أن تُمارس وقت الحمل والولادة، أشهرها تسمية الأبناء بأسماء غريبة مثل “شحتة”، وأن تشحت الأم على مولودها عددًا من الأيام، أو تلحس بلسانها عتبات أهل الله.. إلخ، أو يدورون على مقامات الأولياء والاستعانة بهم للتوسط كي يطيل الله عمر الأبناء، وتنتشر حكايات عن أن العائلات كانت تسمي الذكور بأسماء إناث خوفًا من الحسد، ولا تسجل أبناءها إلا إذا عاشوا وقتًا محددًا، ولا تسجل الوفيات لكي تعطي للمولود الجديد اسم وعمر المولود المتوفى.
الأدب الحديث حول العالم عالج كذلك هذا الشكل من اللعنات غير المفهومة، ففي رواية المانجا اليابانية سلة الفواكه (Fruits Basket) للكاتبة ناتسُكي تاكايا، التي تنتمي إلى أدب الشوجو وتعكس قضايا الأسرة والهوية والصدمات المتوارثة، نجد تصويرًا دقيقًا للعنة عائلية خارقة للطبيعة تطال عائلة سوما وتشكِّل بنيتها النفسية والاجتماعية، حيث: “تدور الأحداث حول مغامرات تورو هوندا، طالبة ثانوية عادية، وعلاقتها بعائلة سوما الغامضة. تورو فتاة عادية تعاني من صدمات يومية، مثل تجارب التنمر وعلاقاتها المتوترة مع أبناء عمومتها، بالإضافة إلى صدمات أشد وطأة، مثل وفاة والديها. مع ذلك، فإن عائلة سوما ليست عادية على الإطلاق. تتعرض العائلة للعنة غريبة تنتقل عبر الأجيال، حيث تستحوذ أرواح الأبراج الصينية المنتقمة على أربعة عشر فردًا؛ كل فرد من أفراد العائلة يتحول إلى برجه الخاص عند المرض أو عند احتضانه من قبل شخص من الجنس الآخر. سرُّ سوما، الذي طارد العائلة لمئات السنين، خلق شبكةً من الأكاذيب والإساءات والصدمات، حيث يحاول أفراد العائلة الملعونون التفاعل مع بعضهم البعض ومع آبائهم ومع العالم الخارجي”(5).
وفي رواية “كتاب التأملات” للكاتبة الأمريكية إيريكا سويلر (صدرت عام 2014)، تتناول لعنة موروثة تصيب نساء العائلة، حيث: “جميع النساء في سلالة سيمون يتمتعن بقدرة غير عادية على حبس أنفاسهن، ينجذبن للماء، ويمتن غرقًا قبل بلوغ سن الثلاثين، دائمًا في 24 يوليو. هذا النمط يشير إلى لعنة موروثة تعكس شخصية الروسالكا في الفولكلور: أرواح نساء مائيات ميتات يغرِّرن بالآخرين نحو الغرق”(6).
الأسفار كمدخل للقراءة: نظرة إلى الشكل
بالرغم من أنني لستُ ممن يميلون إلى التركيز على العنوان كعتبة، أو كمدخل لقراءة العمل الأدبي، باعتباره كاشفًا للمحتوى، ولنية الكاتب في توجيه عمله في اتجاه ما، أو -حتى- كونه يلعب دورًا في قيادة القارئ إلى فهم ما، حيث إن اختيار العناوين يكون عشوائيًّا أحيانًا وتجاريًّا لأسباب تسويقية في أحيان أخرى.. فإن الأمر هنا مختلف كثيرًا، لأن الروائية لم تكتفِ بوضع كلمة “أسفار” في بداية العنوان “أسفار القرنفل”، بل قسَّمت متن الرواية إلى عشرة أسفار: سفر الخلق، سفر الرائحة، سِفْرُ الاعتَراف، سِفْرُ الصَمت، سفر الخطيئة، سفر الغناء، سفر النور، سفر التقويم، سفر الغربان، سفر الخلاص.. وهذا يجعل العنوان مقصودًا تمامًا باعتباره مجموع أسفار المتن العشرة، فالاسم هنا ليس عامًّا يشير إلى تفصيلة في الحكاية يريد التركيز عليها، ولكنه مرتبط بالبنية، ومن هنا يأخذ أهميته.
يقول جيرار جينيت إن “العنوان، للأسف، هو في حد ذاته مفتاح لتفسير النص، لكنه ليس مفتاحًا وحيدًا. فهو يوجه القارئ نحو فهم معين، لكنه لا يحدد ذلك الفهم بشكل نهائي. العنوان يعمل كعتبة، مدخل يُعدُّ القارئ لتجربة القراءة، ويُشكل توقعاته حول المضمون. على سبيل المثال، عنوان مثل ‘مئة عام من العزلة’ يُوحي بطابع تاريخي واجتماعي، مما يؤثر على كيفية تفسير القارئ للرواية. إن دوره الأساسي يكمن في توجيه الانتباه إلى جوانب معينة من النص، لكنه لا يُلغي التفسيرات الأخرى”(7).
نحن هنا أمام كلمة “سِفر” التي هي في الأصل تعني “الكتاب المُجلَّد” الذي يُكتب على أوراق منفصلة، في مقابل المطوية التي كانت تكتب على ورقة واحدة طويلة يتم لفُّها مثل الاسطوانة، لكنها ثقافيًّا ودينيًّا تحيل إلى “أسفار الكتاب المقدس”، العهد القديم تحديدًا: سفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاويين (الأحبار) وسفر العدد وسفر التثنية (تثنية الاشتراع).. إلخ. وبالتالي فهي مقدسة بشكل ما، خصوصًا -أيضًا- أنها كانت تشير إلى “المصحف” في اللغة العربية.
كما يقول “جينيت” فإن الحمولة الدينية قد تكون موجودة، لكنها ليست التفسير الوحيد، فبعد القراءة قد يرسخ من مفهوم “السفر” فكرة “التتابع”، تتابع فصول الحكاية، أو تتابع أجيال العائلة الملعونة، كما ألمحتُ له سابقًا، ولا ينفي ذلك، ولا يمنع، وضع مسحة مقدسة على نسائها، باعتبار أن الله اختصهن بالجمال الفائق والعمر القصير، وبتفرُّدٍ جعلهن مختلفات.
هذا عن الشكل.. أما في المضمون فإن العناوين التي أخذتها الأسفار في الرواية “الخلق والرائحة والاعتراف والصمت.. إلخ ليست كاشفة لمحتواها بالتحديد، بل تأخذ منه القليل ثم تتحرر من قيده. فلو أخذنا “سفر الغناء” مثالًا، وهو السفر السادس في ترتيب الأسفار العشرة، سنجد أنه يتكون من أربعة مقاطع مرقمة (1 و2 و3 و4)، الأول والثاني سيتحدثان عن “سكينة” أخت مريم -واحدة من الشخصيات المهمة في ترتيب نساء العائلة- وكيف أنها كانت تغني يوم موتها، وهذا ينسجم مع العنوان “فيما بعد، حين بدأتْ سكينة بالغناء؛ عرفتُ أنَّها تموت..”، و”في إحدى صباحاتِ شهر سهُوج- الأخضر التفاحي- من عامِ سكينة الأخير، حين كان الصَّباح حُلوًا يحمل معه نسمة ربيعيَّة خفيفة، وبعض الأغاني الدَّاخنة الأشبه بتراتيل الجنائز القديمة في رائحتها وعتمتها؛ بدأتْ سكينة بالغناء”، و”دخلت سكينة المسجد، وصعدت ببنتيها السُّلم الموصل لأعلى المئذنة، وصوتها لم ينقطع بالغناء. حتى وجدنها توقفت، وتوقف انتشاء الناس، وعادت الحركة في الطريق والسوق لطبيعتها. توقفت رعشة يد أبي، الذي أخبرني أن الله أنزل لوحًا من الثلج على صدره وأنَّه ليس حزينًا” (الرواية، ص136).
لكنها ستخصص الجزءين الثالث والرابع لقصة شذوذ “عبلة” خياطة النساء وميلها الفطري نحو بنات جنسها، ثم مرافعتها المُتخيَّلة أمام الله حين تُعرض عليه يوم الحساب، مدافعة عن هذا الميل الذي لا دخل لها فيه، و”عبلة” شخصية مفصلية كذلك في الرواية، سيكون لها فضل إنهاء اللعنة عندما رمت نفسها في النيل، لتكتشف “رؤى”، ونساء العائلة بعدها، أنها كانت تحتاج قربانًا يقدم نفسه طائعًا فداءً لإحدى النساء الملعونات، وكانت رؤى هذه المرأة، لذلك عاشت حتى رأت تجاعيدها، ورأت أحفادها، عاشت بعد زوجها “جمال”، الذي شغل موضوع تزويجه بأخرى بعد موت رؤى المحتم، مساحة ليست قليلة من جسد النص.
وبالقياس على هذا السفر سنجد أن بقية الأسفار تنتهج نهجه من التقيد الجزئي بالعنوان، ثم التفرع إلى موضوعات وشؤون أخرى قد لا تكون مرتبطة به.
الواقعية السحرية: محاولة خلق واقعٍ موازٍ
الناقد الأمريكي من أصل مكسيكي أنجيل فلوريس نشر مقالًا عام 1955 بالإسبانية بعنوان “الواقعية السحرية في الأدب الأمريكي اللاتيني”، تُرجم إلى الإنجليزية عام 1995 ضمن كتاب “الواقعية السحرية: النظرية والتاريخ والمجتمع Magical Realism: Theory, History, Community”، عرَّف فيه الواقعية السحرية بأنها “دمج الواقعية والخيال. إنها تجمع بين الواقع والفانتازيا، حيث يتم دمج العناصر السحرية في سياق واقعي دون أن يتم التشكيك فيها أو التعامل معها كغير واقعية. إنها تهدف إلى الإمساك بتناقض اتحاد الأضداد، وتحدي الثنائيات مثل الحياة والموت، والماضي الاستعماري مقابل الحاضر الصناعي”(8). وفي الكتاب نفسه ترجمة لمقال الروائي الكوبي أليخو كاربنتيير يعرفها بأنها: “تغيير غير متوقع للواقع، كشف مميز للواقع. إنه يبدأ بالظهور بوضوح عندما ينشأ من تغيير غير متوقع في الواقع (المعجزة)، أو من كشف مميز للواقع، أو من تعزيز مفاجئ للواقع. إنه يتجلى في حالات متنوعة، ولكنه دائمًا يتميز بالغرابة والتناقض مع العادي”(9).
الاستشهادان اللذان يعرِّفان الواقعية السحرية كتقنية أدبية يشيران بوضوح إلى “دمج الواقع بالخيال/ دمجه بالفانتازيا/ دمج العناصر السحرية في سياق واقعي/ تغيير الواقع وكشفه/ دمج الغريب والمتناقض مع العادي والمألوف”. هذا ما فعلته شهيرة لاشين في روايتها “أسفار القرنفل”، حيث “اخترعتْ” حكاية غير واقعية (وإن كان لها ظل أسطوري أو شعبي وأدبي كما أسلفت)، وضعتْ قوانينها ورسمتْ حدودها وشخصياتها، ونسجتْ حول هذه وتلك حكايات ومواقف وأسرار كلها غريبة، لكن دمجتها بحكايات واقعية لتمرر هذا الغريب.
أول مظاهر الغرابة تركزت في شكل وتاريخ “شجرة القرنفل” وعلاقتها بالنساء الميتات، وبالدفتر الذي تركته “مريم” وعثرت عليه “رؤى”: “شجرة مزهرةٌ طوال العامِ. معلقٌ عليها ضفائر للنساءِ بأشرطةٍ ملونةٍ.. يُقال إنَّ امرأةً غريبةً تُدعى ليالي،/ تروي الشَّجرة بالماء الذي استحمت بهِ، بعد ليلةِ حبٍّ نامتها مع حارس بيتها/ مع الوقت تعودت الشَّجرة على ريِها بماءِ الحبِّ؛ مما أصابها ببعض الانحرافِ عن طبيعتها كشجرةٍ، حتى إنَّها كانت تصدرُ صوتَ حفِيفٍ غضبانٍ؛ لو تأخرتْ المرأة في الاستحمامِ./ تحولتْ مع الرَّي بماءِ المحبةِ؛ إلى كائنٍ عملاقٍ. تشعرُ بأنفاسهِ حين تمر بجواره، أوراقها أصبحت رمحيَّة الشَّكلِ، وتفرز مادةً صمغيَّةً واقيَّةً؛ تحميها من التعفُّنِ والجفافِ، وتُشكِّل نظام دفاعٍ يمنع تحللها مع التقدمِ في العمرِ”. (الرواية، ص16)
هذه الأوصاف السحرية لشجرة من المفترض أنها طبيعية وواقعية مزروعة في حوش البيت الكبير الذي بنته “ليالي” وتوارثته العائلة من بعدها، أوصاف مهمة تعمِّق مركزية الشجرة في صياغة الأحداث وتسلسلها، ورسم الشخصيات، لأنها هي الثابت الوحيد وكل من حولها متغير، ولأنها ليست مجرد شجرة، بل هي بيت تسكنه النساء الميتات مبكرًا من خلال ضفائرهن المعلقة على أغصانها، فتتحول إلى أجساد حية وقت اللزوم، تنبت لها عيون وأفواه وتصدر عنها أصوات غضب واستنكار.
كما أنها ليست “شجرة قرنقل” وإنما شجرة ضخمة غريبة أخذت اسمها من رائحة القرنفل “رائحتها تشبهُ رائحة القُرنفل”، هذه الرائحة نفسها التي تسكن أجساد بنات العائلة وتميزهن عن غيرهن، ومَنْ تحملها يعرف الناس أنها منذورة للموت المبكر.
أيضًا فإن تحوُّر أجساد نساء العائلة الملعونة الشابات يبدو فانتازيًّا لا علاقة له بالواقع، مع أنه يختلط بحكايات واقعية عن الغيرة والحسد والمكائد والزواج والطلاق: “وانبعثت من جسدها رائحة قرنفل، غمرت ملابس جمال وكامل جسده!/ كيف لامرأةٍ صمَّاء أن تتحول لشجرةِ قرنفل ضخمة تمتد أغصانها لتخترق جسدي؟!”. (الرواية، ص60)
“الأرض نفسها أصبح لونها رمليًّا وأكثر اصفرارًا، حصواتها كانت تتحرك وتتكلم فيما بينها عن موت العجوز، سمعتها رؤى وهي تفسح لها طريقًا”، “الصوت الذي تصدره أفرع الشجرة الكبيرة وهي تتمايل باتجاه البيت، العيون التي نبتت للضفائر المعلقة عليها، الفم الذي تشكَّل على الشَّرائط الملونة ويصدر همهماتٍ غير مفهومةٍ”. “شيءٌ ما يربط الضَّفائر المعلقة على شجرة القرنفل بالدَّفتر. حتى إذا ما أقبلت رؤى نحوها وبيدها الدَّفتر؛ إلا وأخذتْ تصدر صوتًا جنائزيًّا، وتتحرك في انسجام وتناغم وكأنَّها في حلقةِ ذكر. حين جلست رؤى أسفل الشَّجرة؛ تجسدت كلُّ الضَّفائر في صورة نساءٍ جميلات، أحطنَها من كلِّ جانبٍ./ وأثناء تصفحه دبتْ فيه روحٌ غريبة جعلتهُ كائنًا حيًّا يتنفس، وله لسان وصوت”. (الرواية، ص102)
هذا المستوى الفانتازي من السرد يختلط بمستوى واقعي معتاد، فخلقت الكاتبة عالمًا من سكان قرية فقيرة، اضطرت رؤى للعودة إليها بعد موت عائلتها جميعًا، حيث بيت جدِّها لأمها الذي تسكنه امرأة عجوز كانت تخدم عائلتهم، وتزوجت من شاب منهم متأخر عقليًّا، ونسجت حوله أسطورة “المبروك” الذي يتبرك به أهل القرية والقرى المجاورة، وحين مات دفعت لرجلين ليُوهما الناس بأن نعشه طار، وتوقف في قطعة أرض ليست مملوكة لأحد، ما برر لها الاستيلاء عليها وبناء مقام له يزوره الناس ويتبرعون لصندوقه.
أيضًا خلقت شخصية “فادية”، فتاة سمراء بدينة غير مرغوبة من أولاد جيلها، ولا يجعلونها تلعب معهم لعبة العريس والعروسة، تتزوج مغسِّل موتى ولحَّاد، وتتعلم منه المهنة وتقوم بتغسيل النساء، حتى يموت مكهربًا على حدود غيطه لأن جاره كهرب تكعيبة العنب لضمان عدم سرقة ثمارها. كما ابتكرت شخصيات مدرسين وتلاميذ، وحب وزواج وسفر ومكائد وشجارات…
أحداث واقعية لأناس مهمشين فقراء وجهلاء، سكنوا حول البيت الكبير حين جاءته المياه، بعد أن كان قائمًا في أرض صحراء جرداء، ما يشي بأنهم عشوائيون رُحَّل، تليق بهم الأحداث التي نسجتها الرواية في مستواها الواقعي.
لكن الشخصية “الواقعية” الأغرب والأكثر لفتًا للنظر هي شخصية “عبلة”، خياطة النساء التي تميل لبنات جنسها: “بجسدٍ طويل، وكتفين خشبهما عريض، ويبدو من هيئتها أنَّها لا تهتم كثيرًا بمظهرها كأنثى؛ يظهر ذلك من الزغب الخفيف في شاربها، وصوتها الغليظ نوعًا ما، الذي لا تحاول ترقيقه أو خفضهُ”، “الكعبُ الأحمر النظيف/ كأنَّها عكفتْ على حكهِ الليلَ بطولهِ، بكاحلٍ بزه تخين ولونه أحمرٍ أيضًا. ما بين كعبها وساقها عرقوبٌ رفيعٌ يمتد بنحافتهِ داخل الجلبابِ الأسود. يبدو كعبها كأنَّه بوابتها الرئيسية ومفتاح جسدها، ودليل تبعد به عنها تهمة الرجولة التي تعكسها شخصيتها، يسانده في ذلك ثديان صغيران، ومؤخرة مرتفعة قليلًا؛ تتعمد هزها يمينًا وشمالًا في دلالٍ ماسخ لا تجيد تصنُّعه، هكذا فكرت فادية مع نفسها وظلتْ تحلل شخصيتها طوال الطريق”. (الرواية، ص115)
توقُّف السرد طويلًا عند شخصية “عبلة”، وتخصيص مساحة واسعة لها مبرَّرٌ جدًّا في السياق الروائي، لأنها ستكون مهمة في إنهاء اللعنة، حين تقدم نفسها قربانًا -كما أسلفت- دون أن تتعمد ذلك، ودون أن تعرف أن ما تقدم عليه سيغير مصير المرأة التي أحبتها وأخلصت لها، وحملت ملامحها معها سنوات طويلة، وبالتالي تشكِّلُ قفلة روائية مناسبة.
الزمان والمكان: محاولة تثبيت الأسطورة
استخدمتُ مفردات من قبيل “خلقتْ/ شيدتْ/ ابتكرتْ” عمدًا، لأن هذا الشكل من العمارة الفنية يقوم في الغالب على فكرة مجردة تستميت لكي تنزعها من أي سياق مكاني أو زمني معلوم، فيسهل تخيلها في أي ظروف حسب انتماء القارئ الثقافي والبيئي والعمري. هذا ما اجتهدتِ الرواية لتثبيته من خلال تقديم جغرافيا غائمة غير محددة الملامح، وزمان غير محدد، غير أنها تركت علامة واحدة لكل منهما، متأخرًا جدًّا في سياق السرد.
أما المكان فقد ذكرته في الثلث الأخير حيث قالت: “سمعت ليالي أنَّ الفيضان قد تسبب في تدمير القرى البعيدة، وقطع النيل عند فم ترعة الشرقاويَّة. وكان تهديده أشد على الجُسور، فقطع الجسر الأيمن لفرع دمياط عند بحر مويس، والجسر الأيسر عند ميت بدر حلاوة بين زفتي وسمنود” (الرواية، ص168)، في سبيل دمج شخصية أسطورية فانتازية في أرض واقعية معلومة. نحن إذن على تخوم محافظة الشرقية بين الصحاري والزروع: “وصل الفيضان إلى أقصى ارتفاعه؛ محولًا البلدة إلى جزيرةٍ صغيرة تُغني. ثم بدأ بعد ذلك منسوب مياهه بالانخفاض، لتعود مياه النيل إلى مجراها العادي بعد أربعةِ شهور من ابتداء الفيضان؛ حافرةً مجرى جديد للنيل لبلدٍ تسكنه ليالي، وقد حمل المجرى الجديد الطمي معهُ والخصوبة” (الرواية، ص168).
وأما الإشارة الوحيدة إلى الزمن فتأخرت أيضًا إلى الربع الأخير، حين قالت: “إنَّه في يومَ السبت- الحُلو- الأولّ من شهرِ نَعور- الرَّماديُّ اللَّامعُ- للعامِ الأولِّ من التقويمِ القرنفليَّ| الموافق| السبت- الأولُّ من شهرِ يونيو- لعام ١٨٧٨م” (الرواية، ص178)، هذا هو التاريخ الذي نقشته ليالي، الجدة الأولى للعائلة المنكوبة، على صخرة كبيرة، ليكون بداية ما عرَّفته بـ”التقويم القرنفلي”، والذي يوافق يونيو 1878، منذ 147 عامًا هو عمر هذه اللعنة -وعمر بيت العائلة وشجرة القرنفل- من “ليالي” إلى “رؤى” التي تحكى في لحظة الكتابة نفسها، عام 2023، وثمة إشارات كثيرة غير مباشرة على ذلك.
من هذه الإشارات: في السفر الثاني، سفر الرائحة، تذكر “أفلام الكارتون”، وهي حديثة، وفي السفر الرابع “سِفْرُ الصَمت” تقول: “كالتنانين في الأفلام” و”بطارية أرواحهن وشحنها”، وهما إشارتان حديثتان أيضًا، وفي السفر الخامس “سفر الخطيئة” تتحدث عن “راديو قديم يعمل بالبطاريات”، وتذكر أغنية ليلى مراد “يا أعز من عيني.. قلبي لقلبك مال/ شارياك وشاريني.. وش يعملوا العزال” تأليف مأمون الشناوي وألحان محمد فوزي التي أنتجت عام 1947، وغنتها في فيلم “شاطئ الغرام” 1950، بالإضافة إلى الأغاني الفولكلورية التراثية التي تتخلل السرد بكثرة، أغاني الأفراح والمياتم والحصاد، وهي إشارة واضحة للزمان والمكان.
لكن أهم ما نتوقف أمامه في مسألة (الزمن) هو “التقويم القرنفلي”..
في السفرين السابع والثامن، سفر النور وسفر التقويم، استخدمت الكاتبة شخصية “ليالي” لتضع تقويمًا مختلفًا عن التقويم الميلادي -الذي جاء ذكره وأسماء شهوره-، أسمته “التقويم القرنفلي”، يعتمد على مواسم الزراعة والرياح، ولكي تفعل ذلك ميَّزت “ليالي” بقوى خارقة: “أصبحت تمتلك قدرةً عاليَّة على الإنصات لصوتِ الرَّيح، والتفريق بين كلَّ ريحٍ وأخرى. تَعرفُ بالضبط متى تهبُ الريح أو تغير اتجاهاتها. والفرق بين الريح الهادئة والنسمة العاديَّة”، “جعلت لكلِّ صوتٍ من تلك الأصوات لونًا تعرفه به، ساعدها ذلك في تحديد فصول السنة وشهورها حسب التقويم الجديد للشَّجرة”، “وقد جعلت لكلّ شهرٍ رائحة معينة بالإضافة إلى اللون المناسب له” (الرواية، ص169).
قسَّمت العام القرنفلي إلى اثني عشر شهرًا أيضًا، وأعطت الشهور أسماء جديدة: حَرْجَف، زَّعْزاع، سهُوج، بَليل، سمْهَج، نعور، بَارِح، سَموم، نسِيْم، مِهْدَاج، نَكْباء، ونافخ.. وميزت كل شهر بلون معين: أسود حنطي، أحمر خوخي، أخضر تفاحي.. إلخ، ورائحة تميزه: خشب الصندل، عرق الذئب، ملابس متربة… ولكل منها صوت: النار، العواء، الشخير.. إلخ، وأثبتت هذا التقويم في جدول في نهاية الرواية. العام الميلادي = 85% من العام القرنفلي، الذي = حوالي 430 يومًا: “وفي عام ١٧ قرنفلية، يوم الثلاثاء الأقل ملحًا، في ظهيرة شهر مهداج الأبيض القطني؛ ماتت ليالي وعمرها ٢٠ سنة ميلادية و١٧سنة قرنفلة”. (الرواية، ص179)
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل هذا الجهد الكبير في وضع تقويم جديد أفاد البناء الروائي والفكرة التي يعمل عليها؟ والإجابة أنه من الصعب إصدار حكم قاطع عما يفيد وما يضر، فالأمر يُنظر إليه من زوايا متعددة، لكن بالرغم من أن الجهد كبير وثقيل على السرد، وسيجعل القارئ يقفز متجاوزًا هذا الشرح الطويل، إلا أنه يعمق لفظة القرنفل التي تأخذها الرواية عنوانًا، بكل تجلياتها: شجرة القرنفل، رائحة القرنفل، العائلة القرنفلية، التقويم القرنفلي.. إلخ.
الإحالات الثقافية واللغة: تثبيت الجذور
تحيل الكاتبة، في ثنايا السرد، إلى أربع عشرة أغنية من الأغنيات الفلكلورية التي يغنيها فلاحو وفلاحات الدلتا في مصر، وقد تكون متداولة في الصعيد أيضًا، بنصوصها تلك أو بتحريفات تناسب البيئة، أغنيات تعبر عنهم في الأفراح والنوائب، عند الزواج والموت والحصاد خاصَّة.
أغنيات الزواج “فاضحة” إذا قيست بشكل ودرجة الكلام العادي، والمسموح والممنوع، ربما لأنها بديل عن الثقافة الجنسية التي تمارسها شعوب أخرى في ثقافات أخرى، تسمح بأن يكون موضوع الزواج والمعاشرة مطروحًا للنقاش.. وتسمح البيئة الفلاحية بهذه الأغنيات وتفرح بها وتشارك في غنائها كونها مرتبطة بظرف ومكان وزمان محدد لا تتجاوزه. منها مثلًا: “يا منجِّد علِّي المرتبة واعمل حساب الشَّقلبة”، “ياللي على الترعة حوِّد ع المالح.. وشوف الحلوة اللي عودها سارح.. رجلي بتوجعني من مشي امبارح”، هذه الأغنية تحديدًا يتم تداولها بتنويعات كثيرة عزفًا على ثيمة “رجلي بتوجعني”، فتتحول إلى “وسطي بيوجعني”، “صدري بيوجعني”.. إلخ، وإجابة سؤال “من إيه؟” تكون أشد وضوحًا مما ورد في الرواية، وميلًا للكشف الجنسي.
من تلك الأغنيات أيضًا: “يا رمانة واحدة، تعالي لي الساعة واحدة.. طالع يناغشها.. نازل يناغشها.. كسَّر غوايشها بالليل الساعة واحدة”، و”وقصبنا عايز ميه يا واد.. محلاكي يا بت يا بيضا لما العريس يخش.. يلقاكي بيضا بيضا ومبيضاله الوش.. داخل يديكي جنيه.. طالع يديكي جنيه.. على رنة البوفيه.. في الأوضة الفوقانية”.
ومن الأغنيات المهمة التي لم تثبتها الرواية، أغنيات الأمهات وهن يخبزن الكعك والبسكويت والفطير للعروس، لهن أهازيج بموسيقى عميقة أقرب إلى العدودة، لكن كلماتها مفرحة، لا أعرف إن كانت لا تزال موجودة أم انقرضت، لكنها كانت تشكل ملمحًا مهمًّا في هذا التراث.
أيضًا هناك أغنيات الموالد والأفراح التي يغنيها المدَّاحون الشعبيُّون، تكون أكثر عمقًا من أغنيات الفلاحات، وكلماتها أكثر تعقيدًا، مثل: “خلخال خطر ع القدم كل المحاسن فيه.. والصايغ اسمه حسن صانع جميع ما فيه.. دخلت بستان حبيبي أتفرج على اللي فيه.. لاقيت عريض الفلا فارش ونايم فيه.. سحبت سيف المحبه لجل ما أرميه.. رمش بعينه رماني قبل أنا ما أرميه”.
ومن أغنيات الحصاد: “حمدًا للنيل.. الذي ينزل من السماء.. يسقى البراري البعيدة.. وينتج الشعير والحنطة.. ويمنحنا الأسماك.. ويحدد الخير والأعياد للفلاح”، وهي مأخوذة من الفلاح المصري القديم، لكن هناك أغنيات الفلاحين التي يرددونها وهم يعملون “كلُّه على الله.. على الله، القمح أهو طاب.. على الله، طلب الحَصاد.. على الله، حصادُه أتأخر.. على الله، والسَبل اتكسر.. على الله، بخت العيال.. على الله، الصيفَة حلال.. على الله” (الرواية، ص167).
أما أغنيات الموت الأشد إيلامًا ووجعًا، هي تلك التي ينفس فيها المصابون عن آلام فقدهم: “غراب البين عالنخيل يبكي.. عاللي تفوت عيالها وتمشي.. غراب البين عالنخيل ينوح.. عاللي تفوت عيالها وتروح”، “الغاسلة قعدت ورا أكتافي حلت ضفايري وبللت راسي.. الغاسلة قعدت ورا ضهري حلت ضفايري وبللت شعري”، “جايلك عروسة محنية الكفوف والكعب.. خدت معاها الحنة وسابت وجع القلب”، “يا موت يا عرص يا معرَّص خدت المليح.. ياك الوحش خلَّص”، “كنت فين يا وعد يا مقدر.. دي خزانة وبابها مصدر.. يا رجاله عدوا عمايمكم.. عمة كبيرة غايبه عنكم”، “طلعت الجبل على ذمة ألقاهم.. لقيت التراب والحصى سواهم.. كل الناس قِربها مسنودة على الحيط.. إلا قربتى مكسورة ومرمية تحت الحيط”.
وهناك الأمثال الشعبية المرتبطة بالحِرف وتوارثها “يابو العيال في حرفة أبوك لا يغلبوك”.
كما ضمَّنت الكاتبة أغنيتين، الأولى “يا أعز من عيني” لليلى مراد سبق الإشارة إليها وهي من ألحان محمد فوزي، والثانية “استعراض الزهور” كلمات صالح جودت، لحن وأداء محمد فوزي أيضًا “آه م القرنفل دا ريحته تشغل، ساحر ويسحر، قاتل ويقتل، يجعل حبيبك هواه مشعلل، ويكيد عزولك ويبات مفلفل، شقي وشقاوته سبب غلاوته، وأدي حلاوته، ياللي تحب الحلويات شوف القرنفل واتمني، حاكم الزهور زي الستات، لكل لون معني ومغني” (الرواية، ص230)، غالبًا أنتجت عام 1954.
لكن الاقتباس الأهم في الرواية هو ما افتُتِحت به: “استيْقِظي يا رِيحَ الشَّمال وتعَالي يا رِيحَ الجَنوبِ” من سفر نشيد الإنشاد في العهد القديم، الإصحاح الرابع الآية (16)، ثم كان نفس الاقتباس مفتتحًا لقصيدة، أو “أغنية فرعونية” كما أسمتها، غنتها “عبلة” في المشهد الختامي، وهي واقفة شامخة في مقدمة المركب في عرض النيل، وكورال فرعوني يردد خلفها، قبل أن تلقي بنفسها في جوفه، مقدمة نفسها قربانًا -دون أن تدرك- لتمتد حياة رؤى، وتنتهي لعنة عائلتها: “احملونِي إلى هناكَ، أنا قادمةٌ يا ربَّ المكانِ الخفيِّ، يا منْ تسكنْ الضَّفة الشرقيَّة، لبحيرةِ الأزهار، أنا قادمةٌ؛ افتحْ فردَوسَكَ لي”.. وأيضًا ضمنت الآية 155 من سورة البقرة “وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ”، رددها والد مريم حين كانت أختها سكينة تغني، كمقدمة للموت القرنفلي.
تضمين تلك المعارف الثقافية، بالإضافة إلى طرافته وطرافة مادته المستمدة من الفولكلور الشعبي، يشكِّل جسرًا بين الفانتازيا والواقع، يعطي قبولًا للأحداث الغرائبية، وهي ثيمة شائعة حتى في حكايات الأمهات للأطفال قبل النوم، حيث يطير الفيل، ويتغلب الفأر على الأسد، وفي التراث الديني حيث يتكلم النمل ويصعد البشر إلى السماء..
أما بالنسبة للغة، فسيكون مفيدًا استعراض القاموس الذي استخدمته الكاتبة في سبيل توصيل فكرة روايتها وتثبيت أسلوبها الخاص، من ذلك -مثلًا- عدد مرات تكرار بعض المفردات، التي تشكل مركزًا للنص المبحوث، وتدل على عناية السرد بها واللف في مداراتها.
نظرة إلى الترديد الأعلى لأكثر (20) كلمة، سنجدها كالآتي: رؤى (312)، جمال (208)، ليالي (187)، الشجرة (145)، القرنفل (137)، فادية (132)، الضفائر (129)، العجوز (115)، البيت (112)، النهر (107)، الصوت (105)، الحياة (102) الرائحة (98)، الجد (95)، إمام (92)، العائلة (98)، الغراب (87)، النساء (85)، الطفلة (83)، الطريق (81).
ففي أسماء الشخصيات سنجد أن أكثر اسم تردد هو “رؤى” (312 مرة)، وهذا منطقي لأنها بطلة الرواية التي ورثت اللعنة وعثرت على الدفتر وذاكرته وقرأت محتوياته على نساء العائلة المعلقات على غصون الشجرة على شكل ضفائر، وانتهت اللعنة على يديها، وإن بدون قصد. ثم يأتي اسم “جمال” (208 مرات)، وهو منطقي أيضًا لأنه زوجها الذي يقاسمها البطولة، والرجل الذي رأت أن من حقها الاحتفاظ به وسط صراعات مع أخريات، ثم “ليالي” (187 مرة) وهذا منطقي أيضًا لأنها من بدأت الحكاية، و”فادية” (132 مرة). ثم “العجوز” (115 مرة)، “الجد” (95 مرة)، هذا يعكس أهمية هذه الشخصيات في السرد، حيث تتناول القصة علاقاتها وصراعاتها.
أما الكلمات التي تدل على المكان ودلالاته، فكانت: “الشجرة” (145 مرة) و”القرنفل” (137 مرة)، “الضفائر” (129 مرة)، “البيت” (112 مرة)، “النهر” (107 مرة)، و”الرائحة” (98 مرة) وهي تعكس الأجواء الثقافية والوصفية للنص، مع تركيز على العناصر التقليدية والطبيعية. أما الكلمات ذات الدلالات العميقة: مثل “الحياة” (102 مرة)، “العائلة” (89 مرة)، “النساء” (85 مرة)، و”الطريق” (81 مرة) فتسلط الضوء على الموضوعات الرئيسية مثل الصراع العائلي، الهوية، والمسار الحياتي.
أيضًا فإن واحدة من السمات المميزة في كتابة شهيرة لاشين، سواء هنا في روايتها، أو في شعرها، أو في المقالات التي تكتبها، أو في تدويناتها في الأمور العامة كذلك، أنها تستخدم كلمات عامية دارجة بحمولاتها الشعبية في السياق الفصيح، وهنا تستخدم كلمات وصيغ مثل “يخرب بيتك”، “خليك جدع”، “الست الدكر”، “قفشتك”، “بزه تخين”، “عرقوبٌ رفيعٌ”، “دلالٍ ماسخ”.. وغيرها.
هذا التضفير اللغوي يساهم بقدرٍ عالٍ في تحرير اللغة، وإضفاء أجواء واقعية على السرد تجعله سلسًا، ومحببًا لدى القراء، كما تشير إلى ذلك جورجين أيوب “لقد كان لإسهام الرواية دورٌ محوريٌّ في الفهم الحديث للغة، إذ أحدث انقلابًا في القيم. فمقابل المفهوم السائد بأن اللغة خالدة، ثابتة، نقية، لا لبس فيها، تُؤكد الرواية أن اللغة مُقيدة بالزمن، وأن لأشكالها المختلطة قيمةً أخلاقيةً وجمالية. كما تُبرز الرواية كرامة اللهجة. وعبر تعدد مستوياتها اللغوية، تسعى الرواية إلى التحرر من التعاليم الأخلاقية للغة الأدبية التقليدية. ويتيح استخدام اللهجة الإشارة المباشرة إلى الحياة اليومية، ويُحدث تأثيرًا بالغًا على القراء”(10).
—–
هوامش:
1- حاصلة على درجة دكتوراة الفلسفة في التربية قسم مناهج وطرق تدريس التاريخ من جامعة المنوفية، أصدرت ديوان “على الأوستراكا أن تظل خضراء” 2021، ويصدر قريبًا ديوان “في يوم مشمس”.
2- شهيرة لاشين، أسفار القرنفل، دائرة الشارقة 2024، الراوية الفائزة بالمركز الثاني بجائزة الشارقة للإبداع العربي، الدورة 27، 2023.
3- أوفيد، التحولات (Metamorphoses)، ترجمة: أ. د. ميلفيل، دار نشر جامعة أكسفورد، 1986، ص164.
4- ميتشيكو إيواساكا وباربارا روش، الأشباح واليابانيون، جامعة ولاية يوتا، 1994، ص27.
5- إريكا أريفِت، الإساءة والشفاء والصدمات المتوارثة في سلة الفواكه، ورقة بحثية مقدَّمة في مؤتمر “عام القطة”، جامعة تينيسي، 2021، ص2.
6- كايلا جلوفر، صفارات وصمت: خطر الصوت في أدب النساء الأمريكي، رسالة ماجستير، جامعة كنتاكي الغربية، 2014، ص53.
7- جيرار جينيت، النصوص الموازية: عتبات التفسير، ترجمة جين إي لوين، تقديم ريتشارد ماكسي، كامبريدج: طبعة جامعة كامبريدج، 1997، ص213.
8- الواقعية السحرية: النظرية، التاريخ، المجتمع، تحرير لويس باركنسون زامورا وويندي بي. فاريس (دورام، نورث كارولينا: دار نشر جامعة ديوك)، ص109.
9- نفسه ص75- 88.
10- جورجين أيوب، أوديسة الكلمات: تطور اللغة العربية في القرن العشرين، مقال مترجم عن الفرنسية، مجلة الجديد، المجلد 8، العدد 40، صيف 2002.