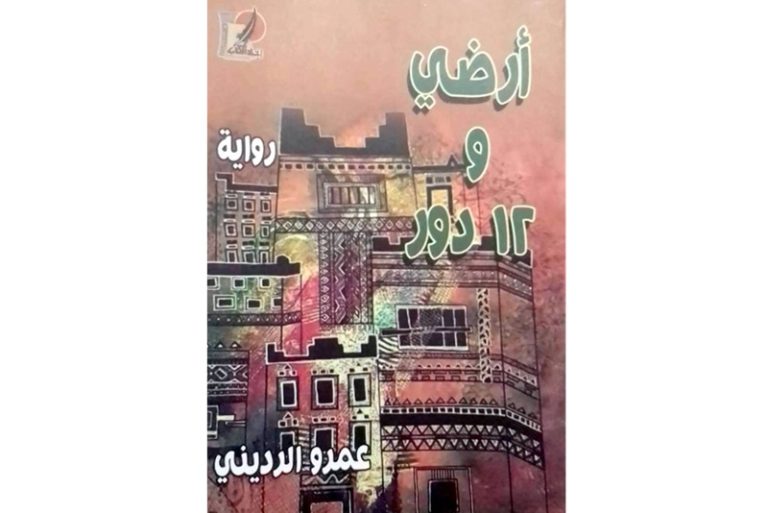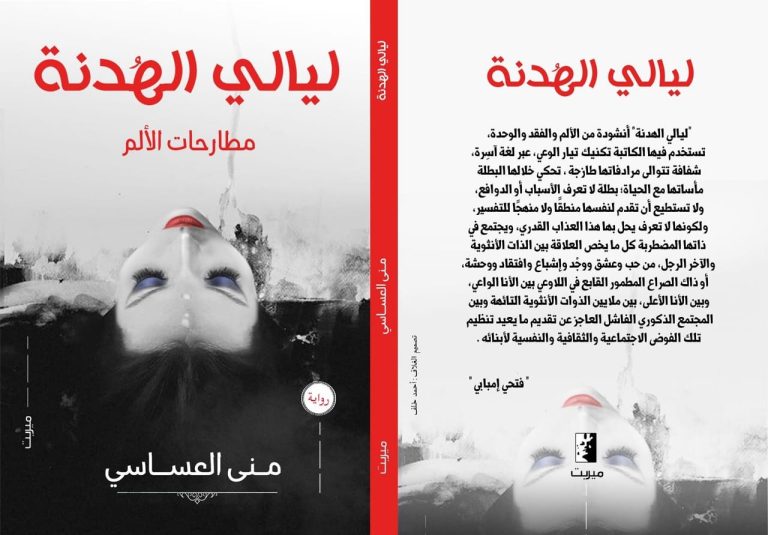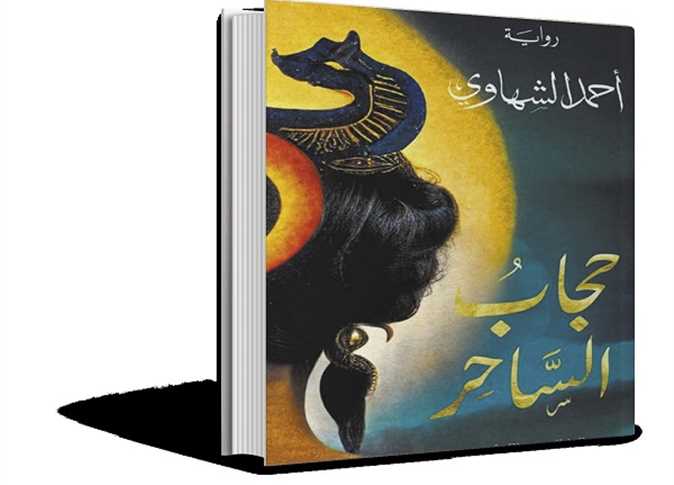د. سمير مُندي
انطوت دعوى ”زمن الرواية“ على إقصائية عنيفة لبقية الأنواع الأدبية، لاسيما الشعر الذي ظل يحتل المرتبة الأولى في تراتبية الأنواع الأدبية لقرونٍ طوال. عدة عوامل ثبَّتت أقدام هذه الدعوى، وأفسحت الطريق أمام أخذها مأخذ التسليم. منها، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتفاء بالرواية والروائيين واختصاصهم بالجوائز والتكريمات، ليس في مصر وحسب. إنما في العالم العربي ككل. أيضًا اتصال مد السرد الروائي الصاعد، بمد السيرة الذاتية، المتمم والموازي لصعوده. والذي أسس، منذ ”أيام“ طه حسين، لنخب وأساطير ثقافية ارتبطت بالسرد تضاءل، في مقابلها، الإنشاد الشعري واتضع. علاوة على التهميش السياسي والاجتماعي الذي رأى في شعراء قصيدة النثر ”صعاليك“ أو ”خوارج“ جدد على المجتمع لابد من تهميشهم وتخليصهم من شحنة النرجسية التي توهمهم أن على رؤوسهم تاج من الريش. أو أنهم أكبر من واقعهم وأقدر على تحدياته.
ديوان طارق هاشم الأخير ”اختراع هوميروس“ الصادر عن دار ”أقلام عربية“ 2020م يساهم على طريقته في إعادة ترميم جدار الشعر المائل، ويحملنا على الارتياب في دعوى ”زمن الرواية“ ويدعونا إلى مراجعتها. ذلك أن ديوان هاشم، ليس فحسب، رؤية جديدة للعالم في إطار قصيدة النثر. إنما هو، علاوة على ذلك، وجهة نظر في الشعر وفي الكيفية التي يمكن أن يكون عليها القول الشعري. فهو ، من هذا المنظور، شعر ومعرفة بالشعر. لاسيما وأن هاشم يطور في هذا الديوان رؤيا شاعرنا الكبير صلاح عبد الصبور للشعر، ويعيد استثمارها بطريقته الخاصة. هذا الاستثمار يعيد إلينا الثقة بالشعر الذي يستطيع أن ينفذ إلى أعماقنا وينطق بلسان معاناتنا متجاوزًا بذلك الغنائية الضيقة التي غرقت فيها قصيدة النثر إلى حوارية ”بينذاتية“ تفكك هذه الغنائية وتعيد وصلها بمحيطها الجماعي.
هاشم الذي أصدر من قبل خمس مجموعات شعرية بالعامية المصرية سادسها هذا الديوان الذي جاء بالفصحى، على خلاف ما اعتدنا، تمكن من وصل العامية بالفصحى وصلاً أزال بمقتضاه الحواجز بين الهامش والمتن. إن قلنا إن العامية بقربها من اليومي والمعاش تنطق بلسان الهامش، وأن الفصحى، بسلطة المقروء، تنطق بلسان المتن. يطرح هاشم رؤيته للشعر من خلال أكثر من قصيدة. ففي قصيدة ”بعض الغناء“، يرى الشاعر، مثلاً، أن قصيدة النثر في حاجة إلى بعض الغناء. قد يشير الغناء هنا إلى ضرورة إضفاء صبغة موسيقية على القصيدة تخفف من نثريتها الصريحة وتقربها، في الوقت نفسه، من القارئ العادي الذي تصدمه هذه الصراحة. يحملنا على هذا الظن قول الشاعر: ”سأعدك يا حبيبتي/ أن أبحث عن مطرب محترف/يمكنه ببساطة أن يغني ما أكتب/يكون جريئًا بالقدر الذي يجعله/يغني لوديع سعادة/ سركون بولص والماغوط“. وقد تكون الغنائية نوعًا من ”البينذاتية“ التي تقرأ بها هذه الذات ذاتها من خلال ذوات الأخرين. بالمعنى الذي يجعلها على قدر من الانسجام الضروري مع مجتمعها يسمح لها بإلتقاط معاناته وترجمتها شعريًا. من هنا يصبح الغناء نقيضًا للمروق الذي يباعد بين الشاعر ومجتمعه ويجعله أقرب إلى الممسوس الذي لا يفتأ يهمس لنفسه بكلمات لا يفهمها أحد، ولا تعني أحدًا. شبهة المس هذه تضع الشاعر في وضعية الدفاع عن شعره أمام حبيبته التي تراه أبعد ما يكون عن شعراء “قصيدة النثر” بتصرفاته الطبيعية والعادية. ولسان حاله يقول إن الشاعر، أيضًا، واحد من الناس، وقصيدة النثر يمكن أن تكون، أيضًا، لسان حال هؤلاء الناس. يقول: ”لا أعرف ما تريده حبيبتي من كراهيتها لقصيدة النثر/ ولماذا تجبرني على الغناء بالرغم من تواضع صوتي/ هي تقول إن شعراء النثر منحرفون/هم يشربون البيرة ليلاً وأنا أشربها بالنهار/هم يحبون نيكول كيدمان وميرلي ستريب/وأنا أحب ليلى مراد/ كثيرًا ما تقول لي أنت غيرهم…/فلا تغضبي يا حبيبتي من كُتاب قصيدة النثر لأنهم أصحابي/ أراهم في قوتي وضعفي“.
في سياق آخر يتحدث هاشم عن الحياة باعتبارها “مأساة”، وعن الشاعر باعتباره ”راوي” مآسي. يقول هاشم في قصيدة ”الحياة مأساة كبيرة“: ”إن الحياة مأساة كبيرة نسى واضعها أن يكتب النهاية“. ويقول أيضًا في نفس القصيدة: ”إن الحزن ليس في المأساة/بل فيما يتحمله راويها“. عند هذه النقطة يلامس هاشم عنوان ديوانه، مثلما نلامس نحن معنى المأساة فيه من خلال الشاعر الإغريقي ”هوميروس“ صانع حبكات المآسي الأول. يعتبر هاشم نفسه أحد صنائع الشاعر الإغريقي الشهير على اعتبار أنه أحد أشباحه التي استحضرها ونسى أن يصرفها مع نهاية إلياذته. ليس من الغريب، بعد ذلك، أن ينحاز هاشم بشعره للمحزونين والمعذبين. وأن يُبرز، خلال ذلك، ما يترتب على هذا الانحياز من حوارٍ دائم مع الخالق باعتباره خالق العالم والمسئول أخلاقيًا عن تحقيق العدالة في الكون الكبير. يتأكد هذا الانحياز الذي يتخطى الحدود الثقافية الضيقة ليتصل ببعد إنساني كوني يتكئ على المعاناة في قصائد مثل: ”عابدين“، ”في حضن ابن رشد“، ”دنيا“. كما يتأكد من خلال الاحتفال بكُتاب وشعراء برعوا في تصوير مآسي حقيقية أو مُحتملة مثل ”دوستويفسكي“، ”شكسبير“، ”جاك بريفير“ و”هوميرس“ بطبيعة الحال.
لكن هاشم الذي اعتاد أن يكتب أشعاره بالعامية المصرية، لابد وأن يثير، بتحوله إلى الفصحى من خلال هذا الديوان، سؤالاً حول أسباب هذا التحول وأثره على قصيدته نفسها، وما إذا كان هذا التحول قد خدم، بشكل أو بآخر، قوله الشعري. ولو أردنا أن نلتمس إجابات على هذه الأسئلة من الديوان لقلنا إن هاشم يرى، بتحوله من العامية إلى الفصحى، أن لغة قوامها بساطة العامية وسهولتها ونفاذها المباشر إلى المعنى، وعمق الفصحى وسلطة معجمها واتساعه للتعبير عن الفكر يمكن أن تكون حلاً شعريًا لأزمة قصيدة النثر التي لازالت تواجه بمعضلة انفضاض المستمعين عنها وزهدهم فيها. فإلتفات هاشم إلى هموم واقعه وأزمات العالم من حوله هو ، بشكل أو بآخر، استثمار لاهتمامات الشعر العامي وتوجهاته. مثلما أن ترجمة هذا الاهتمام بالفصحى هو، بمعنى ما، استثمار جديد لإمكانيات قصيدة النثر ومحاولة لإعادة بناء صلتها بالقارئ. وكأن هاشم يرى أن “راوي المآسي” يجب أن يقطع موضوعاته من رحم الحياة ويعيد صياغتها بلغة فصيحة، اللغة التي حملت إرث المأساة منذ قديم الأزل.
لنقف أمام قصيدة “ابتعد أيها الحزن”، على سبيل المثال. فموضوع القصيدة مقطوع من رحم الحياة: الإنسان البسيط الذي يكافح ضد زحف اليأس والحزن حتى لا ينهش روحه ويختبر إيمانه بحياة لا يطمع فيها إلا بقوت يومه. تنتمي الصورة، كما هو واضح، إلى عالم “الأيام والأعمال”، عالم الحياة اليومية المضاء بنهار الكدح والعمل، الذي تقترن فيه مرارة الشقاء بمرارة ”الشاي الأسود الثقيل“. يقول هاشم في هذه السطور الرائعة: ”وأنا جريمتي حزني/بالليل أجالسه/نحتسي الشاي معًا/هو يكره السكر ويحبه ثقيلاً إلى أقصى حد/شاي الحزن موجات سوداء/بإمكانها قتل الآلاف من البشر الحالمين/…يشرب الحزن شايه مرًا/في الليل يأتيني بخبراته الفائتة/يقترب مني برعونة استثنائية/ويشرد بينما يحدثني عن الذين أصيبوا من جراء شروده“.
ليست هذه الصورة من جنس الصورة التي يرسمها هاشم في قصيدة ”كرسول أنكرته قبيلته“، ولا هي من نفس القماشة التي يقتطع منها صوره. ففي هذه القصيدة يتعطل خيال الشاعر العاشق ويتعلق تمامًا جراء هجر حبيبته له. فهو الذي يصف نفسه بأنه رسام يتأهب لرسم صورة لحبيبته تعانده الألوان وترفض الفرشاة أن تنصاع لرغبته. مثلما أن الشوارع والساحات التي اعتاد عبورها بصحبتها تدير له ظهرها من بعدها. وبجملة واحدة يتعطل خيال العاشق المحزون. على نحو ما يتعطل العالم وتنسحب منه الحياة. يقول: ”حين افترقنا فكرت أن أرسم لكِ بورتريهًا/لكن الألوان عاندتني/الأزرق الذي ياما حدثتني عنه/لم يعد يذكر شيئًا جميلاً لكِ/البيوت التي ألفناها/الشوارع/الساحات التي ياما مررنا بها/أعطتني ظهرها من بعدك/وحدتي خرجت من حيز التخيل لتقفز في الواقع/ كشبح لايهزمه حتى الأعداء“.
أما على المستوى اللغوي المعجمي فإن هاشم يعيد دمج تعبيرات ومفردات من معجم الحياة اليومية داخل الفصحى صانعًا مفارقة طريفة بتوليف الصوت المسموع مع الكلمة المقروءة. يقول مثلاً في قصيدة ”في بحر ستة أيام“: ”في بحر ستة أيام/ أستطيع أن أعيد إليكِ إبتسامتك التي أضاعها الألم/من هنا سأحاول أيضًا / أن أعيد إلى وجنتيك/تلك الورود التي ذبلت حين فارقتك“. فعبارة ”في بحر ستة أيام“ سوف ترن في أذن القارئ فور قراءتها باعتبارها صوتًا أصيلاً من أصوات ”الدردشة“ اليومية. ومع ما تنطوي عليه العبارة من يقين حاسم لا يحتمل إلا الجد، تحدث المفارقة بربط هذه الجدية بوعد يجب أن يقترن بشيء آخر غير الجدية، شيء أقرب إلى الممازحة وملاغاة الحبيبة. لاسيما إذا كان هذا الوعد مرتبطًا بإعادة الابتسامة إلى حبيبته. ولاسيما إذا كان هذا الوعد مصاغًا في تعبير فصيح يضفي على جديته سلطة الفصاحة وبلاغتها.
أيضًا في قصيدة ”في حضن ابن رشد“ نجد أنفسنا أمام هذا التعبير المُولَّف أو المُؤَلّف من العامية والفصحى: ”صوتك يا ماريا/ يعدل روحي/ ويسند خاطري“. فإن ”يعدل“ قادمة إلينا من التعبير العامي ”يعدل المزاج“ والشاعر هنا يستغل حمولتها العامية في الحديث عن روح يعتدل مزاجها بصوت الحبيبة، ويستغل حمولة نظيرتها ”يسند“ القادمة إلينا من التعبير المعروف ”يسند ظهري“ للحديث عن خاطر مسنود، أيضًا، بصوت الحبيبة. لاسيما وأن التعبير ”يسند“ قد صنع مفارقته الخاصة بالالتفات من ”سند“ الظهر إلى ”سند“ الخاطر الذي يظهر لنا، في هذه الحال، مثل ظهر مائل يحتاج إلى سنادة. وكأن الخاطر هو ”ظهر“ الروح وعمودها الفقري. علاوة على ما يحدثه تعبير ”يعدل“ من توقيع بتوائمه وتناسبه مع تعبير ”يسند“. فإذا ما قلنا إن ”صوت ماريا“ هو الذي ”يعدل“ و”يسند“ روح وخاطر الحبيب أصبح واضحًا لنا أن صوت الحبيبة هو الذي يوقف حياة العاشق على قدمين. ولو أن الشاعر لم يحالفه التوفيق في وضع مأساة ”ماريا وحبيبها“ في حبكة مصرية ممكنة في واقعنا أكثر مما يمكن أن تكون ممكنة بشروط ثقافتها الغربية.
وليست كذلك قصيدة ”هو فقط لا يحب البطالة“ فقد أحسن الشاعر، راوي المآسي، وضعها في سياقها وفي مؤامتها مع واقعها. فالقصيدة التي تحمل رثاءً للكاتب الروسي فيدور ديستوفيسكي تقرأ عظمة الكاتب الكبير وبساطته في الوقت نفسه. وذلك من خلال زوجته وأم أولاده التي تفتقده وتعتبر موته، ببراءة، نوعًا من البطالة. مثل هذا الرفض الممزوج بالبراءة نقل إلينا شعورًا بالخسارة بسيطًا وواقعيًا بعيدًا عن حدية المأساة التي عوَّل عليها الشاعر أكثر مما يجب في ديوانه ككل. يقول الشاعر: ”أين زوجي يا الله/هل وجد وظيفة لديكم/حين خرج من المنزل تركني بدعوى البحث عن عمل/ إن زوجي يكره الموت/لا لأنه خائف منك/بل هو طيب ويحبك/ هو فقط لا يحب البطالة/ حين ودعني في اللحظة الأخيرة/كان يقول والدموع تحتل عينيه/إن البطالة موت يا أنَّا ديستويفسكايا…/ذلك أن الموت مرهون بالبطالة“.
………………
*ناقد مصري