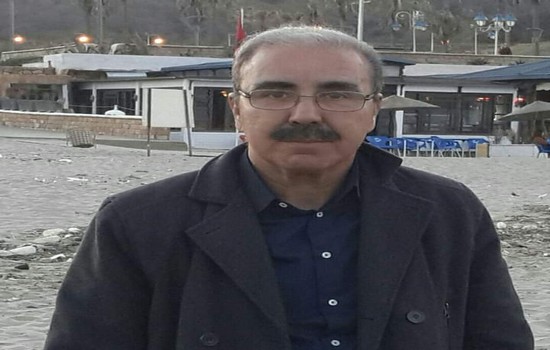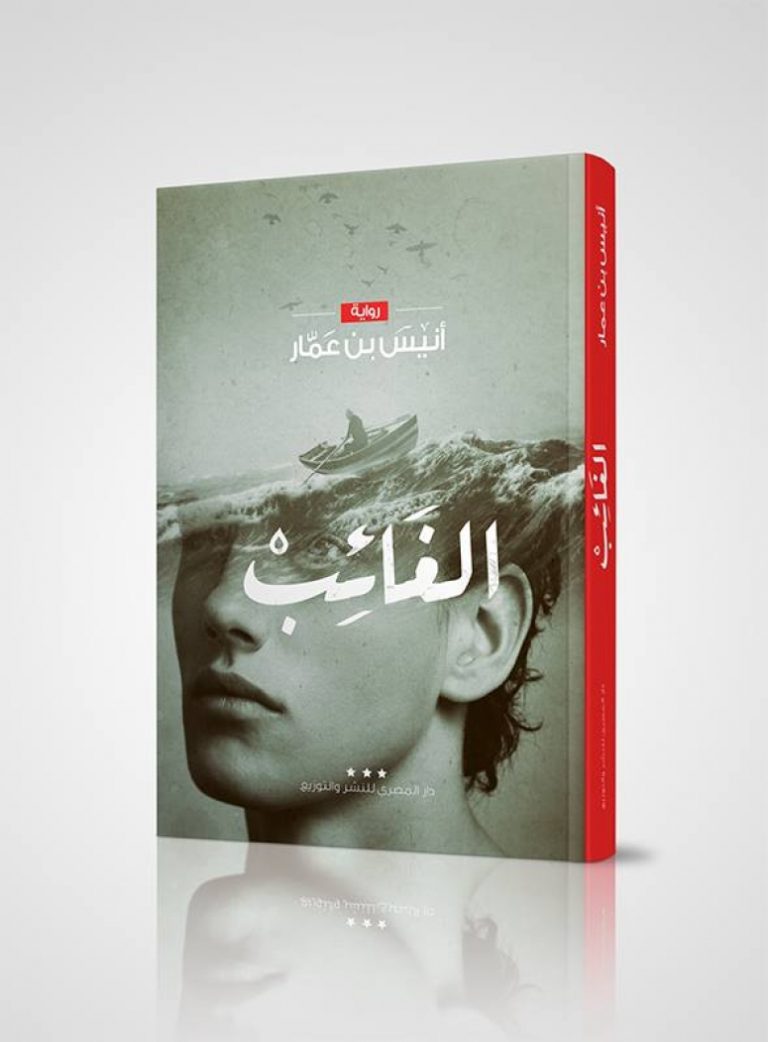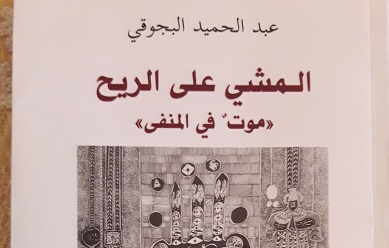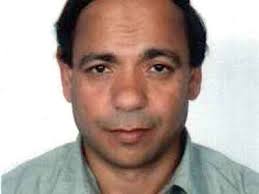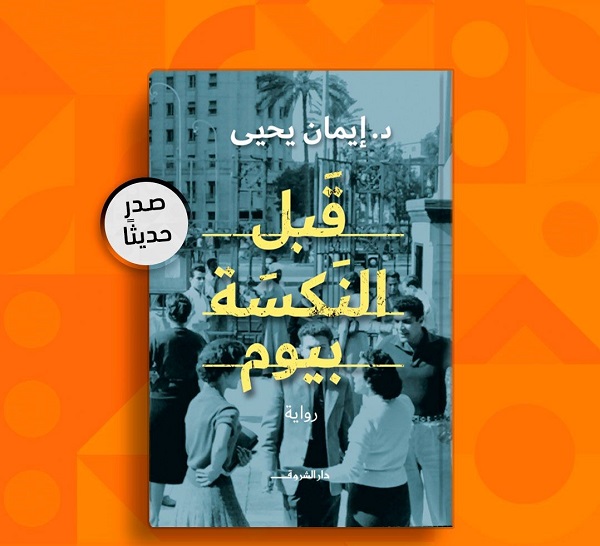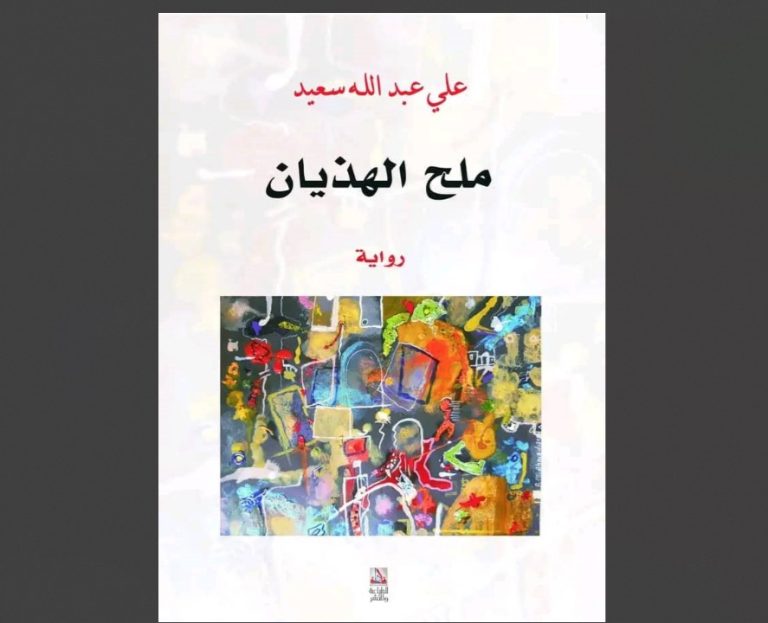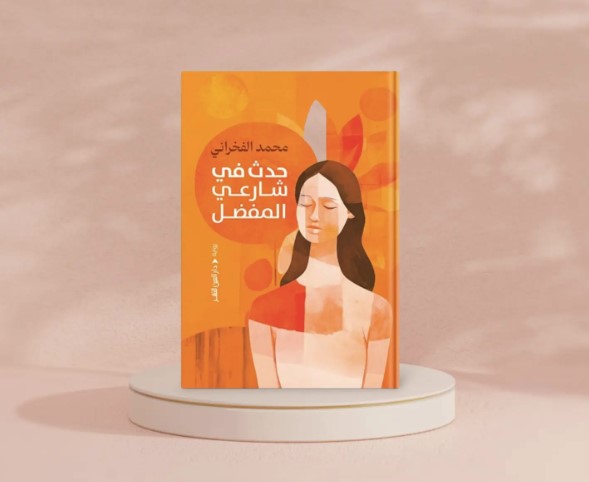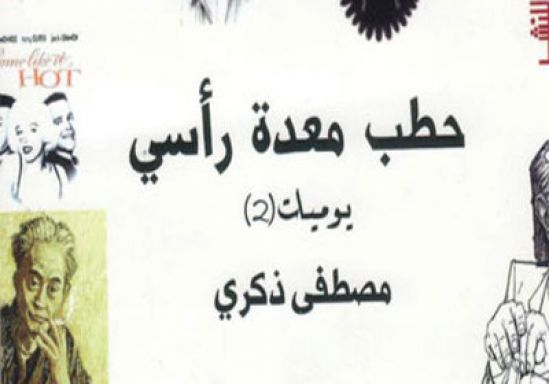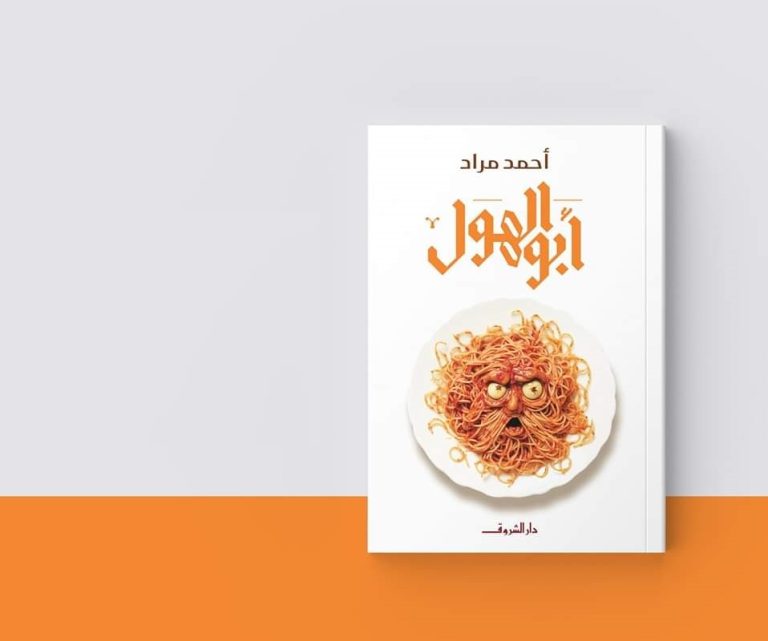د.عبد السلام المساوي
لا أحِبُّ أن أكونَ ملاكًا
ليْس لأنَّني لا أحبُّ الطيَرانَ
والنُّورَ..
لكنْ:
لأنَّني لا أُحِبُّ أنْ أكونَ غيْري
رغْم أنَّني
لا أُحِبُّنِي!
يكاد هذا المقطع الشعري الوارد في الصفحة الثانية بعد الستين، من ديوان (تصطاد الشياطين)(1) للشاعر المصري سمير درويش، أن يلخص فكرة الديوان المركزية، أو بالأحرى رؤية الشاعر لذاته في اقترانها بالوجود الكائن والمتخيل؛ خصوصًا وهذا العمل الشعري عمل متكامل، كتب بنفس واحد في تواريخ متتابعة. وهو بذلك ينأى عن أن يكون مجرد تلفيق لنصوص متباينة مكتوبة في فترات متقطعة. وهذا ما يمنحه قيمة اعتبارية فنية تؤهله لأن يكون كتابًا شعريًّا، مبنيًّا بناءً محكمًا، كأن الأمر شبيه ببناء عمل سردي له بداية ووسط وخاتمة.
والفكرة الكبرى التي ينهض بها المقطع الشعري -المثبت أعلاه- ترصد حركة الذات في انكسارها والتئامها، وفي استشرافاتها وقبولها بالمحتوم. إن الشاعر يقول في المقطع بتكثيف رهيب ما يمكن تفصيله في عشرات الصفحات. فالذات في عريها الوجودي تروي قصتها مستندة إلى الكثافة الشعرية، بعد أن ظفرت ببراءة الاختراع اللغوي، وشحذت حدود حدسها بما رأت، وما عاشت وما وقفت عليه من مراجع وثقافات متنوعة. فأصبح بمقدورها أن تستوعب التفاصيل، وتحولها إلى كتل من الدهشة، وإلى المواقف التي تنجح في الانتصار للهشاشة عن طريق التشبث بخصوصية الذات وهويتها، حتى ولو كان الإغراء من قبيل التحول إلى ملاك بأجنحة.
لا تتأسس شعرية هذا العمل على الصور البلاغية والانزياحات المنصوص عليها في كتب البلاغيين والشاعريين بالشكل المدرسي أو الأكاديمي المألوف، ولا على توظيف الرموز والأساطير مثلما نجد في الكثير من نصوص رواد الشعر العربي المعاصر أو من جاء بعدهم، أو على إيقاع شعري خارجي متبجح ببحوره وقوافيه. فعلى العكس من كل ذلك، كتبت أجزاء هذا العمل الشعري بلغة عادية وهادئة، تحسبها من بساطتها لغة الاستعمال اليومي. فلا انتقاء للألفاظ، ولا معاضلة في التركيب أو الأسلوب. وباختصار فإن الشاعر يراهن على “عمود شعري” مختلف يقوم على اللاتحديد لكن بإيحاءات لا نهائية.
يبدأ ديوان (تصطاد الشياطين) بمشهد قيامي هو أقرب إلى السوريالية منه إلى أي شيء آخر، جاء فيه:
تخْرجُ أفواجُ التُّرابِ مِن قُمْقُمِها
تُلصِقُ ألوانَها على خَدِّ الشَّمْس الصَّفْراء
فَتُلوِّن النّاسَ بالأصْفر المُتْرب.
الرِّياحُ تنْفلتُ منْ عقَالِها..
تجْري في الشَّوارِع والأزقَّة والطُّرُقات
ومَداخِلِ الأبْنيَة الكَئيبَة
وتُلصِق المَلابِسَ الواسِعةَ بأجْسادِ البَنات(2)
وينتهي هذا الديوان بما يشبه مشهدًا إيروتيكيًّا:
كنتُ أعرفُ يقينًا؛
أن بقايا الشعراء السابقين تحيط جسدها
حين تنسل داخلة في جسدي،
فلماذا أغضب الآن حين تلقى اللاحقين ببقاياي
أنا مخطئ والله.. أعترف(3)
وبين البداية والنهاية تمتد مسافة شعرية طويلة تستوعب نحو ثمانية وخمسين نصًّا؛ تستحوذ -خلالها- الأنا الشعري والمرأة (الرفيقة أحيانًا، والحبيبة أحيانًا أخرى) على بطولة العوالم التي تتيحها نصوص الديوان إتاحةً تجعل هذا الأنا الشعري موزعًا بين متطلبات الجسد، في واقع منذور للمتناقضات التي نالت من القيم جميعها، بما فيها قيمة الحب. وبين متطلبات الروح بسبب الحيرة والإحباط الذي تتسبب فيه سماء صامتة لا تستجيب. بمعنى أن العلاقة القائمة بين الأنا الشعري (الذكورة) والمرأة (الأنوثة) على امتداد أجزاء هذا الديوان علاقة ناقصة بعيدة عن كمال الحب المنشود. ويمكن التمثيل لهذا المعطى بمقاطع شعرية متعددة، تصب كلها في هذا المنحى؛ يقول الشاعر:
سَأقولُ لهَا: أنا حَزِينٌ
لأنَّني لسْتُ منْ علَّمَها الحُبَّ:
لمْ أسْرِقْ قَصائِدَ نزار قبَّاني وأُلقِها أُضْحيَةً
تحْت قَدميْها
لمْ أختَبئ خَلْف بابِ الشُّرْفة
أراقبها مُتحفِّزةً وراءَ مَكْتبِها الأبْيَض
ولمْ أُغَنِّ بصوْتٍ عالٍ مَع عبْد الحَليم
“إنِّي أتَنفَّس تحْت المَاء..
إنِّي أغْرق”!
سَأقُول لهَا: أنا حَزِينٌ
لأنَّني لسْتُ مَنِ اكْتشفَ أُنوثتَها(4)
فلننظر كيف يصور الشاعر حقيقة علاقته بهذه المرأة ملتجئًا إلى تفاصيل الحياة اليومية، بما فيها من معيش رتيب وأشياء صغيرة مبتذلة. ولكن الرتابة والابتذال يصبحان عنصرين مولدين لجمالية لا تضاهى. ومثل هذه الإشارات إلى عدم اكتمال قيمة الحب كثيرة في الديوان، وتتمظهر في أشكال وصور متنوعة؛ يصل فيها الأمر أحيانًا إلى تجريح المرأة وهجوها:
هذِه الأصُولية التي تُحبُّ الهَدايا ثَمينةً
وتَكْرهُ البُخلاء المُقتِّرين
-حتَّى لوْ جاءُوا مِنْ بَطْن أمِّها-
وتهْفو إلى أبٍ ميِّتٍ في حَارةٍ نَائيةٍ
هَذِه الأصُوليةُ تُحِبُّ الشّعْرَ
أكْثر ممَّا تُحبُّ شاعرًا أليفًا
فهلْ أكْتبُ أنَا
-بكامِل قُواي-
قَصِيدةً يوميَّةً لِجمَالِها؟!(5)
هكذا يكون القول الشعري القائم على تيمة السخرية السوداء بديلًا موضوعيًّا وتعويضًا عن لحظات الإحباط التي يعيشها الأنا الشعري في رحلة بحثه عمن يسعفه وجدانيًّا وجسديًّا في مواجهة الغربة الوجودية الناشئة أساسًا عن التناقضات والمفارقات التي يعج بها المجتمع. ولما باء البحث عن الشبيه (المرأة المثالية) بالفشل، فقد كان لا بد من الظفر بسلاح أمتن من أجل مواجهة متكافئة مع غربة الوجود، وقد عثر الشاعر عليه متلبسًا بكلام شعريٍّ صالح ليكون زاد المسافة، وتكون القصيدة بذلك مرممة للأعطاب الوجدانية والروحية وصانعة لمعجزة الرواء. فهي التي بمقدورها تجميع شتات الشظايا التي بعثرتها الشهوة والرغبة، والرجوع بالذات إلى نقطة البدء.
وعلينا أن نلتمس قوة الإشعاع التي تنطوي عليها كلمات وعبارات المقطع الشعري السابق، من مثل: الأصولية- جاءوا من بطن أمها- أب ميت في حارة نائية- فهل أكتب أنا- بكامل قواي.. ذلك أن وجود هذه العبارات -رغم بساطتها في السياق والمقصدية- يمنحها قدرة هائلة على توليد دلالي مشعٍّ بالمعاني التي تملأ الثغرات والفجوات، بمساعدة متلقٍّ يدرك أن ما يختفي وراء الأسطر الضامرة والقليلة لشبيه بالشجرة التي يحجب قربها من العين خمائل بل غابات من الأشجار. وهذه الحساسية اللغوية ارتبطت بالشعر عمومًا منذ كان، ولكنها زادت مع جيل الثمانينيات من الشعراء الذين وجدوا أنفسهم في العراء، ووجدوا أن النماذج الشعرية السابقة قد شرعت في استنفاد طاقتها التي كانت محكومة بخلفيات اجتماعية وسياسية وثقافية لم يعد معظمها قائمًا. والشاعر سمير درويش أحد هؤلاء الثمانينيين الذين حاولوا إيجاد إواليات فنية لا تريد أن تتحول إلى قواعد وأصول للاتباع، بل ترغب في ألا تنفصل عن دلالات المقول.
ثمة متطلبات أخرى يهجس بها ديوان (تصطاد الشياطين)، وعلى نحو لافت من حيثُ كمُّ المقاطع الشعرية، ومن حيث الاختياراتُ التعبيرية. ونقصد بذلك وجود نوع من الاحتجاج على السماء أو التمرد على الله. و”الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يرفض أن يكون على ما هو عليه”(6) حسب تعبير ألبير كامو Albert Camus. وأولى مراحل التمرد تبدأ بالاحتجاج على الطبيعة الكثيفة غير المبالية، وهكذا يتجه تمرد الإنسان، أول ما يتجه، إلى السماء الصامتة(7). لكن في حالة شاعر ثمانيني كحالة الشاعر سمير درويش، فإن التمرد يصبح مباشرًا ومتجهًا إلى الجهة المسؤولة عما يحدث:
غَضْبان أنَا يا ألله
لا أعْرفُ منْ أحْرقَ الدُّنيا منْ حَوْلي
لمَاذا أحْرق الدُّنيا مِنْ حوْلي!
قلْ لهمْ: ليسَ على الغَريق حرج.
لا حَرج على الغَريق.
أيًّا ما تكونُ الصِّياغَة يَا ألله:
فَأنا غَضْبان
لا أعْرِف..
لا أقْدِر أنْ أنام!(8)
وهذا تمرد لا نتصوره تمردًا عدميًّا أو عبثيًّا، كما لا نفصل بينه وبين التاريخ “لأن القصائد التي كشفت عن تمرد أصحابها الميتافزيقي، كانت إلى حد ما أثرًا لشعورهم بالظلم التاريخي نفسه، إنهم يبحثون خارج التاريخ عن مبرر للوجود التاريخي”(9). وهكذا يصبح التصريح بالغضب أمام الله صرخة يائسة أمام ضخامة الحدث (إحراق الدنيا من حولي). وهي عبارة تلخص كل أنواع الحرق من حروب مدمرة وأعمال إرهابية همجية. وسبب الغضب من الله أنه أباح للبشر أن يتصرفوا في أمور عظيمة تختص بها الذات الإلهية، كالقتل مثلًا. وهذا يحيلنا على مقولة ألبير كامو: “المتمرد يضع نفسه في موقف الاختيار بين إله قادر على كل شيء ولكنه شرير، أو بين إله طيب ولكنه عقيم”(10).
وقد يعمد الشاعر إلى تغليف هذا التمرد بنوع من السخرية:
الوعاظ يقولون: إننا في امتحان أبدي
وإن الأسئلة الكونية مباشرةٌ
مثل: لماذا خلق الله الجن والإنس؟
أو: بأي شيء تطمئن القلوب؟
..
الوعاظ مطمئنون يا الله..
لا يقضمون أظفارهم
ولا يعانون توترات القولون!(11)
والسخرية هنا من الوعاظ الذين لا يشغلون عقولهم بالأسئلة، ويكتفون بأخذ الجاهز الذي يجنبهم التوترات والأمراض. لكن التمرد قد يصل أحيانًا إلى أقصاه عندما يتجه الأنا الشعري إلى تسمية الأشياء بأسمائها:
كمْ ساعةً غافلتُ الله وفرحتُ
في هذا العمر المنذور للحزن الكثيف
كم لحظة؟!(12)
وعمومًا، وانطلاقًا مما سبق، نرى أن تجربة الشاعر سمير درويش في قصيدة النثر تقيم جمالياتها على أساس شعرية المشاهد والصور الذهنية. وهذه تنتج عن جمل وتراكيب عادية الصياغة، لكنها تستوعب معاني عميقة ومفارقات نادرة، تعكس وجود قدرات باهرة، لدى الشاعر، في توجيه مخياله نحو ضوء المعنى وسر الكلام. كما أن الاعتداد بأسلوب السخرية السوداء في أعماله بوجه عام، وفي عمله -هذا- (تصطاد الشياطين) بوجه خاص، لأمر واضح لا تشوبه شائبة. والسخرية الهادفة -كما نعلم- عملة نادرة في الشعر، وتحققها في تجربة ما يؤشر إلى سمو المستوى الإبداعي لصاحب التجربة. وهذا أمر متحقق بوفرة في هذا العمل الشعري الذي يعتبر تطورًا في مشروع سمير درويش الشعري.
——
الهوامش:
1- سمير درويش، تصطاد الشياطين، دار شرقيات 2011.
2- سمير درويش، تصطاد الشياطين (م. س)، ص7.
3- المصدر نفسه، ص87.
4- المصدر نفسه، ص55.
5- المصدر نفسه، ص54.
6- Albert Camus، L’Homme Révolté، Gallimard، Paris 1952. P 22.
7- يراجع: عبد الغفار مكاوي، ألبير كامو: محاولة لدراسة فكره الفلسفي، دار المعارف (مصر) 1964، ص122.
8- سمير درويش، تصطاد الشياطين (شعر)، ص47.
9- عز الدين إسماعيل، الشعر في إطار العصر الثوري، دار القلم، ط1، بيروت 1974، ص410.
10- عبد الغفار مكاوي، ألبير كامو: محاولة لدراسة فكره الفلسفي (مرجع سابق)، ص115.
11- سمير درويش، تصطاد الشياطين (مصدر سابق)، ص 43.
12- المصدر نفسه، ص 68.