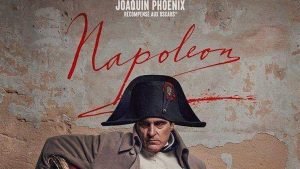سها السباعي
لم أستطع أن أبتهج بعرض فيلم Leave the World Behind، المأخوذ عن رواية صدرت من ترجمتي عن دار الكرمة، بسبب تزامن وقت عرضه مع ما يحدث في غزة، ولم أشاهده إلا منذ يومين بعد مرور أكثر من شهر على بداية عرضه. لا أرى بعد مشاهدته أنه فيلم مكرر يدور حول ثيمة “أمريكا التي تطهر نفسها” أو “أمريكا التي ستسقط بسبب أمراضها، العنصرية والرأسمالية.. “. وعلى الرغم من اختلافي مع هذا الرأي أعجبني كثيرًا مقال “اترك العالم خلفك”… كيف نشاهد سينما الأبوكاليبس بعد “غزة”؟” للأستاذ محمد خير عن الفيلم، في تساؤله عن مدى رقي أفلام نهاية العالم الكابوسية إلى ما يحدث على أرض الواقع من قتل وتدمير وأطراف مبتورة وتراب متشرَّب بالدماء.
مؤلف الرواية المأخوذ عنها الفيلم، والتي تحمل الاسم نفسه، من أصول بنغالية، أي أنه من العالم الثالث المسلم، برؤيته وخلفيته، مهما طرزها بمظاهر وخبايا موطنه الجديد ورؤيته التي اختلفت حتمًا في بلد المهجر عن بلده الذي هاجر منه، وربما اختلفت أكثر إن كان من جيل ثانٍ من المهاجرين. توليفة المؤلف والمخرج والبطل و”المنتج” التي تعود أصولها إلى ذلك العالم الثالث المسلم ولو من بعيد لم تغب عني منذ أول خبر قرأته يعلن عن فريق عمل الفيلم.
في الرواية كما في الفيلم، نحن أمام رجل “أفريقي أمريكي”، ارتقى في ثقافته وعمله ومستواه الاجتماعي والمادي، لكنه يحتفظ بفخر بإرث أصوله في أمريكا، فتظهر صور غائمة على جدار غرفة دخلتها ابنته لتأخذ خبيئتها، للأسلاف، بوصفهم عمالًا وجنودًا من أجل أرض ليست أرضهم في الأصل ولا حتى أرض مستخدميهم -مستعبديهم سابقًا- بل أرض أناس آخرين أُبيدوا وحُبس من بقي منهم في محميات فصل عنصري، ويعتقد هذا الرجل الأسود أن رجلًا أبيض وهو “مقاول” بنى له بيته: “صديق”، “جاهز لكل شيء” و”يعرف ما يجب فعله”، والجملة الأخيرة تكررت عدة مرات في الرواية، فهو يعتقد بيقين أن ذلك الرجل صديقه، بل أنه يحبه، ويثق في رأيه وحكمه، بينما لا يعني هذا الرجل الأبيض إلا حماية نفسه وأسرته فحسب.
تقول الفتاة الشابة في الفيلم عن الكارثة التي تحدث ولا يعرفون لها سببًا: “إنها تحدث لنا جميعًا”.
وتقول: “لكن رغم البشاعة التي يمكن أن يكون عليها الناس.. لن يغير شيء حقيقة أننا فقط من تبقينا لمساعدة بعضنا بعضًا”.
كان هذا ردها على قول أماندا – الذي ربما يخيل إلينا أنه يعبر عن الاستهلاكية والرأسمالية فحسب:
“عملي يتمثل في فهم الناس بما يكفي كي أعرف كيف أكذب عليهم، لأبيع لهم أشياء لا يحتاجون إليها”.
لكن هناك المزيد إذا تابعنا قولها بعد ذلك مباشرة:
“عندما ترين كيف يعاملون بعضهم حقًّا.. ترين ما يفعلونه، ويفعلونه حتى من دون تفكير.. نعامل بعضنا بعضًا بطريقة سيئة، طوال الوقت ومن دون حتى أن ندرك ذلك، نعامل كل مخلوقات الأرض بطريقة سيئة ونظن أن الأمور بخير، لأننا نستخدم لمشروباتنا ماصات ورقية [وليست بلاستيكية] ونطلب لطعامنا دجاج المراعي [فراخ “بلدي” ليست بيضاء، ليست فراخ المزارع المحقونة بالهرمونات].. نعرف في أعماقنا أننا لا نخدع أحدًا.. نعرف أننا نعيش كذبة، ونتفق على وهم/ضلال جماعي لمساعدتنا على تجاهل كم نحن سيئين وأن نستمر في ذلك”.
نحن سيئين، في معاملة بعضنا، وفي معاملة الأرض التي نعيش عليها، ثم نحاول أن نجد حلولًا للالتفاف على ذلك السوء، ولتخدير ضمائرنا، التي -ويا للعجب!- لا تزال حية.
جملة أماندا الأخيرة “أن نتجاهل كم نحن سيئين وأن نستمر في ذلك”، بطرق متعددة وربما فردية، بالإضافة إلى طريقة “الوهم الجماعي”، هي، كما أراها، وسيلتنا الضعيفة للاستمرار. الفيلم، والرواية، لا يتكلمان على مستوى الدول ذات السيادة ولا المنظمات الدولية أو الإرهابية ولا حركات المقاومة ولا حتى الميليشيات، لا يتكلمان عن أي كيان فاعل ذي قدرة وقوة، بل على العكس لا يشيران لكل ذلك إلا في إشارات عابرة وعلى نحو مجهَّل بل وجاهل أو سطحي نوعًا ما لأنه تنميط، غاية ما يعرفونه مأخوذ من ألعاب الفيديو وما يثرثر به الجميع وما يسمعونه على نحو عابر في الأخبار، أو كما قال داني ساخرًا إنهم لا يتعمقون إلى “ما هو أبعد من الصفحة الأولى في الجريدة”. لكن يُحسب للفيلم أنه نفى التهمة المعتادة عن بلدان الشرق الأوسط المتهمة دائمًا، وحاول إلصاقها بكوريا أو الصين، مرة أخرى، تأمَّل فريق العمل.
الفيلم والرواية يتكلمان من أسفل بطريقة خالد فهمي في “كل رجال الباشا”، يتكلمان على مستوى الأفراد، أنا وأنت. كم شخصًا منا، وأنا مثلكم وربما قبلكم، لم يختر الانسحاب داخل حياته الصغيرة ودائرته الآمنة، كم شخصًا منا، حتى أكثرنا إيجابية، لم يفعل أكثر من استعمال أكياس ورقية (التي نقطع من أجلها الأشجار أيضًا) أو حقائب قماشية بدلًا من البلاستيكية، وإيجاد بدائل للسلع الاستهلاكية التي اعتدنا عليها -والضارة في معظمها- من إنتاج شركات متغولة في العالم تدعم المعتدي ببجاحة منقطعة النظير، وأقول بدائل للسلع “الاستهلاكية” لأننا لن نستطيع اتخاذ قرار المقاطعة الشجاع أمام ضروريات لا بدائل لها مثل الأدوية والـ”سوفت وير” الذي أكتب عليه هذه الكلمات والمنصة التي سأنشره عليها ومحرك البحث ومحدد المواقع وكل ما لم نعد نستطيع الاستغناء عنه، كل ما نصبح عميانًا وعاجزين من دونه، كما صور الفيلم بجلاء على لسان كلاي في مشهد كاشف، لحقيقة العلاقات بين الأصدقاء والأغراب.
كم شخصًا من بيننا، وأنا أيضًا، يعتبر نفسه شخصًا صالحًا، يهتم لأمر السلاحف البحرية ويدعو “البواب” بـ “الحارس” كما يقول أمير عيد -الذي لا يعجب كثيرين- في أغنيته “تلك قضية”، لكن ذلك الشخص نفسه لا يستطيع أن يتخلى عن حياته الصغيرة الآمنة المريحة -نسبيًّا، وبنسب تختلف من شخص لآخر- ليتطوع بجزء من وقته وراحته، لتحسين أي وضع بائس، بجهد فردي، أو في مجموعة مكونة من الجيران والأصدقاء، أوفي جمعية خيرية محلية، أو منظمة دولية تذهب بالمتطوعين إلى بقاع الأرض الأكثر بؤسًا لتخفيف شيء من معاناة البشر وجوعهم وفقرهم ومرضهم وجهلهم، مع ما يشوب بعض هذه المنظمات التي ظاهرها الرحمة.
يتفكر الكاتب رُمان علَم:
“كانت الأشجار حية وشعرت وكأنها مخلوقات تولكين المهيبة. راقبت الأشجار ، وليس بحيادية. عرفت الأشجار ما حدث. تحدثت الأشجار فيما بينها. كانت حساسة لدويّ القنابل الزلزالي على مسافة بعيدة. كانت الأشجار على بعد أميال – حيث بدأ المحيط في اختراق الأرض – تحتضر، على الرغم من أن الأمر سيستغرق سنوات حتى تُختزل إلى جذوع بيضاء. كان لدى الأشجار كل الوقت الذي لا يملكه بقيتنا. يمكن أن تفوقها أشجار المانجروف ذكاء، ترفع جذورها مثل تنانير سيدة من العصر الفيكتوري، وترشف الملح من الأرض، لذا ربما ستكون بخير، مع التماسيح والجرذان والصراصير والثعابين. ربما ستكون أفضل حالًا من دوننا”.
يهتم كل من الرواية، والفيلم، كثيرًا للبيئة وما نفعله بكوكب الأرض، لتغير نمط هجرة الحيوانات وربما انقراضها، لكن الفيلم تطوع بشرح الأسباب بينما فصلت الرواية النتائج:
“كان هناك تهديد في الغابة وتمكنت روز من الشعور به، وكان يمكن لطفل آخر أن يسميه الله. أَيَهُمُّ ما إذا كانت العاصفة قد تحولت بخطورة إلى شيء لم يوجد له اسم بعد؟ أَيَهُمُّ إذا تداعت الشبكة الكهربائية مثل شيء مبني من الليجو؟ أَيَهُمُّ إذا لم يتحلل الليجو بيولوجيًّا أبدًا، أسيصمد أكثر من نوتردام، الأهرامات في الجيزة، الصبغة المطلية على الجدران في لاسكو؟ أَيَهُمُّ إذا أعلنت دولة ما مسؤوليتها عن انقطاع الكهرباء، أَيَهُمُّ أنه أُدين كعمل من أعمال الحرب، أَيَهُمُّ إذا كان هذا ذريعة للثأر المأمول منذ زمن، أَيَهُمُّ إثبات أن ما فعله شخص مجهول بواسطة الأسلاك والشبكات كان وارد الحدوث حقًا؟ أَيَهُمُّ إذا ماتت امرأة مصابة بالربو تسمى ديبورا بعد أن علِقت لستِّ ساعات في قطار «إف» المتوقف في نفق تحت نهر هدسون، وأن الأشخاص الآخرين في قطار الأنفاق ساروا أمام جثتها ولم يشعروا بشيء محدد؟ أيهمُّ أن الآلات المخصصة لدعم الحياة توقفت عن القيام بذلك العمل الشاق بعد تعطل المولدات الاحتياطية في ميامي، في أتلانتا، في شارلوت، في أنابوليس؟ أَيَهُمُّ إذا كان حفيد الرئيس الأبدي الذي يعاني من السمنة المفرطة قد أرسل بالفعل قنبلة، أم أن المهم ببساطة أنه يستطيع، إذا أراد ذلك؟”.
منذ سنوات، عندما اصطحبني الطبيب ومساعده خارج غرفة أبي في المستشفى الخاص -الذي اشترته فيما بعد مجموعة استثمارية أخذت تستحوذ على كثير من المستشفيات الكبرى وتفرض أسعارها- وصارحني بإصابة أبي بسرطان البروستاتا، التي أجرينا عملية لاستئصالها منذ حوالي عام، بمبلغ تضاعف بعد التعويم الأول، باستخدام الليزر على يد طبيب شهير يجوب المؤتمرات الدولية، سكتُ لثوان ولم أفتح فمي إلا لأقول بثبات من دون أي تعبيرات: “هل سيتألم؟”. ظهرت المفاجأة على وجه الطبيب الذي ربما توقع رد فعل مختلف، وقال إنه من غير الممكن أن نعرف. كان الله رحيمًا بأبي، فلم يتألم رغم انتشار المرض إلى كبده وعظام كتفه وفخذه وعموده الفقري وبقائه على هذا الوضع لثلاث سنوات حتى توفي، لم يصدر عنه إلا تأوهات خافتة شاكيًا من ظهره أحيانًا إذا حركناه، تفسيري الذي ربما ينم عن جهل لكنني أرتاح إليه، أن جلطة المخ التي أصابته قبل ذلك بسنوات أماتت مركز ألمٍ ما فوفرت عليه المعاناة ووفرت علينا رحلات صرف الترامادول من صيدلية الإسعاف بعد الحصول على أختام حكومية. وربما، ببساطة، استجاب الله لدعائي، ألَّا يتألم. شخصيًّا، منتهى أملي، أن تأتي النهاية -الآتية لنا جميعًا لا محالة- سريعة، من دون معاناة ومن دون ألم، أن يموت مركز الألم في أدمغتنا، قبل أن نموت.
في بدايات ما يحدث في غزة، اكتأبتُ حقًّا، انسحبتُ، لم يكن لأي شيء طعم أو معنى، تملكني شعور اللا جدوى، في عالم لا يركن لأي عدل أو منطق. لكن كان يجب أن أستمر في مهام الحياة اليومية، كان يجب أن استمر في العمل بفعل الالتزام بعقود موقَّعة ومواعيد تسليم وأرزاق لا بد من السعي من أجلها. تضامنتُ بكل ما أقدر عليه، وهو هزيل للغاية: غيرتُ صورة البروفايل إلى السواد، امتنعتُ عن مشاركة أي شيء مفرح أو حتى عادي على فيسبوك، مع عدم قدرتي في المقابل على المتابعة الحثيثة للأخبار ومشاهدة مقاطع الفيديو المرعبة إلا ما يقع أمامي صدفة، شاركتُ بعض منشورات الدعم، ومنشورات قليلة تنقل ما يحدث، تبرعتُ بمبالغ زهيدة لم أعرف إذا كانت قد وصلت لمستحقيها، أقنعتُ نفسي أن هذا أقصى ما تستطيعه امرأة مثلي في الخمسين من عمرها.
كان فيضان ليبيا وزلزال المغرب قبل 7 أكتوبر بفترة بسيطة -لو تذكرون- تعددت الأسباب والموت.. (هل الموت واحد حقًّا؟) كلنا ستأتيه ساعته يومًا ما، كلنا سيصيبه الدور يومًا ما، سواء بكارثة طبيعية أو حرب من طرف واحد أو سوء صيانة وإهمال ناتج عن تناحر أهليّ أو فساد حكومي أو حادثة على الطريق أو مرض ميؤوس من شفائه أو حتى فيروس مخلق أو طبيعي يجعل أنفاسنا الداخلة والخارجة من دون تفكير أمرًا مستحيلًا. هشاشتنا واضحة في الفيلم وفي الرواية – أذكر أن كاتبة وصفت بشريَّتنا في روايتها بأنها “حرير يكسو زجاجًا”، فكم يسهل تمزيقنا وتهشيمنا في أقل من طرفة عين- ماذا نملك في ظل هذا الضعف إلَّا أن نستمر إلى أن يحين وقتنا؟ إلى أن يصيبنا الدور؟
الآن، بعد ثلاثة أشهر، لا أستطيع ألَّا أفرح بإصدارات جديدة تحمل اسمي في معرض الكتاب، وفي الوقت نفسه أشاهد الأخبار الواردة في جنوب أفريقيا بعاطفة أمل واهٍ يشوبه إحساس اللا جدوى وعقل يسرح في المصالح والغايات الخفية. أطهو وجبة شهية لأسرتي على الموقد الكبير المزود بالغاز والكهرباء، ويمر سريعًا أمام عيني فيديو الموقد المصنوع من صفيحة صدئة وناره المشتعلة بوقود من حطب أو أي بقايا يمكن حرقها، هذا إذا وُجد ما يُطهى عليه. في برد القاهرة -الذي ما زال محتملًا مقابل برد الإسكندرية مثلًا أو البرد في بلاد يسقط فيها الثلج- أتدفأ داخل شقتي ذات الباب المصفح وبطانيتي الناعمة المزدوجة وثيابي الثقيلة وتمر أمام عيني خيام مرتجلة وأجساد تفترش الأرض وتلتحف بالشاش. نحن هنا نتحدث عن الحد الأدنى من مقومات البقاء على قيد الحياة لشخص لم يصبه الدور بعد، فماذا عن الموتى وذوي الأطراف المبتورة وأصحاب الأمراض الذين لا يجدون مستشفى أو حبة دواء؟
أحيانًا يشطح بي التفكير إلى تصور أن المقاطعة فعل ترفُّع، انتصار للذات الإنسانية بقدرتها على التحكم في اشتهاءاتها أمام هيمنة الشركات متعددة الجنسيات، التي ترمز إلى هيمنة دولها التي بدأت منها. ما زلت أذكر أخبارًا في الصحف ومشاهد في التلفزيون في بدايات التسعينيات، عن افتتاح فروع ماكدونالدز في روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وتهافت الناس عليه، في مشهد يقرن سقوط إمبراطورية بصعود سندوتش برجر وأصابع بطاطس وكوب صودا. ما زال هناك من يرتادون فروع ستاربكس رغم خوائها ويهجمون على كارفور في عيد ميلاده تحت إغراء التخفيضات- ومع ذلك يشعر كثيرون منا هنا بالأمر بكثافة نوعًا ما لأنه قريب، على المستوى الجغرافي، و”العِرقي”، والديني، واللغوي. ويشعر به كثيرون آخرون في بلاد البعيدة الأخرى فيعبرون عن الدعم ويقاطعون رغم أن الأمر بعيد عنهم على جميع المستويات السابقة. فما المشترك بين هؤلاء وأولئك؟ المستوى الإنساني فحسب.
وهذا المستوى الإنساني هو الذي ستجد أن رُمان علَم يهتم له في روايته “اترك العالم خلفك”، وستراه بين مشاهد الفيلم التي تصور سفينة عملاقة منجرفة (التي اتضح أن اسمها له علاقة بتاريخ العبيد في أمريكا) وسيارات تسلا المندفعة ذاتية القيادة، وبين جُمله الحوارية التي تلمح إلى مجلس قيادة العالم وإلى البليونير الذي يخمن البعض أنه البليونير الذي صار في غفلة من الزمن رئيسًا لأقوى دولة على الأرض. إذا تجاوزتَ الثيمة المكررة لأفلام نهاية العالم وسقوط أمريكا وإعادة إعمارها بإرادة الروح الأمريكية وللحفاظ على “اللايف ستايل” الأمريكي حتى لو فجَّر كوريون أو فضائيون البيت الأبيض نفسه، إذا تجاوزنا كل غثاء هوليود الذي نشاهده باستمتاع ونحرص من أجله على الاشتراك في نتفلكس أو الذهاب إلى السينما في الأسبوع الأول من العرض أو نبحث عنه بين المواقع المختلفة، إذا فعلنا ذلك سنرى جُمل الرواية، سنشعر بها.
في الفيلم – وفي الرواية ضمنًا – تساؤلات عن معنى تجمع الغزلان؟ ما دلالة الفلامنجو؟ ماذا تقول اللوحات المعلقة في غرف المنزل الفاخر؟ يرى المخرج المخرج سام إسماعيل أن تصوير الغزلان، التي هي في الأصل مخلوقات مسالمة، في تلك الصورة المشؤومة، المنذرة، المهددة، مقصود لتحويل الصورة الحلوة البريئة لما لا يُعتبر تهديدًا حقًّا، إلى شيء مهدِّد. هناك فيديو لشخص “أفريقي أمريكي” خدم في الجيش الأمريكي ودرس السينما يقول إنه لا يمكن أن يوجد شيء غير مقصود في تصوير مشهد في فيلم، مدة الفيديو أكثر من ساعتين مررتهما سريعا لأجد أنه يحلل حتى المكتوب على تي شيرت يرتديه كلاي في أحد المشاهد.
أَيَهُمُّ تفسير ما حدث في الرواية والفيلم أمام كون الأمر أكبر من ضعف الأشخاص وقلة حيلتهم، أَيَهُمُّ السبب الذي أدى لانقطاع الكهرباء والتليفون والإنترنت. أم أن المهم نتائج ذلك، هل سنحاول أن نعرف ماذا سنفعل إذا حدث ذلك بالفعل، واستمر على نحو دائم لا نعرف متى ينتهي؟ كيف سنصمد، كيف سننجو؟ كيف سنستطيع العيش ونحن لا نعرف ماذا حدث لـ روس وريتشل في النهاية؟ كيف سنستمر من دون مصادر الإلهاء المتعددة التي تجعلنا تستمر وتمنحنا سعادة زائفة: الانغماس في مشاهدة المسلسلات ذات المواسم المتعددة لساعاتٍ متتالية، والسفر في الأجازات والرحلات، وشرب أصناف القهوة، وتناول الطعام خارج المنزل، والتهام الـ”سناكس” المختلفة من الأكياس البراقة والانغماس في الـ”كومفورت فوود”؟ هل سنستطيع أن نتعامل مع الظروف الخشنة؟ هل سنستطيع أن نقسم اللقمة وحبوب الدواء مع جيراننا؟ هل سنستطيع أن نبذل ما في وسعنا كي نعين من حولنا؟ هذا بالطبع إذا لم يصبنا الدور.
ومع كل ذلك، هل تنكر، حتى لو لم تكن من محبي Friends، أن الأغنية ترسم على وجهك ابتسامة عريضة مثل ابتسامة روز في الفيلم بعد تعبيرات وجهها الباهتة، الخاملة، اليائسة، غير المكترثة؟ هل تنكر أنها تمنحك سعادة لاهية كالتي تمنحها لـ روز؟
هل تنكر أنها تنقلك إلى عالم “مبهج” آخر غير هذا العالم؟ غير هذا الزمن؟!