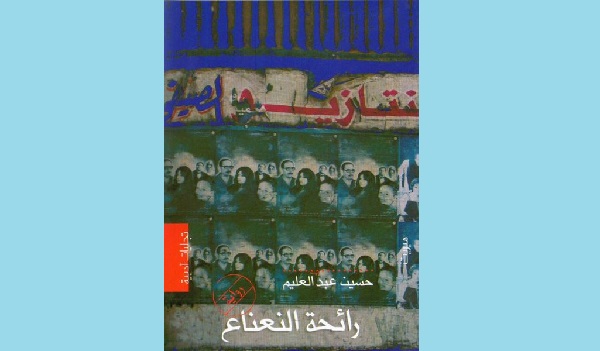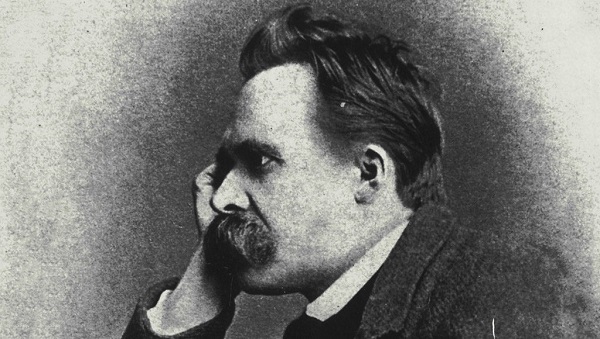شوقى عبد الحميد يحيي
تعود الإنسان العربى، أن (يفتش) عن الأسرار- خاصة النسائية- فيما تكتبه المرأة. حتى لو كانت هذه المرأة استاذة جامعية، كالدكتورة فاطمة قنديل، إلا انها فى البداية، وقبل أن تكون أستاذة جامعية ، فهى شاعرة، ووفق تيار التحول من الشعر إلى الرواية، قدمت الدكتورة رواية –طبقا للمنصوص على غلاف العمل- وبحكم كونها أستاذة للنقد، فلعبت على إثارة حفيظة القارئ ، بعملية الإيهام، بأنها ستقدم له ما يُشبع فضوله، فتقول فى روايتها الأولى “اقفاص فارغة”[1] {أصدقائى الأقرب إلىَّ يقولون لى: واصلى الكتابة، واليوم أخبرت زملاء لى فى العمل يدرسون النقد الأدبى، ويكتبون روايات تجارية” أنا أكتب مذكراتى، نظر لى أحدهم مستنكرا: لا… لا.. حاسبى. والآخر ، صاحب الرواية التجارية، قال لى : اكتبيها بضمير الغائب؟! أنا أريد أن “أحضر” كما لو أننى كنت غائبة دائما، الحضور الكامل هو كل ما أحلم به، اليقظة التى لا تفوت ضوءا واحدا فى جوفى إلا حدقت فيه، حدقت فيه حتى يتلاشى، كعيون الميدوزا، لا أريد سوى أن أمسخ كل الذكريات إلى أصنام، ثم أكسرها، ثم أكنس التراب المتبقى منها، حتى ولو كنت ، أنا نفسى، صنما من بين كل تلك الأصنام. “ضمير الغائب يا راجل؟!”.}ص19. فهى تعد القارئ – وهَمْاً- بأنها ستسير على نهج السيرة الذاتية، بمعناها الشامل، والذى يحتوى الصدق الكامل، فى الوقت الذى تُدرك فيه –وهى الناقدة- أن هذا شبه مستحيل، لا على المستوى الشخصى فقط، وإنما على المستوى الجمعى، فهى تُدرك أنها تقدم محاولتها فى مجتمع (عربى). فالصدق –الحياتى- الكامل، والبوح الكامل، اشبه بالبحث عن الخل الوفى. إلى جانب أنه من الملاحظ أن العمل الأول –لأى كاتب- يحمل من السيرة الذاتية الكثير، حيث يكون الكاتب مهموما بتقديم ذاته، والتعرف عليها، وتعريف القارئ بها –رغم أن الكاتبة قدمت نفسها كثيرا فى دواوينها، غير ان الرواية تختلف عن الشعر فى الكشف عن الشخص-. فضلا عن أن الكتابة فى لحظة لاحقة للأحداث المروية، ووفقا للعديد من الإشارات فى العمل ذاته، سيخضع لعملية النسيان، او الاحتمال، خاصة وأن التركيز على فترة الصبا، أو الطفولة، كان كثيرا، تلك الفترة التى لم يكن الإنسان فيها بقدر وعيه لحظة الكتابة. وإن كانت – الكاتبة- قد ركزت على الكثير مما يعرفه البعض عنها، فى وجودها الحى، إلا اننا نعلم جيدا أن الكثيرين ممن سيقرأون العمل ، لا يعرفونها بصفة شخصية. ولنا فى رائد الرواية العربية “نجيب محفوظ” مثلا. فإن الكثيرين ممن قرأوا رائعته “الثلاثية”، باجزائها الثلاث، ودرسوا حياته الشخصية، سيربطون بينه وبين شخصية كمال عبد الجواد. الأمر الذى معه يمكن وصف الرواية على أنها سيرة ذاتية، غير أن الواضح من الثلاثية، ومن “أقفاص فارغة” أنها تتكئ على الحياة الشخصية فى بعض جوانبها- وهو ما لابد يحدث فى أى عمل إبداعى- ليقدم رؤية للعصر المتناول فى العمل، بمنظور رؤية الكاتب وقت الكتابة.
فإذا ما نظرنا إلى وقت كتابة “أقفاص فراغة”، فسنجد مقولة تتردد بين الكثيرين، مثقفين أو إناسا عاديين، تقول بتفتت وضياع الطبقة المتوسطة، والتى تعتبر هى عماد المجتمع، ومنها برزت أكثر الأسماء المعروفة فى الإبداع والابتكار. وهو ما نستطيع رصد تحولاته عبر الرواية.
تأثيرات الطفولة على شخصية الساردة
ولدت الكاتبة فى مدينة السويس عام 1958. أى أنها عاصرت فترة نكسة 1967و هى طفلة. فانحفر فى جوانيتها، مآساة ما حدث من خراب فى تلك النكسة، ومن بين ما انحفر فى أعماقها، ذلك الحوار الجارح بين الأب والأخ الكبير “راجى”، حيث يقول الأب {انا مش حافضل أصرف عليك طول عمرى يا سى راجى، أنا مش حأفضل أصرف على (شحط) زيط.
- وأنا مش حاسامحك على الكلمة دى، أبدا يا بابا}. -حيث تنزرع الكلمة فى أعماق “راجى” وتؤثر فى شخصيته التى سنتعرف عليها. خاصة إذا ما نظرنا إلى الأب بصورته الرمزية-.
وتواصل الساردة {كان هذا غالبا فى أواخر الستينيات، ولا أعرف، ولم أعرف أبدا لماذا ظل ذهنى محتفظا بهذا الحوار الجارح المقتضب حتى اليوم، ولم يغب عن بالى أبدا، كأنه الافتتاح المهيب للالياذة[2]!…. أنا الطفلة فى الحادية عشرة، بين الكبيرين، أبى وأخى الأكبر، جرم ستتحول به المصائر، “راجى” إلى ألمانيا، وأبى إلى الموت}ص21. فإذا كان هذا الحوار قد وقع {أواخر الستينيات) وفق ما تقوله الساردة، أى بعد تدمير المدينة، بل وعمليات التهجير التى تبعتها، الأمر الذى أفقد الكثير من العائلات بيوتها (المِلك) وبدأت فى عمليات التنقل(عدم الاستقرار) ذلك الذى عبرت عنه الساردة بعديد التنقل بين الشقق والمواقع. وهو ما عبرت عنه الساردة، فى عزوف (الأطفال) عن اللعب أو البهجة، وكأن عملية التهجير أفقدتهم براءتهم، ومفارقة طبائعهم التى جُبلوا عليها {لسنوات طويلة كنت أسافر إلى السويس، لم تنقطع سفراتى إلا بعد حرب 67، وكنا قد انتقلنا إلى “مدينة نصر”، وانتقلت معنا عائلة “أم فؤاد” كلها، ليقطنوا- بين المهجرين- فى الجانب الآخر من شارعنا، وقرب مدرستى فى “رابعة العدوية”. لم تنقطع زيارات أمى لصديقتها، لكن الأبناء بدوا عازفين عن المرح القديم. يقابلون دعوتى اللعب معهم، بفتور، كانوا عائدين من السويس بعد التهجير، ورأوا بيتهم يتهدم أمام أعينهم، لم يعودوا “أطفالا” كما كانوا، فعزفت أنا، بدورى، عن اللعب معهم}ص38.
ثم كانت عملية التنقل بين البيوت، مصحوبة بأثر الطبقة الاجتماعية، التى بالضرورة حاضرة فى كل تنقل، فنلحظ تحول عملية السكن من (المِلك) إلى (الإيجار) وكأنها عملية خلع للجذور من الأرض { “لَمِتْ” الألف مسكن، بالفعل، كما شكت أمى، أواخر الخمسينياات، كانت مكانا جميلا. واعدا للطبقة المتوسطة الباحثة عن الهدوء، بعد أن ضجت أماكن مصر الجديدة العتيدة: روكسى والكوربة ، وميدان الاسماعيلية، وترينف، حيث كنا نسكن}ص48.
{ ولأنها “فيلات” لم يكن من الممكن اعتبارها فى أوائل الستينيات، حين سكنا فيها “مساكن شعبية”}ص48.
و{الانتقال من بيت “الألف مسكن”، وخارج حدود مصر الجديدة، للمرة الأولى، فى حياة الأسرة، أُعتبر مغامرة، لكن البيت الجديد كان “تمليك” هو أيضا، وهو ما جعل الأسرة تحافظ على وجودها داخل الطبقة المتوسطة، التى زهت أمى بالانتماء إليها، بعدما الألف مسكن “لَمِتْ” كما كانت تردد أمى، متذمرة طوال الوقت}ص52.
ثم {لم أعد اتذكر شيئا، سوى عربة “العفش” وميشو يتملص، ويعوى، فى حضنى فى التاكسى، وهو يمضى فى طريقنا إلى البيت الجديد، “الإيجار” هذه المرة، فى النزهة- مصر الجديد}ص60. وعلينا ألا نترك الإشارة {البيت الجديد الإيجار – مصر الجديدة}. ونتأمل ما فيها من نقلة (مقصودة) من التمليك ‘لى الإيجار / وفى مصر الجديدة.
وتتذكر الطفلة، ما تلقى به الكاتبة ضوءا على قراءة تلك الفترة، كيف كانت الحياة، والبيوت والأفكار، وكأنها تضع الماضى أمام حاضرنا، لندرك ونشعر بمدى الانهيار الذى وصلنا إليه بدءا من تلك النكسة التى كانت { كأنها الافتتاح المهيب للالياذة!} أو لتراجيديا الانهيار, حيث كانوا قد غرسوا فى نفوسنا ونحن الأطفال، أن مصر لابد أن تكون هى المنتصرة، ولإسرائيل لابد أن تكون المنهزمة {كنا نلعب “حرب” أيضا، تكون عمارتنا مرة “مصر” ومرة “إسرائيل” حسب الدور، نهتف ، حين نكون مصر: “هنحارب، هنحارب، إسرائيل “الأنارب”، ونختبئ وراء ساتر الطوب، المبنى أمام كل عمارة، لنهاجم “العدو”! 0كنا نتبادل الأدوار لأن عمارة إسرائيل لابد أن تُغلب فى المعركة، ويُؤخذ منها الأسرى، لذا قسمنا الهزيمة بالتساوى).. لم يكن البيت الجديد واسعا كسابقيه}ص53.
وتبين مدى تدهور “الطبقة المتوسطة” التى كانت الأسرة واحدة منها، حين ظل التنقل ، أو الانحدار فى السكن – الدال على الأحوال الاجتماعية- حين تتذكر الساردة { نسميه أنا وجارتى، تندرا، بيت أحمد وهبى… انتقلت بعد سكننا فيه بأربعة أعوام تقريبا، بيت من دور واحد، وشقتين متجاورتين، تقطن أسرتنا فى واحدة، ويقطن فى الأخرى صاحب البيت، المنحدر من عائلة ريفية ذات فروع، وصيت. اعزب، يعمل مديرا لمكتب إحدى الشخصيات المهمة فى القضاء، رغم أنه ظل منتسبا لكلية الحقوق، ولم ينل شهادتها أبدأ}ص220.
ولم يكن البيت فقط هو الذى تغير، حيث الاتساع يوحى بالراحة واستنشاق الهواء، والحرية، بينما كان المكان بصفة عامة قد تغير هو الآخر {كنت، وماما ، نستطيع مشاهدة بابا وأخوى، وهم يهبطون من المترو، على بعد أكثر من كيلو متر، الكلاب الضالة تملأ المكان… صار البيت غريبا بمرور الأعوام، لم تعد الصحراء صحراء، صارت عمارات فاخرة، شاهقة، تحجب المترو، صار غريبا بِدُوره الوحيد بينها، وببنائه الذى يشبه “دوار العمدة” فى القرى، لم نعد نرى الشمس، ولم يعد بإمكاننا أن نجلس على السطح، تحرجا من أولئك الذين يراقبوننا “من حالق”}ص220 و 222. فقد تغيرت مساحة البيوت، وكبست العمارات على الأنفاس، وحتى الأخلاق تغيرت.
وحتى المدرسة {إلتحقت بمدرسة جديدة، التحقت بها على مضض، لأن الالتحاق بمدرسة خاصة، كان عارا، فى تلك الأيام البعيدة… أظن أن هذه الفترة هى التى هددت فيها ماما بالانتحار}ص62.
وكان من نتيجة ذلك كله، تمزق الأسرة، حتى أن الأخ الأكبر “راجى” كان يشتهى لمة العائلة، {راجى رغم عزلته الدائمة، أو ربما بسبب عزلته الدائمة، حين تأتيه “الفورة” كما كنا نسميها، كان يُصر على أن نجتمع على المائدة، مرة واحدة، عايز أحس إنى فى عيلة….. ثم ننصاع له –إلا بابا طبعا – ونجلس على المائدة، ونحن ندارى ضيقنا بالضحكات، نزدرد اللقيمات، لنتعجل الهروب، لكن الأمر كان يعود بعدها لسابق عهده }ص13
وهو ما يدعونا إلى تأمل شخصات الأسرة، وكيف كان كل منها، كما هو، أو كما رسمتها الكاتبة.
فالأب {أبى، أيضا، كان تعسا فى تلك الأيام، التى التقيا فيها، زوجا وزوجة، ظلت حلما بالنسبة إليه، تجمعهما روابط عائلية بعيدة، وموطن واحد، حين اضطرته الظروف لأن يتخلى عن حلم الإلتحاق بكلية الهندسة، ويلتحق بمعهد المعلمين المتوسط، كى يوفر لأسرته ما يعولها }ص80.
وكان طبيعيا –بعد موت الحلم، والشعور بغياب الدافع، كان منطقيا أن يُدمن، الشراب، حد نسيان كل شئ، بما فيها الوضع الاجتماعى، الذى يؤدى بالساردة أن تتجاهل نداءه وهو يجلس على الرصيف، والأم تسمح له بالشراب داخل البيت، حتى لا يكون المزيد من (الفضائح).
فكان العطب فى الأساس {لا يمكن أن ينالها، هى ابنة التاجر الثرى، حبيبة أمها، ودلوعة أبيها، دون باقى اخواتها. وهو ابن التاجر البسيط، الذى اشهر إفلاسه عند أول ضربة سوق}ص81. الأمر الذى يجعل من الأم شامخة على زوجها، ليصبح السوس الذى ينخر فى الأصول. بل إنها لم تكن الجذور القريبة من الأرض، لكنها -أيضا- الجذور الأبعد فى الأرض، التى تمد النبت بالحياة، فكانت الجدة {كانت سيدة فائقة الجمال، تسير فتتلفت الأعين، بشعر أصفر يتناثر على كتفيها، من وراء غلالات طرحة غير محكمة، وعينين واسعتين خضراوين. جدى أيضا كان وسيما، حين كبرت كنت أراه التجسيد الأمثل للسيد أحمد عبد الجواد، يناديها فتلقى ما بيديها، كى تلبى طلبه، فى التو ، متوترة}ص101، وكأننا أمام ليس الجمال فحسب، ,غنما الرجولة أيضا، ذلك ما كان. فنشأت الحفيدة-الساردة- {كنت فتاة مغرورة كما يقول البنات، وحقها كما يقول الأولاد لإغاظتهن}ص110. فنحن إذن أمام جمال الشكل، الذى يمنح الأنثى الشعور بالانتفاخ، غير أن الواقع يهزمهن، فيكون كالغطاء الضاغط على القدر المغلى. فالجدة تلبى طلب الجد ، فى التو، متوترة. والأم كانت ابنة التاجر الثرى، حبيبة أمها، ودلوعة أبيها، وبعد فشل زيجة الحب ترى نفسها (مضطرة) للزواج من (الأب) {تعثر الولدين، وها هى البنت وراءهما، انتقالها من الثراء إلى الفقر، منحنيات حياتها الدرامية، حب مستحيل، ثم زيجة للهروب، انتهت بطلاقها، وزواجها ثانية من أبى}ص80. و كما تفشل الساردة فى زيجتين فاشلتين، لم تخرج منهما بشئ ، سوى فشل التجربة، والمزيد من الإحباط، لنكون أمام شخصيات غير سوية.
ولم تكن الإبنة –الساردة- هى فقط نموذج الإحباط نتيجة تفكك الأسرة، وإنما كان الأخ الأكبر “راجى”- رغم رمزيته- حيث كان هو مصدر تثقيف الأخت، حيث يمدها بالكتب وبالموسيقى الكلاسيك، حتى وهو فاشل فى حياته العادية فى ألمانيا. وكأنه المعادل الموضوعى للمثقف الذى يفشل فى الحياة الاعتيادية، فلا يملك إلا العيش على فتات الآخرين. والأخ الأصغر “رمزى” الذى فشل كثيرا لكنه أخيرا أصبح دكتورا ، ولم يكمل كباقى زملائه الدكتوراه، فعاش ضنينا على أخته وأخيه ، بل فى السابق على أمه، ليصبح أحد نتاجات فترات التأزم، ان يعيش لنفسه، حتى لو كان الأمر على حساب أقرب الناس. فالجميع إذن يعانى عدم التواؤم مع الحياة، الجميع ضيعت الأزمة عليه حياته، فكانت كانها الافتتاح المهيب لإلياذة حياتهم، على المستوى الشخصى، بينما عملية الربط تدعونا لتوسيع الرؤية، حين نعلم أن المجتمع ليس إلا مجموع أفراده وعائلاته.وهى التى عبرت الساردة عنها، وكأنها تصف حياتها بصفة عامة {كم مرة سمعت بأننى “فى عنق الزجاجة؟ كثيرا، بل إن حياتى كلها وكأنها لعبة “انحشار” دائمة فى عنق الزجاجة، أطفو كقطعة فلين، ثم أعاود العوم بيدين حاسمتين، لأنهى هذه القفزة الأخيرة، حين هبت العاصفة، بعودة “الغائب”}ص230.
وتؤكد الكاتبة ذلك التأثير، الواقع على الأجيال التالية (الساردة وإخوتها)، التأثير الجينى الذى لا مفر منه، عندما قررت -الساردة- تناول البيرة، التى كانت ترفضها، والتى كانت ترفضها فى والدها، تتحدث عن الإرث الذى ورثته منهم:{حتى بعد أن يموتوا، يظلون “كمعركة” قائمة بينك وبين العالم، معركة تمنحك الحياة، أو تمنحك الرغبة، والقوة فى الاستمرار فيها، كى تكون واحدا من اثنين” منتصرا، أو مهزوما، ضحية أو جلادا، ليس هناك فرق، لقد منحوك الحياة، وأنت أخذتها منهم، بسذاجة من يقضم حبة من التين الشوكى، كى يقشروها، أولئك الوحيدون، العراة، الذين اختاروا، أول مرة، أن يكونوا مشاجب، ولم يكن فى إمكانهم، أبدا، بعدها أن يختاروا تلك الملابس التى عُلقت فوقهم! }ص118.
ثم تنتقل الساردة -فى الفصىل الثانى- من التغيير الأضيق، أو التغيير الفردى، إلى التغيير المجتمعى، أو التغيير الأوسع والذى يبدا بالحياة الشخصية ، إلا انه لا يتوقف عندها، بل يمنح القارئ رؤية أشمل، تنال المجتمع. حيث يبدأ أيضا العرض من المساحة الخاصة، فنرى شباب العصر الجديد، أو المرحلة التالية، وكأنها بداية الخروج عن روح فترة الطفولة {البيت ممتلئ بأصدقاء “رمزى”،… تسرى بينهم أغنيات الشيخ إمام وأغانى البيتلز، ويذهبون إلى السينما وأحيانا يصطحبوننى معهم، أسير بينهم متلذذة بسندويتش السجق}ص73.
وتتغير المدرسة، ويتغير وضع الساردة، فبعد أن كانت من الأوائل، لا تدرى لمذا لم يعد ترتيبها الدراسى سوى العاشرة، فيكشف لها “رمزى” عن الأسباب التى تشير إلى بؤرة المشكلة –على النحو الفردى، وفى ذات الوقت تنفتح على الرؤية المجتمعية، بعد التغيير {التفوق له شروط، ليست المذاكرة وحدها: البيئة لازم تكون مستقرة، إحنا حياتنا مش مستقرة يا حبيبتى، شوفى زميلاتك الأوائل دول، كلهم مستريحين ماديا، ومستقرين، وما مروش بمشاكلنا.. دى شروط التفوق، غصب عنك، أنا كمان يا دوب بأنجح فى الكلية، ظروفنا زفت، كتر خيرنا إننا مكملين}ص76.
وتكبر الساردة، وتصبح بالجامعة، فتعرض لنا نوعية الحياة- المتغيرة عما كان- خاصة تلك الطبقة (الوسطى) والتى تمثلها الساردة {بمكياج ثقيل،كقناع سميك، وفى الثامنة عشرة من عمرى، أعبر ببطء “ممر جيمى”، الممر الأشهر فى آداب عين شمس، والذى استمد اسمه من اسم صاحب كشك المشروبات والسندوتشات، حيث يجلس جنبا إلى جنب، فتيان وفتيات الطبقة الوسطى العليا فى مصر}ص109.
ثم يُرفَعُ الستار، عن الرؤية المجتمعية، وكأن الساردة قد أغرقتنا فى الرؤية المحدودة، لتفاجئنا بالرؤية الأوسع، والتى تكشف عن أسباب التحول والتغير فى المجتمع، متى بدأت، وكيف بدأت
{لم يكف أونكل “سالم” عن إبداء آرائه اللاذعة، وكراهيته لعبد الناصر، وهى كراهية شاركه فيها أبى، لكنها كانت آراء مبثوثة فى مقالات لا يقرأها سوى القليلين، لذا حين أتى زوار الفجر، واقتحموا بيت طنط شريفة، وأخذوه، كان الأمر جللا… انفض الأصدقاء عن البيت، وانقطع الزبائن، لشهور عدة، وسرت مفردات غير معهودة فى بيتهم: تجهيز الزيارة، التليفون المراقب… إلخ}ص114. حيث تكشف من خلال كلمات بسيطة {آراء مبثوثة فى مقالات لا يقرأها سوى القليلين} كيف أن الرعب كان هو المسيطر، وكيف أن الخوف كان هو السيد. الأمر الذى معه أصبحت الساردة تعيش الغربة، فقد انقطع ما بينها وبين الماضى الذى كانته قبل التهجير و بعد أن سلمت البيت للمالك الجديد{البيت القديم، أثناء زياراتى لأصدقائى، فى مصر الجديدة، لم يعد البيت موجودا، هدمه مالكه الجديد، وأقام عمارة شاهقة مكانه، مرة وحيدة حاولت أن أمر من الشارع، فارتبكت، ولم أستطع تحديد مكانه، فعرفت أننى لن أذهب مرة أخرى، وعرفت أننى ضللت الطريق إلى هناك، إلى الابد….خمس عشرة سنة مرت، كأن الحياة بدأت هنا، فى هذا البيت الذى أعيش فيه الآن، كأن الزمن هناك، أيضا، قد تهدم، وسقطت صخرته الأخيرة}ص251. وحيث تتحول “مصر الجديدة” من المنطقة السكنية المحدودة إلى رمز لعصر جديد.
وتتابع الساردة شهادتها على العصر، وعلى تحول وانهيار الطبقة الوسطى، والتى هى العمود الفقرى للمجتمع، بتغير السلوك وتحول المجتمع، الذى يبرز فى عودة الأخ الأصغر “رمزى”
من السعودية، بالفكر الوهابى الذى انتشر فى المجتمع “{حين عاد بعد سنوات من السعودية، بلحية تصل إلى صدره، وتفوح منه رائحة المسك النفاذة، زاد وزنه، وعلا كرشه بارزا من الجلباب الأبيض… }ص165. ولتكتمل “إلياذة”” الساردة، ويتم ضياع الطبقة الوسطى، ومعها المجتمع، عندما تقر الساردة، وكأنها وصلت لقمة الضياع {من عرف أن انتظارى للأخ الغائب، وفرحتى به، كصخرة أستند عليها، لم يكن، فى أعماقه، سوى الصخرة الأخيرة، للبيت القديم}ص250.
التقنية الروائية
على الرغم من الإغراق فى التفاصيل، خاصة تلك التى تتناول بعض الأقرباء، التى لم تكن تصب فى صلب الرواية ، بقدر ما ساعدت على تشتت الرؤية، وربما لأن الكاتبة كانت فى البداية تكتبها كمذكرات، إلا ان العقد الضمنى المنصوص بغلاف العمل، ينص على أننا أمام (رواية)، فعلينا أن نُنحى تلك المذكرات جانبأ ونقرأ العمل على أنه رواية، وحينها سنتجاوز عن أخطاء البداية، كما يحدث كثيرا فى العمل الأول، من الإفراط فى ذكر التفاصيل. فإننا سنجد أن للعمل رؤية، تتمثل فى عرض مسيرة الطبقة الوسطى، عبر فترة زمنية محددة، تبدأ من عملية التهجير، إثر نكسة 67، وتصل إلى الآن. فأصبح للعمل حبكة محددة المعالم، خرجت عن نطاق (الحكى) إلى تقنيات الرواية، والتى استمدت وجودها فى الحيلة الروائية التى تمسك بتلالبيب القارئ، وتتمثل فى خلق الحركية، والتغلب على سير السرد تراتبيا، اللعب بالزمن.. حيث بينما تسرد الساردة عن فترة معينة، نجدها بعدها تعودة لفترة أسبق منها، وكأنها الجدة تحكى. فتقول ( آه نسيت أقول…..) الأمر الذى صبغ السرد بلون ألف ليلة وليلة، التى تخرج من حكاية لتدخل فى أخرى.أى تولد الحكايات). فكثيرا ما كنا نشاهد الأم تموت.. و بعد فترة وجولات نجدها تحضر، ثم بعد فترة نعلم أنها ماتت من سنوات. ثم نعيش معها فى موقف جديد.
فضلا عن الصدق فى وصف الكثير من المشاهد، المؤثرة ، والخالقة لتعاطف القارئ، مثل وصف تفاصيل مرض الأم.
كما جاء العنوان معبرا عن الرؤية الكلية، حيث من المعروف أن الأقفاص، ما هى إلا وعاء للتعبئة، غير أنها هنا ظلت فارغة. فالأخ الكبير “راجى” رغم أنه كان مصدرا (لتوريد) الثقافة للساردة، إلا أنه لم يستفد من تلك الثقافة، وظل (فارغا) منها، ومن القدرة على المواءمة، ومواجهة المعيشة بتحولاتها. وكذلك الأخ “رمزى”، رغم أنه تعثر كثيرا، إلا انه فى النهاية أصبح طبيبا، غير أنه –أيضا- ظل (فارغا) من المواصفات الإنسانية، حيث تخلى عن الوقوف إلى جانب أخته، رغم ما تعانيه من حاجة ومشقة، فضلا عن تخليه عن علاج أمه، وكان يُفَضلُ تركها، إلى أن يأتى الأجل، بينما كان يكتنز الأموال. وكذلك هروبه من مساعدة أخيه. فهم فى النهاية بشر بالصورة، لكن الجوهر (فارغ).
كما برعت الكاتبة فى خلق شخصية الساردة، وكأنها وضعتها فى محن التجربة والمعاناة، وكأنها تصهر الحديد، لتخرج شخصية تحمل من أعماقها، الشخصة القوية، والتى تظهر عندما تدخل رئيس الكنترول بالجامعة وأخبرها بأنها لن تُعين معيدة، فتذكر له مرض أمها، ولم يشفع لها شئ { لم يكن قلقى نابعا من تقديره، الذى بات متوقعا، فى الامتحان، ولكن من إلاهانة، من ضعفى أمامه، من صوتى المرتعش، من نطقى، وأنا أخبره بمرض أمى بالإنجليزية، كأنه عار، أو كأننى شحاذ يعرض قدمه المبتورة للمارة}ص185. فلم يكن يهمها ألا تُعين معيدة، بقدر ما أهمها أن تبدو ضعيفة أمام أستاذها. رغم أن اللعبة تكشفت فيما بعد، حيث أنهم { استطاعوا بلعبة “الكراسى المتحركة” أن ياتوا بالخامسة على الدفعة لتكون الأولى بتقدير عام ممتاز، وفارق درجتين بيننا، لم يأتوا بأحد من الأوائل، الذين تنافست معهم، عبر أربع سنوات، ولم تكن صدمتى وحدى، بل صدمة الثلاثة الأكثر تفوقا، عبر السنوات، والذين كثفوا جهودهم، ليتجاوزوا تقديراتى الأخيرة، ثم تبين لهم، أن ثمة من تُرَتَب له الأدوار ليأخذ دور البطولة، من وراء الستار}ص185.
وقد يؤكد تلك الرؤية، ويبرر الكثير من تصرفات الساردة، ويخرج بالرؤية من الحيز الضيق إلى الرؤية الأوسع، حين تتحول الأسرة بأكملها من الوجود المحدود إلى الرؤية الجمعية، إذا ما قرأنا هذه الأبيات من ديوان “بيتى له بابان” –للكاتبة- وكأنه جزء من الرواية، او كشاف ضوء لشخصة الساردة:
ماتت امي، ومات أبي،
وأنا أخدمها، وأمسح ما يساقط من فمها
وأغير لها اللفائف في مرضها الأخير
وأتحمل أن تسب أمي وتسب أبي
لكنها حين تهذي وتناديني
لا أرد عليها
وأغطي وجهي وأتصنع النوم
وأحيانا أبكي
لا لشيء
إلا لأنها علمتني كل هذه القسوة”.
وهو ما ظهر فى تصرف الساردة بعد موت أمها.. لم تبك ،، غلا بعد أن شعرت بفراغ البيت.
شاعرية السرد
ليس من اليسير أن تتخلص الكاتبة من مجموعة دواوين للشعر، قدمتها قبل أن تُقدم على إخراج الرواية، خاصة الرواية الأولى. فإذا كانت الشعر يرتكن إلى المجاز، والأساليب البلاغية، فإننا نستطيع أن نتلمس تلك الشاعرية، فى استخدام المجاز، فى العنوان وفى الرؤية.فالعنوان على نحو ما أوضحنا، هو استخدام المجاز، فى (الأقفاص) التى نعتت بها شخصيات الرواية. فضلا عن تلك العبارة المرفقة بالغلاف، والتى تعتبر جزءا من العنوان، {ما لم تكتبه فاطمة قنديل} والذى يُثير التساؤل لدى القارئ، فإذا لم يكن ذلك ما لم تكتبه.. فمن كتبه.. لتكون الإجابة – بعد قراءة الرواية كاملة: كتبته الأيام و الليالى.. كتبته تلك التجربة القاسية للتهجير والتشتت بعد نكسة كانت بدءا لمآساة مجتمعية، ظلت ممتدة لسنوات، كالسوس تنخر فى جذر المجتمع.
وكذلك الرؤية التى أرادتها الكاتبة من عرض حياة أسرة مفككة، كمجاز عن تفكك المجتمع، وخاصة الطبقة المتوسطة، إبان عملية التهجير إثر نكسة 67. حيث سارت اللغة الأشبه ب(الحكى)، غير أنها تشير إلى رؤية أبعد، وهو ما أوضحته الكاتبة فى أحد حواراتها { أنا أحب الأعمال الفنية التي تشبه ورقة الشجر، لها سطح أملس، ولكن بداخلها كون بأكمله}[3].
ويمكن كذلك تلمس الشعرية فى تلك الفجوات التى تُركت مفتوحة، حتى لو حاولت الكاتبة مئلها، بعملية التأويل، لكن التأويل دائما لا يمنح القطعيةـ وإنما يظل مفتوحا لغيره من التأويلات. فعند عرض زواج الأم والأب، وقد اتفقا فى خضوعهما للهزائم العاطفية، تقول الساردة {الإحساس بالرضاء، بما هو أسوأ، والسقوط من طبقة إلى أخرى، والتسليم بالقسمة والنصيب، تمت الزيجة، هكذا يحلو لى تأويل مصيرهما أحيانا}ص83. بينما ينفتح التأويل –لدى القارئ- إلى عديد الأسباب الأخرى، كأن يكون العند، أو الانتقام، أو الرضا بالواقع، فليس فى الإمكان أفضل مما كان، وغيره من التأويلات، التى تثير القارئ، دون أن يستسلم لتأول الكاتبة، أو يثير فيه الخيال، إذ ربما كانت الكاتبة تقوده لرؤية محددة، هى تتغياها، أو تسعى لإخفاء شئ ما.
كما تكمن الشاعرية فى تغير الضمائر الذى يخلق الفجوة القرائية لدى القارئ، ويثير تساؤله. {تفكر الإبنة وتتمنى الانتحار{“بسبب بابا والزفت راجى.. ربنا ياخدهم هما الأثنين سوا”… لقد دفعتِ ثمنا باهظا لهذه الجملة يا فاطمة.. و تزالين تدفعين ثمن هذه الأمنية، التى كنت تعنينها تماما… نعم…. كنت اتمنى لهما الموت، من أعمق أعماق قلبى، ولم يشفع لى أننى كنت فى الثانية عشرة من عمرى}ص24. فبينما السرد يسير بصيغة ضمير الغائب (هو)، يتحول هنا إلى صيغة ضمير المتكلم، حيث وكأن الساردة تحدث نفسها ، أو تسعى لإيجاد المبرر لذلك الشعور المكبوت، وحيث يعتبر حديث الذات أحد عناصر الشعرية أيضا.
شهادة عصر، ونتائج فعله، ومحاولة الخروج من دماره الممتد، وكأنه خروج الضحية من تحت ركام البيت المنهار، والذى ظلوا يبحثون عنه طوال سنوات.. ليفاجا الجميع بأنه.. ما زال حيا. تلك هى الساردة، وتلك هى “فاطمة قنديل” التى صنعت من معاناة شخصية، إلياذة وطنية، أفلحت فى تسميتها “أقفاص فارغة”، خشيت أن يتوقف القارئ عند رؤيتها المحدودة، فكتبت تقول: {اسوأ ما يمكن أن يحدث لى بعد موتى أن يأخذ الآخرون أقوالا مأثورة مما أكتب الآن، أن تصير حياتى قولا مأثورا، هو ما يصيبنى بالغثيان، أن تصير درسا، أو عبرة، هو الجحيم ذاته، أحاول أن أتجنب هذا المصير وأنا أكتب، بلغة عارية تماماـ لا ترتدى ما يستر عورتها من المجازات، لأن الحياة تصير أكثر شبقا بعد أن نموت، كذئب مسعور، لا يروى ظمأه، إلا الحكايا}ص61. وكأنها تخشى أن يقرأ القارئ الرواية على أنها مجرد (سيرة شخصية). ولا زالت الأقفاص فارغة.
فإلى متى ستظل الأقفاص فارغة؟. ذلك { ما لم تكتبه فاطمة قنديل}.
…………………………………
[1] – فاطمة قنديل – أقفاص فارغة- الكتب خان للنشر والتوزيع – 2021. الحاصلة على جائزة نجيب محفوظ بالجامعة الأمريكية 2022.
[2] – تُمثل الإلياذة الرؤية الملحمية الشعرية لحرب طروادة، وهي حربٌ نشبت بين اليونانيين والطرواديين مدة عشر سنوات
[3] – حوار حسن عوض مع الكاتبة – جريدة عمان – 15 سبتمبر 2017.