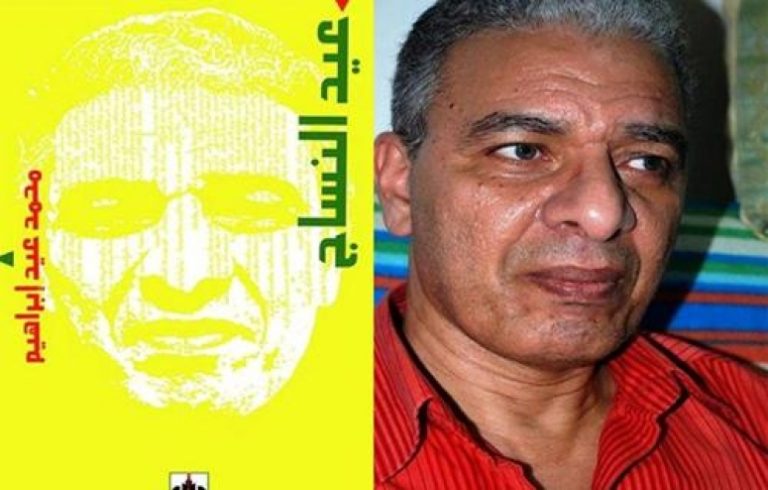د. إلياس زيدان
زَمَنُ القَهْرِ في الكَتاتيب والمدارس والبيوت!
تنوّعت الأدوات و”الأسلحة” والأساليب المُستخدَمة في الكَتاتيب والمدارس لغرض قهر الطّلّاب الذّكور في أرجاء عدّة من الوطن العربيّ، من مشرقه حتّى مغربه. كان “الفلق” من “الأسلحة” الأكثر انتشارًا وفتكًا، واختلفت تسميته بحسب لهجة صاحب السّيرة، فتجد مَن يقول “الفلقة” أو “الفلكة”. يعود عددٌ كبيرٌ من كتّاب السّيرة الذّكور – من مواليد سنوات السّبعين من القرن التّاسع عشر حتّى مواليد سنوات الخمسين من القرن العشرين -، مُصطحبين القرّاء معهم، إلى أيّام الطّفولة، لوصف معاناتهم في الكتاتيب والمدارس، وأحيانًا كثيرة في البيوت أيضًا، خصوصًا من جانب آبائهم. وكانت معاناتهم أشدَّ وطأةً في الحالات التي أقام فيها الكُتّاب، أو المدرسة، “حِلْفًا” مع أسرة الطّالب، وخصوصًا مع أبيه. وحسنًا فعل كتّاب السّيرة بتقديمهم وصفًا مفصَّلًا لبعض تلك “الأسلحة” المُستخدَمة في الكتاتيب والمدارس. قد يدّعي القائمون على تلك الكتاتيب/المدارس، والأهالي معهم، بأنّهم فعلوا ذلك من باب “حبّ الطّفل”، والسّعي إلى “تأديبه”. لكنّ وقعها على الأطفال – كتّاب السّيرة، لاحقًا – كان هدّامًا أيَّ هدّامٍ في حينه، ما ترك في نفوس الكثيرين منهم ذكريات أليمة وأثرًا سلبيًّا مستدامًا. إنّ كثرة الذين كتبوا عن معاناتهم سواء في الكتاتيب أو المدارس، في أقطار عربيّة مختلفة، وفي المناطق الحضريّة منها أو الرّيف أو البادية، على مرّ أكثر من جيلٍ، تُدلِّل على ظاهرة اجتماعيّة-تربويّة اتّسعتْ رقعتها في أرجاء عدّة من الوطن العربيّ، في حينه.
سنستهلّ إطلالتنا هذه بزيارة الطّالب عليّ الطّنطاوي (1909-1999) الّذي عانى الأمرّين في الكتّاب والمدرسة، وبقي أثرهما السّلبيّ مستدامًا لديه حتّى بعد أن أصبح أستاذًا جامعيًّا. إليكم التّفاصيل. يعود بنا الطّنطاوي في “من حديث النفس”، الّذي صدرت طبعته الأولى عام 1959، إلى ذكرياته، حين كان في الخامسة من عمره، فيكتب: “وكرّت بي الذكرى إلى سنة 1914، إلى أول خَطب من خطوب الدهر نزل بي. لا أعني الحرب العامّة فلم تكن الحرب قد أعلنت […] ولكن أعني ما هو أشدّ وأفظع، أشدّ عليّ أنا؛ ذلك هو أول دخولي المدرسة. لقد كان يوماً أسود لا تُمحى من نفسي ذكراه، ولا أزال إلى اليوم – كلما ذكرته – أتصوّر روعه وشدّته. لقد كرّهَ إليّ المدرسة وترك في نفسي من بغضها ذخيرة لا تنفد، ولقد صرت من بعد معلّماً في الابتدائية ومدرّساً في الثانوية، وأستاذاً في الجامعة، وعلّمت الكبار والصغار، والبنين والبنات، وما ذهب من نفسي الضيق بالمدرسة والفرح بالخلاص منها، والأنس بيوم الخميس واستثقال يوم السبت، وما ذهبتُ إلى المدرسة مرّةً إلّا تمنيت أن أجدها مغلقة أو أجد فيها إضراباً يعطل الدروس!”.[1] في مدرسته الأولى – الكُتّاب – تلك “كان على التلاميذ أن يكونوا فيها بُعَيْد مطلع الشمس وأن يبقوا فيها إلى قُبيل الغروب، لا يتحركون ولا يتكلمون ولا يكفّون عن القراءة والتمايل، يحملون أكلهم معهم فيأكلون وهم قاعدون، وإذا عطشوا قاموا إلى البركة فوضعوا أفواههم في مائها الملوَّث وعبّوا […] والمكان مغلق دائماً، لا يُفتح له باب ولا نافذة ولا يُجدَّدُ له هواء، ولا يمضي على الولد فيه يوم لا تصيبه فيه من الشيخ بليَّة: خفقة بالعصا على رأسه من بعيد، أو ضربات على رجليه بالفلق من قريب، أو (مونولوج) كامل من أبدع الهجاء يقرع أذنيه”.[2]
كُرْه الأطفال للكتّاب دفع بعضهم إلى العِصْيان والامتناع عن الوصول إليه بأيّ وسيلة. لكنْ هيهاتَ! يصف الطّنطاوي هذه الحالات كما يلي: “ولقد كان من المناظر المألوفة كل صباح منظر الولد “العَصْيان”، وأهله يجرُّونه والمارة وأولاد الطريق يعاونونهم عليه، وهو يتمسك بكل شيء يجده ويلتبط بالأرض ويتمرغ بالوحل، وبكاؤه يقرّح عينيه وصياحه يجرّح حنجرته، والضربات تنزل على رأسه، يُساق كأنه مجرم عات، يرى نفسه مظلوماً ويرى الناسَ كلهم عليه حتى أبويه… فتصوروا أثر ذلك في نفسه، وعمله في مستقبل حياته!”.[3] لا حاجة في أن تتصوّروا، أيّها الأعزّاء والعزيزات، ذلك الولد، فلدينا شهادة عن الولد “العَصْيان”، القاهريّ إبراهيم المازني (1890-1949)، وقد مرّ بهذه التّجربة قبل سنوات من ولادة الطّالب الدّمشقيّ، عليّ الطّنطاوي. في سيرته “قصة حياة” يروي لنا المازني: “ويصبح الصباح فأُحمل إلى “الكُتَّاب” حملا، وهناك توضع قدماي في “الفلقة” ويهوى عليها “سيدنا” – فقيه الكتاب – “بالجريدة” أو “المِقرعة” أو بكل ذلك إلى مساعده “العريف” وبهذا يبدأ النهار.[4] أمّا “المِقرعة” هذه فقد ورد ذكرها في أكثر من سيرة ذاتيّة “مِصريّة”. ولإلقاء الضوء عليها، سنستعين بالطّالب رءوف عبّاس (1939-2008) الّذي كان يصغر إبراهيم المازني بأربعين سنة، ففي سيرته الذّاتيّة “مشيناها خطى” عرّف “المِقرعة” بأنّها “عبارة عن يد جلدية كيد الكرباج تتفرع منها نحو خمسة سيور جلدية صغيرة”.[5] سنعود إلى “المِقرعة” عند محاولتنا فهم السّرّ من وراء عودة الطّفل توفيق الحكيم (1898-1987) إلى البيت من الكتاتيب الّتي دخلها وقد بال في سراويله، كما ذكرنا في إطلالتنا السّابقة.
وفي عودة إلى عليّ الطّنطاوي، فقد مرّت الأيّام وأصدر عام 1985 “ذكريات”، وفيها يتوجّه إلينا، نحن القرّاء، قائلًا: “قرأتم في بعض ما كتبت قديماً قصة الساعات التي قضيتها في الكتّاب […] كانت تلك الساعات أمرّ مما قرأتم عنها، وكان جرحها في نفسي أعمق، وحسبكم أن تعلموا أنه مر عليها اليوم سبع وستون سنة ولم أنسها […]”.[6] بعد الكتّاب انتقل الطّالب عليّ إلى “المدرسة التجاريّة”، وكانت واسعة الأرجاء ومشرقة، “من روائع فن العمارة والتي يأتي السيّاح للتفرج برؤيتها”.[7] وقد يعتقد البعض بأنّ هذه المدرسة “الفُرجة” ستكون حتمًا مختلفة كلّ الاختلاف عن الكتّاب. للأسف، لم يكن الأمر كذلك. يؤكّد الطّالب عليّ: “هنا كانت المدرسة الأولى التي دخلتها في حياتي، لا تعجلوا عليّ فتغبطوني إن انتقلت من ذلك الكتاب المعتم إلى هذه المدرسة المشرقة، ومن ضيقه إلى سعتها، فقد يعيش المرء سعيداً في الكوخ وقد يشقى في القصر. أما أنا فقد استهللت دراستي شقياً في الكتاب، وشقياً في المدرسة، هذه المدرسة الكبيرة […] ولقد رأيت أول عهدي بها ما كره إليّ العلم وأهله”.[8] ثمّ يضيف: “وكلوا بنا معلمًا شيخاً كبيراً لا أسميه. فقد ذهب إلى رحمة الله، فكان يحبسنا فيها ونحن أطفال، لا يدعنا نخرج منها حتى نكتب (ألف باء) كلها في ألواحنا الحجرية أربعاً وعشرين مرة، نكتبها ليراها ويمحوها، ثم نكتبها ليراها ويمحوها…”.[9] وفي أحد الأيّام كان الطّالب عليّ في غرفة الفرّاشين يأكل رغيفًا وسطه لحم مشويّ أمر له به والده، “وكان في غرفة الإدارة ولد رجلاه في الفلق والخيزران ينزل عليهما، فدعا بي وأخذت من وسط طعامي، وربطت بالفلق، وكانت علقة أقسم بالله أني لم أعرف سببها إلى الآن، وقد مضى على ذلك أكثر من سبعين سنة!!”.[10] وفي الإشارة إلى “الفلق”، يستطرد الطّنطاوي بأنّ المسنّين كانوا “يقولون (الفلكة) أو (الفلقة)، مع أن الاسم عربي فصيح وهو (الفلق)”.[11] ويشدّد الطّنطاوي بخصوص المدرسة التجاريّة: “لبثت حيناً من دهري أرتجف من النظر إليها، أو التفكّر فيها”.[12] ويخلص إلى نتيجة مفادها: “هذه هي المدرسة التي كانت أيامنا”، و”هكذا كان أسلوب التعليم!!”.[13] ينوّه الطّالب عليّ بأنّه “كان المدير العام لهذه المدرسة (المدرسة التجارية) هو أبي الشيخ مصطفى بن أحمد بن علي بن مصطفى الطنطاوي […] فهل تحسبون أني كنت مدللًا مكرماً لأني ابن المدير لا والله، ولقد رأيت أول عهدي بها ما كره إليّ العلم وأهله […]”.[14]
في نهاية إطلالتنا السّابقة أشرنا إلى أنّ توفيق الحكيم (1898-1987) بقي يحمل ذكريات مُرّة من أيّام الكتاتيب التي التحق بها في سنّ مبكّرة جدًّا، وكم من كُتّاب دخله بسبب طبيعة عمل والده في سلك القضاء، إذ قال: “في تلك المرحلة كنت أذهب إلى الكتاتيب في كل بلدة نحل بها … ولا بد أنهم أرسلوني إليها منذ سن مبكرة جداً… لأني أذكر صوراً غامضة عن حاجتي الملحة الضاغطة إلى التبول والمرحاض ولكن خشيتي من المقرعة الجريد المرفوعة في يد شيخ يحفظنا القرآن كانت تفزعني وتلجم لساني عن الإفصاح بحاجتي، فكنت أكتم ما بي وأعود إلى البيت كل يوم وقد فعلتها في سراويلي!”.[15]
على ذكر التّبوّل يذكر الطّالب محمّد كرد عليّ (1876-1953)، في “المذكرات”، أنّ أهله أدخلوه إلى المدرسة الابتدائيّة في دمشق وهو في الخامسة من عمره، برعاية ابن عمّه الذي كان دون العاشرة، وكان صوت ابن عمّه هذا جميلًا. يذكر الطّفل محمّد حادثة متعلّقة بخوف الطّالب من المعلّم كان فيها ابن عمّه هذا “[…] في سدة الجامع مع بعض الأولاد يؤذّن بصوت رخيم، وصوته كان جميلاً، فدخل المعلم فارتعش الفتى وبال على ثيابه، فقطرت على رؤوس بعض المصلين تحت السدة من الأولاد قطرات، فكانت قصةً ضحك لها كل من في المدرسة”.[16]
في بيت لحم يذكر الطالب جبرا إبراهيم جبرا (1919-1994)، في سيرته الذّاتيّة “البئرُ الأولى”، أنّه في نهاية الدّروس في أحد الأيّام كان “محصور جدا”، فرفع أصبعه وطلب من المعلّم الخروج، وكذلك فعل جاره الطّالب سليم الذي رفع أصبعه وقال: “معلمي، معلمي، لازم اطلع برّا!”، وعندها نهره المعلّم آمرًا إيّاه بأن ينتظر قليلًا، فالكل سيخرج بعد تلاوة الصّلاة. في تلك اللحظات صاح المعلّم “قيام!”، ويكتب جبرا: “فوقفنا جميعاً، وأنا أراوح على قدميّ، ضابطاً مثانتي بأقصى جهدي، ولاحظت أن جاري لا تقلّ حاله كرباً عنّي. وأردف المعلم: “صلاة!”. وأخذنا نصلّي: “السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك […] ولم نكد ننتهي من التلاوة حتى رأينا سيلاً حييّاً يترقرق من تحت المقاعد في اتجاه المعلم. “سواها” سليم. لم يستطع ضبط نفسه. وانفجر الصبية ضاحكين: “شخّ تحته سليم! شخّ تحته!”.[17] في هذه اللحظات صرخ المعلّم بالطّلّاب “اخرجوا يا قليلي الأدب!”. ويؤكّد جبرا: “ولو تأخرنا دقيقة أخرى، لشاركت جاري في جريمته. انطلقتُ كالرصاصة في اتجاه الحاكورة الخلفية، وأفرغت مثانتي تحت التينة الكبيرة، والصبية ما زالوا يتصايحون، وعندما عدت إليهم كان سليم يبكي، وقد تبلّل بنطلونه القصير وساقاه بشكل فاضح”.[18]
انتبهوا أيّها الأعزّاء والعزيزات إلى أنّ “بال” و”شخّ” تفيدان المعنى نفسه، فقد تختلف التّسميات بين مكانٍ وآخر، لكنّ المعنى واحد. وفي هذا الشأن، ففي القدس – جارة بيت لحم – تعلّم الطّالب واصف جوهريّة (1897-1973) وأخوه توفيق في مدرسة الألمان المعروفة بمدرسة الدباغة. يكتب واصف جوهريّة في مذكّراته “القدس العثمانية في المذكرات الجوهرية” ساردًا قصّته مع “الشّخ”: “كنا نكره المعلم بشارة وكذلك كان مكروها من كل التلاميذ نظرا لقسوته وبطشه وضربه القاسي للأولاد وبدون سبب معقول […]”.[19] وكان الأخوان جوهريّة يشكوان أمر قساوة المعلّم بشارة للأسرة ولأخيهما الأكبر خليل. في أحد الأيّام كان المعلّم بشارة يسير في الشّارع، وكان الإخوة الثّلاثة معًا، فسخر الأخ الأكبر خليل من المعلّم بشارة انتقامًا لأخويه. ويضيف واصف واصفًا المشهد: “عندما لاحظنا بأن المعلم بشارة شاهدنا قلنا واأسفاه علينا!! ماذا يحدث لنا غدا معه يا الله!! ما هذا يا خليل؟”.[20] في اليوم التّالي طرق المعلّم بشارة باب غرفة صفّ الأخوين جوهريّة بقوّة، فقال واصف في نفسه “الله يستر!!”. لكنْ هيهاتَ، من أين يأتي السّتر! يصف واصف حالة الأستاذ وسلوكه كما يلي: “وقف والشرار يقدح من عينيه وصاح مؤشرا إلي بإصبع يده الأيمن “جوهرية صغير”. حضرت فوقفت أمامه فما كان منه إلا أن صفعني صفعة على وجهي كدت أن أرى نجوم الظهر كما يقولون ومن قوة الضربة رماني إلى الأرغن ثم رجع جسمي من الأرغن إلى البنك [أي المقعد] الأول من التلاميذ وسقطت على الأرض فشخيت تحتي وأنا ماسك رأسي بيدي وأصيح بأعلى صوتي يا يابا يا يابا […]”.[21]
لم تكن حال الطّلّاب في الجهة الغربيّة من الوطن العربيّ أفضل من حالهم في جهاته الأخرى، وقد يكون الاختلاف الجوهريّ في تسمية “الكتّاب”، فيكتب أبي الفتوح عبد الله التليدي (1926-2017)، الذي وُلِد في قرية الصاف من قبيلة بني كرفط المغربيّة، ما يلي: “لما بلغ عبدُ ربِّه نحواً من خمس سنين أو قبلها أدخله أبوه الكُتَّاب المسمَّى عندهم في البادية: الجامع والمعمرة، وفي المدن: المسيد”.[22] ويوضّح التليدي: “المعمرة: بفتح الميمين، والراء وسكون العين، والمسيد: بكسر الميم، والسين ثم ياء ساكنة، وآخره دال”.[23] يشدّد على أنّه “ولعدم اعتناء المعلمين حفظة القرآن بالأطفال الصغار بقي مهملاً لم يتعلَّم شيئاً مدة”.[24] وفي وصفه لطريقة التّعليم يكتب: “ثم جاء دور تعليمه على الطريقة القديمة العقيمة الجوفاء… فقاسى شدائد في تعلُّم الكتابة، فكم لُطم وجهه، وكم جُذبت أذناه، وكم ضربت رجلاه مدًّا أو حملاً، وكم وكم، ممَّا حمله على الفرار من القراءة المرة بعد المرة، وهو في ذلك يعاني من أنواع الضرب تناوباً بين المعلم وبين الوالدين، وخاصة عندما جعل يستظهر بعض السور، واستكثرت عليه، وصعب أمرها عليه، فكان عند عرضها على المعلم ربما توقف في كلمة، فينهال عليه بالضرب المبرح الذي لا يطيقه الكبار، فكيف بالطفل ابن ست أو سبع سنين، وربما تكرر ذلك في العرضة الواحدة بعد العصر أو بين العشاءين مرات متعددة”.[25]
ولد محمّد عابد الجابري (2010-1935) في فجيج في المغرب، بعد تسع سنوات من ولادة الطّالب عبد الله. يؤكّد الجابري في “حفريات في الذاكرة من بعيد” أنّه تعلّم في “المسيد” على يدي “الفقيه”. “كان “الفقيه” يفترش “هيضورة” (سجادة من جلد الخروف وصوفه…). وبجانب الفقيه ثلاث عصي، صغرى للأطفال الصغار القريبين منه، ووسطى للذين يجلسون في الوسط، وطويلة لمن هم في الأطراف، وكانوا في الغالب من كبار السن”. [26] ويضيف: “كانت الكتابة تتم في الصباح غالباً. أما بقية النهار فتخصص للحفظ: كل طفل يكرر جهاراً الآيات المكتوبة على لوحته، وفي الغالب يميل بجسمه إلى الأمام وإلى خلف، أو يميناً وشمالاً، والفقيه ينصت للجميع يصحح الخطأ ويراقب النطق ويشهر بعصاه القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة، حسب الحالة، على الأطفال الذين يلهون ويلعبون أو يتثاءبون وينامون. كانت العصا تأتي إلى الطفل لتقع على رأسه على حين غرة، وإن هو سبقها ومال أدركته على كتفه أو يده، وفي جميع الأحوال فقليلاً ما تخطئه، وإذا أخطأته كانت من نصيب جاره”.[27]
لم تقف الأمور عند هذا الحدّ، إذ يؤكّد الجابري: “أما إذا ارتكب طفل ما مخالفة تستوجب العقاب أو جاء به أبوه يشكوه إلى الفقيه فإن “الفلقة” عقابه: يحمله طفلان من ذوي البنية الصحيحة على أيديهم ويمسك ثالث برجليه موجهاً بطن قدميه نحو العصا التي تنهال عليهما من الفقيه نفسه أو ممن ينيبه عنه من “الكبار”، والطفل المعاقب يصيح ويتدافع، ولا ترفع عنه العصا إلا عندما يقدر الفقيه أنه استوعب “الدرس” فيأمر بإنزاله على الأرض، فيمكث الطفل جالساً يتلوّى لا يقوى على الوقوف ولا على المشي يضع لوحته في حجره ويتظاهر بالحفظ”.[28]
أمّا في لبنان، فيأخذنا مارون عبّود (1886-1962)، في “أحاديث القرية”، إلى أحد أيّام طفولته الذي سمع فيه أباه يقول لأمّه: “دبرنا له مدرسة”، أي لمارون. وفي هذه اللحظات دقّ قلب مارون “دقات عنيفة”. ثمّ يشدّد قائلًا: “ودخلت المدرسة مع من دخلوا فكانت الفاتحة أن أكلت قضيبين سخنين على سفح ظهري، فأرخيت العنان لرجلي […]”.[29] وإلى أين يلجأ هذا الطّالب المضروب في يومه الدّراسيّ الأوّل ولمن يشكو أمره؟! طبعا إلى البيت والوالدين. لكن سارت الرّياح بما لا تشتهي سفن الطّالب مارون، فيكتب: “فاستقبلني والدي العملاق بأحد قضبانه. كان غفر الله يعمل بنصيحة […] إذا أحببت ولدك فهيئ له القضبان حزمًا حزمًا”.[30] لم يكتفِ “الأب” بهذا العقاب، فيضيف عبّود: “ثم قادني بأذني كالعنزة الشاردة، وهناك على أعين التلاميذ قال الكلمة المأثورة للمعلم: اللحم لك والجلد والعظم لي. ثم التفت بي وقال: فهمت يا كلب. ومنذ ذلك الحين صرت أطوع من الخاتم في الخنصر، وأنعم من المخمل”.[31] في أحد الأيام كان الطّفل مارون يسير مع والده، فمرّا بزمّارين معهم دبّ، يُغنّون له فيرقص على وقع الدّفّ والقصب. تعجّب مارون من “طواعية هذا الدب واستوائه كالبشر […] ينام ويقوم كما يكلفه صاحبه. حتى إنه يدخن بالغليون”.[32] كان لدى الطّفل مارون حبّ استطلاع، فسأل والده كيف تعلّم الدّبّ كلّ ما رآه. في تلك اللحظة ضحك الوالد “وقال لي المثل المعروف: العصا تعلم الدب الرقص”.[33] ويستخلص الطّفل مارون العبرة: “ففهمت تعريضه بي وقلت في نفسي: إذا كانت كقضبانك تعلم أكثر من دب”.[34] ويجمل قائلًا: “وفي تلك المدارس كانت تسوسنا العصا أستاذة الدب. أما عقاب الجرائم الكبرى فكان (الفلق) ليتك تذوق طعمه”. ويسهّل مارون الأمر على القرّاء الذين لم يروا أو يذوقوا طعم الفلق من خلال التّعريف التّالي: “الفلق خشبة تكمش الساقين كالعض، لتعرض القدمين إلى قضيب المعلم فينصبّ بلا شفقة”.[35]
من لبنان ننتقل عبر شبابيك مصر لزيارة طالب جايل مارون عبّود، وهو الطّالب أحمد أمين (1886-1954). في “حياتي” يذكر أحمد أمين ثلاث مدارس في طفولته الأولى: مدرسة البيت، ومدرسة الحارة، ومدرسة الكتّاب. كانت “مدرسة البيت” هذه على العكس من “مدرسة البيت الطّوقانيّة”، المذكورة في إطلالتنا الثّانية، تلك المدرسة الّتي أحبّتها فدوى طوقان، لأنّها تعلّمت وتثقّفت عن طيب خاطر على يدي أخيها إبراهيم طوقان. يصف أحمد أمين مدرسته هذه كما يلي: “وكان بيتنا محكومًا بالسلطة الأبوية، فالأب وحده مالك زمام أموره، لا تخرج الأم إلا بإذنه، ولا يغيب الأولاد عن البيت بعد الغروب خوًفا من ضربه […] يشعر شعورًا قويًا بواجبه نحو تعليم أولاده، فهو يعلمهم بنفسه ويشرف على تعليمهم في مدارسهم، سواء في ذلك أبناؤه وبناته، ويتعب في ذلك نفسه تعبًا لا حد له، حتى لقد يكون مريضًا فلا يأبه بمرضه […] أما إيناسنا وإدخال السرور والبهجة علينا وحديثه اللطيف معنا فلا يلتفت إليه. ولا يرى أنه واجب عليه. يرحمنا ولكنه يخفي رحمته ويظهر قسوته؛ وتتجلى هذه الرحمة في المرض يصيب أحدنا، وفي الغيبة إذا عرضت لأحد منا، يعيش في شبه عزلة في دوره العالي، يأكل وحده ويتعبد وحده، وقلما يلقانا إلا ليقرئنا. أما أحاديثنا وفكاهتنا ولعبنا فمع أمنا”.[36]
وفي معرض حديثه عن مدرسة الكتّاب، يصف الطّالب أحمد معلّمهم الشّيخ كما يلي: “[…] قد لبس العمامة وقباء من غير جبة وبيده عصا طويلة، ومسمار كبير في الحائط علقت فيه “الفلقة” […]”.[37] وكما فعل الطّالب مارون عبّود، يحرص الطّالب أحمد أمين على تعريف “الفلقة” لمن لا يعرفها أو لم يذقها: “وهي عصا غليظة تزيد قليلا عن المتر، ثقب فيها ثقبان ثبت فيهما حبل، فإذا أراد سيدنا ضرب ولد أدخلت رجلاه في هذا الحبل ولويت عليهما الخشبة، فلا تستطيع القدمان حركة، ونزل عليهما سيدنا بالعصا”. إضافة إلى الفلقة، كان لدى الشّيخ “عود من الجريد طويل يستطيع سيدنا أن يضرب به أقصى ولد في الحجرة […]”. ويضيف أحمد: “وكان لسيدنا عريف […] يساعده في مد رجل الطفل في الفلقة”.[38] أمّا بخصوص القراءة، فيروي: “وإذا قرأنا وجب أن نهتز وأن نصيح، فمن لم يهتز أو لم يصح لم يشعر إلا والعصا تنزل عليه فيصرخ ويصيح بالقراءة والبكاء معاً، ونبقى على هذه الحال إلى قرب العصر فنخرج إلى بيوتنا؛ ومن حين لآخر يمر أبو الطفل على سيدنا فيسأله عن ابنه ويطلب منه أن “ينفض له الفروة”، وهذا اصطلاح بين الآباء وفقهاء الكتاب أن يشتدوا على الطفل ويضربوه”.[39] ويؤكّد أمين: “فلا تعجب بعد ذلك إذا وجدت أرواحاً ميتة ونفوساً كسيرة. ومن أجل هذا كان أكره شيء علينا الكتاب واسم الكتاب وسيدنا؛ بل أذكر مرة أني كنت في البيت آكل مع أمي وإخوتي، فما أشعر إلا وقد انتفضت من غير وعي، لتوهمي أن عصا سيدنا نزلت علي لأني لم أهتز، وكان أكره ما أكره يوم السبت صباحاً عند الذهاب إلى الكتاب، وأحب ما أحب يوم الخميس ظهراً لأنه سيلحقه يوم الجمعة وفيه لا كتاب”.[40]
بعد الكتاتيب أدخله أبوه مدرسة “أم عباس” الابتدائيّة، “وناظر المدرسة رجل طيب […] ضبط مرة تلميذًا يسرق كراساً فأخذه وعلق في رقبته لوحة من الورق المقوى، كتب عليها بخط الثلث الكبير “هذا لص” حتى إذا وقف الطلبة في طابور العصر أمسكه الناظر بيده، ومر به على التلاميذ ليؤدبه والحق أنه لم يؤدبه ولكن قتله، فلم أر هذا التلميذ يعود إلى المدرسة بعد. وأغلب الظن أنه انقطع عن المدارس بتاتًا”.[41] ويستخلص أمين: “وهكذا كانت المدرسة بتلاميذها ومدرسيها وناظرها تمثل رواية مملوءة بالحياة والحركة والمناظر تكون أحيانا مأساة، وأحيانا ملهاة”.[42]
وعلى ذكر مدرسة البيت، كانت مدرسة بيت الطّالب حنّا أبو حنّا (1928-2022) أشدّ قساوةً من مدرسة الطّالب أحمد أمين، لكن لحسن حظّ حنّا فقد كانت هذه المدرسة مؤقّتة. وكما كانت حال توفيق الحكيم الّذي تنقّل كثيرًا في طفولته، فقد تنقّل حنّا أبو حنّا وأسرته من بلدة إلى أخرى بحكم ظروف عمل والده أيضًا. في سيرته الذّاتيّة “ظلّ الغيمة”، التي أطلق على نفسه فيها اسم “يحيى”، الاسم العربيّ لحنّا، يصف طفولته كما يلي: “مثل غيمة تنقّلت طفولة يحيى في سماء بلده […] كان أبوه موظفا في دائرة “مساحة فلسطين” […] والعائلة تنتقل مع الوالد من بلد إلى آخر ومن قرية إلى أخرى”.[43] في إحدى تنقّلاتها مع الوالد، انتقلت الأسرة من “أسدود”، الواقعة بين يافا وغزّة حيث تعلّم يحيى في كُتّابها، إلى قرية “نجد”، القريبة من “أسدود” حيث لا مدرسة فيها ولا كتّاب، “فقد جاءه أبوه بكتاب للقراءة فأخذ يعلّمه فيه بعد الظّهر، بعد أن يعود من عمله، ويعيّن له فرضاً لليوم التالي. الأب العائد من العمل المرهِق […] لم يكن دائماً ذا مزاج رائق للتعليم. كان يثور لأقل غلطة أو تلعثم: “لا.. لا يمسكون القلم هكذا […] الدال غير الرّاء.. لماذا ترتعد يدك…؟”.[44] يؤكّد يحيى بخصوص والده: ” كان الوالد يؤمن بالتخشين: عبر الصعوبات يُربَّى الرجال […] يؤمن بالعصا كوسيلة للتربية وتقويم السلوك […] وكان الضرب شديداً يترك آثاره الزرقاء على مختلف أنحاء البدن”.[45] انتقال الأسرة من نجد إلى حيفا أنقذ يحيى ابن السّابعة من مدرسة البيت. لكن، دخل يحيى الصّف الثّاني في المدرسة الرسميّة للبنين، حيث يصطفّ التلاميذ في الصّباح في صفوف يضبط كلًّا منها مربّي الصفّ المختصّ. يصف يحيى مربّي صفّه: “كان مربي الصف الثاني نحيفاً جداً […] نظرته حادّة كالنّورس […]”.[46] بعد أن يضمن استقامة الوقوف يبدأ بفحص الأولاد واحدًا واحدًا؛ الحذاء والملابس الموحّدة والمنديل النّظيف المطويّ بترتيب والأظافر المقلّمة، “وإلا فالمسطرة تعرف سبيلها. ثم يلتفت إلى الشّعر، فإذا شك في مدى قصره أمسك الولد من سالفيه ثم رفعه منهما عن الأرض ليقنع الألم الولد أن شعره بحاجة إلى حلاقة”.[47] بعد ذلك انتقلتْ أسرة الطّالب يحيى من حيفا إلى النّاصرة. يصف يحيى بداية عهده في مدرسة المعارف الابتدائيّة للبنين: “الغربة باردة كالثلج، والاستغراب شديد. وكانت الصدمة الكبرى في درس الحساب […] ومعلم الحساب ثقيل اليد يؤمن أن العصا من الجنّة، وأنها – وهو رجل مؤمن – الوسيلة التي خلقها الله لفتح الأدمغة للفهم وتقويم السلوك”.[48]
هل عُومِل جميع طلّاب الكتاتيب والمدارس بالقسوة ذاتها؟ وهل عامل المعلّمون والآباء جميعُهم الطّلّاب بهذه القسوة المذكورة في إطلالتنا الحاليّة؟ وهل أذعن الطّلّاب لهذا القهر أم تمرّدوا عليه؟ وماذا بشأن الكتاتيب والمدارس التي شَغَلت النّساء فيها مناصب إداريّة وتعليميّة؟ وهل عاملت هؤلاء النّساء الطّلّاب كما عاملهم الرّجال؟
يسعدني أن ترافقوني في الإطلالات القادمة في محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة.
ألقاكم/نّ بخير.
…………………………………..
[1] . الطّنطاوي، علي. (2011). من حديث النفس. الطبعة الثامنة. جدة: دار المنارة للنشر والتوزيع. ص 47.
[2] . المصدر السّابق. ص 49.
[3] . المصدر السّابق. ص 49.
[4] . المازني، إبراهيم. (2010). قصة حياة. وندسور: مؤسسة هنداوي. ص 18.
[5] . عباس، رءوف.(2008). مشيناها خطى: سيرة ذاتية. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. ص 38.
[6] . الطّنطاوي، علي. (1985). ذكريات (1). الطبعة الأولى. جدّة: دار المنارة للنشر. ص 14-15.
[7] . المصدر السّابق. ص 30.
[8] . المصدر السّابق. ص 29-30.
[9] . المصدر السّابق. ص 31.
[10] . المصدر السّابق. ص 32.
[11] . المصدر السّابق. ص 32.
[12] . المصدر السّابق. ص 30.
[13] . المصدر السّابق. ص 32.
[14] . المصدر السّابق. ص 30.
[15] . الحكيم، توفيق. (1964). سِجن العُمر. القاهرة: مكتبة الآداب. ص 80.
[16] . كرد علي، محمّد. (1948). المذكرات. مطبعة الترقي بدمشق. ص 11.
[17] . جبرا، جبرا إبراهيم. (2001). البئرُ الأولى: فصول من سيرة ذاتيّة. الطّبعة الثانية. بيروت: المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر. ص 37.
[18] . المصدر السّابق. ص 37.
[19] . جوهريّة، واصف. (2003). القدس العثمانية في المذكرات الجوهرية: الكتاب الأول من مذكرات الموسيقي واصف جوهرية 1904-1917. ص 21.
[20] . المصدر السّابق. ص 21.
[21] . المصدر السّابق. ص 21.
[22] . التّليدي، أبي الفتوح عبد الله. ذكريات من حياتي. الطّبعة الأولى. دمشق: دار القلم. ص 27.
[23] . المصدر السّابق. ص 27.
[24] . المصدر السّابق. ص 27.
[25] . المصدر السّابق. ص 27.
[26] . الجابري، محمد عابد. (1997). حفريات في الذاكرة من بعيد. الطبعة الأولى. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ص 46.
[27] . المصدر السّابق. ص 47.
[28] . المصدر السّابق. ص 48.
[29] . عبود، مارون. (2013). أحاديث القرية: أقاصيص وذكريات. القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. ص 149.
[30] . المصدر السّابق. ص 149.
[31] . المصدر السّابق. ص 149.
[32] . المصدر السّابق. ص 149.
[33] . المصدر السّابق. ص 150.
[34] . المصدر السّابق. ص 150.
[35] . المصدر السّابق. ص 150.
[36] . أمين، أحمد. (2011). حياتي. القاهرة: كلمات عربية للترجمة والنشر. ص 20.
[37] . المصدر السّابق. ص 41.
[38] . المصدر السّابق. ص 41.
[39] . المصدر السّابق. ص 42.
[40] . المصدر السّابق. ص 42.
[41] . المصدر السّابق. ص 48.
[42] . المصدر السّابق. ص 49.
[43] . أبو حنّا، حنّا. (2001). ظلّ الغيمة: سيرة. الطبعة الأولى. بيروت: المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر. ص 18.
[44] . المصدر السّابق. ص 47.
[45] . المصدر السّابق. ص 99.
[46] . المصدر السّابق. ص 55-56.
[47] . المصدر السّابق. ص 56.
[48] . المصدر السّابق. ص 60-61.