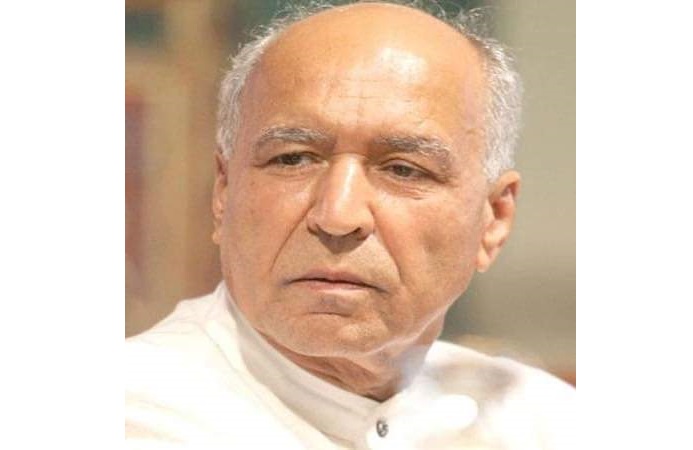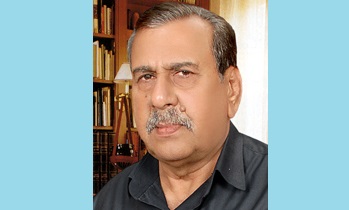د. إلياس زيدان
إطلالات تربويّة من شبابيك الوطن – 5
عميد الأدب العربيّ اتّهمها بإفساد التّعليم والأخلاق!
سنطلّ اليوم على ثلاثة من أدبائنا الغنيّين عن التّعريف: د. طه حسين (1889-1973) والأستاذ عبّاس محمود العقّاد (1889-1964) والأستاذ توفيق الحكيم (1898-1987). في سِيَرِهِم الذّاتيّة عاد بنا ثلاثتُهم إلى عالم الطّفولة والشّباب، وكانت أيّامهم زاخرة بالأحداث الّتي انطبعت في أذهانهم على مرّ السّنين. وصفوا في سِيَرِهم الذّاتيّة تجاربَ ومواقفَ قاسية تتعلّق بمشكلة واجهوها في طفولتهم كطلّاب في الكُتّاب و/أو المدرسة و/أو البيت. لسوء حظّ توفيق الحكيم فقد رافقته هذه القساوة في مراحل حياته التّعليميّة كلّها، بما في ذلك مرحلة الدّراسة لنيل شهادة الدّكتوراة في باريس. أمّا طه حسين، فبعدما كبر وأصبح رجل تربية، وجّه إلى هذه الظّاهرة انتقادات لاذعة، وكتب في مؤلّفه “مستقبل الثّقافة في مصر” الصّادر سنة 1938 ما يلي: “وهناك مشكلة عسيرة إلى أبعد حدود العسر، سخيفة إلى أقصى غايات السخف، يتأثر بها تعليمنا كله على اختلاف أنواعه وألوانه أشد التأثر، فيفسد بها أعظم الفساد، وهي لا تفسد التعليم وحده ولكنها تفسد معه الأخلاق […] وأظنك قد عرفت هذه المشكلة، ولم تحتج إلى أن أسميها لك […]”.[1]
في سيرته الذّاتيّة “أنا” يكشف لنا عبّاس محمود العقّاد هذه المشكلة، من خلال سرده حادثة وقعت له وهو طالب في المدرسة الابتدائيّة وشكّلت بالنسبة إليه “[…] الدرس الأكبر — الدرس الذي أحسبه أكبر ما استفدته من جميع الدروس في صباي”. كان الطّالب عبّاس شديد الولع بحلّ المسائل الحسابيّة، وهو يؤكّد في هذا السّياق: “لا أدع مسألة منها بغير حل مهما بلغ إعضالها”.[2] وكان أستاذه في مادّة الحساب يصطحب دفترًا فيه مسائل حسابيّة محلولة، وكان يعيدها على التّلاميذ كلّ سنة، وقلّما يزيد عليها شيئًا. ولسوء حظّ هذا الأستاذ، فقد عُرضِت في إحدى الحصص مسألة لم يشملها دفتره، وعجز التّلاميذ عن حلّها، وحاول الأستاذ حلّها، لكنّ محاولاته باءت بالفشل، ولكي يتملّص من هذه المحنة قال لتلاميذه: “إنما عرضتها عليكم امتحانًا لكم؛ لتعرفوا الفرق بين مسائل الحساب ومسائل الجبر، وهذه من مسائل الجبر؛ لأنها تشتمل على مجهولين!”.[3] لم يقتنع الطّالب عبّاس بهذا الكلام، وأكّد: “لم أُصدِّق صاحبنا، ولم أكفَّ عن المحاولة في بيتي، وقضيت ليلة ليلاء حتى الفجر وأنا أقوم وأقعد عند اللوحة السوداء حتى امتلأت من الجانبين بالأرقام … وجاء الفرج قبل مطلع النهار، فإذا بالمسألة محلولة […] فأحفظ سلسلة النتائج وأعيدها لأستطيع بيانها في المدرسة دون ارتباك أو نسيان”.[4] وفي اليوم التّالي أبلغ الطّالب عبّاس أستاذه بأنّه حلّ المسألة، فقال له الأستاذ مستخفًّا مُستهزئًا: “أوصحيح؟! … تفضَّل أرِنا همَّتَك يا شاطر”.[5] بدأ عبّاس بحلّ المسألة على اللوح، ورغم محاولات الأستاذ إفشاله ومقاطعته مرارًا إلّا أنّ “سلسلة النتائج كانت قد انطبعت في ذهني لشدة ما شغلتني، وطول ما راجعتها وكررت مراجعتها”.[6] بعد إتمام الحلّ انتظر عبّاس ما سيقوله الأستاذ، ولربّما انتظر الإطراء والتّقدير منه. لكن هيهات! فلسوء طالع هذا الطّالب النّجيب سارت الأمور عكس ما توقّع، وهو يكتب عن ذلك الموقف: “فإذا بالأستاذ ينظر إليَّ شزرًا وهو يقول: “لقد أضعتَ وقتَك على غير طائل؛ لأنها مسألة لن تعرض لكم في امتحان!”.[7] وكيف كان ردّ فعل سائر طلّاب الصّفّ؟ يؤكّد عبّاس في هذا السّياق: “وإذا بالزملاء يعقبون على نغمة الأستاذ قائلين: “ضيَّعت وقتنا … ما الفائدة من كل هذا العناء؟!”.[8]
إذًا، المشكلة الّتي أشار إليها طه حسين هي “الامتحان”. كان من شأن سلوك المعلّم وطلّاب صفّ عبّاس على هذا النحو أن يشكّل صدمة ذات أبعاد سلبيّة وخيمة على أيّ طالب، لكن ليس على الطّالب عبّاس الّذي يتّسم بعصاميّة قويّة، وهو يُجْزِم: “كانت هذه صدمة خليقة أن تكسرني كسرًا، لو أن اجتهادي كان محل شك عندي أو عند الأستاذ أو عند الزملاء، أما وهو حقيقة لا شك فيها، فإن الصدمة لم تكسرني بل نفعتني أكبر نفع حمدته في حياتي، […] ولم أحفل بعدها بإنكار زميل أو رئيس”.[9]
لغرض التّعمّق في فهم ما حدث للطّالب عبّاس مع أستاذه وزملائه، إليكم/نّ ما كتبه طه حسين في هذا السّياق: “الأصل في الامتحان أنه وسيلة لا غاية […] ولكن أخلاقنا التعليمية جرت على ما يناقض هذا أشد المناقضة، ففهمنا الامتحان على أنه غاية لا وسيلة، وأجرينا أمور التعليم كلها على هذا الفهم الخاطئ السخيف، وأذعنا ذلك في نفوس الصبية والشباب، وفي نفوس الأسر، حتى أصبح ذلك جزءاً من عقليتنا، وأصلاً من أصول تصورنا للأشياء وحكمنا عليها. فالأسرة حين ترسل ابنها إلى المدرسة تفكر في تعليمه من غير شك، ولكنها لا تفهم هذا التعليم إلا مقرونا بالامتحان الذي يدل على انتفاع الصبي به ونجاحه فيه. وهي من أجل ذلك تعيش معلَّقة بآخر العام، وبهذه الورقة التي ستأتيها من المدرسة أو من الوزارة لتنبئها بأن الصبي أو الفتى قد جاز الامتحان فنجح أو أخفق فيه”. لا يقف الأمر عند هذا الحدّ، إذ يضيف طه حسين: “ولا يكاد الصبي يبلغ المدرسة ويستقر فيها أياماً حتى يشعر بأن أمامه غاية يجب أن يبلغها؛ وهي أن يؤدي الامتحان وينجح فيه. يشعر بهذا في المدرسة من معلمه ومن أترابه، ويشعر بهذا في البيت من أبويه […].[10] ويخلص طه حسين إلى الاستنتاجات التّالية:
- “وإذن فالصبي منذ يدخل المدرسة موجّه إلى الامتحان أكثر مما هو موجّه إلى العلم، مهيأ للامتحان أكثر مما هو مهيأ للحياة وإذن فليس المهم عند الصبي أن ينتفع بالدّرس، وأن يجد فيه اللذة والمتعة، وأن يستزيد منهما وإنما المهم أن يستعد للامتحان وللنجاح فيه ليتفوق على أترابه أو ليحتفظ بمكانته بينهم، وليرضي أبويه ويسرهما ويحقق ما يعقدان به من أمل، وينوطان من رجاء، وليظفر بما يمنيانه من مكافأة وجزاء”.[11]
- “وإذن فقد استحالت المدرسة إلى مصنع بغيض يهيئ التلاميذ للامتحان ليس غير”.[12]
- “فما دام الامتحان غاية فالنجاح فيه غاية الغايات، إذن فموسم الامتحانات هو من أهم المواسم الوطنية أثراً في حياتنا وتغلغلا في أعماق هذه الحياة”.[13]
بخصوص أهمّيّة “تفوّق الطّالب على أترابه”، يعيدنا عبّاس محمود العقّاد إلى حادثة أخرى كان هذه المرّة شاهدًا عليها كطالب في المدرسة، فيصف “حادث شجار عنيف بين تلميذين على قلمين من أقلام الكتابة العربية، يدعي كلاهما أن أحد القلمين قلمه، ويرد الآخر إلى صاحبه”. ويطرح العقّاد في هذا السّياق سؤالًا استنكاريًّا: “أكان النزاع على القلم المطلوب من أجل قيمته الغالية؟”. ويجيب: “كلا … فإن قيمة القلمين معًا لم تكن تزيد على ثلاثة مليمات أو أربعة؛ لأنهما من أقلام البوص التي كانت توجد يومئذ في جميع الأسواق”. إذًا، ما السّبب الحقيقيّ لهذا العنف؟ يؤكّد العقّاد: “فلم يكن النزاع بين الزميلين لغلو الثمن، وإنما كان لنفاسة أخرى غير نفاسة المال، وهي أن القلم الذي تنازعا عليه كان من الأقلام التي براها الأستاذ وقطها بيديه، فهو صالح لتجويد الخط، وضمان بعض الدرجات في الامتحان!”.[14]
تشكّل تجربة طه حسين في الكُتّاب حالة فريدة من نوعها في العلاقة بين الامتحان وإفساد الأخلاق؛ أخلاق المعلّم الشّيخ وكانوا يلقّبونه “سيّدنا”، وأخلاق الطّالب، طه في هذه الحالة، وأخلاق “العريف” الّذي عيّنه “سيّدنا” مساعدًا له، وأخلاق الطّلبة أتراب طه. يكتب طه حسين في سيرته الذّاتيّة “الأيّام”، وكان يتحدّث عن نفسه بصيغة الغائب، أنّه: “[…] حفظ القرآن؛ فقد أتم حفظه ولمَّا يُتم التاسعة من عمره، وهو يذكر في وضوح وجلاءٍ ذلك اليوم الذي ختم فيه القرآن […]”.[15] وبالطبع استطاع تحقيق ذلك بجهوده وبجهود “سيّدنا”. في تلك الأيّام كانت أجرةُ “سيّدنا” تعتمدُ على أُسَر الطّلبة، في الأساس، وكانت الأجرة بمثابة “حقوق”، “تتمثل دائمًا طعامًا وشرابًا وثيابًا ومالًا، فأمَّا الحقوق التي كان يقتضيها إذا ختم صاحبنا القرآن فَعشْوةٌ دَسِمةٌ قبل كلِّ شيء، ثم جُبَّة وقُفطان، وزوجٌ من الأحذية […] وجنيْه أحمر، لا يرضى بشيء دون ذلك”.[16] في حال أدّت الأسرة حقوق “سيّدنا” يكون راضيًا عنها وعن الطّالب الّذي يلقّب من لحظة ختمه للقرآن بـ “الشّيخ”. لكن إذا لم تُؤدِّ الأسرة حقوق “سيّدنا”، “فهو لا يعرف الأسرة، ولا يقبل منها شيئًا، ولا صلة بينه وبينها، وهو يقسم على ذلك بمُحْرِجات الأيْمان”.[17] بعد أن ختم الطّالب طه القرآن، رافقه “سيّدنا” إلى بيته لكي ينال حقوقه من أسرة طالبه “الشيخ” الصّغير طه ابن التّاسعة. وفي البيت ألحّ “سيّدنا” على والد طه أن يمتحنه، ولكنّ الوالد أجابه: “دعه يلعب إنه صغير”.[18] عجبٌ! وماذا مع حقوق “سيّدنا”؟! وكيف ستؤتى له إن لم يُجر الامتحان؟ لم ينلْ “سيّدنا” في ذلك المساء، لسوء حظّه وحظّ تلميذه طه، سوى وجبة عشاء، لا جُبَّة وقُفطان ولا زوجٌ من الأحذية ولا ما يحزنون. منذ تلك اللحظة، وكعقاب من طرف “سيّدنا” للأسرة وللطّالب طه، “أهمله لأنه لم يتقاضَ أجرًا على ختمه للقرآن”.[19] استراح “الشّيخ” الطّفل طه إلى هذا الإهمال “وأخذ يذهب إلى الكُتَّاب يقضي فيه طوال النهار في راحة مطلقة ولعب متصل”. ومضت الشّهور “إلى أن كان اليوم المشئوم […] ذاق فيه صاحبنا لأوَّل مرَّةٍ مرارةَ الخزي والذِّلَّة والضَّعَة وكَره الحياة”.[20] و”صاحبنا” هنا هو طه نفسه طبعًا. يصف طه حسين أحداث ذلك اليوم كالتّالي: “عاد من الكتَّاب عصر ذلك اليوم مطمئنًّا راضيًا، ولم يكد يدخل الدار حتى دعاه أبوه بلقب الشيخ، فأقبل عليه ومعه صديقان له، فتلقَّاه أبوه مبتهجًا، وأجلسه في رفق، وسأله أسئلة عادية، ثم طلب إليه أن يقرأ”[21] بعض السور من القرآن ولكنه لم يفلح في أيّ منها فقال له أبوه: “قم؛ فقد كنت أحسب أنك حفظت القرآن، فقام خَجِلًا يتصبَّب عَرَقًا، وأخذ الرجلان يعتذران عنه بالخجل وصغر السن، ولكنه مضى لا يدري أيلوم نفسه لأنه نَسي القرآن، أم يلوم سيِّدنا لأنه أهمله، أم يلوم أباه لأنه امتحنه!”.[22] وما زاد الطّين بلّة أنّ خبر هذه الحادثة قد وصل إلى مسامع “سيّدنا”، وعندما ذهب طه إلى الكُتّاب في اليوم التّالي دعاه “سيّدنا” في جفوة، وانهال عليه بالتّقريع، وامتحنه هو الآخر “وكانت له مع سيِّدنا قصة كقصته مع أبيه”. وكيف علّل “سيّدنا” حقيقة أنّ الطّالب طه نسي القرآن؟ يكتب طه حسين في هذا السّياق: “قال سيِّدنا: عوَّضَني الله خيرًا فيما أنفقت معك من وقتٍ، وما بذلتُ في تعليمك من جَهْدٍ، فقد نَسِيتَ القرآن ويجب أن تعيده، ولكن الذنب ليس عليك ولا عليَّ، وإنما هو على أبيك؛ فلو أنه أعطاني أجري يوم ختمت القرآن لبارك الله له في حفظك، ولكنه منعني حقي فمحا الله القرآن من صدرك. ويضيف: “ثم بدأ يُقرئه القرآن من أوَّله، شأنه مع من لم يكن شيخًا ولا حافظًا”.[23]
خلال مدّة قصيرة عاد الطّالب طه وحفظ القرآن “حِفظًا جَيِّدًا”. ويومئذٍ رافقه “سيّدنا” إلى بيته، وقال بكلّ جرأة لوالده: “زعمت أنَّ ابنك قد نَسي القرآن، ولُمْتَني في ذلك لوْمًا شديدًا، وأقسمتُ لك إنه لم ينْس وإنما خجل، فكذَّبتني وعَبِثْتَ بلحيتي هذه، وقد جئتُ اليوم لتمتحنَ ابنك أمامي، وأنا أُقسم: لئن ظهر أنه لا يحفظ القرآنَ لأحْلِقَنَّ لِحيتي هذه، ولَأُصْبِحَنَّ مَعَرَّة الفقهاء في هذا البلد”.[24] فأجاب والد طه “سيّدنا” بقوله: “هوِّن عليك! وما لك لا تقول: إنه نسي القرآن ثم أقرأته إيَّاه مرةً أخرى!”. وكان جواب “سيّدنا”: “أقسم بالله ثلاثًا ما نسيه ولا أقرأتُه، وإنما اسمعتُ له القرآن، فتلاه عليَّ كالماء الجاري، لم يقف ولم يتردَّد”. كان طه الّذي جُرّدَ من لقب “الشّيخ” يسمع هذا الحديث بين والده وسيّدنا، “وكان مقتنعًا أن أباهُ محقٌّ وأن سيِّدنا كاذبٌ، ولكنه لم يقل شيئًا، ولبث منتظرًا الامتحان”. رغم صعوبة الامتحان فقد كان طه “في هذا اليوم نجيبًا بارعًا، لم يُسأل عن شيء إلا أجاب في غير تردُّدٍ”. كان فرح أبيه عارمًا، وقال له “فتح الله عليك!”. ويضيف طه حسين: “وخرج سيِّدنا في ذلك اليوم، ومعه جُبَّة من الجُوخ خلعها عليه الشيخ”.[25]
بعد تلك اللحظة وضع سيّدنا للشّيخ طه برنامجا لقراءة القرآن وأوكل المهمّة للعريف الذي يساعده. ضاق الطّفل طه بهذه التّلاوة منذ البداية وضاق بها العريف أيضًا، فاتّفقا على عدم القيام بالمهمّة، لكن بشروط من طرف العريف الّذي طمع في أن يستفيد من موقف الصّبيّ طه بين يديه. ويعترف طه حسين أنّه “كان يكره أن يمتحنه سيِّدنا، ويشتري صمت العريف بكل شيء، وكم دفع إلى العريف ما كان يملأ جيبه من خبز، أو فطير، أو تمر! وكم دفع إليه هذا القرش الذي كان يعطيه إياه أبوه من حين إلى حين […]”.[26] استطاع طه، من خلال هذه العلاقة التّبادليّة، اكتساب مودّة العريف، فاتّخذه العريف صديقًا له ثمّ أخذ يعتمد عليه، ويثقُ به، ويطلب إليه أن يُقرئ القرآن بعض الصبيان. يشهد طه حسين عن نفسه قائلًا: “كان صاحبنا يسلك مع تلاميذه مسلك العريف معه بالدِّقَّة”. ويضيف: “وإذا كان العريف لا يشتُمُهُ ولا يضربه، ولا يرفع أمره إلى سيِّدنا؛ فذلك لأنه يدفع ثمن ذلك كله غاليًا، وقد فهم الصبيان هذا فأخذوا يدفعون له الثمن غاليًا أيضًا، وأخذ هو يستردُّ بالرشوة ما كان يدفع إلى العريف”.[27] ويعترف طه حسين في هذا السّياق، أيضًا: “وبينما كان صاحبنا يرشو ويرتشي، ويَخْدع ويُخْدعُ، كان القرآن يُمحى من صدره آية آية وسورة سورة، حتى كان اليوم المحتوم … ويا له من يوم!”.[28]
في أحد الأيّام دخل “الشّيخ” الطّفل طه إلى البيت وإذ بـ “سيّدنا” في بيتهم يجلس مع والده في المنظرة. في ذلك المقام أجرى له أبوه امتحانًا وطلب منه أن يقرأ إحدى السّور، لكن هيهات “فلم يفتح الله عليه بحرف”.[29] عندها لامه والده على أنّه أضاع القرآن، وقال: “ولكنَّ لي مع سيِّدك شأنًا آخر”.[30] في تلك اللحظات خرج طه “من المنظرة مُنَكَّسَ الرأس مضطربًا يتعثَّر […]”.[31] ومن شدّة غضبه أخذ الساطور “وأهوى به إلى قفاه ضربًا […] والدم يسيل من قفاه!”.[32]
أمّا تجارب توفيق الحكيم مع الامتحانات فحدّث ولا حرج، إذ كانت كقصّة “إبريق الزّيت”، وشكّلت محورًا أساسيًّا من “سجن العمر” الّذي عاشه وكتبَ عنه. في سيرته الذّاتيّة “سجن العمر”، يكشف الحكيم، بمنتهى الجرأة، مدى تحكّم أهله، وخصوصًا والده، في تفاصيل حياته بمختلف مراحلها. فمنذ نعومة أظفاره مال الحكيم إلى الفنّ والأدب، وكان قارئًا نَهِمًا، لكنّ ذلك لم يرضِ والديه، لأنّهما أرادا منه أن يركّز على دروسه وعلى الامتحانات المدرسيّة، ما اضطرّه إلى المطالعة خفيةً، ويكتب في هذا السّياق: “إني كنت أختفي بمطالعاتي القصصية عن عيون أهلي، كما لو كنت أرتكب وزراً من الأوزار… مع أنها في أغلبها كانت على مستوى جيد من حيث التأليف والترجمة… كنت أتسلل حاملا الكتب لأقرأها تحت سريري […] وكنت أمضي أقرأ في الظلام حتى أعجز عن تمييز الأسطر، فأخرج خفية وأحضر “شمعة” أشعلها وأعاود القراءة على ضوئها”.[33] وفي مرحلة التّعليم العالي، مال الحكيم إلى دراسة الفنّ والأدب، لكنْ فرضَ عليه والده، الّذي كان يعمل في سلك القضاء، أن يسير في طريقه، فيتعلّم القانون في مصر ثمّ يرسله إلى باريس لنيل شهادة الدّكتوراة في القانون، ليحقّق بذلك حلم والده والأسرة في أن يصبح قاضيًا. سنعود في إطلالة مستقبليّة، بمزيد من التعمّق، إلى “سجن العمر” الّذي عاشه الحكيم وعانى منه.
وبالعودة إلى موضوع إطلالتنا، فقد بدأت محنة الطّالب توفيق مع الامتحانات في الصّفّ الثّاني الابتدائيّ، ولازمته في المراحل التّعليميّة كلّها وهو في مصر، ثمّ طاردته حتّى بعد انتقاله إلى باريس لنيل شهادة الدّكتوراة في الحقوق هناك. بخلاف العقّاد، الّذي كان مولعًا بحلّ المسائل الحسابيّة، كانت بين الحكيم والحساب والأرقام عداوة تعود إلى مرحلة المدرسة الابتدائيّة، ويكتب في هذا السّياق: “أما الحساب […] فقد لبثت إلى يوم الامتحان أفزع من تلك المسائل التي كالألغاز عن قطارين أحدهما يسير بسرعة كذا والآخر يسير بسرعة كيت […]”.[34]
رسب الطّالب توفيق أكثر من مرّة في امتحانات النّقل من سنة إلى أخرى في مراحل دراسته المختلفة. ففي سنته الأولى في المدرسة الثّانويّة صبّ جلّ اهتمامه على المواضيع الفنّيّة والأدبيّة وعلى السينما غراف والمسلسلات وقراءة الكتب والروايات “إلى أن جاء آخر العام… فإذا بي أرسب في امتحان النقل إلى السنة الثانية الثانوية رسوباً قبيحاً”. وماذا كان ردّ فعل أهله على رسوبه؟ يقول: “وغضب أهلي لذلك غضباً شديداً.. وكرهوا السينما تغراف وسيرته وحرموه علي تحريماً.. وانهالوا على ما كان في حوزتي من روايات تقطيعاً وتمزيقاً”.[35]
بعد أن حصل الطّالب توفيق على شهادة “البكالوريا” التحق بمدرسة الحقوق مُكرهًا، ويؤكّد في هذا الشأن: “لم أكن بالطبع من الطلبة المبرزين في مدرسة الحقوق… بل إني رسبت في امتحان النقل من السنة الأولى إلى الثانية […] وكان لهذا الرسوب أثره السيء بالطبع عند أهلي”.[36] لكن، في نهاية الأمر يقول: “نلت ليسانس الحقوق في ذلك العام الميئوس منه […] كان لوجود اسمي بين الحاصلين على ليسانس الحقوق أكبر مفاجأة لي […] وأنا أبعد الناس في التفكير في النجاح… كان كل تفكيري متجها إلى إتمام تلك الأوبريت أو “الأوبرا كوميك” “علي بابا” كما كنت أسميها”.[37] ويضيف الحكيم، بأسلوب كوميديّ هذه المرّة، أنّه لم يصدّق أنّه نجح “إلى أن جاءوا بالصحف… وطالعت فيها العبارة المألوفة وقتئذ: نجح في شهادة الليسانس الأفندية الآتية أسماؤهم: وبحثت عن اسمي بسرعة فوجدته قبل الأخير باسمين… فحمدت الله أن قد وجد اثنان أسوأ مني!!”.[38]
سافر الحكيم إلى باريس سنة 1925 لنيل شهادة الدّكتوراة في القانون بقرار من والده، ويشدّد على أنّه في باريس: “جرفني الأدب والفن جرفاً”[39]، وهناك بدأت “مرحلة التأليف الفعلي فإنها لم تبدأ عندي على نحو جاد إلا بعد سفري إلى أوروبا والارتشاف من منابع الثقافة الحقيقية والتكوين الحقيقي لبنيتي الفكرية”.[40] لكن، ماذا بخصوص الدّراسة والامتحانات لنيل شهادة الدّكتوراة؟ للأسف، كانت قصّته مع الدّكتوراة بعكس قصّته مع الأدب وتكوين بنيته الفكريّة، ففي فترة تقدّمه للامتحانات النّهائيّة لنيل شهادة الدّكتوراة في القانون كتب له والده: “أبرق لنا في حالة نجاحك”. ويكتب الحكيم في هذا الشأن: “كلمة النجاح غريبة على أذني الآن. أأنا استطيع ان انجح في شيء؟”.[41] وهذا ما حدث بالفعل، فقد رسب في امتحانات الدّكتوراة ولم تتحقّق أمنية الوالد والعائلة بأن يصبح ابنهم دكتورًا في القانون. وكان لا بدّ للطّالب الرّاسب من العودة إلى الوطن، فيكتب: “وعدت إلى بلادي… عدت بالحقيبة ذاتها التي كنت حملتها معي […] لم ينقص منها شيء…”. ويضيف: “كما عدت بصناديق خشبية مملوءة بما جمعت من كتب على مدى تلك الأعوام…”. ويذكر بمرارة: “كل ذلك عدت به… ما عدا شيئاً واحداً لم أعد به… وهو ما ذهبت للحصول عليه: الدكتوراه في القانون…”.[42] وكيف استقبله أهله؟ يصف الحكيم استقبال أهله له: “عدت فاستقبلني أهلي كما يُستقبل الخائب الفاشل… وتصادف أن سمعوا أصوات فرح على مقربة من منزلنا، فلما سألوا عن الخبر قيل إن سرادقا أقيم وأكواب “شربات” تقدم ابتهاجا بجار زميل لي عاد من الخارج ناجحاً فالحاً ظافراً بشهادة الدكتوراه، فازداد مركزي سوءاً… ورأيت الهم والغم والأسى في عيون أهلي… وسمعتهم من حولي يتهامسون: “يا خيبتنا”!… يا خيبتنا!”.[43]
لفت انتباهي الاختلاف في التّفسيرات الّتي قدّمها الحكيم لأسباب رسوبه في امتحانات الدّكتوراة في “سجن العمر” التي صدرت سنة 1964، وهو في السّادسة والسّتّين من العمر، مقابل التفسيرات التي قدّمها حول رسوبه في مؤلّفه “زهرة العمر”. كتاب “زهرة العمر” عبارة عن رسائل قام الحكيم بإرسالها إلى صديقه الفرنسيّ، أندريه، خلال وجوده في باريس، واستمرّت إلى ما بعد عودته إلى مصر، سنة 1928.
في “سجن العمر” حمّل الحكيم نفسه كامل المسؤوليّة عن رسوبه في امتحانات الدّكتوراة، فكتب: “فإن بطء الفهم عندي، وواعيتي الضعيفة، بالإضافة إلى أعباء الجهاد الثقافي الشامل الذي ألقيت بنفسي كلها في لجته، مع النهم الفكري الذي استولى عليّ أمام موائد الحضارة الكبرى… كل هذا لم يترك لمثلي القوة ولا القدرة على حمل عبء آخر”. [44]
أمّا في رسائل الحكيم الواردة في “زهرة العمر”، فيكتب إلى صديقه أندريه، قبل تقدّمه للامتحان بأشهر: “نفسي قد خلقت لتقرأ ما تريد وقتما تريد. لتحيط علما بكل شيء، وتسعى إلى تأمل كل شيء وتستبقي في الذاكرة ما تشاء وتنسى ما تشاء. أما تتبع دراسة منتظمة لجزء معين بالذات من العلوم يستذكر استذكارا ليستفرغ بعد ذلك استفراغا بين يدي ممتحنين ومحلفين؟! هنا كل المشكل يا صديقي أندريه”.[45]
وفي رسالته بعد تقدّمه للامتحان يكتب: “عزيزي اندريه: لقد لفظ القدر كلمته. انه لا يريد لي طريق القانون. لقد رسبت […]”. أمّا بخصوص جدّيّته في الدّرس فيؤكّد لصديقه: “اياك ان تفهم اني تهاونت في الدرس. لقد كانت اجابتي مرضية جدا في علم تاريخ المبادئ والمذاهب الاقتصادية […] ولم اهبط إلى حد الرسوب إلا في علم واحد هو علم “المالية” (ولعل هذا يفسر لك ارتباك ماليتي). انه علم إجراءات وأرقام لا تستقر في ذاكرتي”.[46] ثمّ يشرح الحكيم الاختلاف الجوهريّ بين أهدافه من القراءة والمطالعة وبين أهداف الامتحان، فيكتب: “آه للذاكرة يا اندريه. ما دامت الذاكرة هي المعول عليها إلى حد كبير في الامتحان فلا امل لي. اما المطالعة في ذاتها فما ايسرها وما الذها عندي. اني اطالع في اليوم ما لا يقل عادة عن مائة صفحة في مختلف الوان المعرفة (من ادب وفنون وفلسفة وتاريخ الى علوم رياضية وروحانية). مائة صفحة في اليوم أي ثلاثة آلاف صفحة في الشهر. بينما المقرر كله لامتحان الدكتوراه لا يتجاوز ثلاثة آلاف صفحة في العام كله. لو تعلم اني قرأت مقرر الدكتوراة للقانون العام وهو عن: (سلطة الكنيسة والدولة) […] قرأت ذلك كله دون ان اتقدم فيه الى امتحان. قرأته لمجرد القراءة […] الم أخبرك اني تتبعت كثيرا من دروس السوربون لغير غاية الا تتبع آثار الثقافة التي تعنيني”.[47] ويضيف “وانغمست في مطالعتها لنفسي، وسرت على دربها وأنا في حجرتي. ان التحصيل في ذاته للثقافة والتكوين هو لذتي الكبرى الآن. انما الذي يخيفني اليوم هو الامتحان. لقد تحقق لدي اليوم اني لا أصلح بطبعي للتقدم إلى اي امتحان. ذلك ان الامتحان يريد مني عكس ما أريد انا من القراءة. اني اقرأ لأنسى. والامتحان يريد مني أن اقرأ لأتذكر. اني اقرأ لأهضم ما قرأت اي احلل مواد قراءاتي الى عناصر تنساب في كياني الواعي وغير الواعي. اما الامتحان فيريد مني ان احتفظ له بهذه المواد صلبة مفروزة. اني اشعر وانا اقرأ حتى مقرر الدكتوراه في القوانين ان مواده قد تفككت واختلطت بمواد اخرى لقراءات اخرى لا علاقة لها بالقانون، كما تختلط في المعدة المواد الغذائية بعضها ببعض. واذا الناتج من هذه المواد المختلطة هو عصير ثقافي يسري في دمي المعنوي فأحس كأن وزني الفكري قد ازداد. وكأن قدرتي على احتمال التأمل المثمر قد نمت. أما المواد الغذائية في ذاتها فقد هضمت أي نسيت. الامتحان يريد مني ان أقف عملية الهضم حتى يتحقق الممتحن من وجود المواد صلبة مفروزة داخل المعدة الذهنية”.[48] رغم هذا الشّرح الوافي إلّا أنّ توفيق يعود ويحمّل نفسه مسؤوليّة الرّسوب، فيكتب لصديقه أندريه: “لا اريد بذلك أن اعيب نظام الامتحان في ذاته. انما اعيب نظام بنيتي الفكرية. اني سريع الهضم الى حد قد يعد مرضا في نظر الممتحن. ومع ذلك لماذا أتقدم لممتحن، ما دمت قد تناولت الغذاء، وأحس حرارة الدم القوي تفور في رأسي، فلماذا أدع الناس يفحصون ما في معدتي؟!”. ويتساءل الحكيم: “أتراني ادافع عن نفسي وألتمس الاعذار يا أندريه!”. ويجيب: “لست أدري”.[49]
هل دافع توفيق الحكيم عن نفسه والتمس الأعذار؟ هل العيب في الامتحان أم في نظام بنية توفيق الحكيم الفكريّة؟
وبالعودة إلى طه حسين، فرغم حكمه الجازم على الامتحان إلّا أنّه كان يعي في حينه أنّه أمر لا مفرّ منه، ولكنّه وجّه لومه إلى وزارة المعارف بقوله: “وأنا أعلم أن الامتحان شر لا بد منه، ولكن الغريب أننا لا نتخفف من هذا الشر ولا نكتفي منه بأقل قدر ممكن. وإنما نتزيد منه ونثقل به المعلمين والمتعلمين، فنضطرهم إلى الشر ما وسعنا ذلك”.[50] ويقترح: “[…] فلنتخفف من هذا الشر ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً، ولنردَّه إلى أصله، ونجعله وسيلة لا غاية، ولنصطنع بعض الجراءة، ولنردّ إلى المعلمين ما هم أهل له من الثقة، ولنقدر آراءهم في تلاميذهم كما نقدر الامتحان أو أكثر مما نقدر الامتحان”.[51] ويضيف أنّ هذا التّخفيف قد “[…] يتيح للوزارة وللمدارس أن تفرغ للتعليم الذي هو أهم من الامتحان، ويتيح للتلاميذ أن يفرغوا للتحصيل الذي هو أهم من أداء الامتحان. […] وهذه الامتحانات نفسها كما هي الآن عسيرة معقّدة، تحتاج وتحتمل كثيرًا من التيسير والتسهيل إن نظرت الوزارة إلى الامتحان على أنه وسيلة، وسيلة يسيرة لا غاية”.[52] ويخلص طه حسين إلى أنّ حلّ مشكلة الامتحان من شأنه أن يعزّز قيمة القراءة الحرّة وأهمّيتها في تنشئة الطّالب المثقّف، وهو يتّفق هنا مع رأي الحكيم بخصوص القراءة الحرّة، فيكتب: “كل ذلك سيعين على حل مشكلة أخرى نشكو منها ونضيق بها ولا نعرف كيف نجد لها حلا. وهي مشكلة الإعراض عن القراءة الحرة السمحة التي لا تتقيد بمنهاج الدرس وبرنامجه ولا تقتصر على الكتب المقررة والمذكرات التي يمليها المعلمون”.[53]
ما رأيك عزيزي/تي القارئ/ة، دام فضلك، بما طرحه طه حسين سنة 1938؟ أين نحن اليوم من هذا كلّه؟ هل الامتحان شرّ لا بدّ منه؟ هل هو وسيلة أم غاية في جهاز التّعليم في بلدك؟ وما هي الوجهة المنشودة في تقييم أداء الطّالب، ومن يجب أن يقوم بذلك، وكيف؟ وما هي الطريق لتعزيز القراءة الحرّة؟
إذا كانت مشكلة الامتحانات في حياة توفيق الحكيم قد بدأت مع مرحلة المدرسة الابتدائيّة، فهناك مشكلة أخرى وذكريات مُرّة بقيت عالقة في ذهنه تعود إلى أيّام ما قبل المدرسة، وهي تكمن في الكتاتيب الّتي أرسله أهله إليها حين كان في سنّ مبكّرة جدًّا، وكم من كُتّاب دخله بسبب طبيعة عمل والده في سلك القضاء. يكتب الحكيم بمرارة: “[…] أذكر صوراً غامضة عن حاجتي الملحة الضاغطة إلى التبول والمرحاض […] وأعود إلى البيت كل يوم وقد فعلتها في سراويلي!…”.[54] لم يعانِ الطّفل توفيق من مشكلة صحّيّة جعلته يفعلها في سراويله، بل عانى، ككثيرين غيره من كتّاب السّيرة الذّاتيّة الذّكور من المحيط إلى الخليج، من أثر تعامل الكتاتيب والمدارس معهم.
يشرّفني أن ترافقوني في جولة على عددٍ من هؤلاء الطّلّاب لكي نطلّ، عبر شبابيك كتاتيبهم ومدارسهم، على تلك المشاهد والمواقف القاسية الّتي بقيت راسخة في ذاكرة كلّ منهم، حتّى بعد مرور عشرات السّنين على حدوثها.
ألقاكم/نّ بخير.
……………………..
[1] . حسين، طه. (1938). مستقبل الثّقافة في مصر. الجزء الأول. مصر: مطبعة المعارف ومكتبتها. ص 205.
[2] . العقاد، عباس. (2013). أنا. القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. ص 39.
[3] . المصدر السابق. ص 39.
[4] . المصدر السابق. ص 39.
[5] . المصدر السابق. ص 39.
[6] . المصدر السابق. ص 39.
[7] . المصدر السابق. ص 39.
[8] . المصدر السابق. ص 39.
[9] . المصدر السابق. ص 39.
[10] . حسين، طه. مصدر سابق. ص 205-206.
[11] . حسين، طه. مصدر سابق. ص 207.
[12] . حسين، طه. مصدر سابق. ص 207.
[13] . حسين، طه. مصدر سابق. ص 209.
[14] . العقاد، عباس. مصدر سابق. ص 55.
[15] . حسين، طه. (2013). الأيام. وندسور: مؤسسة هنداوي. ص 29.
[16] . المصدر السابق. ص 29.
[17] . المصدر السابق. ص 29-30.
[18] . المصدر السابق. ص 30.
[19] . المصدر السابق. ص 32.
[20] . المصدر السابق. ص 32.
[21] . المصدر السابق. ص 32.
[22]. المصدر السابق. ص 33.
[23] . المصدر السابق. ص 33.
[24] . المصدر السابق. ص 35.
[25] . المصدر السابق. ص 35.
[26] . المصدر السابق. ص 41.
[27] . المصدر السابق. ص 41.
[28] . المصدر السابق. ص 42.
[29] . المصدر السابق. ص 43.
[30] . المصدر السابق. ص 44.
[31] . المصدر السابق. ص 44.
[32] . المصدر السابق. ص 45.
[33] . الحكيم، توفيق. (1964). سجن العمر. القاهرة: مكتبة الآداب. ص 111-112.
[34] . المصدر السابق. ص 127.
[35] . المصدر السابق. ص 129.
[36] . المصدر السابق. ص 171-172.
[37] . المصدر السابق. ص 262-263.
[38] . المصدر السابق. ص 264.
[39] . المصدر السابق. ص 243.
[40] . المصدر السابق. ص 223-224.
[41] . الحكيم توفيق. (1943). زهرة العمر. يافا: دار الثقافة العربية للنشر. ص 18.
[42] . الحكيم، توفيق. (1964). سجن العمر. القاهرة: مكتبة الآداب. ص 298-299.
[43] . المصدر السابق. ص 299.
[44] . المصدر السابق. ص 299.
[45] . الحكيم توفيق. (1943). زهرة العمر. يافا: دار الثقافة العربية للنشر. ص 22.
[46] . المصدر السابق. ص 49.
[47] . المصدر السابق. ص 49-50.
[48] . المصدر السابق. ص 50-51.
[49] . المصدر السابق. ص 51.
[50] . حسين، طه. (1938). مستقبل الثّقافة في مصر. الجزء الأول. مصر: مطبعة المعارف ومكتبتها. ص 212.
[51] . المصدر السابق. ص 213.
[52] . المصدر السابق. ص 215.
[53] . المصدر السابق. ص 216.
[54] . الحكيم، توفيق. (1964). سجن العمر. القاهرة: مكتبة الآداب. ص 80.