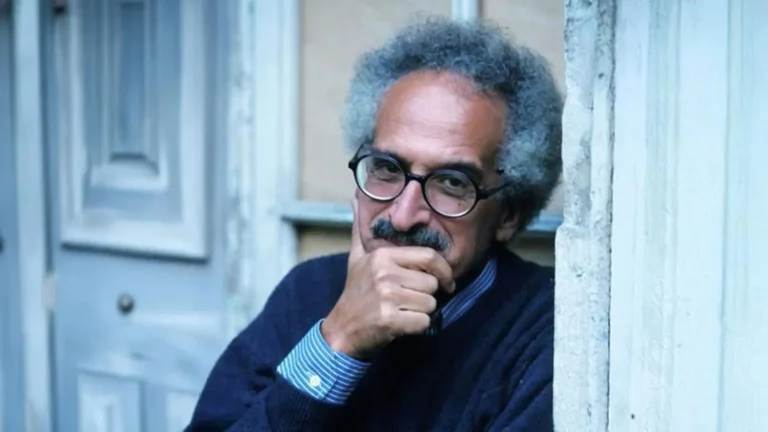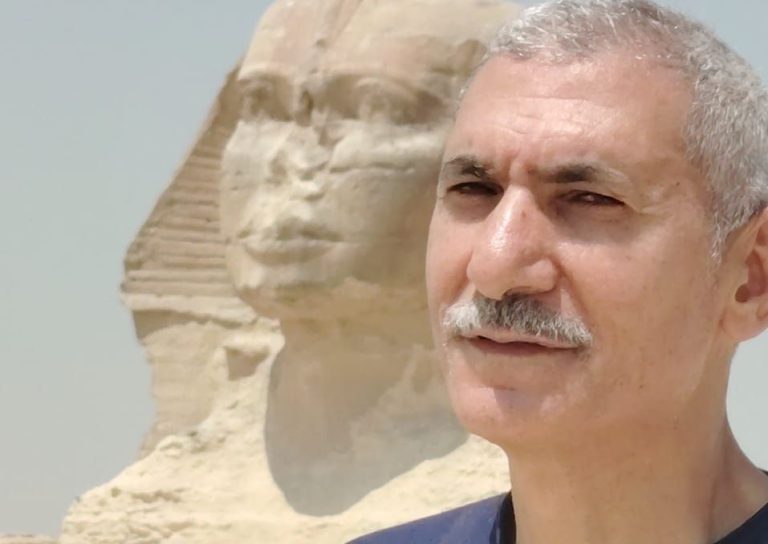لعل غياب الدوريات المهتمة بنشر الإبداع له تأثير مباشر؛ ففي زمن “إبداع”، و”القاهرة”، و”الكرمل”، و”الآداب”، وغيرها كانت المساحة المخصصة فيها لنشر النصوص القصصية دافعا للعديد من المبدعين أن ينشروا إنتاجهم القصصي. وكانت تلك القصص بمثابة محفزات إبداعية لأجيال تالية كانت تجد في تلك النصوص البديعة ملهما لإنتاج يخصهم . ومع ذلك فليس هذا هو السبب الوحيد، فربما أن القصة المصرية قد وجدت نفسها في مأزق خاص يتعلق بأسئلة جمالية مطروحة لم يجد المبدعون إجابات شافية عليها، وهو ما أدى إلى هذه الحالة من الركود القصصي.
ففي لحظة تحول مؤثرة صدر كتاب: “خيوط على دوائر” لمجموعة من الكتاب الذين قرروا نشر نصوصهم معا في كتاب واحد، أذكر منهم الآن: أحمد فاروق وهيثم الورداني وأحمد غريب ووائل رجب ونادين شمس وعلاء البربري. كانت تلك القصص رسالة مباشرة على أزمة انعدام منابر نشر الإبداع من جهة، ووثيقة على عدد من التحولات التقنية في النص القصصي، مثل اللغة الوصفية المباشرة المحايدة، والاهتمام باليومي العادي، والمشهدية المستعارة من فن السينما وغيرها. لكن مع الأسف لم تكن هناك امتدادات لهذه التجربة.
ثم ظهرت مجموعة من المحاولات الفردية كان لها اهتمامات مختلفة؛ تقنيا وموضوعيا ، من بينها، مثلا، تجربة مي التلمساني في “خيانات ذهنية” التي كانت بمثابة فتح للنص القصصي النسائي المعاصر، ومحاولة غادة الحلواني في كتابة قصة جديدة ترتكز على البعد عن الواقعية، والتعبير الموازي الرمزي للحواس، ثم تجربة منصورة عز الدين في “ضوء مهتز” التي جسدت أيضا تجربة شديدة الخصوصية امتلكت كل سمات القصة الجيدة من جهة التكثيف والتركيز من جهة، وأضفت عليها بعدا غامضا وساخرا جديدا على النص القصصي المعاصر، وقدمت فيه وجها مختلفا للأنثى ومشاعرها، وطريقة تعاطيها مع الحياة. ثم محاولتي الأولى في”باتجاه المآقي” وكانت محملة بشبهة الغنائية والميوعة العاطفية، تلتها تجربة أكثر نضجا هي” أشباح الحواس” وفيها حاولت ترسيخ النزعة الغرائبية في اشتباكها بالواقع اليومي والعادي، وتوسيع مساحة بحث العلاقة العاطفية والحسية في مجتمع يشهد تحولات اجتماعية وعولمية لا تخطئها عين.
لكن القصور النقدي أوقع هذه التجارب في فخ اليأس وانعدام الأفق ما أدى إلى اتجاه، أو انتقال، الكثير من الكتاب إلى النصوص الروائية؛ على أمل لفت انتباه النقاد الصامتين بلا جدوى، باستثناء بعض المخلصين للقصة مثل هيثم الورداني الذي قدم تجربة تعتبر امتدادا لتجربة “خيوط على دوائر” وإن أصبحت أكثر جدية، وحداثة، وتجريبا، وتعبيرا عن البطل المعاصر بشكل عام، ثم التجربة الاستثنائية للكاتب حسام فخر الذي قدم عددا من النصوص اللافتة على مستويي الموضوع والتقنية في “وجوه نيويورك” ، ثم “حكايات أمينة” لفت بها الانتباه بالرغم من التحيز النقدي والقرائي السائد للرواية على حساب النص الإبداعي. وحتى في تجربته “يا عزيز عيني” قدم محاولة تجريبية رغم عدم نجاحها لكنها كشفت عن جانب تجريبي يحتاجه النص السردي المعاصر بشكل عام.
فيما يتعلق بي فإنني أعتبر القصة أكثر الأشكال الإبداعية اقترابا من الشعر، من حيث أنها تأتي مثل دفقة وجدانية وشعورية، مكثفة وعميقة، تتجنب الهندسة وتبدو أقرب للانفعال. ولكني أرى أن القصة القصيرة التي أبدعها يوسف إدريس قد استنفذت أغراضها، برغم عبقريتها، وعمقها في فهم تعقد النفس البشرية، ورصدها للتحولات الاجتماعية، وقدرتها الفذة على اجتراح التابوهات واختراقها.
أعتقد أن القصة القصيرة الآن تحتاج إلى آفاق جديدة، تمتثل لمواصفات النص السردي الحديثة بشكل عام، والذي يتعارض مع النص الواقعي، وينحو للخيال والتجريب والسحرية والغرائبية، أو، حتى، إلى فتح آفاق جديدة للواقعية تنتمي لما يمكن تسميته بالواقعية القذرة التي تصور الواقع البشع في الهامش بالقبح الذي لا يحتمل أي تجميل إبداعي من أي نوع. لكن الأسئلة الآن ربما تتحول للنص الروائي أكثر، لأن الرواية الجديدة ما زالت تحاول الإجابة على اسئلتها الإبداعية والجمالية دون إجابة شافية في ضوء الفقر النقدي المفزع الذي تشهده ساحة الإبداع العربي، خاصة في مصر.
المأساة في ظني ليست مجرد كسل النقاد وعزفهم عن المتابعة النقدية ، وإنما تتجاوز ذلك لقصور أدوات النقاد وانحيازها لتقاليد القص التقليدية، وبالتالي عدم تفاعلها مع النصوص الحداثية والتجريبية، ناهيك عن غياب جيل جديد من النقاد المؤهلين بأسلحة النقد الحديث ومتابعة النصوص العالمية ومعرفة الأساليب الحداثية والتقنيات الجديدة في السرد العربي المعاصر، سوى بعض الاستثناءات التي لا تتناسب مع الزخم الإبداعي بشكل عام.
إلا أن المساحات الإلكترونية، بوسائطها الافتراضية الجديدة، استطاعت، في الواقع، خلق منابر إبداعية سواء في شكل مجلات إلكترونية، أو مدونات أو صفحات شخصية يكتب فيها من يشاء ما يشاء، وينشرها على الوسيط الافتراضي، ويخضع لتعليقات من القراء ولعدد من الآراء النقدية الانطباعية، مما تسبب في حالة من الانتعاش، كشفت أيضا عن قاريء مختلف نسبيا عن القاريء التقليدي. فهو قاريء يبدو عليما بتقنيات الاتصال الحديثة، متأثرا بتجارب التدوين، وباللغات الأجنبية إلى حد ما، لديه نوع من الإحساس الفردي الخالص، الذي يظهر في قوة طرح ما يكتبه، كما أنه يبدو لي متأثرا بالحرية التي تتيحها مثل هذه الوسائط الافتراضية الجديدة التي تشهد اقتحاما لمناطق اعتبرت لسنوات طويلة مناطق مسكوت عنها خاصة ما يتعلق بمشاعر الإناث الحميمة والمثلية الجنسية والعذرية والممارسة الجنسية وغيرها من موضوعات شبيهة.
لكني أتشكك في مدى ما يمكن لهذه النصوص أن تقدمه للمنجز السردي إذا لم يواكبها نقد محترف، خاصة وقد بدأت بشائر ذلك في ظهور بعض النصوص المتواضعة التي ما كان لها أن تنشر لولا تضليل المدونين ومنها مثلا مجموعة “كراكيب ” لنهى محمود، ونصوص باسم شرفـ، وإن كانت نزعة الأخير التجريبية قد تشفع له بعض الشيء وإن كانت لا تبرر تعجل النشر، وهذان النموذجان هما على سبيل المثال لا الحصر. وفي نفس الوقت فإن غياب النقد يؤدي لتأخر نشر نصوص لافتة يكتبها بعض الكتاب فقط على المدونات مثل الكاتبة اللافتة الموهبة رحاب بسام، والتي يمكن أن تقدم تجربة جادة إذا شرعت في النشر الورقي، إلا أنها مثل كل أصحاب المواهب الحقيقية ليست متعجلة للنشر.
الأزمة في ظني أزمة نقدية، لا بد من علاجها حتى تكتمل الجمل الإبداعية القصصية وتفتح لنفسها آفاقا جديدة يمكنها بها أن تستعيد مجدها القديم، وتفتح للتجريب في النص القصصي المعاصر الأبواب التي تليق به.