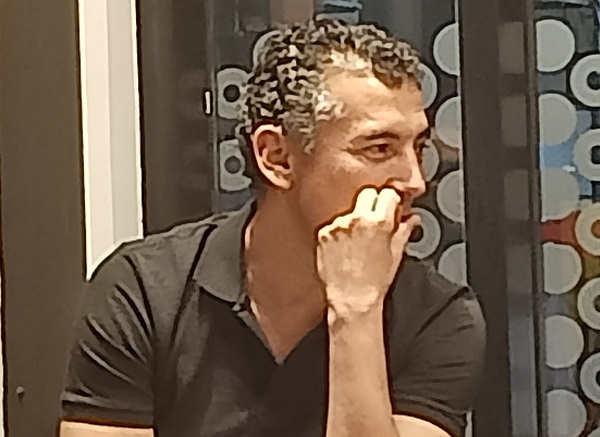محمد الأحمد
أنا من رأى (جحشه) بأم عينه في محطة القطار (بعقوبة) التي شيدها الإنجليز لتربط بين (بغداد) وبقية نقاط التقاء المسافرين إلى العالم. فأنا من قرأ عنه فيما بعد، وأنا الوحيد من بين أبناء جيلي كنت عارفاً بمصيره، لأني عثرت عليه، مصادفة، بشحمه ولحمه بين الكتب، وعرفت عنه أشياء أخرى بعد ما قرأت (العم محفوظ)، الذي كان يتخذ مما يشاهد، وما سطرته الأيام والحوادث في سجل المحيط المصري مادة لأقاصيصه.
ففي “بذلة الأسير” من كتاب (همس الجنون)، ذلك هو نفسه بائع السجائر الذي خلقه (نجيب محفوظ)، العظيم الذي لن يلحق بركبه أحد من أهل هذه الأرض، (العم محفوظ) الذي وجدته يغمرني بعطفه كلما أمسكت كتاباً من كتبه. وإني أعني كلما شاهدت أمامي، بلحمه ودمه، شخصاً يتجول بين دفتي الكتب التي كنت أقرأها، أكون في غاية الإجحاف عندما لا أعترف بخلق الخالق المبتكر الصانع الأمهر الذي وضعتني براعته على المحك: أن أكون أو لا أكون كاتباً. فكنت ذلك الكاتب الذي تقرؤون له اليوم، والذي حدث أني حاولت بكل ما عندي من طاقة، وعناد، ووقت. يومها لم أكن أعرف اسمه أصلاً، ولكني بعد (همس الجنون)، صرت أعرفه: (بائع السجائر)، باسمه وتاريخه وكل شيء عنه.
فهذا لا يمكن أن يتكرر أو يحدث مع أي منكم، وإن كان بيته على مقربة من تلك المحطة المجلجلة في الذاكرة. كنت يومها في الثالثة عشرة، أو ما يقارب، عندما اختفى السيد (جحشه) من طريق مروري اليومي كلما أعود من بيت خالتي وزوجها (محسن المحولجي). فأراه في كل مرة لا يتوقف عن قضم الخبز، يمضغه، وينادي على بضاعته المحمولة بعلبة خشبية معلقة إلى رقبته، ويلبس (دشداشة/ جلباب) بلون قاتم، ولا يفارقه الذباب، حافي القدمين، نتن الرائحة، يلحن بصوت مخيف على بضاعته، ويتطاير زبد أبيض على شدقيه، ولا يسلم من رذاذه العطن أي زبون. وبرغم ذلك كان يعده أغلب عمال وموظفي المحطة من الناس المبروكين؛ فمن أعطاه خبزاً، فحتماً سيصيبه رزق كبير من حيث لا يحتسب.
وفي يوم عاصف ممطر اختفى بائع السجائر من على ناصية المحطة، وكان غيابه حدثاً غير مسبوق، لأنه كان يعيش بحضور لافت على رصيف المحطة يثير الشفقة والعطف. ففي غيابه راحت قصص الناس تترى من ظنهم، حيث من قال بأنه “ملك” صالح أخذه الرب ليصلح به مدينة أخرى من بعد أن هداه لهذه المدينة، وقال آخر بأنه هرب، وقال من قال إن أهله أخذوه ليعيش بينهم. وكنت أنا أسمع من الجميع أثناء مروري غير مهتم بأمره: أن غاب أو حضر. بل كنت أتحاشى رذاذ فمه المتطاير على وجوه من يتحدث إليهم، إذ كنت أعود في أغلب الأحيان إلى البيت لأغتسل أكثر من مرة. وهكذا بقيت القصة غارقة في تشاريح الذاكرة، مستقرة بين طبقاتها، متليفة بين طيات العمق السحيق منها.
والأدهى أن معظم الناس المتعايشين معه في ذلك المكان قد حزنوا كثيراً على فراقه، وعبروا عن حزنهم يومذاك بالكلام عنه في كل مكان، وبدا يوماً كابياً كثير العتمة، والناس بقيت تسمي ذلك اليوم “يوم اختفاء ذلك الرجل”. وصارت تبحث عنه في كل مكان: من (جملونات) مخازن التمر المهجورة، وحوض الماء، وحتى مقهى (الكانتين) بفارسها البيزنطي إبراهيم (زعيله). ولم يعثر أي منهم على أثر أو جواب، باستثنائي؛ فقد أخبرتكم سرّ الرجل الذي قرأت عنه، تلك القصة البديعة المكتوبة قبل ولادتي بعشرات الأعوام.
وبمثل ما قال (جورج لوكاتش) الناقد المجري المعروف: “الشخصية الأدبية لا تصبح مهمة ونموذجية إلا حين يتسنى للفنان الكشف عن الارتباطات العديدة بين الملامح الفردية والمسائل الموضوعية العامة، وإلا حين يعيش الشخص الأدبي أمام أعيننا نفسها أشدّ قضايا العصر تجريداً، وكأنها قضايا الفرد الخاصة، وكأنها مسألة حياة أو موت”.
وبعد أن فرغت من خبري، اسمحوا لي بأن أسرد لكم واقعة (1977)م. حدث أن طلب منا ذات يوم بمرحلة الرابع إعدادي (عام) أستاذ اللغة العربية، في درس الإنشاء، أن نختار أحد موضوعين: الأول أن نشرح بيتاً شعرياً للمتنبي: “لم أعد أنساه كما كنت أدّعي، خير جليس… إلخ”، والثاني أن نكتب قصة قرأناها أو سمعناها. وكانت حيرتي بين الاثنين المغريين كبيرة، عريضة، شائكة، وأيضاً شائقة، فاخترت الخيار الثالث: أن أكتب القصة التي طالما رغبت تأليفها.
وبدأت التأليف، واكتشفت لذة تسليم القلم إلى المخيلة، واستطعت فعلاً إنجازها بما تبقى من الوقت الضيق في غرفة الدرس، وأن أكتبها بمثل ما ضربتني قصة (جحشه) العظيمة. وأقول عظيمة بما لها عندي وعليّ من تأثير، لأنها جعلتني أطارد الكتابة بخيالي أينما تكون: في الكتب، أو في أحلام اليقظة، أو التأملات المستقبلية. حيث يعبر الروائيون، حين يبدعون الروايات، عن عدم رضاهم بإظهارهم أن العالم صُنع بطريقة سيئة، وأن حياة المتخيل أغنى من الرتابة اليومية.
إن تعمقت البديهية داخل الحساسية والوعي، تكون أكثر قدرة على المجابهة، على عدم قبول أكاذيب أولئك الذين يرغبون في إقناعنا بأنهم يعيشون من أجلنا وهم يعيشون بشكل أفضل منا وبطمأنينة أكبر منا، بينما نحن بين القضبان، وتحت رقابتهم. باتت القراءة تحول الحلم إلى حياة، والحياة إلى حلم. كما روت لي (جدتي) أن أولى الأشياء التي كتبتها، أو التي تخيلت أنني كنت أحاول التمكن من كتابتها على ورق الكرتون الأنيق، وأرسمها بقلم (الماجيك)، مقلداً بعض ما وقعت عليه يداي من مجلات (سوبرمان)، (الوطواط)، (المغامر)، (ران تان تان) المثيرة.
كانت متواليات القصص التي قرأتها، أو التي حلمت بها، قد فرضت عليّ وقعها، وكأنني عشت بطلاً من أبطالها، لأنني كنت أشعر بالحزن على نهاياتها، أو لأنني رغبت يومها في تصحيح نهاياتها.. بينما كنت أنضج. فالقصص التي ملأت طفولتي بالحماسة والمغامرات، هي الآن تحضر وتُكتب بذهنية ما حصل عندي من رؤية، وكما حدثت لي من أحداث، فأنا بطل جميع تلك القصص التي كتبتها، ولن أتنكر منها أبداً، لأني عشتها مضاعفة. أقول مضاعفة لأن القلم قد دوّن بضعف، لأنه قلم، مهما كانت له مقدرة على الإيصال، فإنه غير قادر على موازنة كوابيس الحياة الحقيقية المرعبة التي يعيشها العراقي، حيث اليوم يمرّ عليه أفضل من الغد، وهلم جراً.
فالقلم علّمني أن أقرأ جيداً، وعلّمني أن أركض خلف الأشياء المتحركة لأثبتها كما الكاميرا الرقمية، ورحت أقرأ وأقرأ، لأشحن كاميراتي الذهنية بالمعلومات، حيث علّمني (فلوبير) أن الموهبة نظام متدفق يدفع للقراءة تلو القراءة بالصبر الطويل. كما علّمني (فوكنر) بأن الشكل، الكتابة والبنية، هو الذي يحيل الموضوع كبيراً أو فقيراً. بينما (سيرفانتس) و(ديكنز) و(بلزاك) و(هيجو) و(تولستوي) و(كونراد) و(توماس مان) علموني بأن الاعتداد بالنفس والطموح هما أيضاً مهمان في رواية الرواية بقدر المهارة الأسلوبية والإستراتيجية الحكائية.
كما علّمني (سارتر) بأن الكلمات هي أفعال لها بصمة على الواقع المعاش لأجل التغيير، وعلى الرواية أن تكون كالبحث (الأكاديمي) تحفر إبستيمولوجيا وتلتزم الراهن كخيار حسن، إذ يمكن لها أن تغير مجرى التاريخ. وأيضاً علّمني (كامو) و(أورويل) و(كازنتزاكي) و(ماركيز) و(عبد الرحمن منيف) و(إدوار الخراط) و(محيي الدين زنكنة) بأن أدباً عديم المثل هو أدب غير إنساني، بينما وجدت عند (مالرو) و(بورخس) و(يوسا) أن ثمة مكاناً للبطولة والشعر الملحمي في اللحظة الراهنة، كما كان عليه الأمر في عصر الإلياذة والأوديسة.
وعلى الرغم من (دوستويفسكي) فقد ألهمني بأن كل من حولي يصلح لأن يكون بطلاً يُضرب به المثل. كذلك (الأخوان رحباني)، بصوت فيروز، جعلاني عالي الحساسية، ومتذوقاً جيداً لكل موسيقى. أما (جورج لوكاتش) فكان يرى أن على الأديب أن يختزل في شخصياته ومواقفه أبعاد عصره ومشكلاته الكبرى، وأن يجمع في نماذجه المصورة بين اللحظة الفردية والاجتماعية معاً.
وجدتني أتوقف طويلاً عند محطة (غاستون باشلار) لأتأمل جماليات الصورة والمكان، لأنني عهدته خير دليل في مدينة الكتب الطيبة، كونه أكد لي أن الصورة، أو الشكل، في مقابل المادة أو المضمون.. فمضيت قدماً أعيد قراءة (أدونيس) شعراً وبحثاً، فوقعت في بنية العقل العربي بين ثابته ومتحوله. ولم أعلق إلا في مجهود مشروع (الجابري)، حيث قرأت العقل العربي بأثافيه الأربع، فأرشدني إلى متن المتون، وأيضاً أثافي رد فعل العقل العربي المقارن بالغربي المتنامي بتطوره لـ(جورج طرابيشي[4]) بلواحقه الفريدة العريضة.
عرفت منه الكيفية الموضوعية المسقطة علينا من بحر الظلمات الباهر، أما (طه حسين) المعلم الأول فقد علّمني كيفية الإصرار على وضع النقاط فوق حروفها. وصرت أبحث في المتخيل (الرواية) عن الذي لم نُعبّر عنه، من دون الحاجة إلى قول ذلك ومن دون أن نعرفه، نبحث في أغواره عن الحياة مثلما هي عليه. وهي لا تكفي لكي تردم عطشنا المطلق الذي يشكل أساس مساحتنا الإنسانية، وعليها أن تكون أفضل.
نبتكر (الروايات) كي نستطيع التعايش، بطريقة ما، مع الحيوات المتعددة التي نرغب في الحصول عليها حين لا نملك بالكاد سوى حياة واحدة. فكل من (هاملت) و(دون كيشوت) و(أخيل) و(شيلوك) و(عطيل) و(الجبلاوي) و(زوربا) و(رجب إسماعيل) هم رفقتي الافتراضية، أراهم بمحبة يطلّون عليّ من رفوف مكتبتي، ويلوحون لي بأيديهم يومياً، مساندين لي بكل ضرّاء قبل سرّاء. كوني تعلمت منهم أنه يجب أن ندافع عن الديمقراطية الليبرالية بالرغم من جميع (مساوئها)، ما دامت تعنى بالتعددية السياسية، والتعايش، والتسامح، وحقوق الإنسان، واحترام النقد، والانتخابات الحرة، وتناوب السلطة.
(أي تعني كل ما أخرجنا من الحياة المتوحشة وقرّبنا – على الرغم من أننا لم نصل إليها في الواقع – من الحياة الحلوة والمتكاملة التي صنعها الأدب، كما يقول صديقي العظيم (ماريو بارغاس يوسا) الفائز بجائزة نوبل للآداب لهذا العام). أي تلك الحياة التي لا يمكن أن نستحقها إلا بابتكارها، إلا بكتابتها، وإلا بقراءتها.