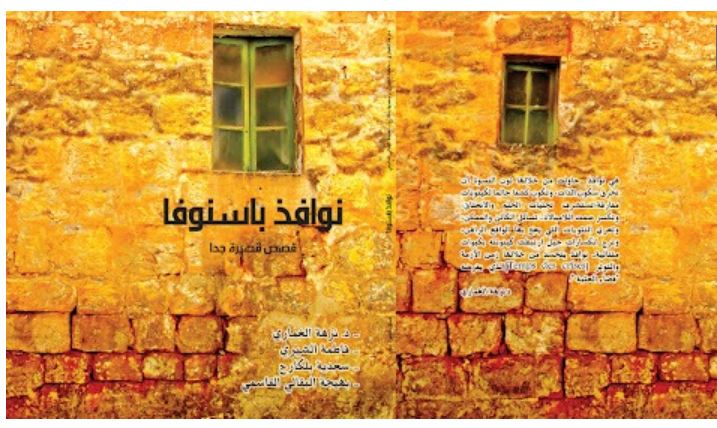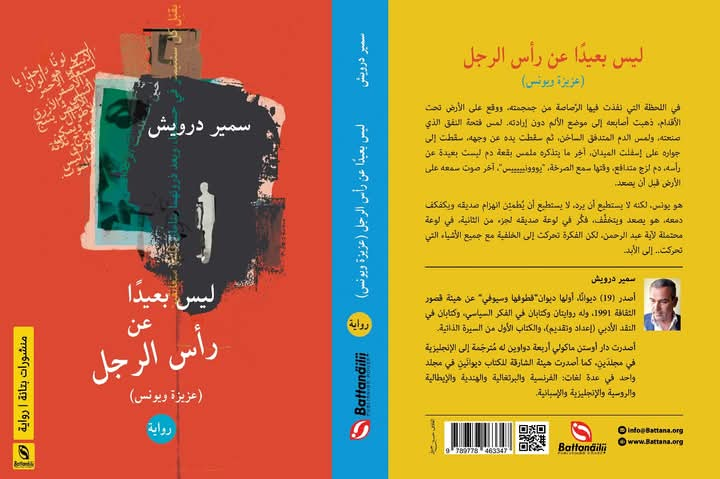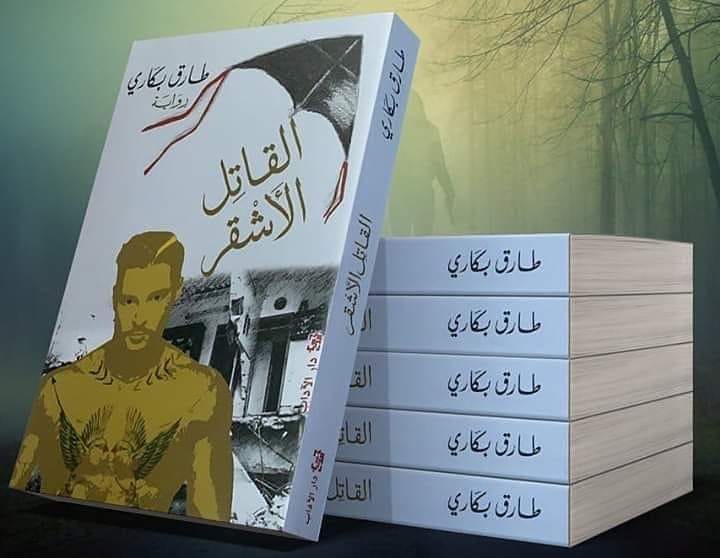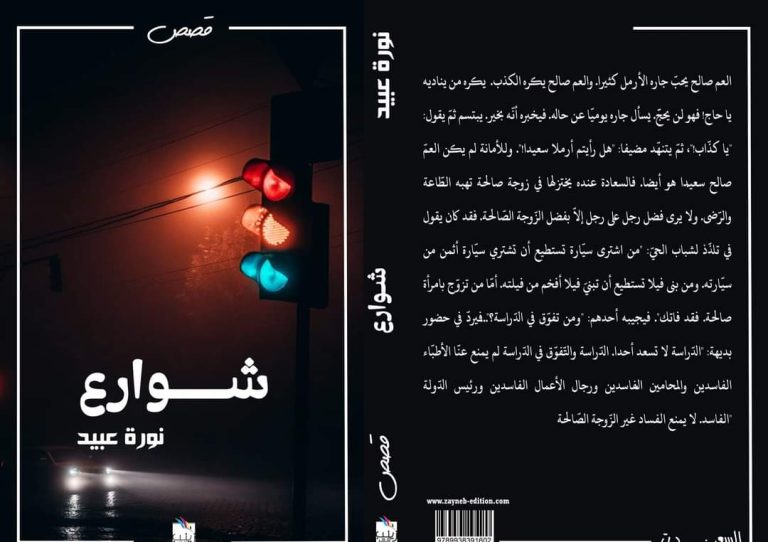د .حمزة قناوي
عنونة ديوان «أنتِ الحزن الأول» تجعلنا نستحضر حالةً من حالات الوجع المخزون، ما يجعلنا نتوقع معه أن يأتي الديوان في معانيه دالّاً على حالةٍ خاصة من حالات الحب المفقود، والوجع المكلوم، بيد أن التلاعبَ الدلالي منذ بداية العنونة يجعلنا نقف أمام حالة الشجن التي يبثها الشاعر (أحمد المؤذن)[[1]] في قلوبنا؛ عبر استخدام تقنياتٍ لغويةٍ تعتمدُ نمطَ المخاتلة، وتوغل في مداعبة مخيلة القارئ؛ فتنطلق في أفق التلقي إلى اللانهائي من الطاقات الممكنة لتوليد المعاني عبر اقتران الكلمات، وكل ذلك يتم معاً وفي وقتٍ واحد، ففي حالة العنونة هنا – العتبة النصية الأولى [[2]] – نجد كلمة «الأول» تؤدي دوراً خاصاً في تحويل الدلالة من مغلقة إلى مفتوحة، ولو كانت العنونة قد توقفت عند قوله: «أنتِ الحزن»؛ فإن المعنى الذي كنا سنفهمه من هذه العنونة سيبدو واضحاً وجلياً، ولا يمكن الاختلاف حوله، فهو تعبيرٌ مُحدَّد يتوجهُ من مُخاطِب إلى مُخاطَبة، يُخبِرُها بما سبَبَّه له تعلقه بها، فهي مصدر الأوجاع والأسى بالنسبة له، وساعتها كنا سنحاول أن نُؤِّولَ سبب الحزن، هل هو الفقد؟ أم عدم القدرة على التواصل مع المحبوبة؟ أو ربما عدم قبول هذه المشاعر من قبل الطرف الآخر والاعتراف بها، لكن بإضافة أولوية لها عبر سمةٍ عَدديةٍ هي «الأول» إلى وصف «الحزن»، نصبح هنا أمام تساؤلٍ دلالي مشروع: ماذا يكون هذا الحزن الأول؟ وما المقصود من إضافة ترتيب «الأول» إلى «الحزن»؟
نحن هنا أمامَ مَجموعةٍ من الاحتمالات الدلالية التي علينا أن نختار أحدها وننحاز له، فهل يقصد الشاعر بالحزن الأول التعبير عن واقعة غرامية لها نتائج محزنة؟ أم كانت هي التجربة الأولى لشاعرنا؟ ومن ثم فإنه يعود لكي يخاطب هذه الحبيبة الأولى، ويؤكدُ أوليَّتَها بالنسبة له؟ وهل هذا التعبير يأتي بعدما خاض الشاعر تجاربَ أخرى- وربما خاض مغامراتٍ أخرى أفضت إلى سيلٍ من الأحزان- ولكن ها هو يعود من جديد إلى الحبيبة الأولى، ويخبرها بأنها هي من كانت حُبَّهُ الأول وحُزنَهُ الأول، وهكذا طوال الوقت يمكننا توليد العديد من المعاني التي لا نستطيع أن نرجِّحَ واحدةً بينها دون الأخرى، بيد أنه في كل هذه الاحتمالات الدلالية تبقى جزئيةٌ واحدةٌ فقط هي المؤكدة، أن من يخاطبها كانت – وربما مازالت – الحبيبةَ الأولى، وأيضاً هي سبب وجعه الأول، وها هو يعود إليها بعد فترةٍ زمنيةٍ طويلة لكي يخاطبها من جديد ويعرِّفها بمقدار ما تركته في قلبهِ من ألم؛ إذن نحن أمام حالة من حالات تأكيد الإخلاص لهذه المحبوبة الأولى، وعدم نسيان ما فعلته في القلب، كل ذلك جاء من إضافة ترتيب «الأول» للحزن، لذا لا نتعجب بعدها إن وجدنا (أي. إي. ريتشاردز) يقول: «إن أهم ما يمتاز به الشعراء هي سيطرتهم على الألفاظ سيطرة تدعو إلى الدهشة»[[3]].
إذن بهذا القدر من التلاعبِ الدلالي الذي وجَّهنا الشاعر به إلى مقدار ما يملكه من مقدرة على التحكم في الكلمات والمعاني، ندخل إلى عالمه، ونحن نتأمل صوَرَه المبثوثة عبر قصائد الديوان، ولا شك أن للصورة أهمية خاصة في تشكيل جماليات التلقي في الشعرية المعاصرة، وتحتل الصورة الشعرية أهمية خاصة في النقد المعاصر، فهي ذات بعد شمولي لما تستطيع أن تحتويه بداخلها من معانٍ مُتعددةٍ قد لا يمكنُ تقديمها مفردةً بهذه الكيفية، وفي الوقت ذاته، ذات ملمح تكثيفي، لما تستطيع أن تختزنه من معطيات[[4]]، وهنا نواجه ثنائيةً عجيبةً في الصورة التي يجب أن يحققها الشاعر، والتي تُعتبرُ برهاناً على تأكيدِ شاعريته، أن تكون الصورة شاملةً، ومكثفةً في الوقتِ ذاته، وقد عاينّا معاً الصورةَ المتضمَّنةَ في العنونة، وما إن نمضي لثنايا الديوان حتى نشاهد العديد من الصور التي تستحقُ أن نقفَ أمامها، ونتأملها كأحد العناصر الدالة على الشاعرية المهيمنة على الديوان المقدم هنا، يقول في قصيدة «شظايا من تعب»:
«شظايا من تعب
أنتِ في خاصرة الوقتِ
شوكٌ يكبل يدي
ودروبٌ بلا مطر
هنا ..
أذودُ عن الحلم المكسور سطوة الظلام
لكن سراب الأماني ..
بلا سقفٍ ..
بلا ظِلال ..
تراكم فوقها الكذب» ص56-57
نلاحظُ هنا أن الصورة الكلية مُركّبةٌ من صورٍ داخلية، وكأننا نشاهدُ لوحةً مجمعةً بقطع الفسيفساء، بيد أن في هذه الحالة، كل قطعة تمثل في حدّ ذاتها لوحة جمالية خاصة بها، ثم إذا ما أردنا ضمها مع القطعة التي تليها اكتشفنا أن هذه الصور تندمج كقطع البازلت معاً مكونةً شكلاً مُتكاملاً يخلقُ صورةً أكبر، وهكذا؛ حتى نصل في النهاية إلى لوحة كبرى مُشكَّلَةً من هذهِ الصور المصغرة، وسنعاين من المقطع المستشهد به هنا كيفية تكوين الصور وتوليدها، وأثرها في التلقي عندما تندمج معاً.
نلاحظ التعبير الاستعاري في قول الشاعر: «شظايا من تعب»، كيف حوَّل المعنوي إلى حسي، كيف يصبح ذلك «التعب» الذي يفترض أنه شيء غير مُدرَك، إلى مُدرَك، وكأننا نراه أمامنا وقد تمت تجزئتهُ إلى قطع صغيرة، إلى شظايا متناثرة، ولما كنا نعتادُ استخدامَ مفردةِ شظايا مع القنابل والمتفجرات، فإننا نستحضر هنا معنىً ضمنياً يعودُ أثرُهُ على المُتكلّم، على الشاعر، والمتلقي في الوقت ذاته، فنتخيل مقدار ما أصبح يُلمُّ بهذا الانسان الذي وقع ضحية قنبلة التعب المتفجرة، فانتشرت في جسده الشظايا، بهذه الخلفية المدهشة من القدرة على تصوير مقدار الوجع القائم، نمضي في ثنايا الصورة الكلية الأكبر.
ثم يأتي توصيفُ الشظايا ب« كونها من تعب»، دون أن ينفي ذلك معنى الشظايا الأخرى، وكأن الشخص الذي نتخيل أنهُ وقع ضحية هذه الشظايا طالته أنواعٌ متعددةٌ منها، بيد أن ما يركز عليه الشاعر هو التعب، وما إن ننتقل من هذا السطر الشعري إلى الذي يليه حتى نشعر بنقلةٍ نَوعيةٍ في الصورة الشعرية، فأسلوب الخطاب يختلف تماماً، والصورةُ يحدث فيها نقلة نوعية، فينتقل الشاعر من الوصف المقرر من دون زمان ومكان في «شظايا من تعب»، إلى توجيه الحوار إلى مخاطَبةٍ أنثى: «أنت في خاصرة الوقت»، فهنا نفترض أنه يخاطب المحبوبة، وقد حوّلها إلى كائنٍ أثيريٍّ أسطوري، وحوّلَ الزمن إلى جسد، له سماتٌ محددة، أو قُل تشبيه الزمن بجسد إنسان، وبما أن الزمان بالأساس يحتوي الأحداث والمكان والإنسان بداخله، فإن محبوبته قد اختارت أن تتواجد في «خاصرة الوقت»، وهنا نجد معانيَ متعددةً من الضبابية التي تجعل المحبوبة أشبه بكائن أسطوري لا يمكن الإمساك به.
إذن لدينا صورة الشظايا المتفرقة من الألم، ثم لدينا صورة المحبوبة الغائرة في الزمن، والموجودة في مكان لا يمكن الإمساك بها فيه، وبينما نتوقع أن يكمل الشاعر في وصف هذه المحبوبة، أو ما فعله بها الزمن، نجده يقوم بنقلة تصويرية أخرى، وعلى امتداد الديوان يتقن شاعرنا هذه الانتقالات بين أفق المتوقع، ثم التوجه إلى الزاوية غير المألوفة، وقد نشعر أحياناً أنها لا تندمج مع الصورة التي تسبقها، لكن مع التحليل الدقيق نجد نوعاً من السيمترية قد ارتسمت من خلال هذا التنويع المدهش، وهنا نجد نقلة بعيدة عن الصورة التي كانت من قبل، فيقول: « شوكٌ يكبل يدي/ ودروبٌ بلا مطر/ هنا ..»، سنتعامل مع هذه الصورة كأنها جزءٌ واحد، كأن عناصرها تشكل لوحة خاصة بذاتها، ونبدأ من النقطة التي تير حالة من حالات الدهشة: ما الشوك المقصود والمشار إليه هنا؟ إن الشاعر يصفُ شيئاً ما بأنه شوك، وهذا الشوك ينتج عنه أنه يكبل اليد، رغم أن المفترض أنه يوجِّهُ اليد، لكنه يتحول إلى قيد يغلُّ اليد عن الحركة، فما هذا الشوك؟ هل هو ضياع المحبوبة عبر الزمن؟ أم هو شظايا التعب التي تحدث عنها سابقاً؟ أم ماذا؟ كيف يمكن أن نصل لتحديدٍ قريبٍ من التأكيد حول ما يقصده الشاعر من مفردة «شوك»؟ يمكنناً مبدئياً قبولُ حالةٍ من المعنى الوسيط بأنه رمزٌ لشيءٍ مُوجِع، وأن هناك تجاوزاً في المعنى من الحالة الشعورية، إلى الحالة الناتجة عن وفرة وجود هذا الشوك في اليد ما أدى إلى تكبيلها، وغلها، وأيضا لا نعرف غلها عن ماذا؟ ما الشيء الذي كان يريد أن يصل له الشاعر لكنه لم ينجح في الوصول إليه؟
نشعر هنا أننا أمام حالة من حالات التأجيلية الدلالية بتعبير الدكتور (محمد عبد المطلب)، يقول: «وبما أن الخطاب لا يطرح غالباً أي إجابة أو استجابة لهذه الإنشائيات؛ فإن التأجيلية الدلالية تصبح صاحبة السيادة.» [[5]]، وينجح (أحمد المؤذن) طوال الوقت – ومنذ العنونة – في رسم الصورة ذات «التأجيلية الدلالية»، بدليل أننا طوال الوقت في المقطع الشعري المقتبس نشعر بأننا لا نمسك بمعنى نهائي، وإن كنا نشعر بألفة مع المعاني الواردة إلا أننا في الحقيقة لا نجد معنى متشكلاً من كل هذه الصور، ورغم ذلك ينجح المؤلف في أن يجذبنا بقدر كبير من التشويق لانتظار ما سيتولد من كل هذا، فنمضي معه من الشوك، إلى الطرق التي بلا مطر، ونضطر هنا أن نؤول وصفه تعبيراً عن الجدب والقحط الذي أصاب هذه الطرق، فأصبحت بدون زرع، وبدون انتاج، ثم يتم جمع هذه الصور المتنافرة معا عبر حصرها مكانياً، فيصبح كل ذلك موجوداً في منطقة محددة، معروفة بعينها، موجوداً: «هنا».
إذن لدينا حتى الآن امرأة في اللازمن واللامكان، ولدينا في الوقت نفسه اللاطريق والشوك الذي يغلُّ يدَ الشاعر، وتحديدٌ مكاني بــ «هنا».، أي في داخل الديوان، أو داخل الصورة المتولدة عن الديوان، وكل ذلك معانٍ مؤجلةٌ مستمرة، ولا نستطيع أن نجد القرينة التي تساعدنا على ترجيح شيء دون الآخر؛
يفاجئنا الشاعر ( المؤذن) بنقلة كبيرة من خط وصف المحبوبة إلى المطلق، فيقول: «أذودُ عن الحلم المكسور/ سطوة الظلام/ لكن سراب الأماني ../ بلا سقفٍ ../ بلا ظِلال ../ تراكم فوقها الكذبَ».
هنا ننتقل من المحبوبة التي لم نتعرف عليها بعد، و لم نستطع الإمساك بها إلى ذات الشاعر، التي تعاني انكسارها وتشظيها، ولا شك أن ظاهرة التشظي مع الاغتراب إحدى سمات الشعرية العربية المعاصرة، في ظل الأجواء التي تعيشها الأمة العربية حالياً، وامتداد الإشارة إلى المحبوبة، ثم عدم قدرة الشاعر على التواصل مع هذه المحبوبة، هو خطٌ مُستفيضٌ منذ جيل الستينياتِ ومنذ تأصيله مع شعراء الستينيات إلى الآن، وتأتي «بلا سقف/ بلا ظلال» كتأكيدٍ كاملٍ على الضياع الكبير الذي يشعر به الشاعر، وكتعبيرٍ وسمةٍ على العصر الراهن وما تمر به المنطقة من الفوضى، ومن الإخفاق المستمر.
في مجمل قصائد الديوان الذي بين أيدينا نجد خطاً من الدمجِ بينَ الذاتيّ العاطفيّ والعامِ القومي، وإن كنا نشعر بأن هذا الخط يأتي على استحياء وبدونِ الاستفاضة فيه، إلا أن هناك إشاراتٍ داخلَ الصور التي يرسمها شاعرنا لا يمكن أن نتجاهل إشارتها إلى هذا الأمر، فعلى سبيل المثال يقول في قصيدته «في استهلال الغزو الذي»:
«فكيف لي ..
أغض بصري عن قوافل الحناء
وزيت العمر يشتعل
وسياط الصمت ..
وئيدة الفتك فينا ..
تخلفنا
شجرةً ينهشها قدوم الخريف
ثم لا نرسم ..
في مرايانا ..
غير آهة تعبٍ ..
فقد محطته الأخيرة
قبل أن نفتتح طقسنا
أنا وأنتِ .. »ص62-63
رغم أنه يمكن تحميل كامل المعاني الممكنة للصورة هنا باعتبارها تعبيراً عن شعورٍ داخلي، وعن حالة خاصة من حالات الفقد والألم بين الشاعر العاشق، وتلك المحبوبة التي فارقته ولم يعد للوصول والوصال إليها من سبيل، إلا أننا نقف أمام بعض المفردات التي يمكن إسقاطها على الواقع الذي نعيشه، ونشعر بها غريبةً في هذا السياق عن واقع صورة العشق المرسومة، فالإشارةُ إلى القهر الذي أوجده الصمت، حتى أنه تحول لسياطٍ تفتك، ثم ما نتج عن ذلك من تخلف، وضياع العمر مع آهة التعب، وفقدان الأمل في المستقبل القادم، كل ذلك يمكن أن نعده إشارة من إشارات الواقع الذي نعيشه، خاصة مع ربط ذلك بالعنونة التي تحدثت عن الغزو، فإننا نجزم بأن الشأن العربي العام حاضر وموجود بقوة في ثنايا النصوص المقدمة هنا، لكنها لا تأتي بصورةٍ مباشرة، تأتي على هيئة «تلميحات»، قد تكون لها معانيها في السياق العاطفي، لكن أيضا لها إسقاطاتُها التي لا يمكن فصلُها بأي حال عن الواقع الراهن الذي نعيشه، وعن المشكلات التي تواجهنا.
إذن نحن أمام ديوانٍ يعتمد على الدهشة وغير المتوقع في تشكيل الصورة، ويعتمد على الإحالة إلى مخزون الذكريات لدى القارئ، ولدى المتلقي، مما يذكرنا بمقولة (رولان بارت): «لأن كل نص نسيج جديد من استشهادات سابقة»[[6]] ،وهنا ينجح شاعرنا في التلميح الذي تقرؤه مخيلة القارئ على أنه تصريح، ينجح في أن يقدم نصاً يحدثُ نوعاً من التفاعل والذي يكمله القارئ، فهذه القصائد بدون جهد القارئ، وبدون بنائه للمعاني والإشارات الكامنة فيها، لا تؤدي وظيفتها الشعرية، ودورها المنوط به من المتعة والبهجة، وأقول البهجة رغم أن أغلب القصائد تأتي حزينة ومعبرةً عن حالة خاصة من حالات الحزن، لأنها تمتاز بلغة رفيعةٍ ومنتقاة، توصل المعنى دون أن تنجرف لخط الحزن العميق، توجد حالة من الشجن، لكنه الشجن الواعي المدهش، الذي يستطيع معه القارئ أن يتذوق جمال الصورة، وأن يستشعر روعة التراكيب التي أودعها الشاعر في مجمل قصائده وهو يرواح بين ضبابية التصريح وإيحائية التلميح.
.………………………..
[1] – أحمد المؤذن: أنت الحزن الأول، دار أركان للنشر، القاهرة، 2021 م
[2] – بسام موسى قاطوس: سيمياء العنوان، وزارة الثقافة، عمان – الأردن، 2001م، ص53
[3] – آي.إي ريتشاردز: العلم والشعر، ترجمة: د.مصطفى بدوي، مراجعة: سهير القلماوي، مكتبة الأنجلو، القاهرة، د.ت، ص46
[4] – جان كوهن: اللغة العليا: النظريّة الشعريّة، ترجمة: أحمد درويش، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1995 م، ص 145
[5] – محمد عبد المطلب: هكذا تكلم النص: استنطاق الخطاب الشعري لرفعت سلام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1997م، ص 233.
[6] – رولان بارت: نظرية النص، ترجمة: محمد خير البقاعي، مجلة العرب والفكر العالمية، بيروت، عدد 2، 1988م، ص 96.