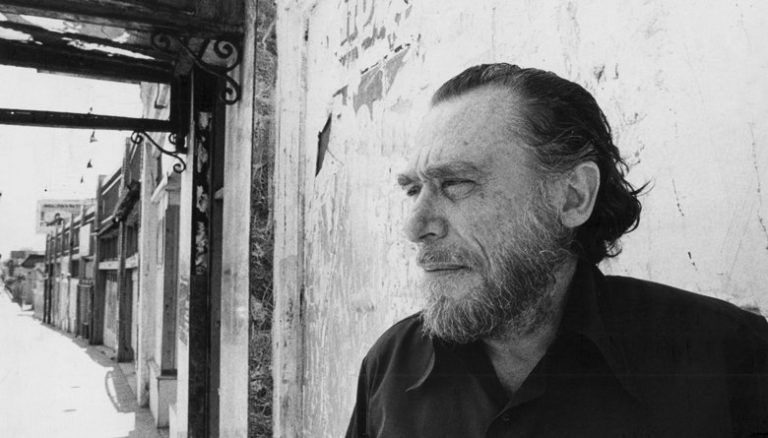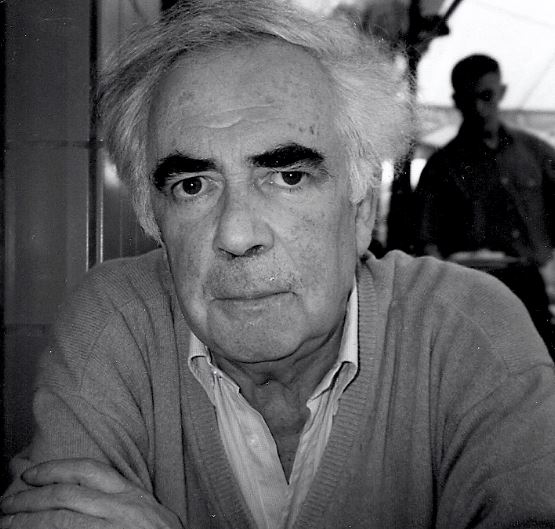روبرت أولن باتلر
ترجمة: خالد العارف
ماذا على أم أن تفعل بعالم مليء برجال خطيرين بشكل أخرق؟ مثل جميع أمهات العالم، أنا عالقة مع القيصر فيلهلم البربري، المتخم بذاته، والفارغ مثل المنفوش مع ذلك، وذلك المعلم الأبله ذي النية السليمة، وودرو ويلسن– فقد عرفت رجالا مثلهم طوال حياتي، حيث كنت قريبة من الوعاظ والمدرسين وكذلك أبي رحمة الله عليه، الذي كان نوعاً من المزيج بينهما، رجال واثقون أنهم يقبضون على أشياء لا يستطيع رجل القبض عليها بشكل مؤكد— وبلاك جاك برشين، رجل من نوع آخر، مثل الرجل الذي تزوجته، رجل بأيادي خفيفة وواثقة، أراهن على ذلك، وبرابط وثيق مع رجال آخرين تحت أي علم—أمريكي، لأجل الجنرال جاك وجاك زوجي—ولا شيء في العالم يمكنه إضعاف ذلك الرابط أو تليين تلكم الأيادي. ابني رجل أيضا، طبقاً لقانون التجنيد الإجباري، لكن ليساعدني الله إذا تركته يصبح رجلا في النهاية من دون معركة.
هذا شيء أعرفه مثلما تعرفه أي أم. الولد لم يصبح رجلا كلية مادمتُ أتذكر بشكل واضح كيف كنت أرفع جسمه الصغير وأضعه على مستطيل قطني نظفْتُه بماء الغلاية المُغلى؛ مستطيل دفأتْه الشمس، ثم أقمطه وأحضنه وهو وديع وهادئ، ثم أحمله، وأوصله إلى العالم، وخلال ذلك كله يدرك الأشياء التي أعرفها كوني أمه، كوني امرأة، لكنني لا أستطيع التعبير، لا أستطيع أن أصفها بالكلمات عدا أن أحضنه بين ذراعي وأهمس إليه بتحنان مخبرة إياه أنه طفل صالح وأنني أحبه.
إنهم يأكلون الجرذان. سمعت الناس يتحدثون عن ذلك. يعيشون في المياه الملوثة، لذلك تنتفخ أرجلهم وتتعفن. لا يمكنهم النوم خوفاً من الأسلحة. يتقاتلون. ابني أُخِذ إلى حياة بهذه الشاكلة. وهكذا وضبتُ حقيبة لأن زوجي جاك مات بسبب الإنفلوانزا ولا يستطيع الآن أن يمنعني وركبت سفينة وذهبت إلى باريس وطلبت خدمة رجل سبق أن أدى ثمن كل حماقات رجال آخرين—إحدى ذراعيه هي مجرد جذع ذراع بسبب الأيام الأولى لهذه الحرب—وساقني في عربته إلى البادية ونِمْنا في الحقول على طول الطريق وكنا في يونيو ولم تكن هناك أمطار وكان يتحدث القليل من الإنجليزية، وفي ليلة من الليالي، حين اقتربنا من الجبهة، قال لي وسط الظلمة البعيدة، من خلف إحدى الأشجار: “سيدتي، أنت تنظرين إلى ابنك، صحيح؟”[i].
فهمت قصده. “صحيح” قلت، “oui”[ii].
كان هناك صمت طويل، ثم إنه قال: “أنتِ أمٌّ لي كذلك، صحيح؟”
“لدي ما يكفيني” قلت، غير واثقة أنه فهم قصدي. لكنه لم يضف شيئاً.
كنتُ أستطيع سماع صوت باهت لخطوات تنحدرعند الأفق.
في اليوم التالي، كانت هناك موجة خفيفة من المدنيين تمر قربنا. قدّرتُ أنهم كلهم قد تركوا المكان هناك في المرتفع أمامنا. لم يكن لهؤلاء اللاجئين أي إحساس بالتعجل، كما يمكن للمرء أن يتوقع، لكنهم كانوا يتحركون بإرهاق شديد. امرأة تمشي حاملة وليدها، رفعت رأسها حين مررنا وبدت عيناها هرمتين رغم أنها كانت شابة إلى حد بعيد. هي ربما شابة في سن ابني. كان يمكن أن أكون جدة الوليد. ألقيت نظرة سريعة فوق كتفي حين مررنا، وأدارت رأسها هي ايضاً.
نظرتُ أمامي مجدداً. إدوارد هو ولدي الوحيد الذي على قيد الحياة، الجندي إدوارد ماركوس غينز من قسم المشاة المائة والثامن، الكتيبة السابعة والعشرين، السرية كذا وكذا. كان ذلك مدوناً في رسالته إليّ. في خندق في مكان ما في فرنسا. لم يكن لديه وليد. واجهنا سوياً، هو وأنا، شيئاً ما في هذا المكان الأجنبي. نهاية دمائنا. فكرت في المرأة التي مررنا بها، فكرت في حمل وليدها لوقت قصيرفقط. بإيقاف العربة كانت ستتوقف هي أيضاً، وكنت سأنزل وكانت لتأتي نحوي وتقول، ربما بلغتها ولكني كنت سأعرف ما عنته، هاك، كانت ستقول. احمليه. وكنت سأحمله، إذن، وبعد ذلك كنتُ سأعيده لأمه قائلة احمليه بعيداً الآن. بسرعة.
رائحة احتراق في الهواء. العربة تصرُّ في الأخاديد على الطريق. مع كل دورة عجلة، كان هنالك صوت كما لو أنها ستنكسر. هذا الرجل الأكتع بجانبي يهمهم لحصانه كما قدّرت. كانت الانفجارات قد توقفت في المرتفع أمامنا. جرفني النوم، ولمدة من الزمن كنتُ في يونكرز[iii] أعتني بوُرودي، وكان الصباح مشرقاً وهادئاً وكان الجو قد أضحى حاراً. كان الوقت صيفاً. كانت الريح تتسكع بتثاقل على كتفيّ. في الحلم كنتُ لوحدي مع الورود وكنتُ أجُزُّ الرؤوس الذابلة. عملت بانتظام، لكن الحديقة كانت مليئة بالورود الميتة. كان المقص يطقطق ويطقطق بصوت يشبه عجلة تدور.
وأفقت على وقع خيام تمر والهدير القريب لمركبات بتصفيح مُدرّع فوقها ونزلت من العربة وشققت طريقى وسط صف من الرجال الحمقى الذين تفاجأوا لرؤيتي، لكنهم كانوا خدومين بشكل مطاوع، وفي النهاية وجدت نفسي أمام ظابط له سلطة التعامل مع احتياجاتي. جلسنا على كراسي من القصب في خيمة تفوح منها رائحة العشب والتراب.
كان ابني قد كتب، أمي، الرجال يعانون هنا بشكل كبير، أولائك الذين هم هنا منذ وقت طويل. هؤلاء هم، عموماً، الفرنسيين والإنجليز والأوستراليين، حيث أتواجد. لقد أضحيت قذراً رغم أن المسألة على ما يرام لأنني أحس أنني واحد منهم. هذا العقيد الذي أمامي ليس قذراً على الإطلاق. إنه نظيف بشكل صحيح تماماً ومنشى وبذلته العسكرية حفّت بالدماثة حين انحنى إلى الأمام وقدم لي الشاي.
“لقد وجدت المكان الصحيح” قال وهو يستلقي جالساً ويقبض على فنجانه بيد ثابتة قبالة وجهه. “لكن عليّ أن أسألك عن السبب. ما الذي ترغبين في فعله من أجل ابنك هنا؟”
لم أكن قد طرحت السؤال على نفسي بمثل تلك الفظاظة. ذكرني العقيد بزوجي. منذ زمن بعيد، كنت قد تعلمت، مع جاك، أن أكون مستعدة للسؤال المباشر. لكنه كان يطلب أجوبة نادراً ما تكون بمثل البساطة التي كان يريدها. لم أكن قد هيأت نفسي للحظة مماثلة مع شخص غريب.
رشفت من شايي.
كان العقيد ينتظر وهو يرفع كأسه إلى شفتيه. بعد أن استقر كلا فنجانينا في صحنيهما وبقيت صامتة لبرهة إضافية، سألني، “هل أنت ضد دخولنا الحرب؟”
“أنا أمريكية،” قلت. “أنا وطنية مثل ابني”.
“أنا متأكد أنك كذلك” قال العقيد. أومأ لي برأسه على نحو ضعيف.
كان وجهه طويلا بلغدين ضخمين، وجه رجل له أحفاد.
كنتُ ما أزال أحاول إيجاد جواب لسؤاله. ولنفسي كذلك. أعرف أن هناك أشياء يجب القيام بها، هكذا كتب ابني إليّ، وأنا سعيد أن أكون الشخص الذي يقوم بها بدلا من شخص آخر. لكنني أخبرتك الحقيقة دائما ماما. أنا خائف.
“ابني لم يطلب مني الحضور.” قلت له. “إنه ولد شجاع.”
“لديه أم شجاعة.” قال العقيد. “أريد أن أراه؛ هذا كل شيء.” لم يكن بوسعي التفكير بشيء آخر لأضيفه إلى ما قلته.
بدا أن العقيد يفكر في أخذ رشفة أخرى من شايه، لكنني أعرف الرجال على شاكلته. لم يكن يحب الشاي في الحقيقة. لم يكن يميل إلى الجلوس بتلك الطريقة الحساسة مع شخص آخر. لم يكن ميالا إلى الاضطرار للتعامل مع أحاسيس لم يكن باستطاعته فهمها. وضع العقيد فنجان الشاي على الطاولة القريبة منه. استدار إلى ناحيتي على شاكلة لاعب بيسبول. حان الوقت للبدء بمهمة أخذ القرار.
“ليس بمقدوري أن أضمن أمنك.” قال.
“أتفهّم ذلك” قلت.
“كيف لي أن أضع براحة بال شخصاً مدنياً، امرأة فوق ذلك، على طريق الأذى؟”
“إنه اختيار أخذته بنفسي.” قلت. “بكل بساطة أريد أن أراه، أن أشجعه. أصدقاءَه كذلك.”
حضرتني هذه الجملة الأخيرة في الحال. كنت أعرف أن ضباط الجندية يهتمون كثيراً بمعنوايات رجالهم. “سيجعلهم ذلك يجتهدون.” قلت، مبتعدة أكثر عن أية إجابة صحيحة عن سؤاله. زمّ العقيد شفتيه ورفع ذقنه. أبعد نظره عني في اتجاه الخارج. رجال كثر كانوا يتحركون هناك خارج الخيمة. كان بوسعي سماع وقع أقدامهم. والهدير القوي لللآليات ذات المحرك. لكنني أبقيت عينيّ على وجه ذلك الرجل.
مر وقت طويل فقال العقيد أخيراً: “الخنادق هنا مبنية بشكل جيد. هناك ثلاثة خطوط منها. واحد في الجبهة. لايمكنك الذهاب هناك بطبيعة الحال. حتى لو كانت نوبة ابنك في الأمام هناك قد حلت، وهو ما قد يكون صحيحاً. لا يمكنك أن تذهبي إلى خط الدعم أيضاً. طلقات الأسلحة الألمانية تصل إلى هناك بسهولة، رغم أنه ليس مستحيلا أن تلحق ضربةٌ ما حتى بهذه الخيمة. سأتركك تذهبين حتى خط الإحتياط. يمكنك العودة قبل الغروب وبدء القصف.
وهكذا، وُضعتُ في سيارة وساقني ضابط شاب وترنحنا بشدة بسبب الأرض المخددة وكان هنالك خيام كبيرة وعلامة الصليب الأحمروأصوات صراخ—أصوات صراخ مكتوم، لكن من الواضح أن رجالا كانوا يصرخون—وأغمضت عينيّ ووضعت يدي على صدري لتهدئة خفقاني الداخلي. وفكرت بابني. ليس بابني إدوارد. في الصيف الذي سبق قدومَه إلى العالم، فقدت وليدي الأول جورج. فقدته في صيفه الثاني. هناك إذن أمهات كثيرات فقدن طفلا في صيفه الثاني. كان ذلك موعد الموت بالنسبة للأطفال. كان عليّ أن أسميه اسماً آخر، أو على الأقل أن أناديه جورجي حين كانت الفرصة متاحة. لم يكن له اسمُ طفلٍ أبداً. سُمّي على اسم والد زوجي، وجاك كان يناديه الرجل الصغير.
وبعد ذلك، اقتربت في النهاية من برية شاسعة بها أنفاق وشديدة الانحدار عند الأفق القريب وصف من الأشجار البعيدة، وكانت الأنفاق مليئة بالحفر الضيقة تمتد على حد البصر وكانت كلها متقطعة وبها زوايا وغير منتظمة، لا تمتد إلى أكثر من عشر ياردات تقريباً قبل أن تنقطع لمسافة قصيرة في اتجاه آخر. قادني الضابط الشاب من السيارة وأصررت على حمل حقيبتي الخاصة وأوصلني إلى مجموعة من الأدراج الخشبية الخشنة ونزلت إلى النفق، كما لو كنا، الوعّاظ وتابعيهم، قد أخطأنا طوال الوقت: هذا الرجل النحيف بأسنانه المهترئة، الذي يلبس بذلة عسكرية باهتة، كان مثل الملاك، وعليك أن توضب حقيبتك وتتبعه نازلا عبر أدراج من جذوع الأشجار إلى قلب النفق وتحس أن كل شيء قد انتهى فجأة، حياتك، لم يكن يمستطاعك أن تتنفس والهواء مترع برائحة الأجساد النفاذة والتعفن والظلال ثتقل عينيك وقطعة السماء الزرقاء في الأعلى مجرد ذكرى باهتة من حياتك الضائعة. ترنحتُ بعض الشيء ووضعت الحقيبة على الأرض.
“هل أنتِ بخير؟” سأل الملازم وهو يضع يده على ذراعي.
“هذا يحدث لنا جميعاً.” قلت له.
“عفوا؟” نحيت اهتمامه بتلويحة من يدي.
تحركنا على طول الخندق حيث اصطفت، على الجوانب وفي الأسفل، ألواح خشبية. كنت أنتبه حيث أضع قدمي إذ كانت البرك المائية في كل مكان، ماء أسود لامع، وكان هنالك مجموعات صغيرة من الرجال المحتشدين، بعضهم نائم في شكل كتلة، ومجموعة أخرى تلعب الورق— رنا وجه من هناك، رجل بلكنة بريطانية قال “ماما” بمزيج من الإعلان والدهشة، فرنت الوجوه الثلاثة الأخرى وكانوا جميعهم ينظرون إليّ مذهولين ولكن بطريقة بها خرس غريب—واستأنفت مسيري وكان هنالك مجموعة أخرى من الرجال يدخنون ويتجاذبون أطراف الحديث بهدوء، ورفعوا هم أيضاً نظرهم وحيوني بإيماءة من رؤوسهم. رجل منعزل رفع يده السوداء جراء السخم وأتى بتحية الصليب—الجبهة، الصدر، الكتف الأيسر والكتف الأيمن.
انعطفنا عند إحدى الزوايا وأمامنا مباشرة كان هنالك عدد من الرجال المتحلقين حول إناء كبير أسود بشع يغلي بقوة. رفعوا نظرهم فاغري الأفواه وتقدم الملازم إلى الأمام يسبقني إلى حافة الإناء، لكنني توقفت وقلت لأولئك الشبان “هل تعرفون ابني؟ لقد أتيت لتشجيعه. وتشجيعكم أنتم أيضاً. إنه الجندي إدوارد ماركوس غينز، قسم المشاة المائة والثامن، الكتيبة السابعة والعشرين.”
“إيدي غينز” قال أحدهم “إنني أعرفه.”
“أيمكنك تشجيع طبختنا العجيبة؟” قال شاب آخر.
“هل تعني أن ذلك هو حساءكم ؟”
“حساؤنا.”
أمعنت النظر في قلب الإناء وكان اللون مثل لون نهر هادسون في يوم هائج. “هل لي أن أعرف ماذا يوجد هنا؟” سألت.
“لا” قالت الأصوات مجتمعة.
“سيدة غينز” قال الأول الذي يعرف إيدي. رفعت نظري وسط عمود من البخار الصاعد من الإناء، وكان بحوزة الشاب آلة تصوير، فتراجع الآخرون والتقط هو صورة لي.
كنا جميعنا واقفين بصمت، وفي لحظة قصيرة وغريبة، كانوا فقط جمعاً من الأطفال، أصدقاء ابني، أتوا في زيارة عابرة من أجل الغذاء. إيدي كان قد دعاهم دون إخباري، وبقينا واقفين جميعنا هناك، مرتبكين بذلك الشكل في مطبخي.
بعد ذلك، فكرت بولدي، وفي المكان الحقيقي حيث هو، وانعطفت بمحاذاة الإناء وكانت تنبعث منه رائحة مثل رائحة ركن في قبو، وكان الشبان يعتمرون خوذاتهم، غامقي البشرة جراء السخام وهذا بلد آخر وتقدمت بجانب ملازمي ومشينا بمحاذاة الخندق إلى أن لمس مرفقي وقال: “هنا”.
انعطفنا يساراً ودخلنا عبر شق مظلم في حائط الخندق فقال: “حاذري أين تضعين قدمك” وكانت عيناي قد خدشهما الظلام بقوة، لكني رأيت انحدار الخطوات في العتمة وانحدرت إلى قلب رائحة تراب حادة نفاذة وباردة. نزلتُ كما لو كان ذلك الملاك ذو الثياب الرثة آتيا من جهنم طوال الوقت وجهنم هي بكل بساطة باردة ومظلمة، ليست ناراً على الإطلاق.
لكننا وصلنا إلى غرفة فسيحة محصنة تحت الأرض وهناك كان سرير من القش ومصباح إعصاري ورجل آخر نحيف والذي هب واقفا من وراء طاولة صغيرة أمامه عليها أوراق. تبادل الرجلان التحية رغم أنه لم يكن هنالك أي كلام لاذع ولا تحية عسكرية، وأعطى الملازم رسالة العقيد إلى هذا الضابط الجديد وأمالها الضابط ناحية المصباح وقرأها.
“هذا القبطان مورغان” قال الملازم، ثم غادر المكان. ألقى القبطان نظرة قصيرة فقط إلى الأعلى وهو يلحظ ذلك، ثم هزّ رأسه هزة خفيفة وفحص الرسالة وكان بوسعي أن أرى يديه ترتعشان بعض الشيء. بدا وجهه غريباً تحت ضوء المصباح. لم يكن بوسعي التمييز ما إذا كان فتياً جداً أم عجوزاً جداً. فتياً، قررتُ، بالنظر إلى جلده المصفر بسبب المصباح، ولكن ناعم مع ذلك، رغم أنه كان هنالك شيء آخر، في عينيه ربما، مثلما في عيني الأم الشابة التي كنت قد مررت بها في الطريق. من الذي يستطيع أن يقول ماذا كان ذلك الشيء؟ شيء آخر متناقض. المَوات، مما قد سبق أن رأوه، لكن حيوية مصطنعة و باهتة كذلك بسبب معرفتهم أن المزيد سيأتي.
أخيراً قال: “قرأت هذه الرسالة مرتين.”
توقف لبرهة كما لو كان يبحث عن مزيد من الكلمات. انتظرت. فتح فمه ثم أغلقه، ارتعش كتفاه شيئاً ما. “نعم؟” قلت أخيراً.
“سأرى ما إذا لم يكن في المقدمة.” قال القبطان.
تركني من دون أي كلمة أخرى.
بقيت واقفة أنتظر هناك لمدة أحسست كما لو أنها طويلة. لم أفكر في الجلوس. كان ذلك مكان القبطان وهو لم يقل لي أن أجلس أو أن آخذ راحتي، تسلق الأدراج فقط وتركني في النفق. كان مكتبه مغطى بالأوراق وخريطة منشورة، ومسدس ملقى هناك إلى جانبهم أيضاً. كان سريره من القش على درج من التراب في غرفة محصنة تحت الأرض. كانت هناك طاولة فوقها بضعة كتب وبعض الجرائد. وهناك بضع صور مثبتة بدبابيس على الحائط الترابي. خطوت خطوة في اتجاهها. كان النور باهتاً والأشخاص صغيري الحجم واقفون في شرفة منزل بهيكل خشبي بكُوّات وشجرة قيقب.
أحسست بعدئذ بشيء ما في هذا المكان. استدرت. لم يكن أحد قد دخل. لكنني بقيت مع ذلك أحس بذلك الشيء. بعدئذ وقع نظري على الأرض وهناك، على دفق نور الكيروسين، رأيت جرذاً بحجم سنجاب. كان جالساً على حوضه يلعق قدمه بهدوء ويمسح وجهه بعدها، مثل قط. كان يتجمل، هذا الجرذ الذي سوف يخرج لاحقا في الليل ليتعشى على الفضلات والجثت. أنا لست امراة سريعة الغثيان. لم أصرخ لرؤية هذا المنظر. لكنني لمست صدري وأمسكت نفسي بقوة هناك لإيقاف الخفقان. بعد ذلك، توقف الجرذ مؤقتاً ونظر فوق كتفه وانحنى واقفاً على أطرافه الأربعة وانطلق مسرعاً إلى قلب العتمة.
بعد برهة، ظهر ولدي. خطوت خطوة في اتجاهه حين كان نازلاً.
“أماه” قال، بصوت فاتر للغاية.
مَثّل ذلك تغييراً فيه. كنتُ دائماً ماما.
كنت مستعدة لأخذه في حضني. لكنني توقفت حين توقف أسفل الأدراج.
وجدت نفسي أتفحص ما حولي بحثاً عن موضوع للثرثرة. “قبطانك” قلت “يبدو…مرهقاً.”
غضّن إدوارد جبهته، راغباً عن الثرثرة وغير عارف كيف يوقفها. قال أخيراً: “كان هنا طوال تسعة أشهر. الضباط يصمدون لمدة ستة أشهر، وبعد ذلك يبدؤون بالتفكك.”
كان علي أن أشفق على القبطان مورغان، لكن الحزن الذي امتلأ به صدري في تلك اللحظة كان لأجل ولدي بسبب معرفته كيف أن الرجال يتفككون. وبسبب مناداته إياي ب “أماه.”
“ماذا فعلتِ؟” سألني.
“أنتَ لست سعيداً برؤيتي.” قلتُ.
“أنا جندي.” قال. “أنا في فرنسا. خط الجبهة على بعد آلاف الياردات. من المحتمل أن أموت هناك هذه الليلة.”
“لهذا السبب أتيتُ” قلت، رغم أنني لم أكن قد فكرت في المسألة بهذه الكلمات؛ أن ولدي، ولدي الوحيد المتبقي، كان يفكر بالموت. لكنه بطبيعة الحال كان يفكر به.
“ستحل نوبتي في الأمام خلال بضع ساعات.” قال.
فكرت للحظة أن أحمله وآخذه بعيداً. اعتراني جيشان وأحسست كما لو أنني، فجأة، كنت قوية بما يكفي لتعليق هذا الطفل الكبير على كتفي وحمله بعيداً. فكرت أنه علينا جميعاً أن نقوم بذلك، كل أمهات العالم. فقط وضبن حقيبة وتعالين إلى هنا واحملن هؤلاء الأطفال إلى المنزل. الأمهات الألمانيات أيضاً. سيتطلب الأمر أن نفعل ذلك جميعاً دفعة واحدة. ولكن عوضاً عن ذلك، بطبيعة الحال، قبلناهم قبلة الوداع وقلنا لهم إننا فخورات وحشونا كنزة مَحيكة في الحقيبة التي يحملون.
“هل كنزتك معك؟” سألته.
“أماه” قال مجدداً، بحدة، مبعداً نظره.
كنتُ قد ساعدته على توضيب حقيبته. كنتُ قد لوّحتُ بعَلم في محطة القطار. كانوا قد أعطوا أعلاماً لكل الأمهات والآباء والأخوات والإخوان والحبيبات ولوحنا بها—بكل النجمات الثمانية والأربعين الآن—وكانت فرقة موسيقى نحاسية تعزف ونحن نصيح مشجعين هيا إلى الحرب. كنا قد نظفنا وجوههم ونفيناهم.
“كان عليّ ألاّ آتي.” قلت.
هزّ إدوارد كتفيه.
“هل لي بعناق وقبلة وداع، إذن؟”
“بالطبع” قال. وقطع المسافة بخطوتين وكان ذراعاه حولي، هذا الطفل الراشد، هذا الجندي، هذا الرجل. تعانقنا وقبلته على كلتا وجنتيه وقبلني على وجنتيّ وكانت رائحته كريهة، ولدي. كان يحتاج إلى حمام، وبعد ذلك غادر صاعداً الأدراج، وفكرت في أن أحمله من حمامه وهو يقطر وألفه في فوطة ثم خنقت هذه الذكرى في الحال. كان ذلك قبل وقت طويل.
جلست على حافة مكتب القبطان. لم أستطع الوقوف. نظرت إلى حقيبتي حيث تركتها في وسط الغرفة. جلست على تلك الشاكلة لفترة طويلة وراقبت دائرة النور على الأرضية في انتظار عودة الجرذ، لكنه لم يفعل.
بعدئذ كان هنالك صوت في أعلى الأدراج. ذلك كان القبطان.
“هل المسألة على ما يرام؟” سألني.
“نعم” قلت.
نزل بهدوء مثل الجرذ ووقف أمامي. أدركتُ أنني أريد البكاء، وبذلت فصارى جهدي لكبح الدموع قبل أن أرفع نظري إليه. فعلت ذلك أخيراً.
كان وجه القبطان معتماً بما أن المصباح كان خلفه، لكنني كنت أستطيع رؤية عينيه الأكثر حلكة من العتمة، ثم قال “لم يمكث هنا طويلا بما يكفي.”
لم أفهم. أحسَّ بذلك.
“ليُقدر التفاتتك” قال. ضغطت لكبح الدموع للمرة الأخيرة. كان القبطان مورغان يتصرف بنرفزة أمامي، محاولا بالتأكيد أن يبقى هادئاً، لكنه بقي يترنح قليلا بشكل دائم من قدم إلى أخرى، وكانت يداه مدفونتين بحدة في جيبيه، ربما لمنعهما من الارتعاش.
“أين هي أمك اليوم؟” سألت.
“أوماها”[iv] قال.
ربتت على سرير القش الذي بجانبي، وتردد للحظة.
“من فضلك” قلت.
. جلس.
رفعت ذراعي وحططتها حوله. أحسست به يرتعش. بعدئذ وضع رأسه على كتفي. برقة، برقة متناهية، قلت “أنت ولد صالح. أمك تحبك.”
…………………..
[i] يستعمل الكاتب صغية الفعل العباري “look at”، لأن الشخصية لا تتقن الإنجليزية. تريد الشخصية أن تقول: “look for”، أي بحث عن.
[ii] بالفرنسية في النص.
[iii] مدينة تقع جنوبي ولاية نيويورك.
[iv] مدينة في ولاية نيبراسكا.