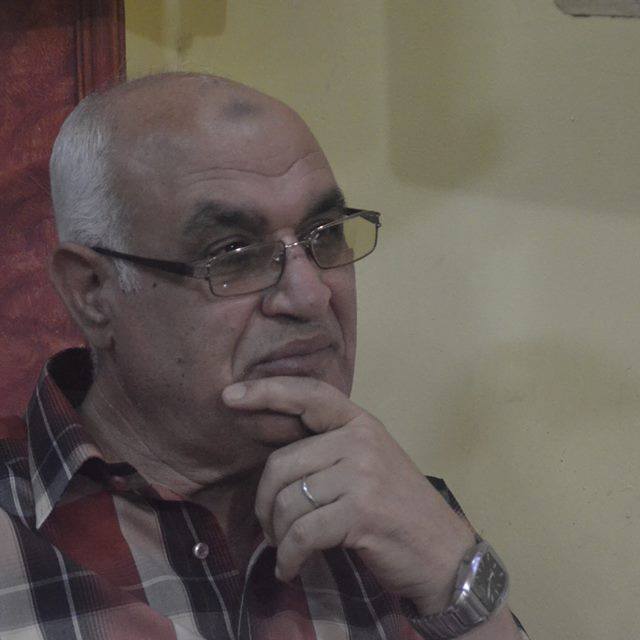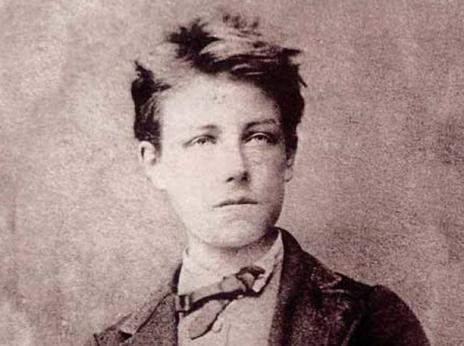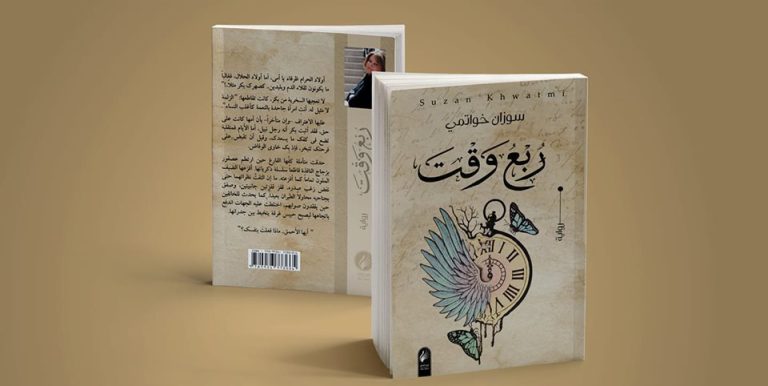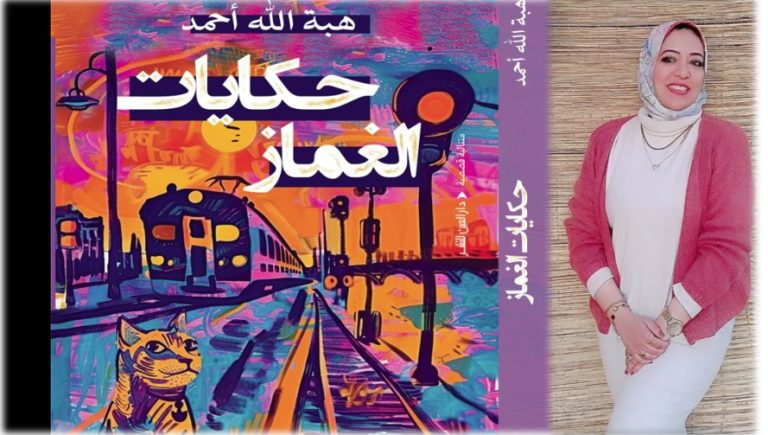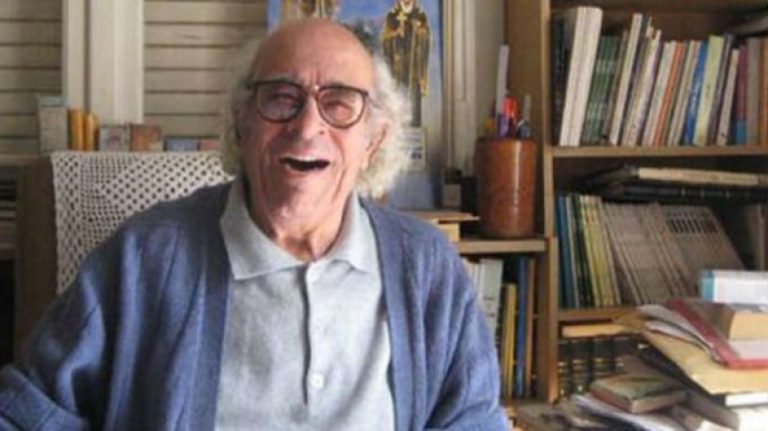شوقي عبد الحميد يحيى
قد يتساءل القارئ- بعد القراءة- عن سبب تسمية القصة باسم “يوم ممطر” على الرغم من أن الأمطار لم تكن كثيفة، ولم تؤثر على الأحداث التي حضرت فيها الحرائق أكثر من المطر؟ وأتصور أن الكاتب لم يقصد المعنى المباشر للعنوان، بقدر ما أوحى للقارئ بأن يستحضر الأجواء المصاحبة لذلك العنوان، خاصة للقارئ الشرقي الذي يعي جيدا أن اليوم الممطر لا يأتي إلا في الشتاء، المعروف فيه التقلب وعدم الاستقرار، وهو ما يوحيه الجدال الذي بين الراوي وذلك الذي قابله فجأة وفي النهاية أخبره أن اسمه “لونيا” حيث يشير الراوي- وكأنها جملة اعتراضية- {بدا كما لو أن الحديث يتجه اتجاها معاكسا للطقس، ويأخذ مسارا غير محمود العواقب}. حيث كان {هذا طقس معتدل يثير الحسد، لا يفسده إلا أخبار الحرب}. فالكاتب هنا يصنع المواجهة، حيث يفرض الإحساس والتداعيات التي يولدها الموقف، وليس الموقف ذاته. وهو ما سار عليه بالقصة، حيث نجد الحرائق التي تسود المجتمعات، بما فيها الأوروبي، والعرب، على حد سواء، وكأن العالم كله قد نشبت فيه الحرائق، والتي وصلت إلى الفرد ذاته. فبدأت القصة بـ {طالعتنا نشرات الأخبار في الأسبوع الأخير بأخبار سيئة عن ارتفاع درجات الحرارة في العالم كله. تركيا تعاني من ارتفاع درجات الحرارة بشكل يقلص أعداد السياح، بينما اليونان وصفت ما يحدث عندها بالحرب الطاحنة، حيث نشبت في عدة جزر منها حرائق واسعة النطاق، وأرسلت مصر طائرات مروحية لإطفاء الحرائق، بينما راحت روسيا كالعادة توجه الحدث في اتجاهات سياسية، وتعلن أنها على استعداد لإرسال قوات الطوارئ والمروحيات الروسية الضخمة المخصصة لإطفاء الحرائق في حال إذا قدمت أثينا طلبا رسميا بذلك. وكانت الجزائر أيضا تتابع العالم بما يجري فيها من حرائق في عدة ولايات، وتتحدث وسائل إعلامها بالإنجازات الجبارة في إخماد الحرائق، وفي الوقت نفسه تبث بيانات غريبة عن استمرارها، وعن الخسائر المروعة..}. ولتنتهي كل تلك الحرائق العامة إلى الحريق الخاص- في بيت “لونيا” الذي {راح يحكي عن الحريق الذي شب في شقته قبل عدة أشهر، وأن المطبخ مليء بالأثاث والصناديق وأثار الحريق تظهر على الجدران من الخارج وتصل حتى الطابق الرابع أو الخامس}. ويمكن هنا فهم الطابق الرابع والخامس بوضعهما الرمزي أيضا.. حيث يمثلان عمق الآثار النفسية التي انتابت (الفرد) جراء تلك النيران المشتعلة في كل مكان بالعالم. تُحرق كل أوراق السيد “لونيا” الشخصية، وكأن الحريق الخارجي، لم يكن خارجيا بقدر ما هو حريق داخل الإنسان ذاته {فسأله: “ماذا حدث بعد ذلك؟ هل تضررت الشقة بالكامل، وهل احترقت أوراقك وأوراق الشقة؟”.. قال إن أوراقه الشخصية كانت معه. لكن أوراق الشقة وكل ذكرياته غارقة في مياه الإطفاء، وصوره وصور زوجته تسبح على سطحها. ضاع كل شيء} فالمكان هنا لازال موجودا لكن الإنسان ضاعت هويته. وهكذا انعكست التقلبات (المناخية) التي أحدثتها الحرائق، كانت هي التي أضاعت هوية الإنسان في العالم أجمع. إلا ان العالم العربي، والشرق أوسطي عامة، كانت تعاني من الجمود والتوقف بالزمن، لتضيع هوية الإنسان فيها-أيضا- {كانت الدول العربية وإيران وتركيا غارقة في قضية حرق القرآن في السويد والدانمارك، وأزمات القمح والمياه، والتركيز على المظالم التي تطولها من الغرب بإهانة مقدساتها، وتقسم بأن الحرب الروسية الأوكرانية هي السبب في نكباتها ومشاكلها الغذائية. وتطالب حكوماتها بمقاطعة البضائع السويدية والدانماركية وطرد السفراء وقطع العلاقات إلى أن تسلم الدولتان مواطنيهم الذين قاموا بهذه الجرائم البشعة. كل ذلك والحرب الروسية الأوكرانية في منتصف عامها الثاني، ولا غالب ولا مغلوب، والأمور تتطور إلى سيناريوهات مخيفة}.
وليست تلك الاهتمامات المختلفة هي فقط التي توضح الفرق بين هنا وهناك، وإنما يأتي ايضا تلك الزيارة لعمل الأشعة والفحص الطبي، حيث نرى هناك، الموعد بالدقيقة، بينما هنا لا ننظر إلى الدقائق ولا حتى الساعات. فقيمة الزمن والإحساس به تختلف هنا عن هناك {وفي الواقع كان لدىَّ موعدان. الأول في الساعة الثانية وعشرين دقيقة بعد الظهر لإجراء أشعة على الصدر. والثاني في الثانية وأربعين دقيقة لإجراء أشعة على الضلوع من الجانب ومن الخلف}.
وعندما أراد– السارد- أن يغير في ذلك النظام- الدقيق- باعتباره (شرقيا) فيطلب لآخر أن يحل محله، فتكون الإجابة الصارمة {“لا تتدخل فيما لا يعنيك. هذا ليس شأنك}. وملحوظة أخرى- بدت لو أنها أيضا جملة اعتراضية إلا أنها تعني أسلوب حياة، وأسلوب تربية، ووعى بدور كل فرد في المجتمع {وكنا بالفعل قد اقتربنا من ساحة لعب الأطفال الخالية تماما منهم في هذا الوقت من المساء}. حيث تنعكس أيضا قيمة الوقت والالتزام بالمواعيد الصارمة.
فضلا عما يستحضره الحوار من استدعاء ومواجهة، ذلك الحديث الذي دار بين السارد والرجل الآخر “لونيا” حول الدين وتأثيره الجذري هنا، وغيابه هناك وتأثيره على تصرفات الفرد، وعلاقته مع الآخر، بقبوله الزواج من تلك الأرمنية رغم أنه لم يكن يعرف أنها يهودية، ورغم ذلك كان الحب هو الجامع بينهما، ليعيشا زوجين فترة طويلة.
وعلى الرغم من أن القصة- القصيرة- قد تبدو متباعدة، زمانيا ومكانيا- إلا أنها تحتفظ بمفهوم القصة القصيرة، إذا ما وعينا أن السرد يتحدث هنا عن زمن ماض، أي أن الراوي يتحدث عن فترة كانت، بدليل أنه عندما تكررت زياراته للبحث عن ذلك الغريب، ولم يجده في مرات عديدة حتى أتت لحظة النهاية، والتي تضع كل ما سبقها في الزمن الماضي {توجهتُ مباشرة نحو مدخل البيت، ضغطتُ جرس باب شقته. خرجت امرأة شابة تحمل رضيعا. سألتها عن “لونيا”. فنظرت إلىَّ في دهشة، وقالت: “لا أحد يعيش هنا بهذا الاسم”}. لتضع تلك النهاية بلا توقف حيث لابد أن القارئ يبحث عن سبب واحتمال سبب عدم الوجود، وما إذا كان قد مات، أو أنه لم يكن له وجود في الأصل، وما هي إلا تهيؤات في داخل السارد، وليعود، القارئ ويتأمل كل ما فات، ويتأمل تلك الحياة هناك، وكيف هي هنا، وليعلم أن القصة تربطها وحدة واحدة، تربطها من البداية إلى النهاية، وهى الفرق بين الشرق والغرب.. ولماذا هم هكذا، ونحن في مكاننا. حتى إذا ما أردنا تصنيف القصة، فنقول إنها قصة تنويرية.
……………………
* مجلة “الكلمة”، العدد 191 يوليو 2024