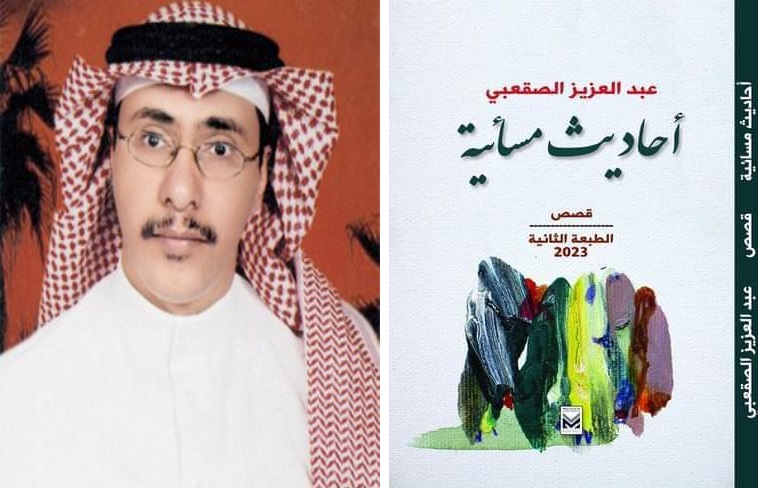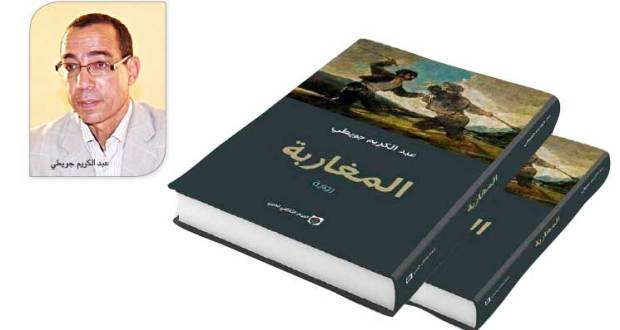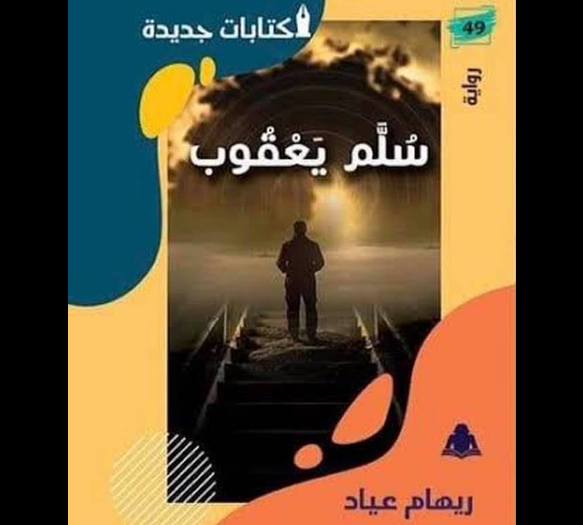سمير مندي
لا تقتصر معاناة “الحَجْر” في رواية “أغنية للشرفة” للكاتبة الأردنية جميلة عمايرة، الصادرة مؤخرًا عن دار “خطوط وظلال-2021م”، على لزوم البيت اتقاءً للوباء، إنما يتحول “الحَجْر” إلى استعارة كبرى تُلقي الضوء على معاناة تتصاعد حدتها بداية من العائلة، مرورًا بالسلطة السياسية، وليس انتهاءً بمعاناة العيش في عالم مثقل بالهموم والخيبات. تنجح “عمايرة”، بمكر، في تحويل “الثرثرة” التي فرضها الحجْر بين جدران البيوت، إلى نوع من الهجاء السياسي شديد الوطأة. خلال ذلك تمزج “عمايرة” الشخصي بالاجتماعي والسياسي من خلال سرد مكثف، يوازي في تكثيفه الضيق ونفاد الصبر اللذين ترزح الكاتبة تحت وطأتهما.
تثرثر الأم، التي “لا تفوتها شاردة، أو واردة”، مع ابنتها حول ما يُستجد من أخبار الوباء، سواء من خلال ما يجري حولها من تغيرات اجتماعية تشل حركة المجتمع وتقلب خط سير عاداته وتقاليده رأسًا على عقب، أو من خلال ما ينقله الإعلام من أخبار وأحداث وتعليمات تَترَى وتتلاحق. تعكس هذه ”الثرثرة“، في غير حال، رواية المجتمع عن الوباء واستجابته له، في مقابل ما يعكسه الإعلام من رواية السلطة وردود أفعالها المثيرة للريَّب. يتبين القارئ، خلال هذه المراوحة بين الروايتين، نبرة الاستياء والسخط السياسي التي يضمرها السرد في رواية “أغنية للشرفة”. على سبيل المثال النبرة نافدة الصبر التي تصطنعها الأم حيال ما تسمعه أو تشاهده من أخبار حول الوباء. فمنع ”المخالطة“، مثلاً، أمر لا يستحق، من وجهة نظرها، إلا السخرية ”إلهي يخلطكن بخلاط كبير لا يخطئ واحدًا منكن“. ربما للحدس القار في المُخيلة الجماعية الذي يرتاب في نوايا السلطة، ويتشكك في دوافعها ومراميها، حتى وإن خفيت هذه المرامي عليه. وربما لأن منع المخالطة قد صادف هوىً في نفس السلطة التي يزعجها أن يتجمهر الناس لأمر أو لآخر. عند ذلك تشتد نبرة التهكم وتتصاعد حتى تغدو الرواية أشبه ﺑ“هجائية”، للتسلط والاستبداد، تزخر بالسخرية والتفكه والتندر على ”أبو الإنسانية جمعاء“ الوزير الذي لا يفتأ يكرر ”الله يحفظكم ويحفظ الإنسانية جمعاء“، أو ”جورج كالوني الأردن!“، وزير الصحة ونقيب الأطباء الذي فتَّن الفتيات بوسامته، فأصبح نجمًا تسخر وسامته وصحته من الوباء الذي يحذر الناس منه، أو مسئول ملف كورونا الذي شَبه الوباء ”بالضبع”: “ماذا ستفعل إذا جاءك “ضبع” وأنت بالبيت؟ بالحالتين يريد الضبع افتراسك. إذا أغلقت الباب أمامه سيدخل بالقوة. لذا دعه يدخل…ربما سيخرج من تلقاء نفسه كما دخل“. ناهيك عن مزحة ”كلب إربد“. أو الفيروس الذي “سيموت وينشف لحالو”!
تضم الساردة/ الكاتبة، من ناحية أخرى، صوتها لصوت الأم فتناكف السلطة برواية تحتفي ﺑ”شرفة“ هي طاقة الحرية الوحيدة الممنوحة لها في عالم البيتُ فيه سجن، والسجن فيه مصير كل من يفتح فمه ليتكلم. تخصص الكاتبة، على سبيل المثال، فصلاً كاملاً بعنوان”احتجاجات وسجن“ تتناول من خلاله ردود أفعال المواطنين على ”أوامر الدفاع“، أو احتجاجات المعلمين على سياسة الدولة تجاه التعليم والمعلمين. تقول: ”تم طعن المعلمين في عقر دارهم، وذُبحت ناقتهم بدم بارد. طُعنوا فجأة بالظهر. وهم يستعدون لبدء الفصل الدراسي الجديد. قامت قوات الأمن باقتحام مقر النقابة وفروعها المنتشرة بالمحافظات، وإغلاقها بالشمع الأحمر. زُج بالرئيس المنتخب وأعضاء النقابة، ورؤساء الفروع والهيئة الإدارية بالسجن. غُطيت رؤوسهم بأكياس سوداء، وكُتفت أيديهم، واقتيدوا كمجرمين قتلة للسجن في مشهد يُدمي القلب“. ولنلاحظ العبارات الحدية التي تستخدمها الكاتبة لوصف “لحظة سلام” أُخذت على حين غِرة مثل “طُعن المعلمين في عقر دارهم”، “ذُبحت ناقتهم بدم بارد”، “طُعنوا فجأة بالظهر”..إلخ.
على أن الابنة، الساردة والكاتبة، تشكو ، أيضًا، من تسلط الأم التي ”تقصف يمينًا ويسارًا“. بل ومن تسلط عائلي أكبر تشعر فيه المرأة بالوحدة والضعف: ”فأنا لست سوى كائن وحيد، لا أملك من الأمر الكثير خارج ذاتي، في عائلة كبيرة وممتدة“. من هنا يلمح القارئ نبرة الشكوى المبثوثة في ثنايا السرد. سواء من القدر العائلي، أو الاجتماعي أو السياسي. تقول مثلاً عن افتقادها لبيت خاص بها، وهي تعطف حالها على حال “المتنبي” الشاعر الشريد والفريد: ”لا بيت لي. لا بيت للمتنبي الشاعر الكبير الذي أحب”. يتفاقم هذا الشعور وتشتد نبرة الشكوى لتتحول إلى صمت يثقل الوجود ”حبسي طويل، وزادي قليل، وصمتي حجرُ“. أو هذه الرغبة الملتاعة في هجر العالم واللواذ بجبل أو كهف ترعى في ظله الأغنام: “ليتني صرت راعية أغنام…الناي بيد وباليد الأخرى عصاي…أغني بلا رقيب أو حسيب. بلا قلق أو خوف. بلا ترقب أو انتظار. بدون تذمر أو شكوى، بلا كورونا أو حظر”.
بذلك ينعطف التسلط السياسي على تسلط عائلي واجتماعي، ناهيك عن تسلط الوباء. والمحصلة النهائية هي ”الحَجْر“. الحَجْر بما هو عزل وعزلة، والحَجْر بما هو حجر على الرأى وتضييق على الفضاء العام، وبما هو صمت ثقيل يجثم على صدر الكاتبة. ليس غريبًا، إذن، أن يتحول ”البيت“ إلى سجن،”أسواره الخارجية شاهقة كانتصاب الحزن“، تتوق الكاتبة إلى الفرار منه حتى ولو قال الناس ”خرجت ولم تعد“. وحتى لو سلط المجتمع على رقبتها سيف الفضيحة والخزي الذي عادة ما يصاحب فرار المرأة من بيتها، أو سجنها.
يوازي الوباء الشبيه ببروفة غير مكتملة للعدم، من منظورٍ آخر، الفراغ القابع خلف ”جملة غير مكتملة“. حيث تتحول الكتابة، الترياق الوحيد الذي يمكن أن يدرأ الفراغ القابع في الخارج، إلى مطاردة للفراغ الذي ينتشر على أطراف صفحة بيضاء يهدد بياضها باستفحال أوبئة الروح وقلاقلها. تقول الساردة: ”أكتب من أجلي روحي القلقة لتهدأ. كي أبدد مخاوفي وأحزاني. من أجل ألا أموت وحيدة. ومن أجل ألا أكون بمستشفى الأمراض النفسية“. لكن الكتابة، لا تتخلى عن الكاتبة وحسب. إنما تخونها “بدم بارد”، تتملص منها، تتبخر من الرأس واليد. فلا تعود قادرة على الإمساك بها. تقول الساردة: ”أكتب بمزاج سيء للغاية هذا المساء، إلا أنني أحاول أن أقبض بقوة على الكلمات التي تفر هاربة مني”. في مقابل إفلات الكتابة وانفلاتها تُهدي الكاتبةُ الكتابةَ جملاً وعبارات غير مترابطة، كأنما ترد لها الصاع صاعين، وتقابل صدودها وتملصها بهروب لغوي موازٍ يترك العبارات مفككة ومهلهلة بلا معنى، تساوي في تفككها تفكك الواقع الذي صنعه الوباء. تقول عمايرة: ”ربما أكتب بكلمات، بجمل غير مترابطة ولا معنى لها. مزاجي عاطل هذا الصباح“.
تشعر الساردة/الكاتبة، في ظل أوضاع كهذه، بخيبة أمل منْ عَرف كل شيء وفَهم كل شيء، وصُدم في كل شيء. تقول الساردة: “أغزل تعب النهار. وحينًا أُخيط بالإبرة. أُخيط مخاوفي وشكي ويقيني. أُخيط أحزاني. أُخيطها بعد أن أمرر الخيط بعين الإبرة الضيقة، كسم الخياط. فتدمي أصابعي. أرتق مشاعري، وألملم جروحي كي لا يسيل دمي أمام أعين الأخرين ويجف قطرة إثر قطرة. أُخيط خيبتي“. ليس من الغريب بعد كل هذا أن تتحول ”الشرفة“ إلى “حصاة” صغيرة تسند أكوام الخيبات التي ترزح تحتها الكاتبة قبل أن تتهاوى فوق رأسها: “حصاة واحدة صغيرة كفيلة بأن تقي صخرة كبيرة من السقوط”.