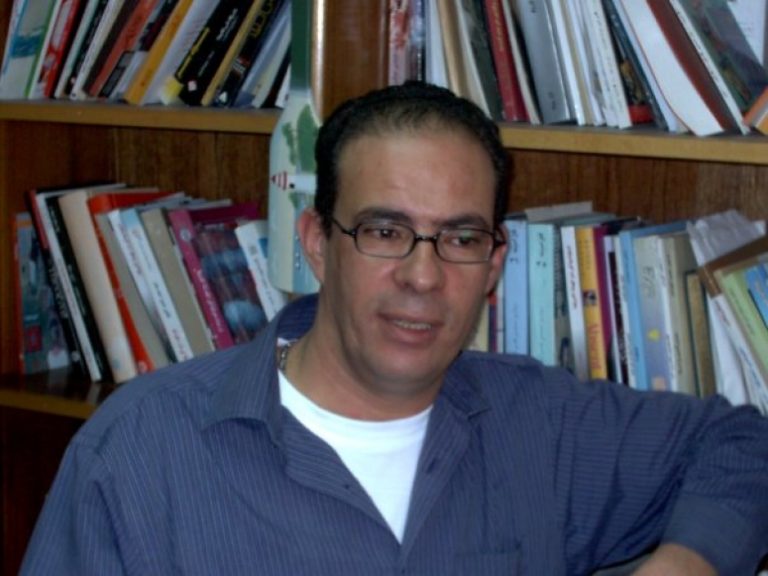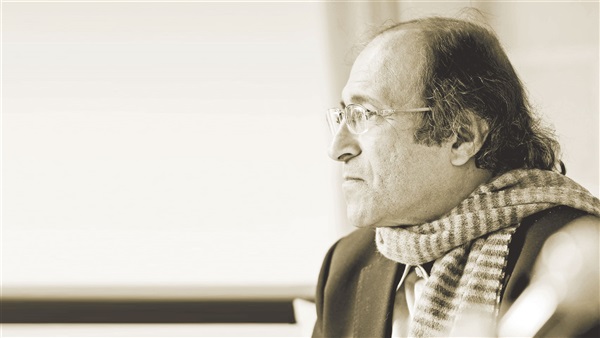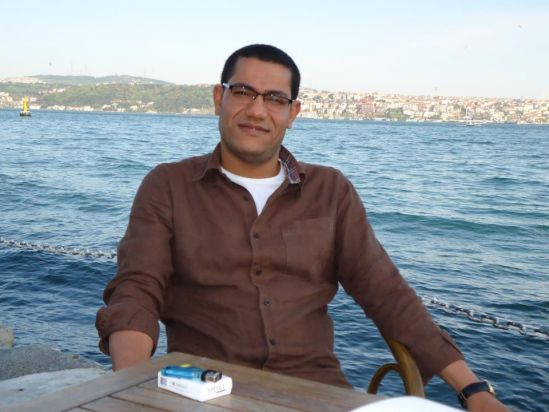يوسف محمد
“العوافي عليك يا أشرف يا ابن الحارة المصرية، صباح الحرية، للصاحب الجدع ابن البلد”
أشرف الصباع إعلامي وكاتب صحفي وقاص وروائي مصري مقيم بموسكو، حاصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء من روسيا، ولد بالقاهرة عام 1962 عرفناه مترجما للغة الروسية للعديد من المؤلفات والدراسات في مجالات الأدب والفن والسياسة، وعمل مراسلا تليفزيونيا لعدة قنوات عربية وعالمية.
بالرغم من إقامته زمنا طويلا في موسكو، وترجمته للأعمال الأدبية من الروسية إلى العربية، إلا أنه ظل يحمل في وجدانه مفردات الحارة المصرية، تطل بوضوح في ملامح الأماكن والشخوص في قصصه ورواياته.
على سبيل المثال، يقول في قصة (الحوض المرصود):
“احتمالات الوصول من بيتنا الكبير، في حارة اليهود، إلى مستشفى الحوض المرصود تتعدد بقدر الحواري والشوارع والأزقة والإحساس بالألم والرغبة في الشفاء، وبقدر تحيات الصباح التي سنلقيها، أنا وروزا، على صبيان المخابز والمقاهي وأصحاب الدكاكين والنسوة اللاتي يعرفنها منذ كانت صغيرة تتسكع مع أمي صفية فرج في حواري الغورية ودروب المغربلين وأزقة الحسين والأزهر، بقدر أنفاس روزا المتلاحقة وكأنها صبية صغيرة خرجت لأول مرة من البيت لتكتشف العالم. كانت أنفاسها، وما زالت، تتردد وتتلاحق حتى عندما تقرأ أسماء الورش والمقاهي وتتذمر من إهمال أصحابها أو العاملين فيها، أو تعلن عن ضيقها بسبب اختفاء أحد الشقوق في هذا الباب أو ذاك أو في هذه النافذة أو تلك، ما يعني أن مجال الرؤية لديها سيتقلص، وستقل احتمالات معرفتها بما وراء ما تراه العين المجردة”.
هنا نجد لغة أشرف الصباع، غارقة في مفردات وثيمات الحارة المصرية، بما تحمله من ملامح شعبية أصيلة، بداية من اسم القصة (الحوض المرصود)، وهو حوض أثري كان يعتقد العامة أن الشرب منه يشفي الأمراض ويحل المشكلات، وانسحب الاسم على المنطقة نفسها، ثم استعراضه لمناطق شعبية ارتبطت في الوجدان المصرية بعادات مصرية أصيلة، وحياة المصريين الأصلاء في هذه الأماكن، مثل حارة اليهود التي كان يقطنها المسلمون والمسيحيون وليس اليهود فقط، والغورية والمغربلين وأزقة الحسين والأزهر، والمقاهي والورش. كأنما رحلت هذه الأماكن معه، وسكنته قبل أن يسكنها.
كذلك في قصة (الورشة):
“يقطع الحارة وهو لم يستيقظ بعد. ينعطف يسارا نحو شارع “اسكندر مينا” المؤدي إلى سوق الوايلي، ومنه عبر المساكن الشعبية إلى شارع بورسعيد. يفتح عينيه بالكاد، وينظر بكسل وحذر يمينا ويسارا. يسرع خطواته ليقطع خط الترامواي، ويتجه إلى شارع الشركات. قدماه تعرفان الطريق جيدا إلى ورشة الكاوتش التي تتميز برائحتها نفاذة حولها، ومشهد كئيب يحيط بها على الرغم من أنها تحتل الطابق الأرضي لعمارة فخمة وضخمة من خمسة عشر طابقا يمتلكها الحاج صبحي صاحب الورشة”.
هنا نجده يستعرض ملامح الشارع المصري، والمساكن الشعبية والتروماوي والورش، بلغة أقرب إلى سيناريو الأفلام الروائية، ينقلنا من مكان لمكان بخطوات سريعة، تُشعر القارئ أنه يسير مع البطل في هذه الأماكن بالفعل، وليس مجرد قارئ لوصف البطل.
من أهم ما يميز أشرف الصباع أديبًا، أنه يتنقل ما بين عالم المدينة إلى عالم القرية بنفس المهارة في قصصه ورواياته، وهذه ميزة لا تتوفر في كثير من الأدباء، وعلى رأسهم نجيب محفوظ نفسه، الذي نادرا ما نجده يتحدث عن القرية في أعماله الأدبية، ذلك لأنه عاش في المدينة، ولم يعش في القرى، على عكس يوسف إدريس الذي قدم من القرية وعاش في المدينة، فاستطاع التعبير عن العالمين في أعماله الأدبية.
فمن الجميل أن نجد أشرف الصباع (ابن المدينة)، وقد أجاد التعبير عن القرية المصرية بمفرداتها وشخوصها، يعيد تفسير الدوافع النفسية للقرويين، ويستعرض ملامح البيت الريفي. يتحدث عن روتين الحياة اليومية لنساء القرية المكافحات، اللائي يستيقظن قبل الفجر، يسحبن البهائم للغيط، يذكر مفردات العلف والتبن، والزريبة التي كانت في بيوت الفلاحيين يربون فيها البهائم، والخبيز. كذلك أعمال الزراعة من زرع القمح والأرز والقطن وجمع المحصول، كأنما يرسم صورة تشكيلية يعبر فيها عن ملامح المكان والشخوص، ويصف حركة الحياة مثل فيلم سينمائي مرئي.
نجد هذا بوضوح في رواية (شَرطي هو الفرح):
“القرية لا تزال منهمكة في سيرة الشيخ السباعي، بينما راحت ملامح نعيمة وأمين تتلاشى تدريجيا. دارنا الكبيرة تعيش حياتها التي لم تتغير منذ سنوات طويلة. النساء يستيقظن قبل آذان الفجر. يقمن بحل البهائم، ويساعدن عمي الأكبر في تحميل العلف والتبن، ثم يتركن له وضع الأشياء الثقيلة على ظهور الدواب. يدخل جدي مهرولا كعادته، بعد صلاة الفجر حاضرا في الجامع الكبير، ويتحرك الموكب اليومي، الذي كان أبي وعمي الأصغر يتأخران عنه دائما. بعد ذلك تنصرف النساء لتنظيف الزرائب، ثم ينقلن المراتب والأغطية إلى السطح في انتظار أشعة الشمس. الكلام لا ينقطع عن الخبيز والغسيل، وموسم تخزين القمح، وري الأرز، وجمع القطن.. في ذلك اليوم، قرب الضحى، امتطى ابن عمي البغلة الصغيرة وانطلق يحمل الغداء إلى الرجال في الغيط. كان يلعن الفلاحة والجد والأب والزراعة والبغلة. قال كلمات كثيرة غير مفهومة. تذكرتُ تأنيب جدي له بالأمس على كسله وهروبه الدائم من مساعدة الكبار”.
يفسر أشرف الصباع من خلال أعماله، مسارات الحياة والسياسة والعلاقات الاجتماعية، بلغة فلسفية متعمقة، تعيد ترتيب الأوراق، وتغير المفاهيم.
ففي قصة: (يبعثون بنا إلى الحرب فنضئ كالشمس في ملكوت أبينا)، كتب: “كل الحروب التي أخذونا من أجلها لم تكن حروبنا، ولا حروب أبنائنا. كانت حروبهم ومصدر رزقهم، وسر قوَّتهم ونفوذهم وثرائهم. كل الحروب كانت تنتهي بقبور كثيرة وأحذية مليئة بالدماء، ودموع أطفال ونساء، وأمهات يبكين حتى العمى وينتظرن رائحة قمصان أولادهن. وكنتُ أنا، رغم كراهيتي للحرب، أزور المقابر وأجمع الأحذية وأكفكف الدموع. وكانت تطربني فكرة الموتى الذين هربوا من الحرب وسكنوا المقابر إلى أبد الآبدين، أو أولئك الذين تركوا أحذيتهم الدامية كشاهد على غياب الجسد”.
يقدم أشرف الصباع، رؤيته للحرب، وإشكالية الصدام بين أحلام البسطاء في حياة مسالمة، وأحلام الأقوياء في السلطة والثروة على حساب البسطاء، الذين تكون نهايتهم القبور والدماء ودموع الأطفال والنساء. ويصف بعبقرية الموت في الحروب، بأنه نوع من الهروب من الحرب ذاتها، وسكنى القبور.
يبهرنا الصباع، بقصصه متناهية الصغر، التي نجح من خلالها في تكثيف المعنى، لدرجة أن قصته موت البرتقالة، عبارة عن سطر واحد، كثف فيه أشرف الصباع المعنى الفلسفي للموت، مقابل الحياة.
“تصاعد السائل اللزج إلى الحلق، كان مرا وحارقا، وأمام العين تكون غشاء شفاف أحمر له طعم حامض، فنزت البرتقالة آخر قطرة وانفجرت“.
يحمل أشرف الصباع، رؤية للمتغيرات التي فرضت نفسها على عالمنا المعاصر، والتي يحاول من خلال أعماله الأدبية والفكرية ” تفكيكها”، معالجا إياها بـ “الصدمة”، كنوع من رفع الوعي ودفع الإفاقة الإنسانية لمواجهة ما اسماه بـ “قرن تعدد الأبعاد والقياسات” في القرن الحادي والعشرين، ومدى خطورته على مستقبل البشرية في القرن القادم، الثاني والعشرين، حيث يقول الصباغ:
“هنا نتوقَّف قليلا لنتأمل اللوحة، أو ببساطة لنطلق العنان لخيالنا بالمعنى العلمي والإيجابي بعيدا عن الشطحات والهلوسات: إذا كان القرن الحادي والعشرون هو قرن تعدد الأبعاد والقياسات، وتراجُع الثقة بالواقع، والتوالد السريع للمهرجين والأفاقين، وتنامى التزييف، والتصنَّعِ، والنَسْخ الإعلامي، والمَسْخ الإعلامي، والأشباه الإلكترونية، والعوالم المتعددة.. إذا فماذا يمكن أن يكون عليه القرن الثاني والعشرون؟ وماذا يمكن أن نطلق عليه؟ وبأي كرامات سيهل علينا؟ هذا إذا كنا سنستمر في الوجود بأحاسيسنا العادية والمألوفة بالواقع!”(1).
ومازال طائر بلاد الشمس محلقا بعيدا – قريبا، يحمل لون التراب المصري في ملامحه، ومفردات الحارة والقرية المصرية في لغته، وإبداعاته القصصية والروائية.
20 مارس 2025
…………………………
- أشرف الصباغ: الواقع أكثر غرابة من الخيال العلمى، زيارة، صحيفة الخليج، 1 فبراير 2016
.