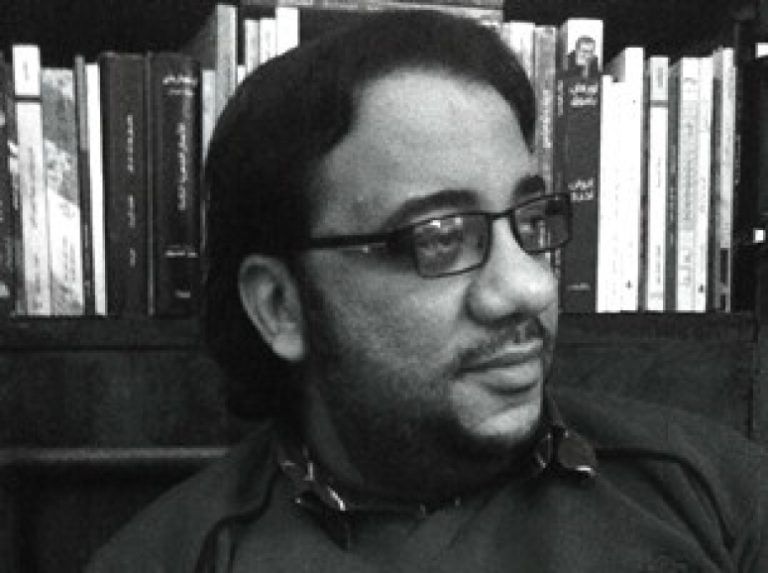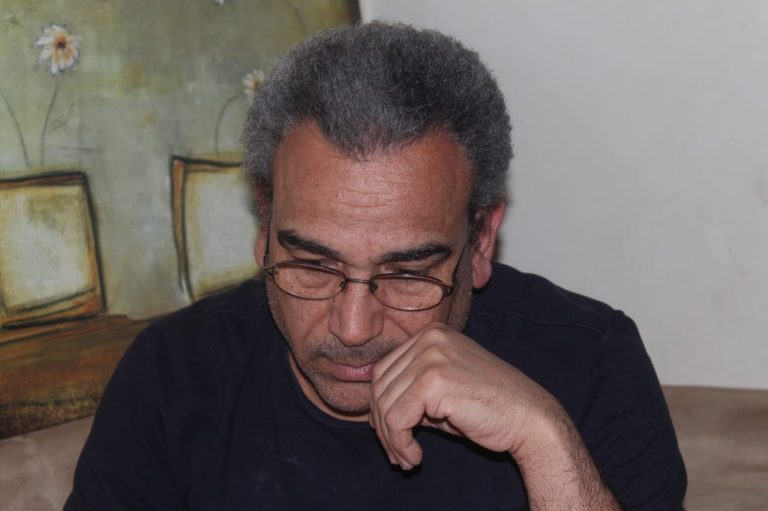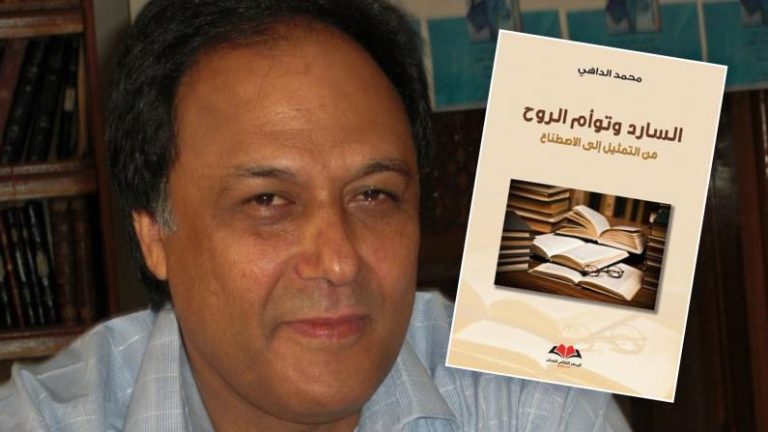حاورته: آية السمالوسي
في رحلة امتدت عبر عقود، بين الفيزياء النظرية والرياضيات والصحافة الميدانية، وبين أروقة الجامعات وساحات الحروب والكتابة الإبداعية، من قاهرة الثمانينيات إلى موسكو السوفييتية وما بعدها، يبرز اسم أشرف الصباغ، ابن جيل الثمانينيات، ذلك الجيل الذي تاهت ملامحه وسط التحولات العنيفة التي شهدتها مصر سياسيًا واقتصاديًا. بدأ طريقه بين رموز المعادلات وقوانين الفيزياء، لكنه وجد نفسه لاحقًا في قلب العواصف السياسية، مراسلًا يتنقل بين ساحات الحروب وأروقة الدبلوماسية وتغطية الاحتجاجات والانقلابات، وكتابة التحقيقات والتحليلات، ومتابعة الصراعات من آسيا الوسطى إلى البلقان، ومن تركيا إلى ليبيا والسودان، ورأى بعينيه انهيارات كبرى، من سقوط الاتحاد السوفيتي إلى اضطرابات الشرق الأوسط.
حصل الصباغ على بكالوريوس العلوم في الفيزياء عام 1984، ثم عمل بالصحافة عقب إنهائه الخدمة العسكرية. وبعد ذلك توجه إلى موسكو السوفيتية لمواصلة دراساته العليا في جامعة موسكو الحكومية- كلية الفيزياء، حيث حصل على الماجستير في الفيزياء النظرية والرياضيات عام 1990، تلاه دبلوم في اللغة الروسية (تعليم وترجمة) عام 1991، ثم الدكتوراه في الفيزياء النظرية والرياضيات عام 1993.
على الرغم من تكوينه العلمي، توجه الصباغ إلى عالم الصحافة والأدب، فعمل مراسلًا لعدد من الصحف والمجلات العربية والدولية، كما أصدر نحو 15 عملا أدبيا بين الرواية والمجموعة القصصية، من بينها “قصيدة سرمدية في حانة يزيد بن معاوية” (1996)، “العطش” (1997)، “مقاطع من سيرة أبو الوفا المصري” (2006)، “رياح يناير” (2014)، “شرطي هو الفرح” (2017)، وأحدث أعماله “مراكب الغياب” (2024).
إلى جانب الكتابة الأدبية، لعب الصباغ دورًا بارزًا في ترجمة الأدب الروسي إلى العربية، حيث نقل أكثر من 20 عملا في مختلف المجالات الأدبية والنقدية والتشكيلية والسياسية، مثل “نتاشا.. العجوز” و”المهلة الأخيرة” لفالنتين راسبوتين، و”تشيخوف بين روتشيلد والخال فانيا”، إضافة إلى أعمال فكرية مثل “كيف تحب وطنًا” و”الوصية السياسية: أفكار بليخانوف الأخيرة”.
أما في مجال التأليف السياسي والثقافي، فقد كتب الصباغ عن تحولات المسرح الروسي بعد الانهيار السوفيتي، وألف كتبًا تحليلية مثل “غواية إسرائيل: الصهيونية وانهيار الاتحاد السوفيتي” (2000)، و”الدروس المستفادة من الثورة الروسية” (2012)، كما تناول بالنقد والتحليل شخصية نجيب سرور في أعمال مثل “نجيب سرور فارس الميثولوجيا المصرية” (2020).
يُعد أشرف الصباغ نموذجًا فريدًا للمثقف المتعدد الأوجه والمسارات، حيث جمع بين العلم والأدب، وبين الصحافة والتحليل السياسي، وبين الترجمة والتأليف، ليترك بصمة متميزة في المشهد الثقافي العربي.
العمل الإبداعي
– البداية من أحدث أعمالك مراكب الغياب، عادةً ما تقدِّم شخصياتك النسائية في أعمالك دون تقديس أو شيطنة أو قولبة، كما جاء في روايتك الأخيرة مراكب الغياب. كيف ترى دورها في الفضاء العام بين الطموح والإحباط، كما في شخصية نورا خطاب، والواقعية، كما في مديحة؟
– في الحقيقة، أنا مهموم بعملي الأدبي قبل أي شيء آخر. كما أنني لا أستطيع الحكم على المرأة أو الرجل، سواء داخل العمل الأدبي أو خارجه. المسألة ببساطة تدور حول بشر محكومين بواقع معين وظروف محددة. ومن ثم، فهم يتصرفون وفق دوافع ومصالح مباشرة، ووفق أفكار تدور في رؤوسهم، وأحلام وطموحات تراوغهم ويراوغونها. والمرأة في هذا السياق ليست استثناء، سواء كانت نورا خطاب أو مديحة. وبالتالي، فإصدار أحكام على البشر ليس من بين وظائف ومهام الكاتب.
– تعرض الرواية نساءً مستغِلّاتٍ ومستغَلّاتٍ، مثل ميرفت أندراوس التي تستغل السياسة لمصالحها. هل يعكس ذلك واقع المرأة في التنظيمات السياسية؟
– أنا لا أعرف ماذا يجري مع المرأة في التنظيمات السياسية، وماذا تفعل، وماذا يفعلون معها. ومن جهة أخرى، لا أستطيع تعميم ما يجري في عمل أدبي على الناس عموما، وعلى المرأة بالذات، في الواقع. ومن المؤكد أن المرأة ليست “كمية” ثابتة أو مفهوما جامدًا- مسمطًا، بل على العكس، إنسان من لحم ودم يتمتع بكل العطايا والقدرات والمواهب وحرية الاختيار التي وهبتها الطبيعة لكل البشر. وبالتالي، فمن الممكن أن نرى ميرفت أندراوس ليس فقط في الأحزاب والتنظيمات السياسية. كما يمكننا أن نرى نورا خطاب أو مديحة في صور وأماكن مختلفة ليست مقصورة فقط على الندوات الثقافية أو الغرز والبارات.
– صوَّرتَ في رواياتك المثقف بين المثالية والعجز عن التغيير، حيث يعاني من التردد بين الواقع والأيديولوجيا. ففي مراكب الغياب، لم يتمكن المثقفون من تكوين أسر أو إنجاب أطفال أو تحقيق إنجازات ملموسة. فهل ترى ذلك دليلًا على فشلهم وعدم قدرتهم على الفعل؟ وهل لا تزال هذه الأزمة قائمة اليوم؟
– المثقفون في رواية “مراكب الغياب” محكومون بظروف وشروط معينة، يعيشون في واقع قاس ومتقلب، وتسير مصائرهم على خلفية تحولات سياسية واجتماعية. وبالتالي، من الطبيعي أن تكون هناك نتائج محددة تظهر بأشكال ودرجات مختلفة على كل منهم وتؤثر عليه وعلى ردود أفعاله وحركته. قد يحقق بعضهم إنجازات محدودة في أوقات بعينها. لكن المسألة ليست في تلك المنجزات المحدودة، بقدر ما هي في علاقة هذه المنجزات ببعضها البعض، وبمساراتها في سياقات معينة تحولها إلى قوة مادية، بحيث لا تظل مجرد إنجازات صغيرة لا علاقة لها ببعضها البعض ولا بالواقع. أما مسألة استمرار الأزمة في الواقع وأنها لا تزال موجودة حتى اليوم، فلا أدري. ربما تكون موجودة بصور مختلفة. لكن الأزمة في العمل الأدبي ظلت موجودة، ومحل نقاش تارة بين المثقفين، وفعل على الأرض بين الأشخاص البسطاء الذين لا يمتلكون رفاهية العصف الذهني تارة أخرى.
وفيما يتعلق بمسألة الإنجاب وتكوين الأسر، فهي ليست دليلا على الفشل وعدم القدرة على الفعل. قد تكون هذه مبالغات من جانب الأبطال عندما يحاكمون أنفسهم في لحظات ضعف أو سقوط. وقد تكون نابعة من إحساسهم بالمهانة وقلة الحيلة والعجز. وربما يفسرها القارئ أو الناقد وفق مرجعيات ثقافية واجتماعية خاصة به، أو وفق رؤيته للعمل الأدبي ككل.
– انتهى رجب الصافوري محبطًا رغم كونه ناشطًا يساريًا، فهل هذه نهاية حتمية للمثقف الثوري؟ وماذا عن رشاد عامر؟ هل يعكس تحوله فقدان المثقف لبوصلته ليصبح جزءًا من المنظومة التي كان يعارضها؟ وفي النهاية، هل ترى أن المثقف في الرواية صانع تغيير أم مجرد شاهد عاجز عن الفعل، كما حدث في رياح يناير، عندما خرج الشعب إلى الشوارع بينما ظل المثقفون في البارات يسكرون وينظّرون؟
– هذا هو واقع الحال، سواء في “مراكب الغياب” او في “رياح يناير”. توازيات ومفارقات وواقع خانق يحول الإنسان إلى مجرد رقم أو “كائن”. ومع ذلك لا توجد حتميات أو أحكام مسبقة، لأن الإنسان أكثر تعقيدا من التفسيرات والتأويلات. وهذا ما نراه في نموذج رجب الصافوري، ونموذج رشاد عامر. لا أحد يمكنه أن يتصور ما جرى لهما من تحولات. لكنها جرت على كل حال.
– في رواية رياح يناير، نجد أنك تتلاعب بالمصادفات كعامل مؤثر في تشكيل حياة الشخصيات. هل ترى أن المصادفة أكثر تأثيرًا من الإرادة الحرة في حياة الإنسان؟
– لا أدري، هل تلاعبتُ أنا بالمصادفات، أم ان المصادفات داخل العمل الأدبي هي التي تلاعبت بالشخصيات وبمصائرها. نحن أمام حالتين ومهمتين مختلفتين تماما. فتلاعب الكاتب بالمصادفات، أمر يدخل في صميم عمله وحرفيته. وأعتقد أنه من الصعب أن يقوم الكاتب بشرح العمل أو توضيح كيف كتبه. فهذا أمر معيب للغاية، من وجهة نظري. أما المصادفات في العمل الأدبي، فهي تتعلق بحياة وعلاقات وعوالم الشخصيات والدوافع والأفعال وردود الأفعال، أي قوانين الدراما. وهذه الأمور تتعلق بفهم القارئ وبطبيعة قراءته وإمكانيته على التلقي. وفي الحقيقة، أنا لا أرى فرقا كبيرا بين المصادفات وبين الإرادة الحرة من حيث النتائج والتداعيات والكوارث التي يمكن أن تحدث.
– كيف تعكس قصة أول فيصل العلاقة بين المجتمع والسلطة في سياق مكافحة الإرهاب؟ وهل تقدم تفسيرًا متوازنًا لأسبابه وتأثيره؟
– أنا لا أريد تحميل القصة أكثر مما تحتمل. إننا ببساطة أمام مفارقات مضحكة بنتيجة سوء الفهم، أو بنتيجة التخبط وانعدام المسؤولية، وربما في ظل التشتت والاستسهال والحسابات الخاطئة. كل ذلك يمكنه أن يسفر عن مفارقات مضحكة لا تلبث أن تنقلب إلى أحداث مأساوية. العشوائية والاستسهال، وتوظيف الموارد في غير مكانها، واستخدام وسائل الإعلام بما يتعارض مع مهامها الأساسية، قد تتسبب فيما لا يحمد عقباه.
– في ضوء المفارقة اللافتة بين أحداث قصتك (أول فيصل) والواقع الذي شهدته مصر لاحقًا، كيف ترى دور الأدب في استشراف الأحداث؟ هل هو نتيجة إدراك عميق للواقع واتجاهاته، أم أن هناك أحيانًا نوعًا من (الحدس الأدبي) الذي يسبق الوعي العام؟ وكيف ترى تفاعل السلطة والمجتمع مع هذه النبوءات الأدبية عندما تتحقق على أرض الواقع؟
– هذا السؤال معقد ومربك ومغري في آن معا. معقد، لأنه يتطلب الغوص في ليس بالضبط في العمل الإبداعي بقدر التوغل في عقل الكاتب وتركيبته الذهنية وعلاقته بالسلطة وإدراكه لحركة الواقع. ومربك، لأنه يُعَرِّض الكاتب بشكل شخصي للوشايات، ويستنطقه خارج سياق العمل الأدبي. ومغري، لأن كل كاتب يحب أن يتحدث عن حدسه ودقته وعظمته ونظام حياته وطريقة تفكيره. في هذا المقام، أنا لا أكتب إلا روايات وقصص وأعمال سردية، وأرى أن الكتابة- الأدب مجرد نشاط إنساني مثل بقية الأنشطة والمهن، واحتياج مثل بقية احتياجات الإنسان.
وفي الحقيقة، يهمني هنا، الجزء الأول المتعلق بصعوبة السؤال أو بتعقيده. المسألة مركبة للغاية، وليسن مباشرة أو ميكانيكية. وبالتالي، هناك أعمال يمكن القياس عليها، لأنها لا تشير مباشرة إلى النتائج، مثل غالبية مؤلفات نجيب محفوظ في الفترة ما بين نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن العشرين. وكذلك رائعة ثروت أباظة “شيء من الخوف”. هنا، العلاقة معيارية بين ما يطرحه العمل الأدبي وبين الواقع وما سيحدث لاحقا. وإن كان ما سيحدث قد يتجاوز ما كان يفكر فيه الكاتب ويتجاوز حدسه وتوقعاته. وهذه وظيفة النقد. وهناك أعمال وضعت مقدمات مهمة لنتائج أكثر أهمية وخطورة، من ضمنها رواية عز الدين شكري فشير “باب الخروج” التي توقعت الكثير مما سيحدث. ومع ذلك يظل العمل الأدبي، عملا أدبيًا يمتلك فضاءات ونوافذ لا نهائية.
قصة “أول فيصل” تتحدث عن واقع عام خانق ومربك يمكنه أن ينتج لنا ظواهر لا نهائية. قد ظهر هذه النتائج بأشكال ومعايير وحدود مختلفة، لكنها في واقع الأمر مجرد موجات متتالية تتسع مع الزمن ومع استمرار الشروط الموجودة في العمل الأدبي.
الكاتب إنسان طبيعي وعادي مثل بقية البشر. وكل ما هنالك هو أنه يمارس عملًا لم يجبره عليه أحد. أي أن الكاتب لا ينبغي أن يحمل نفسه ما لا طاقة له به، ويزعم أنه يحمل رسالة، أو أنه يقف مع قيم الحق والعدل والحرية. هذه أمور يمكن تفسيرها لاحقا. لكن كل ما عليه هو أن يتقن عمله بالطريقة التي تناسبه، وتناسب إمكانياته وطريقة تفكيره، سواء حدسه أو قراءاته أو تحليلاته للواقع، أو حتى المواظبة على قراءة صفحة الحوادث والقضايا وصفحة الوفيات في الصحف اليومية. لكن لا ينبغي، من وجهة نظري، أن نبالغ في الأمور ونمنح الكاتب “صلاحيات” و”أفضليات” قد تعمل ضده هو شخصيا، وضد أعماله، في المستقبل. فالكاتب ليس كاهنًا وليس ضاربًا للودع، وليس نبيًا.
أما كيف تتعامل السلطة مع الأعمال الأدبية التي يتم تأويلها أو تفسيرها بطرق مباشرة، في ضوء ما قد تشير إليه من أحداث لاحقة، فهذا أمر معقد للغاية، تتداخل فيه الوشايات مع التأويلات المباشرة مع سلطة المنع والمنح والرقابة. هذا الأمر خانق ومعتم ولا يبشر بأي خير. أعتقد أن الأعمال الأدبية الجيدة قد تتسع لتأويلات لا نهائية، وقد تتقاطع هذه التأويلات مع أحداث لاحقة. لكن الكاتب يكتب أدبًا أكثر اتساعًا وعمقًا. وربما هذا ما يثير قلق السلطة وموظفيها والأوصياء على الفضيلة والاستقرار وهندسة الوعي العام من أجل صناعة أدب “رفيع” و”نظيف” خالٍ من الهرطقة والمساس بالمقدسات وإهانة الرموز والعبث بالعادات والتقاليد والقيم، وخالٍ أيضا من شبهة التعرض للسياسة والدين والجنس.
المكان في العمل الأدبي
– القارئ لأعمالك يدرك أن للمكان مساحة مميزة ومؤثرة تصل إلى حد البطولة. لماذا نجد لديك ميلًا لوصف الأماكن بطريقة تجمع بين الفلسفة والسخرية؟ هل ترى أن هذه الثنائية تساعد في تقديم صورة أعمق للمكان؟
– سأعتبر ذلك إطراء. فالمكان الميت لا ينتج إلا علاقات ميتة، ولا يضم إلا موتى أو جثثا حية. ولا يمكن أن يموت المكان إلا إذا توقف الزمن. وهذه علاقة تحلينا إلى علوم الفيزياء وطبيعة الوجود ومتلازمة الحياة نفسها. وبالتالي، فالمكان كائن حي في علاقة جدلية متلازمة مع الزمان والإنسان. وبما أن المكان كائن حي يتنفس ويمتلك ذاكرة، فمن الممكن أيضا أن يكون محل سخرية. ومن الممكن أن يحتمل الكثير من التفسيرات والتأويلات. ومع كل ذلك، فالمكان في حد ذاته لا يشغلني ولا يعني لي أي شيء بدون الإنسان. هنا يكتسب المكان قيمته ومعناه.
– تلعب القاهرة دور البطولة في العديد من أعمالك، فكيف ترى علاقتك بهذه المدينة؟ وهل تعتقد أن المكان، وخاصة المدن، كائن حي يتطور مع الزمن؟
– علاقتي بالقاهرة معقدة ومركبة. وأحيانا تكون مرتبكة ومربكة. ويهمني كثيرا ألا تنعكس هذه العلاقة على شخصياتي التي تعيش فيها. من الطبيعي أن يتطور المكان، وتتطور المدن والشوارع. وإذا حدث هذا التطور بمعزل عن الإنسان، فإننا هنا نكون أمام مهزلة تقترب من المأساة. أما دور البطولة الذي تلعبه القاهرة، فهو أمر يكاد يكون “مصادفة”. وربما يكون بنتيجة سطوتها وثقلها التاريخي والإنساني. وربما أيضا لأنها مدينتي التي أرى العالم من خلالها ومن خلال كائناتها ومبانيها وشوارعها وحواريها.
– في مجموعة، أو بالأحرى في متتالية “أبواب مادلين”، هناك حضور قوي للمكان كعنصر نفسي وروحي. فهل ترى أن المكان في رواياتك مجرد خلفية للأحداث أم أنه بطل مستقل يؤثر في الشخصيات؟
– متتالية “أبواب مادلين” تحديدا، هي مرثية العمر التي تنطلق من تاريخ القاهرة وسكان أعرق شوارعها وحواريها ومعابدها وكنائسها وجوامعها. هذه المتتالية بالنسبة لي بمثابة ذاكرتي الشخصية التي لا تنفصل بأي حال من الأحوال عن ذاكرة كل الأماكن والأرصفة والحانات ودور العبادة في مدينتي. وإذا شئنا الدقة، فكل حجر وجدار وباب ونافذة في أي مبنى بهذه المدينة يمتلك طاقة حية، ربما تبقى موجودة حتى إذا تمت إزالة الأحجار والنوافذ والأبواب.
في أول فيصل، نجد الأماكن تتحول إلى مساحات اجتماعية معقدة. فهل تعتقد أن المكان يلعب دورًا دراميًا حقيقيًا أم يظل مجرد إطار للأحداث؟
– أنا أميل إلى فكرة المكان الذي يتحول إلى مساحة اجتماعية معقدة ومركبة. وهو بهذا المفهوم يضم دوره الدرامي وكونه إطار للأحداث. هذه المجموعة تضم عشر قصص مختلفة من حيث الأحداث والأماكن. وبالمناسبة، قصتا “حارس الدباسات” و”زائدة جلدية” تنتميان إلى متتالية “أبواب مادلين”، لكن لأسباب تقنية، تم ترحيلهما ونشرهما في هذه المجموعة. لكنها جزء من متتالية “أبواب مادلين”. وعلى كل حال، يمكن قراءتهما كقصص منفردة مثل بقية قصص مجموعة “أول فيصل”. أما قصة “أول فيصل” نفسها، فهي تبرز المكان ككائن اجتماعي- سياسي حي يحتمل الكثير من التأويلات التي تحمل جانبا من تناقضات ومرارات وسخرية الحياة التي يعيشها المصريون.
– في شرطي هو الفرح، هناك تناقض واضح بين الريف والمدينة. فهل ترى أن الريف لا يزال يحتفظ بسحره في مواجهة التحولات الحضرية؟
– لا يوجد أي سحر للريف إطلاقا في “شرطي هو الفرح”. الريف في هذه الرواية ثقيل وخانق ومرعب. لا يقل مأساوية وإعتاما عن المدينة التي غادرها البطل في رحلة البحث عن نفسه. وفي نهاية المطاف لم يعثر على أي شيء. بل تضاعفت شكوكه، ولم يجد أمامه إلا الوهم ليمتطيه. إنه ببساطة لم يعثر على إجابة واحدة لأي سؤال لديه.
معضلة اللغة في العمل الأدب
– في سلسلة مقالات لك، انتقدت هيمنة اللغة على النصوص السردية والانشغال بالقضايا الشكلية على حساب الخطاب، برأيك، ما السبب الجذري لهذا الهوس باللغة؟ هل هو أزمة نقد أم أزمة كتابة؟ وكيف يمكن تجديد النقد الأدبي العربي للخروج من هذا الجمود؟
– في الحقيقة، السبب هو أزمة “عقل”. لا أستطيع وضع حلول بقدر ما يمكنني طرح المشهد بشكل مباشر، من دون لف أو دوران أو تلاعب. لا شك أن الكتابة والنقد كطرفين أساسيين في عملية الإبداع في مأزق، او لنقل- تجاوزًا- في أزمة.
هناك دلائل كثيرة تشير إلى أن موضوع اللغة عموما، وموضوع لغة الحوار في السرد المصري على وجه الخصوص، سيظلان موضوع جدال خطير يهيمن على المتلقي، ويسفران عن قضايا خطيرة في عملية التلقي نفسها. بل ويهدمان تأثير الخطاب لصالح تأثير اللغة. وعلى الرغم من العلاقة الجدلية بين اللغة والخطاب، إلا أن الخلط لا يزال يسيطر على هذه العلاقة ويصنع حالة ارتباك وهوس تبعدنا عن الهدف الأساسي من وظيفة السرد، حيث يتم التركيز على اللغة لجعلها البطل الرئيس في النص. كل ذلك يجعلنا نخصص المساحة الأكبر لتفسير الماء بالماء. فنجد أنفسنا قد نسينا موضوع النص، ومتابعة الأحداث والبناء والتراكيب النفسية للشخصيات وتصرفاتها وتطوراتها وتحولاتها لتصبح اللغة بطلا رئيسا. وفي نهاية المطاف نجد أنفسنا وقد جلسنا في فصل دراسي من فصول الدراسة الابتدائية لنصحح جميعا موضوع تعبير كتبه أحد التلاميذ من أجل أن نمنحه درجة على لغته الجميلة، ونحكم عليه من حيث قدرته العظيمة على استخدام اللغة والمفردات والمرادفات.
من الواضح أن مشكلة الحديث بلغتين أو ثلاث (الفصحى والعامية وما بينهما) لا يدفع ثمنها إلا النص السردي، أو بمعنى أدق، الأدب هو الذي يدفع ثمن جريمة الحديث بلغتين وثلاث. فعندما نتحدث بلغة واحدة يكون الاهتمام المبدئي بالخطاب وليس باللغة. ومن ثم تسير عملية القراءة والتلقي بشكل طبيعي، وينجح القارئ أو المتلقي في متابعة أحداث العمل الأدبي بصورة طبيعية. لكن عندما نتحدث بالفصحى وبالعامية وما بينهما تنشأ عملية فصل مشينة حيث يتم الاصطلاح على أن الراوي يتحدث بالفصحى، والشخصيات المثقفة تتحدث بالفصحى أو ما شابهها، والشخصيات البسيطة أو غير المتعلمة تتحدث بالعامية.. لنكتشف أننا أمام كارثة حقيقية يدفع ثمنها النص الأدبي والكاتب نفسه، ويتحول أي نقاش إلى جدال حول اللغة ويضيع النص الأدبي في زحمة الانشغال باللغة وعبادتها حد الهوس.
لقد ارتحنا كثيرًا إلى ما تم رسمه لنا منذ قرون على أيدي النقاد ومفسري الأدب ومسؤولي التأويلات الأدبية والثقافية. وأصبحت الأعراف والمعايير والقوانين تملي على الجميع إسناد اللغة الفصحى لفئة معينة، واللغة العامية لفئة أخرى. وبالتالي، أصبح خطاب الشخصية يأتي في الدرجة الثانية أو الثالثة على الرغم من أن الخطاب هو الأساس والرئيس في النص وليس اللغة. وأرجو ألا يتم انتزاع الكلام من سياقاته لنصرخ في هلع: إن اللغة هي وسيلة التوصيل وأداة الاتصال، فكيف نهمل اللغة! لا أحد يدعو إلى إهمال اللغة أو تحييد اللغة. والنص السردي مكتوب أصلا باللغة وليس بالشاكوش. إن الكلام هنا يدور حصرا عن جريمة يتم ارتكابها بقصد أو بدون قصد، وهي إهمال أو تغييب الخطاب لصالح اللغة بنتيجة الخلط بينهما تارة، وعبادة اللغة تارة أخرى.
من الواضح أننا بددنا العديد من الحقب الزمنية على عبادة اللغة لأسباب كثيرة نعرفها جميعا. وهي ليست موضوعنا الآن في السياق الحالي. ويبدو أيضا أننا سنبقى طويلا أسري هذه الإشكالية التي تريحنا وتجعلنا نسير وفق المعايير والقوانين لنؤكد أننا تلاميذ وطلاب صالحين ينفذون ما يطلب منهم من قبل النقاد أو القراء أو لجان الجوائز. فهي- الإشكالية- على الأقل تمنح البعض السلطة لهدم أي شيء وأي نص، وتعطي البعض القدرة على تبرير الكسل والاستسهال والقراءة الهزيلة والهزلية.
من المعروف أنه لا توجد قراءات متشابهة. ولا يتشابه المتلقون. ومع ذلك يجنح البعض إلى سلطة المعايير والقوانين لتوحيد لغة السرد، وتعميق الفصل (لغويًا) بين الراوي والبطل المثقف والسيدة الأمية بائعة الجرجير. ولا يتصور أحد ماذا كان يمكن أن يحدث إذا كنا نتحدث بلغة واحدة في الواقع! إذًا، فلنتصور معا أننا نتحدث بالفصحى فقط أو بالعامية فقط، أو بلغة بينهما. فهل ستكون كارثة اللغة والفصل بين الشخصيات وعبادة اللغة موجودة داخل النص السردي؟!
ربما يكون منطق الشخصية وخطابها ورؤيتها للعالم، هي الأمور التي تستحق الاهتمام بدلا من عبادة اللغة وتأليهها ومحاولة فرض نسق سردي وحواري معين يثير السخرية في الكثير من الأحيان، ويساهم في تكريس حالة التراجع والضعف والهشاشة التي تهيمن على النص الأدبي، أو بالأحرى موضوع التعبير الذي يشغل بال لجنة المحققين والقضاة الذين يجتمعون لمحاكمته هو وكاتبه ويمنحون كلا منهما درجة لاجتياز امتحان اللغة.
– ولكن ماذا تقصد بهشاشة النص الأدبي. وما علاقة ذلك بموضوع الهوس باللغة؟
– لنتصور أن هناك قارئًا يقرأ عملًا سرديًا مترجمًا إلى اللغة الألمانية أو الإنجليزية أو النرويجية. فماذا سيلفت نظره في العمل: بناء الشخصيات؟ تحولات الشخصيات النفسية والاجتماعية والمهنية والوظيفية؟ بناء العمل السردي ككل؟ خطاب الشخصيات؟ خطاب العمل السردي ككل؟ وبطبيعة الحال، فالشخصيات في هذا العمل المترجم ستتحدث بمستويات لغوية واحدة “تقريبا”، وفي الوقت نفسه ستقدم نفسها عبر خطاب متباين المستويات يخضع لمنطق الشخصية ووعيها ونظرتها للعالم وتصرفاتها.
لا علاقة هنا لوعي الشخصية بلغتها. وإنما وعي الشخصية مرتبط ارتباطًا عضويًا بخطابها ويما تقوله وبما يحمله هذا الخطاب من طاقة وأفكار. وبالتالي فبائعة الفجل الأمية يمكنها أن تتحدث مثل البطل المثقف الفبلسوف. وهنا نصطدم بكل العوائق التي تفصلنا عن الإبداع والخيال، وتبعدنا عن التخلي عن النظرة الجامدة والكلاسيكية الهشة، وتجعلنا خاضعين لسلطة العناد والجهل، والإصرار على الخضوع التام للغة.
إنهم قرروا أن بائعة الفجل الأمية، سيدة ذات وعي متواضع. وبالتالي، يجب أن تتحدث بلغة متواضعة، ولتكن مثلا اللغة العامية. وإمعانا في الصلف والغيبوبة والعناد مع النفس قرروا أن المتعلم أو المثقف يجب أن يتحدث بلغة فصحى تعكس وعيه الرفيع.. ولكن ماذا لو كانت بائعة الفجل أكثر وعيًا من المتعلم والمثقف الفيلسوف؟ ماذا لو كانت السيدة البسيطة غير المتعلمة لديها خطاب أرفع وعيًا من هذا المثقف؟ هل نجعل المثقف يتحدث العامية، ونجعل بائعة الفجل تتحدث الفصحى؟
أحيانا نجد أنفسنا أمام حوار طويل بين شخصيتين أو ثلاث في العمل السردي. يطول هذا الحوار لصفحة أو صفحتين. ونفاجأ بوجود جمل حوارية لا تتماشى مع منطق الحوار الدائر وخطاب كل شخصية، بل تتناقض معهما وتتعارض مع منطق الحوار. لكنها في الوقت نفسه تتفاعل بشكل عضوي وجمالي مع منطق العمل ككل؟، ومع خطاب العمل بشكل عام. ألا يستحق ذلك أن يكلف الناقد أو القارئ نفسه عناء القراءة الجادة والتأمل والسعي لرؤية أكثر شمولية بدلًا من التمترس خلف فكرة مسبقة، وخلف نظرة ضيقة وبائسة، وخلف معايير وقوانين كان يجب هدمها منذ حوالي القرن؟
لقد اعتاد القارئ أن يستغرق في اللغة ومحاسنها. وبطبيعة الحال، هو حر في رؤيته وذائقته. ولكن من الأفضل طبعا أن يذهب ليقرأ الشعر مثلا، أو يشاهد عرض باليه، أو يستمع لمقطوعة موسيقية. لندعه يستمتع قليلا بـ “اللغة”. لكن الشعر والموسيقى والباليه لن يمنحوه أي راحة، ولن يلبوا له تلك الذائقة المعوجة والمثالية والهشة، لأن الشعر ليس ولن يكون أبدا مجرد براعة لغوية وقدرة على التعبير اللغوي. الشعر أعظم وأرقى وأهم من أن يكون مجرد لغة: إنه عالم كامل من الصور والتراكيب والمجازات والخيال التي تحتفظ في داخلها بمنطق وخطاب، وليس بتهويمات لغوية وتأملات من تحت “الجميزة”. وهو ما ينطبق شئنا أم أبينا على الموسيقى والباليه على سبيل المثال. وللأسف الشديد، كل ذلك ينسحب على جملة من النقاد، استراحوا لأكليشيهات واسطمبات جاهزة، منهم من يفعل ذلك بوعي شديد لأهداف معينة، منها الحفاظ على اللغة نفسها وعلى “قداستها”، ومنهم من يفعل ذلك بدون وعي لأن هذا ما ورثه عن آبائه الأولين.
أن يحبس القارئ، أو الناقد، نفسه في فقاقيع اللغة، وفي سجنها، فهو في الواقع يجرد أي عمل سردي أو فني من دعائمه الأساسية ويحوله إلى لغة وتدريبات لغوية. وفي نهاية المطاف يمكن أن نجد بين أيدينا نصا سرديا بلغة حسنة وصحيحة من حيث الصرف والنحو والفصحى والعامية، ولكن لا يوجد به شيء. بالضبط مثل الفقاعة. تلك الفقاعة اللغوية الجميلة.
وهنا أود طرح بعض الأسئلة: مَنْ الذي افترض أن الإنسان البسيط يجب أن يتحدث بلغة عامية، والإنسان المثقف يجب أن يتحدث بلغة فصحى أيا كان مستواها؟ ومن الذي قال إنه يجب أن تكون هناك فصحى وعامية تعبران عن مستوى وعي الشخصيات ووضعها الاجتماعي وتعليمها؟ ومن قال أصلا إنه يجب أن تكون هناك فصحى وعامية في العمل السردي، أو حتى في الواقع؟!
كون الواقع معوجا، وكون الحياة خاضعة لحالة فصام بشع وسخيف وردئ بسبب وجود فصحى وعامية، فهذا لا يعني إطلاقا أن ينتقل هذا الفصام إلى الأعمال الأدبية. وبالتالي ليس أمامنا الآن، وبشكل مؤقت، إلا أن نتعامل مع الفصحى والعامية وما بينهما على اعتبار أنها- كلها- لغة واحدة يمكن استخدامها لا للتعبير فقط عن وعي الشخصيات ولا عن وضعها الاجتماعي أو وظيفتها، وإنما أيضا لغة نكتب بها عملنا السردي الذي يتضمن خطابات مختلفة ومستويات خطاب متباينة كجزء من بناء العمل ومنطقه وخطابه العام.
إن التمترس وراء اللغة وانعدام الخيال، والتمسك بالفشل والكسل وتضخم الذات والاستعلاء وإصدار الأحكام على الشخصيات الروائية وعلى كتابها، يبعدنا كثيرا عن الإخلاص للكتابة، وعن الإخلاص للقراءة وإعادة القراءة، ويلقي بنا في تلك المنطقة الخانقة التي لا وجود للعمل السردي فيها إلا كنص لغوي أو “موضوع تعبير” يجب أن نحاكمه ونحاكم صاحبه ونمنح كلا منهما درجة أو علامة. كل ذلك يبعدنا عن فهم العمل وعن كتابة الأعمال السردية الجيدة التي يمكن أن تكون على مستويات راقية من حيث البناء والخطاب وطرح الافكار والأسئلة، ويحبسنا في فقاقيع اللغة التي لا تنتج لنا إلا فقاقيع لغوية وسردية تعمينا وتجعلنا مرعوبين ومسعورين وقتلة للعمل الأدبي ولبعضنا البعض. ومن جهة أخرى، تعمل على تضخيم ذواتنا وتعميق استعلائنا الناجم عن الإحساس بالدونية وقلة الحيلة. بل تجعلنا ننظر إلى كل الأعمال، الموجودة خارج الفقاعة التي حبسنا أنفسنا فيها، كأعمال تافهة لا ترقى لما نكتبه نحن داخل الفقاعات.
– هل ترى أن الجوائز الأدبية العربية تساهم في تكريس هذه الإشكالية من خلال معاييرها في اختيار الفائزين؟
– الجوائز الأدبية مشكلة شائكة للغاية، تكاد تكون دائرة مغلقة لا يمكن كسرها أو فهمها. وغالبية الجوائز العربية مكرسة للحفاظ على اللغة والثقافة، انطلاقا من مراعاة العادات والتقاليد والحفاظ عليها، وعدم المساس بالتابوهات أو التعرض للقيم أو المقدسات والرموز العامة والتاريخية والسياسية. لا أدري ماذا يتبقى للكتابة عنه، غير التهويمات تحت “الجميزة” أو ممارسة الألاعيب والتمرينات اللغوية، واللف والدوران لكي يتم تمرير ولو حتى فكرة واحدة. ومن شدة البؤس، فإن غالبية الجوائز والمسابقات تمعن في فرض الموضوعات من جهة، ووضع الشروط والمعايير التي لا علاقة لها بجوهر الإبداع من جهة أخرى. وهذا جانب واحد من كوارث الجوائز الأدبية. فضلا عن الفساد المتعلق بلجان التحكيم وتبادل المصالح، والعلاقات غير البريئة بين دور النشر والصحافة الثقافية ولجان الجوائز نفسها.
الجوائز تحولت إلى نوع من المسابقات الهدف منها صناعة أجيال “مخصية” إبداعيًا، ومتقولبة في حدود فكرة الاستقرار، والالتزام بالمعايير الأخلاقية والدينية والوطنية. هذه المسابقات تتعامل مع المتسابقين كقطيع يجب حشده ودفعه في طرق معينة وبطرق معينة، بحيث تبدو الأمور طبيعية. وبالتالي، تتشكل لدينا حالة من حالات قولبة العقل وهندسة الخيال، والتحكم في حرية الكاتب وذوقه وحجم إدراكه للجمال، وتسييد معايير فقيرة وضحلة للكتابة والإبداع. ومن الواضح أن أهداف ومعايير الجوائز تتعارض مع جوهر الإبداع نفسه، ما ينتج نوعًا هشًا من الكتابة، لا يرقى إلى أي مستوى يمكن التعامل معه بجدية أو تقدير. ثم نعود لنتشكى ونولول على ضياع الأدب وانهيار الإبداع وفقر الخيال!
أزمة جيل الثمانينات
– لديك مقالة شهيرة وجهت فيها نقدًا لاذعًا لجيل الثمانينات، وهو الجيل الذي تنتمي إليه، ووصفت محنته بأنه جاء بعد جيلين قويين (الستينات والسبعينات) دون أن يحظى بملامح واضحة أو آباء أدبيين يدعمونه، مما جعله جيلًا “منكوبًا” ومشتتًا في ظل سطوة جيل السبعينات. برأيك، ما السبب الحقيقي وراء هذا التشرذم؟ وهل ترى أن هناك عوامل خارجية أو حتى “مؤامرة أدبية” ساهمت في تهميشه؟
– في الحقيقة، جيل الثمانينيات غائب عن المشهد النقدي المنهجي من جهة، وغائب أيضا عن القارئ من جهة أخرى بحكم الزمن والنقلة التاريخية والاجتماعية والتقنية وبعض الحسابات الأخرى. وربما أيضا بنتيجة عمر هذا الجيل القصير من حيث الفترة الزمنية بين سطوة جيلي الستينيات وهيمنة جيل السبعينيات والهجوم الكاسح لجيل التسعينيات الذي كان مسلحا آنذاك بأدوات أخرى وبأفكار وإمكانيات أخرى تماما، وربما بنتيجة تشتت أسماء هذا الجيل وتباين مصائرها. فهناك من ترك الإبداع ورحل إلى الصحافة، ومن ترك العملية الثقافية كلها وهاجر إلى مكان آخر أو سافر في نفس المكان أو اختفى في الإحباط وقلة الحيلة أو مات. ومن أهم تقاليد الكتابة عند هذا الجيل، هو الاغتراب الداخلي وانعدام اليقين والإحساس المُذل بالغربة من جهة، والثقة في نتائج العملية الإبداعية والكتابة بصرف النظر عن النتائج النهائية، والإقلاع عن تقليد وتقاليد الستينيين والسبعينيين، ومحاولة ابتكار زوايا مختلفة للنظر إلى التفاصيل وإعادة إنتاجها وصياغتها من جهة أخرى. ومع ذلك فلا توجد محاولات لرصد تقاليد الكتابة لدى جيل الثمانينيات، وكأن هناك اتفاقا ضمنيا على تجاهله بمبررات سخيفة ومثيرة للتساؤلات، من قبيل ندرة الإنتاج، أو قلة الأسماء، أو التأثير الأدبي، أو بحجة الغياب والسفر، وصعوبة الإلمام بإنتاج هذا الكاتب أو ذاك أو عدم القدرة على جمع أو تتبع الأعمال.
الفكرة أن أحد أهم العوامل المشتركة “الجيدة” بين جيلي الستينيات والسبعينيات، هو أنه رغم الشللية والمنفعة وتبادل المصالح، إلا أن هذه الشلل والمجموعات توافقت على صيغة مهمة نافعة تتمحور حول دعم بعضهم البعض، وفتح الطرق أمام بعضهم، وتسويق أعمال بعضهم والترويج لها. وطبعا نحن نتحدث في العموم وفي سياق تيار عام بعيدا عن استثناءات وضغائن معينة أو تهميشات لشخص او اثنين، سواء في جيل الستينيات أو جيل السبعينيات.
كانت الخلافات بين أبناء جيل الستينيات عقائدية وأيديولوجية، ولا نستثني أيضا الخلافات المادية والنفعية المباشرة. ولكنهم كانوا يوسعون الطريق أمام بعضهم، ويتحايلون بطرق معينة للترويج وتبادل المصالح التي تعود بمنفعة عامة على الحركة الثقافية والفنية والفكرية.
أما جيل السبعينيات، فكانت خلافاته تتضمن جزءا أيديولوجيا بعد انهيار الأيديولوجية والأحلام الكبرى وفقدان الثقة في الشعارات الكبرى. وكان الصراع متمركزا حول تكوين شلل جديدة، وشغل مناصب في المؤسسة الثقافية وقيادة سلاسل للنشر. وبطبيعة الحال، ساعدهم كل ذلك للترويج لأعمال كل واحد منهم على حدة، وعلى الترويج لأعمال بعضهم البعض وفق أسلوب تبادل المصالح، وفتح الأبواب أمام بعضهم البعض للنشر هنا وهناك، للحصول على الأموال والحظوة والجوائز.. وهذا بدوره ساهم في تنشيط الحركة الثقافية والفنية والإبداعية بدرجات كبيرة وجيدة على الرغم من المشاكل والصراعات الكثيرة التي كانت تحدث.
غابت كل هذه التقاليد بحلوها ومرها وسوءاتها عن جيل الثمانينيات الذي يمكن أن نطلق على أبنائه مصطلح “الجزر المنعزلة”. وأصلا لم يكن هناك جيل ثمانينيات له ملامح أو تقاليد. كان مجرد “جزر منعزلة” و”جثث حية” وحضور رمادي. هنا يبرز جيل الثمانينيات مثل “الغراب الأبيض” بفشله ونكوصه وشحه وإحباطاته واغترابه. وحتى عندما ظهر لفلوله وبقاياه بصيص ضوء من أجل الحياة والاستمرار أو لتحصيل بعض المكاسب التافهة، تعامل مع الأمر وكأنه فعلا جيل ثمانينيات ليس لديه أي هدف أو منهج. تعامل بعشوائية وانعدام ثقة، ولم يكن يرى أبعد من أنفه، أو بالأحرى أبعد من الكائنات التي تحاصره وتفرض عليه سطوتها المادية والمعنوية والجسدية. واتضح أنه جيل محروم من كل شيء. والحديث هنا عن سياق عام وحركة عامة وملامح جيل، وليس عن جهد فردي أو مبادرة شخصية، حتى لا ينزعج أبناء أي جيل من الأجيال المذكورة.
لا شك أن حقبة الثمانينيات شهدت بعض النماذج التي كانت تحاول تقليد نجيب سرور ويحيى الطاهر عبد الله وأمل دنقل على مستوى السلوكيات والتصرفات و”الصعلكة”، ولكن هذه النماذج فشلت بامتياز، لا لأنها كانت فاشلة إبداعيا فقط، بل وأيضا لأنها لم تكن نماذج إبداعية أصيلة من حيث مصادر الإبداع وامتلاك الموهبة الحقيقية. كما أنها انطفأت سريعا بفعل تشتيت الطاقة والجهد، وتغير الأوضاع الاجتماعية والثقافية والسياسية، وانحسار المد الثقافي- الفكري- الحضاري، ودخول العالم منذ بداية التسعينيات، أو منذ منتصف التسعينيات، إلى المرحلة الانتقالية التي كانت مقدمة لما نحن فيه الآن.
– في أحد حواراتك، شككت في دقة مصطلح “الجيل” في الأدب، معتبرًا أنه مصطلح جدلي لكنه يظل مستخدمًا مجازًا لغياب بديل واضح. برأيك، كيف يمكن تعريف “الجيل” كفكرة أدبية؟ وما المعايير التي يمكن اعتمادها لتحديد ملامح أي جيل إبداعي بعيدًا عن التصنيفات النمطية؟
– نعم، مصطلح “جيل” هو مصطلح استثنائي يثير الكثير من الجدل، ولكن ليس لدينا إلى الآن مصطلح آخر يمكن أن نستخدمه. فلنستخدم كلمة “جيل” مجازًا إلى أن نجد الصيغ والمصطلحات المناسبة. وفي الحقيقة، هناك أكثر من طريقة لتحقيق هذه “الصيغ والمصطلحات”. فمن الممكن تحديد ملامح ومعايير أدبية معينة وعناصر مشتركة لتجارب، ثم نضع تحتها أعمالًا تتوافر فيها هذه الملامح والمعايير والعناصر المشتركة. وبالتالي يمكن أن تضم كتابًا من أعمار مختلفة، أو متقاربة. ولكن للأسف الشديد، مثل هذه الخطوة تحتاج إلى جهود نقدية أدبية، وجهود في النقد الثقافي والفلسفة، لكي نستطيع أن نتعامل بشكل منهجي وعلمي مع تحديد الملامح والمعايير والعناصر المشتركة في الأعمال الأدبية. وعموما، لن نتوقف كثيرا عن مسألة الأجيال وفق المراحل العمرية، لأننا ورثناها على ما يبدو من الاتحاد السوفيتي الذي كان يسير وفق هذا الترتيب أو التصنيف.
الترجمة
هل ترى أن المكتبة العربية ما زالت متعطشة للمزيد من الترجمات.. أم تشبعت؟
– المكتبة العربية، والمصرية بالذات، لم تتشبع بأي شيء، بما في ذلك الترجمة. هناك الكثير من الترجمات ومن كل لغات العالم، ولكنها أقل مما نتصور، وأقل بكثير مما يلزم. الترجمة ليست مجرد نقل أعمال أدبية وعلمية وفكرية وفلسفية من لغة إلى أخرى، وإنما مشروع كامل يستلزم الكثير من الأدوات والمنهجية لكي يصبح مجديا ونافعا. المنهجية في الترجمة تشكل حوالي نسبة 50 بالمائة من جدوى الترجمة وفوائدها.
ماذا عن حضور الأدب العربي في روسيا وصورة العرب عموما في الثقافة الروسية؟ وماذا عن التعاون بين مصر وروسيا في المجال الثقافي؟
– يمكن أن نقول إن الأدب العربي والمصري متواجد في روسيا على مستوى طلاب الدراسات العربية والترجمة. لا أحد يتحدث عن الأدب العربي في روسيا سوى بعض الأشخاص المهتمين أو العاملين في مجال الترجمة، أو في الاحتفالات الرسمية ولقاءات المجاملات. لا نستطيع أن نقول إن الأدب العربي والمصري موجود على مستوى شرائح أو قطاعات من القراء وله سوق مثل بقية الآداب الأخرى، الفرنسية والإنجليزية والأمريكية واليابانية والصينية واللاتينية.
وفي الواقع، هذا موضوع قديم. الأدب العربي والثقافة العربية لا يشكلان أي أهمية في روسيا إلا في حدود تخريج عدة طلاب للعمل في السلك الدبلوماسي أو الأجهزة الأمنية، أو ترجمة مقال أو بحث منفردين لأسباب تخص الروس. وربما نجد كتابا أو اثنين تمت ترجمتهما بشكل سيء جدا. لا يوجد أدب عربي أو ثقافة عربية في روسيا كتيار أو كمساحة تتسم بالحركة والحيوية والتطوير. هناك ادعاءات ومبالغات وتضخيم في الإمكانيات وفي عمق العلاقات، ولكن كل ذلك يُخَدِّم على أهداف سياسية قصيرة النظر تتغير بتغير الأنظمة أو سقوط الدول. أعتقد أنه من الصعب الحديث عن شيء غير موجود: لا أدب عربي في روسيا، ولا حضور للثقافة العربية في روسيا. أما صورة العرب في روسيا فهي صورة إعلامية أكثر منها واقعية، أو صورة مرتبطة بعظمة الماضي و”التعاون والأخوة والصداقة” وبقية الشعارات السوفيتية السابقة. يوجد فقط الحضور الرسمي، والحضور في المناسبات والكلمات الحماسية التي تلقى فيها. وطبعا لا يمكن أن ننفي وجود أشياء منفردة يتذكرها بعض المستعربين القدامى أو بعض الطلاب الذين يدرسون اللغة العربية. وهناك حضور بدرجات معقولة نسبيا للمنتجعات السياحية ومراكز التسوق في بعض العواصم العربية.
ماذا عن وضع الأدب الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي؟
– الأدب الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، يعاني من نفس الأزمات التي يعاني منها الأدب في دول كثيرة. وكلمة أزمات هنا، هي تعبير مجازي تماما، لأننا في مرحلة تحول على مستوى العالم كله في جميع المجالات، بما فيها الأدب والثقافة. هناك عملية هدم حدود وإقامة أخرى، وتغييرات جذرية في أشكال التعبير ومناهجه، وفي شكل وجوهر الموضوعات المطروحة. لقد حدثت كبوة حقيقية للأدب الروسي في الفترة من منتصف الثمانينيات وحتى السنوات الخمس الأولى من قرننا الحالي. ومع ذلك كان هناك إنتاج أدبي بفعل قوة الدفع الذاتي، وحيوية موضوع انهيار الاتحاد السوفيتي وتبدل خريطة العالم، وكشف المسكوت عنه في فترة الاتحاد السوفيتي. ولكن كل ذلك لم يرق إلى مستوى الأدب السوفيتي أو الأدب الروسي الكلاسيكي. وفي الحقيقة، لم يكن مطلوب أن يكون الأدب ما بعد السوفيتي مشابها للأدبين الروسي والسوفيتي.
– أنت واحد من قليلين اهتموا بالترجمة عن الروسية في مجال الاقتصاد حين كتبت المقدمة لترجمة “إمبراطور الغاز” وساعدت لطبع الكتاب في مصر… لماذا اهتمامك بهذا القطاع غير المطروق في الترجمة؟
– في الواقع، عندما قام الصديق الدكتور عمار قط بترجمة هذا الكتاب في عام 2009 عن الروسية مباشرة، كنا مشغولين منذ أكثر من عشر سنوات قبلها بالحديث عن “الغاز” الروسي، وكيف ستستخدمه روسيا كأداة سياسية ضد الغرب بالدرجة الأولى، ولتحسين مواقعها الجيوسياسية في خريطة العالم الرأسمالي. وعندما تحدثنا أنا والدكتور عمار قط، الذي يقيم حاليا بفرنسا لأسباب سياسية، عن أهمية الكتاب، اكتشفنا أن مكتبتنا العربية خالية من مثل هذا النوع من الكتب، وأن مراكز الأبحاث العربية غير مهتمة إلا بالقشور وبالطبخات السريعة المبنية على تقديرات غير دقيقة أو محابية أو معادية.
لم يكن الدكتور عمار قط يطمع في جني أموال من وراء هذا الكتاب، بقدر ما كان يريد أن يطرح هذا الكتاب أمام المتخصصين وأصحاب القرار في العالم العربي، ودفعهم للمزيد من استشراف الوضع الدولي العام، وما سيأتي بعد سنوات، وكيف ستصعد روسيا إقليميا ودوليا بفعل أدوات معينة. ولا أدري، هل تحققت أهداف مترجم الكتاب أم لا! أما أنا فقد تكفلت بمراجعته وكتابة مقدمة طويلة توضح الجوانب السياسية والجيوسياسية لما تفعله، وستفعله، روسيا. وقمنا بطباعة الكتاب في القاهرة.
– لماذا لا نرى انتاجا في الترجمة عن الروسية في مجال الاقتصاد برأيك؟
– لأن روسيا نفسها تعيش على ما يكتب في الاقتصاد الغربي، وعلى برامج الاقتصاد الغربي بعد أن انهارت التجربة السوفيتية وخرجت روسيا من عباءة الاشتراكية السوفيتية. ما يؤلَّف في روسيا من كتب في الاقتصاد هو مجرد صدى أو انعكاس لما يكتب في الغرب، أو رد فعل على دراسات غربية بالأساس. أو أوهام قومية تتسم بالعنصرية والإحساس بالتفوق. وبالتالي، لن نجد شيئا ذا قيمة. ولكن الكتب والدراسات التي تتناول مكامن الطاقة (نفط وغاز) في روسيا، هي مهمة بنسبة لا بأس بها، لأنها تمنحنا بعض الأرقام والإحصائيات، أو توضح طموحات روسيا في مد نفوذها خارج محيطها الإقليمي التقليدي باستخدام أدوات الطاقة أو الأسلحة. وأعتقد أن هذه مهمة مراكز الأبحاث العربية، ومراكز القرار في الدول العربية المتنفذة. غير أن الروس من جانبهم، يهتمون بنشر الكتب والمقالات الدعائية التي تغري الآخرين باتباع النموذج الروسي، وتعمل على زيادة نفوذ روسيا ولو حتى إعلاميا. وفي كل الأحوال، مَنْ سيبحث عن كتب مهمة في الاقتصاد في روسيا، يمكنه أن يعثر على بعضها. ولكنها لن تكون مفيدة بالقدر الذي يستفيد منه المتخصصون ومراكز الأبحاث ومراكز القرار من الكتب التي تصدر عن الغرب.
– صدر لك كتاب مهم في 2012 هو “الدروس المستفادة من الثورة الروسية”. هل لا تزال تلك الدروس صالحة حاليا؟
– كان المقصود “بالثورة الروسية” هي ما حدث بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث أوضحنا أوضاع روسيا في حقبة التسعينيات وحالة الانهيار والتردي التي وصلت إليها في جميع المجالات، ثم بداية التحول والعوامل التي ساعدت هذا البلد الأضخم في العالم لتفادي التفكك والانهيار. وبالطبع ركزنا أيضا على مكافحة الإرهاب، وكيف ضرب الإرهاب العديد من أقاليم وجمهوريات روسيا ووصوله إلى العاصمة موسكو، ومصادر هذا الإرهاب ومناشئه، وكيف كافحته روسيا وانتصرت عليه. وفي الواقع، وعلى الرغم من أهمية التجربة الروسية، سواء في النهوض من الانهيار أو في مكافحة الإرهاب، فإننا نحذر دوما من أنه من الصعب اتباع أي نموذج روسي أو محاولة تحقيق أي نموذج روسي في ظروف دول أخرى. فنحن نعرف أن روسيا دولة غنية بالموارد والمواد الخام ولا تزال تعتمد عليها إلى الآن، بينما الصناعات التحويلية فيها فقيرة وضئيلة، ولديها مشاكل في التقنيات العالية والرفيعة، ولديها أيضا نظام حكم يختلف عن دول كثيرة في الشرق والغرب، وهي تفضل “الانضباط” على “الديمقراطية”، وفق ما قاله وأكد عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بدايات وصله للسلطة. كما أن لديها منظومة إعلامية تختلف أيضا عن المنظومات الأخرى في العالم، وهي منظومة دعائية- تضليلية بالأساس. كل ذلك يجعل تكرار أي تجارب روسية أو نماذج روسية، في دول أخرى، في غاية الصعوبة. ولكن الاطلاع على التجارب الروسية أمر لا يضر، على الأقل من باب العلم بالشيء.
– بصفتك حاصل على الدكتوراه في تخصص علمي من موسكو، برأيك لماذا تكاد تقتصر الترجمات العربية عن الروسية على الأدب مع استبعاد شبه كامل للعلوم؟
– هذه مشكلة العالم العربي بالدرجة الأولى. بعد ذلك يأتي دور روسيا كمذنب أيضا ولكن في المرتبة الثانية. العالم العربي والمؤسسات التعليمية العربية ومنظومات العلوم في الدول العربية تثق في العلوم الغربية وفي المناهج والأساليب الغربية بحكم العلاقات التاريخية الطويلة، وتبادل المصالح والبعثات، وبحكم التعاون الوثيق أيضا. كما أن حركة العلوم في الغرب أكثر سرعة وحيوية منها في روسيا. وفي الحقيقة، روسيا نفسها تلجأ إلى مناهج العلوم الغربية وتستخدمها. وبالتالي، فمن الأفضل أن نترجم عن الأصل. وفي السنوات العشرين الأخيرة، لم يعد هناك فارق كبير بين روسيا والغرب من حيث البناء والسلوك الرأسمالي في الكثير من المجالات. بمعنى أن روسيا لا تنتهج طرق وأساليب خاصة بها، وإنما تستعين بالمناهج والأساليب الغربية، وتقوم بتهجينها أو بخلطها مع بعض الأفكار الروسية.
– كيف ترى مشكلة أنه حتى في الأدب، اقتصرنا على الكلاسيكيات مثل دوستويفسكي وتولستوي ولم نترجم للأجيال الأحدث في الأدب الروسي؟
– لا يوجد أدب في روسيا أرقى وأهم من الأدب الروسي في القرن التاسع عشر. هناك الأدب السوفيتي، أدب الواقعية الاشتراكية، ولكنه لا يرقى إلى مستوى أدب القرن التاسع عشر. الروس أنفسهم يعملون على ترويج أدبهم الكلاسيكي، ويكتفون بأنهم كانوا في إحدى الحقب يبدعون أدبا جيدا. لا أحد يترجم حاليا عن الأدب السوفيتي، حتى الروس لا يلتفتون إلى هذا الأمر. أما الأدب الحالي في روسيا، فهو متواضع للغاية، وليس لديه إلا موضوع واحد فقط، ألا وهو انتقاد المرحلة السوفيتية وسب ستالين. أما الأدباء الخمسة الذين حصلوا على جائزة نوبل، فقد حصلوا عليها إبان الحقبة السوفيتية، وكان ثلاثة منهم يعيشون خارج الإمبراطورية السوفيتية، بينما الاثنان اللذان كانا يعيشان فيها، لم يسمح لهما بتسلم الجائزة. وفي كل الأحوال كان إنتاج هؤلاء الخمسة بعيدا تماما عن الدعاية السوفيتية المقيتة التي كانت تتعارض أصلا مع الماركسية ومع التجربة اللينينية، وكان ضد الاستبداد والقمع والشمولية. هناك ترجمات قليلة في سوريا والعراق لأعمال بعض الكتاب السوفييت الجيدة والرزينة والعقلانية والبعيدة عن الدعاية الفجة لأفكار سوفيتية عقيمة. وهناك أيضا ترجمات لأعمال بعض كتاب ما بعد انهيار التجربة السوفيتية. وعلينا أن نقر أيضا بكتاب ثمانينيات القرن العشرين الذين ظهرت أعمالهم بعد انهيار الإمبراطورية. وهي أعمال مهمة للغاية ولكن يجري التعتيم عليها لأسباب سياسية، وأنا ترجمت مختارات ونماذج لعشرة من هؤلاء الكتاب.
– ما هي مشكلات الترجمة عن الروسية عموما؟
– حركة الترجمة من الروسية إلى العربية والعكس، فقيرة جداً وضحلة للغاية، في حال مقارنتها بالترجمة من الإنجليزية والفرنسية والعكس. هناك أسباب كثيرة لذلك، منها السياسي ومنها التاريخي. فالارتباط بين الثقافتين العربية والغربية أكثر قوة ومتانة، تدعمه السياسات الثقافية والتعليمية، والتوجهات السياسية، ومجموعات المصالح الاقتصادية والسياسية والثقافية. وفي الحقيقة، فالروس أنفسهم ليس لديهم وقت لموضوع الترجمة في اتجاه العالم العربي إلا في أحوال نادرة مرتبطة بالتقاربات السياسية أو حفلات الاستقبال والمناسبات السياسية والدبلوماسية، أو في حال الترويج لشخص أو لفكرة قصيرة النظر كما يحدث عادة. هم يركزون على الترجمة في اتجاه الغرب، وعلى بيع السلاح في اتجاه الشرق. كما أننا نعرف جميعا أن روسيا من إمبراطوريات الأطراف، أي أنها فاعلة بدرجات مختلفة في محيطها التاريخي (منطقة آسيا الوسطى والقوقاز وما وراء القوقاز وجزء من شرق آسيا)، بينما أوروبا والولايات المتحدة أوسع انتشارًا وأكثر تأثيرا، بحكم عوامل كثيرة.
مشكلات الترجمة من الروسية، هي مشكلات تخص روسيا بالدرجة الأولى، وتتعلق بتوجهات نخبها السياسية، وبحركة نخبها الثقافية، وببرامجها وتعاونها مع الدول الأخرى، وبأولوياتها مع أصحاب هذه الثقافة أو تلك. كما أن الأمر يتوقف أيضا على ما تنتجه الثقافة الروسية، وهل هو مهم أو ملائم أو يمتلك خصوصية أو قيمة ما.
– لماذا اهتممت بالكاتب فالنتين راسبوتين تحديدا في ترجماتك للأدب الروسي حيث ترجمت له مجموعة قصصية حملت عنوان “نتاشا ” فضلا عن ترجمات منفردة له؟
– كان اهتمامي بأعمال فالنتين راسبوتين نابعا من عدة عوامل، على رأسها أنه أحد القلائل المتبقين من جيل الستينيات، وأنه كان بعيدا عن الآلة السوفيتية الصاخبة، وحاول الابتعاد قدر الإمكان عن عصابة يلتسين في التسعينيات. كما سعى أيضا للاستقلالية عن السلطة بعد ذلك. وأعماله متعلقة بالإنسان وبحياته واحتياجاته وحريته الداخلية والخارجية. إضافة إلى أن أعمال راسبوتين كانت تشكِّل امتدادات بدرجات معينة للأدب الروسي الكلاسيكي من حيث الموضوعات والاهتمامات ومكامن القلق الإنساني الطبيعي.
نجيب سرور
-وتأتي الخاتمة مع آخر أعمالك وهوكتاب “نجيب سرور بين العبقرية والبطولات المزيفة”. لماذا هناك تعتيم على تجربة نجيب سرور في موسكو؟ ومن المستفيد من تغييب هذه المرحلة عن سيرته؟ وهل كان تحوله ضد الاتحاد السوفيتي نابعًا من قناعات فكرية أم أن هناك عوامل شخصية وسياسية لعبت دورًا في ذلك؟ ما أبرز الأحداث التي دفعته للانتقال من الإيمان بالمشروع السوفيتي إلى نقده العنيف؟
– هذا سؤال معقد يحتاج إلى إجابات طويلة يمكن أن نجدها في. ولكن باختصار شديد، عندما وصل نجيب سرور إلى موسكو، بدأ يدرك حجم المأساة الذي توزع على مسارين: مسار شخصي، ومسار عام. فغالبية المبعوثين الحكوميين المصريين كانوا محافظين وغير ناشطين سياسيا. بينما نجيب سرور الشاعر والفنان مهموم بالشأن السياسي المصري والعربي، ويمتلك طاقة رهيبة على الحركة والكلام. وهنا حدث الصدام الأول بينه وبين المبعوثين الذي وصفوه بأنه “شيوعي” بل وبدأوا يعزلونه ويحاصرونه ويكتبون فيه تقارير للسفارة. ومن جهة أخرى، بدأ مبعوثو الأحزاب اليسارية العربية وحزب البعث والطلبة الفلسطينيون وشيوعيو المشرق يشككون فيه وفي نواياه، ويتساءلون: كيف يمكن لهذا الشخص أن يتحدث بكل هذه الصراحة والشفافية وكأنه معارض للسلطة في مصر. وهذا كان غمز واضح ومباشر في اتجاه أنه “مباحث” ويعمل لصالح “النظام المصري”. أما المسار الثاني، فقد كان القشة التي قصمت ظهر البعير، عندما وصلت أنباء مقتل شهدي عطية الشافعي في سجنه بمصر، وتذويب جثة فرج الله الحلو في الأحماض بسوريا. وفي الوقت نفسه كانت العلاقات المصرية- السوفيتية “سمنة على عسل”، والزعماء يلتقون بالقبلات والأحضان ويقلدون بعضهم البعض الأوسمة والميداليات. هنا ظهرت الحساسية المفرطة لدى الشاعر والفنان نجيب سرور. ونظر إلى الأمر بمعزل عن السياسة والمصالح السياسية. ومع الوقت فقد الثقة في النظامين السياسيين. ونظرا لعناده الشديد، ومحاولات تبرئة ساحته من اتهامات المبعوثين المصريين، ومن اتهامات الشيوعيين العرب ومبعوثي الأحزاب اليسارية العربية، بدأ يتخذ مواقف راديكالية تماما. ثم توالت الأحداث عندما ساءت العلاقات بين موسكو والقاهرة، وطلبت الأخيرة من مبعوثيها العودة إلى مصر. فرفض نجيب سرور. وهنا بدأت حلقة جديدة من معاناته.
– لماذا لم ينضم نجيب سرور إلى أي حزب رغم إيمانه بالعدالة والاشتراكية؟
– لا أستطيع الإجابة على مثل هذا السؤال الافتراضي. فمسألة الإيمان بمبادئ إنسانية عامة شيء، والانضمام إلى أحزاب أو تنظيمات سرية، أمر آخر تماما. وفي الحقيقة، شخصية نجيب سرور لا يمكن أن تتوافق مع القواعد الصارمة للتنظيمات السرية، ولا يمكن أن تتحمل التراتبية الحزبية وطاعة الأوامر وتنفيذ التعليمات. فضلا عن أنه من الصعب أن نتوقع من شخصية مثل شخصية نجيب سرور أن تمتلك القدرة على المناورات السياسية والحزبية.
– هل كان عداء المثقفين المصريين له بسبب الغيرة الإبداعية، أم أن هناك أسبابًا أعمق؟ ولماذا لم يغفروا له فضحه للنفاق السياسي؟
– بعد عودته من الخارج عام 1964، تراجع سرور إلى الوراء خطوة أو خطوتين بعيدا عن الشعارات الكبرى، وانتقد في العلن سياسات الاتحاد السوفيتي الذي كان يمثل “قبلة المريدين” والممول الرئيسي للتنظيمات والأحزاب، أو على الأقل الداعم الأول لهذه التكوينات والهياكل. وبالتالي، فانتقادات نجيب سرور للوضع داخل الاتحاد السوفيتي، والكوارث التي رآها هناك والتي تتناقض تماما مع ما يتم الترويج له من ازدهار وبحبوحة وتنمية ورخاء، ‘ضافة إلى سياسات موسكو التي تكيل بمكيالين، وتنافق حتى أتباعها ومريديها.. كل ذلك كان من شأنه فضح الشعارات، وفضح من يتبنونها، وإفشال جانب مهم من “نضالهم” بشأن الاشتراكية والعدالة الاجتماعية و”التحرر الوطني”. وهذا الكلام لا يعني أن الصورة كانت معتمة حتى النهاية. وإنما، للحقيقة أيضا، كان هناك مخلصون في هذه التنظيمات والأحزاب، يعملون من منظور وطني، ويفهمون أيضا ما كان نجيب سرور يقوله ويقصده. هنا، كان لابد من حصار نجيب سرور، ومعاقبته، بل والانتقام منه. وفي الحقيقة، فانتقامات المثقفين عندنا قاتلة لا تصدر إلا عن قتلة حقيقيين يمارسون إعدام خصومهم بدم بارد تحت شعارات وأفكار كونية مطلقة تبدو بريئة للغاية. وفي نهاية المطاف، بدأ عزله تارة، والترويج للشائعات تارة أخرى، والتقليل من قيمة إنتاجه ألإبداعي لصالح الترويج للعنعنات والقصص الوهمية، والمبالغات المثيرة للسخرية، ووصفه بالكسل تارة، وبالتصلب تارة أخرى.
– ما أكثر الأكاذيب التي التصقت بسيرته بعد وفاته؟ ولماذا تحوّل إلى “أسطورة” رغم التجاهل الذي عاناه في حياته؟
– الأكاذيب كثيرة حول نجيب سرور، منها الذي يتردد بحسن نية، ومنها ما يتردد بسوء نية وبدافع الانتقام وتصفية الحسابات. لكنه في كل الأحوال لم يعان من أي تجاهل. بل كان نجما ساطعا في سماء المسرح، وطاقة ملهمة في مجال الشعر والنقد والكتابة. ربما يعتقد البعض أن نجيب سرور كان يجب أن يتولى منصبا مهما يليق به، أو يحظى بجوائز رفيعة تساعده على تحسين ظروفه المادية. وبالتالي، ظهر اللغط بشأن “التجاهل”. وتطور هذا اللغط ليختلط بكلام فارغ من قبيل وقف أعماله ومقاطعتها. وهذه أكاذيب ومبالغات.
من الطبيعي أن يتحول نجيب سرور إلى أسطورة في ظل ما يمتلكه من قدرات إبداعية وفنية. لكن كان من الأفضل أن يتم التركيز على إبراز هذا الجانب الإبداعي، بدلا من خلط الأمور والترويج لبطولات مزيفة لن تعلي من قيمته العالية أصلا. بل على العكس، يمكنها أن تسحب من رصيده الإبداعي. وأعتقد أن إنتاج سرور جدير بالمتابعة المستمرة. وقد يحدث هذا على أيدي أجيال قادمة أكثر شفافية واهتماما بميراثها الإبداعي.
– هل ساهم الإعلام والمثقفون في تضخيم صورته، أم أن جمهوره هو من صنع هذه الصورة الذهنية عنه؟
– للأسف الشديد، طغت العنعنات والصور الذهنية على سيرة نجيب سرور، وكأنه بحاجة إلى بطولات إضافية، وإضفاء المزيد من القداسة على شخصه. بينما هو شاعر وفنان طبيعي لديه حساسية زائدة مثل أي فنان حقيقي بكل تناقضاته ووجهات نظره المختلفة أحيانا، والمتطرفة في أحيان أخرى. إضافة إلى انفتاحه وصراحته اللذين عرضاه لصدامات مباشرة مع من حوله. إن تركيبته المعقدة، من حيث أنه شاعر ذو حساسية مفرطة، يتميز بذكاء فطري ووعي نقدي، وليس لديه أي حسابات على الإطلاق، كانت سبب كوارثه. لكنه كان يمتلك في الوقت ذاته طوق نجاته من حيث التفرد الإبداعي، والصلابة الروحية والنقاء، والإخلاص لما يؤمن به، إضافة إلى درعه الواقي الأساسي، وهو عشق مصر. فهو في الحقيقة كان يعشقها ويعشق ناسها بشكل مَرَضي. مثل هذه الثروة الوطنية بحاجة إلى “تنقية” و”تفكيك”، لكي نقف على مصادرها وينابيعها الأساسية، لا أن نشوهها بأساطير إضافية، وصور ذهنية تبعدنا عن الأساسي فيها، وهو الإبداع، والإخلاص للفن، والإنتاج الذي يمتلك قيمة استثنائية. فنجيب سرور لم يكن مقموعا، ولا سجينا سياسيا، ولا مريضا نفسيا تم إيداعه في مصحة للأمراض العقلية. بل على العكس، كان إنتاجه يتمتع باهتمام خاص. ولم يحظ أحد بما حظي به من انتشار بعد عودته من المجر عام 1964، حيث كانت أعماله حاضرة تجوب مسارح الدولة، ومسارح الثقافة الجماهيرية والأقاليم المصرية بدون أي منع.
– هل كانت مأساة نجيب سرور حتمية بسبب شخصيته الصريحة والحساسة، أم أنه كان بإمكانه تجنبها لو تصرف بشكل مختلف؟
– من الصعب أن نطلب من المبدع أن يغير طبيعة شخصيته، او يتصرف بالشكل الذي يريده عليه الناس. وفي كل الأحوال، من الصعب أن يتفق الناس على طبائع وتصرفات هذا أو ذاك من المبدعين، خاصة إذا كانت صراحته مباشرة، ونابعة من حساسية مفرطة. ويمكننا أن نتذكر في هذا المقام حكاية جحا وابنه وحماره. وفيما يتعلق بنجيب سرور هنا، فإن “النقمة عليه” و”الانتقام منه” كانا رد فعل طبيعي على شخص لا يتردد في أن يقول للقرد أنه “مؤخرته حمراء”. وإذا شئنا الدقة، فالكثيرون حاولوا إعادة تربيته وإعادته إلى الصفوف المطيعة المتوددة. لكنه بطبيعة شخصيته كان متمردا ولا يقبل بأنصاف المواقف او انصاف الحقائق. وأنا هنا لا أبرر له أو أدافع عنه، بقدر ما أحاول أن أوضح طبيعة شخصيته المختلفة والمتفردة.