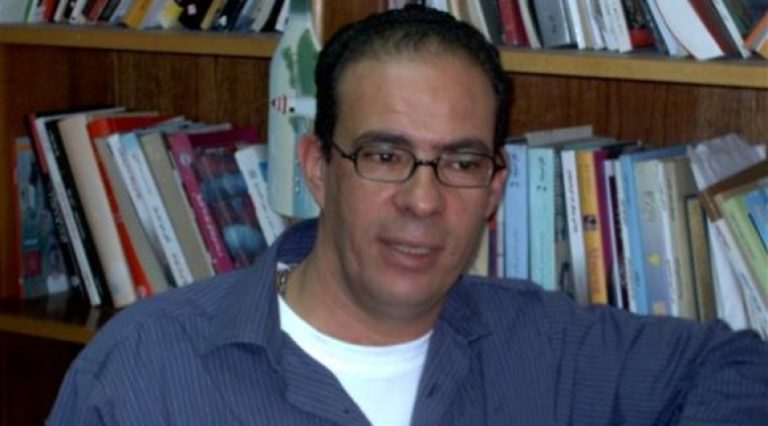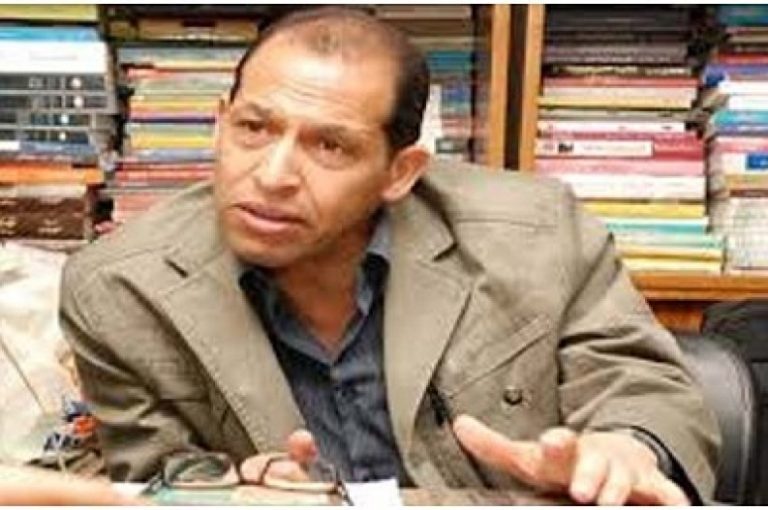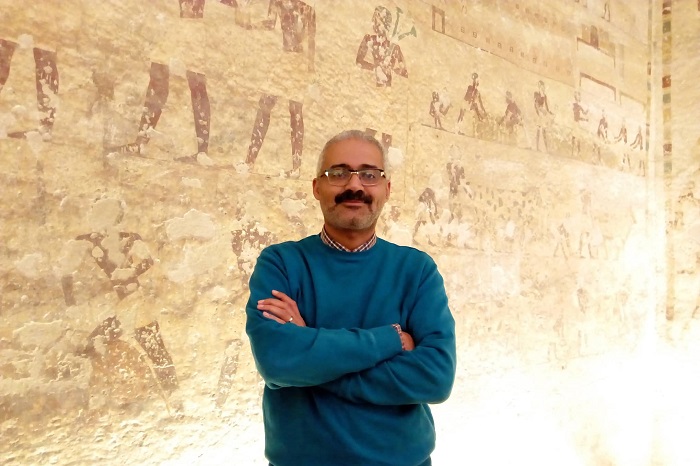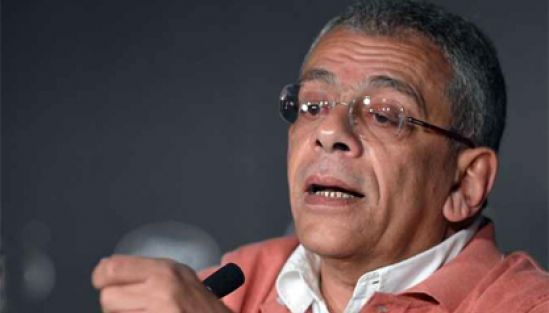حاوره: خالد حماد
القارئ لسيرة أشرف الصباغ، يصاب بالدهشة حينما يعرف أن ملفه الوظيفي يحمل لقب دكتور في الفيزياء، ويحترف كتابة الرواية والترجمة، ورغم اقتراب مشواره الإبداعي من ربع قرن من الزمان، إلا أنه يعتبر نفسه هاويا، بدأ النشر في عام 1996، بمجموعته القصصية «قصيدة سرمدية في حانة يزيد بن معاوية»، وآخر أعماله الروائية «كائنات الليل والنهار»، عام 2019، وبين العملين الكثير من الأعمال الإبداعية.
– هذا يأخذنا إلى سؤال حول وقع مهنة الفيزيائي على أذن أشرف الصباغ؟ يبدو أنك بدأت مشوار النشر الإبداعي متأخرا، لماذا؟
– عملية النشر عموما، كانت على مرحلتين بالنسبة لي. فقد بدأتُ النشر في عام 1985 في الإصدار الأول لمجلة “القاهرة” وكنت أؤدي الشهور الأخيرة من خدمتي العسكرية آنذاك. كانت أول قصة لي “ملخص ما نشر عن سلمى”، حيث نشرها الشاعر الراحل عمر نجم ومن هنا بدأت صداقتي به وبكل العاملين في المجلة، ومن ضمنهم شمس الدين موسى وعدد من المبدعين المصريين الذين كنا نقرأ لهم. بعد ذلك كانت أعوام 1985 و1986و1987 غنية بالنشر في المجلات المصرية حصرا، وبالذات في مجلة “الثقافة الجديدة”: قصص ومتابعات مسرحية وموضوعات ثقافية مختلفة ومتنوعة. كانت فترة خصبة، وكنتُ على بداية الطريق. وعلى الرغم من أنه كان لدىَّ مجموعة قصصية ورواية جاهزتين للنشر، إلا أنني لم أتمكن من نشرهما لأسباب تتعلق بالعلاقات في الوسط الثقافي وفي المؤسسات الحكومية التي تقوم بالنشر.
كان الفترة من 1985 إلى سبتمبر 1987 فترة قصيرة لتكوين علاقات في الوسط الثقافي وأوساط النشر، وقصيرة أيضا للدخول في هذه الأوساط واكتساب ثقتها، خاصة وأنها كانت عبارة عن شِلل ومجموعات لها انتماءات فكرية ودينية وسياسية مختلفة، بل وأيضا مجموعات من حيث الانتماءات الجغرافية والإٍقليمية. ويكفي أن ترتكب خطأ بسيطا أو تدخل من الباب الخطأ أو تدق الباب الخطأ ليكلفك ذلك معارك ومهالك واحتكاكات وشكوك وكوارث وتهميش واستبعاد. وأنا بطبيعتي أحب الاحتفاظ بطاقتي وأشعر بمشكلة حقيقية عندما أبددها في أمور غير مجدية.
سافرتُ في سبتمبر 1987 إلى الاتحاد السوفيتي لاستكمال دراساتي العليا (ماجستير ودكتوراه) في الفيزياء والرياضيات. وظللتُ مرتبطا بكل من مجلتي “القاهرة” و”الثقافة الجديدة”، وكنت أراسلهما من موسكو.
في الحقيقة، توقفتُ تماما عن الكتابة، وتفرغتُ للدراسة من أجل الحصول على الدرجتين العلميتين في تخصصي الأصلي. كنتُ أعيد ما قرأته من الأدب الروسي المترجم إلى العربية، ولكن بالروسية هذه المرة. عَدَّلتُ الكثير من المفاهيم والأمور والأخطاء التي كانت لدىَّ بسبب سوء الترجمات، وأدركتُ قيمة المترجم المصري أبو بكر يوسف عندما قارنت ترجماته بترجمات أخرى. قرأتُ بالروسية، ورحت أقرأ في أمور أخرى مثل التاريخ الإسلامي وتاريخ الخلفاء والخلافات، وفي التاريخ المصري. ظللتُ ما يقرب من 9 سنوات في موسكو من دون أي زيارات إلى القاهرة أو غيرها. حصلتُ على الماجستير (1990) والدكتوراه (1993). وكانت الدنيا قد تغيرت تماما، وانهار الاتحاد السوفيتي، وظهرت على أنقاضه 15 دولة، من بينها روسيا الجديدة التي أعيش في عاصمتها موسكو. واختلفت الأحلام والطموحات والظروف، وانتهى الأمر إلى أنني لم أعد إلى مصر، ولم أواصل العمل في نفس الجامعة التي حصلت منها على درجاتي العلمية، وقررتُ العودة في عام 1995 إلى الصحافة والكتابة، والترجمة من الروسية إلى العربية، حيث كنتُ قد أتقنت اللغة بشكل معقول.
ظهرت مجموعاتي القصصية الأولى تباعا: “قصيدة سرمدية في حانة يزيد بن معاوية” (1996)، ثم “خرابيش” (1997)، ثم “العطش” (1997). وفي الوقت نفسه كنت قد بدأت الترجمة من الروسية في مجلة “الثقافة العالمية” الكويتية، وفي المجلات والصحف المصرية.
لا أدري ماذا يمكنني أن أقول بشأن، هل بدأت نشر المواد الأدبية الإبداعية الخاصة مبكرا أم متأخرا! ولكنني أعتقد أن كل شيء يأتي دوما في أوانه، أي عندما تكتمل الظروف المحيطة. خرجتُ من القاهرة وعمري 25 عاما وعدتُ إليها أول مرة وعمري 24 عاما. وطوال هذه الفترة وقفتُ تماما عن الكتابة. ربما تكون هذه الفترة هي السبب. ولكن في كل الأحوال حدث وبدأتُ النشر. وبطبيعة الحال، كنتُ بعيدا عن مصر، وعن القاهرة، وعن الوسط. و”البعيد عن العين بعيد عن القلب”.
– إلى أي مدى أخذت منك رحلتك الدراسية، وهل كانت الغربة الاضطرارية سبب رئيسي فى استعادة المكان، أقصد مصر بحواريها وشوارعها وناسها عبر إبداعاتك؟
– رحلة الدراسة أخذت الكثير، وأعطت الكثير. لا أستطيع أن أحسب ذلك بمنطق الربح والخسارة. ولكنني أستطيع أن أحسبها من حيث الناتج الإجمالي النهائي: لقد ربحت وكسبت أكبر وأكثر بكثير مما كنت أتصور وأحلم وأتمنى. ومع ذلك، فلو عاد بي الزمن إلى الوراء، فسأغير الكثير من القرارات والخطوات والأفكار والرؤى.
طبعا، المسافة بين القاهرة وموسكو فعلت فعلها، وأعادت إنتاج المكان، وخلقت منظومة من الرؤى والمفاهيم والأحاسيس الجديدة تماما، والوعي بالمكان وكيف يتطور هذا الوعي ويرتبط خلسة بالزمن، ثم ينعطف ليرتبط بالذاكرة ويتشعب فيها ليُعاد إنتاجه يوميا وفي كل لحظة ومع كل خطوة. لقد لاحظ ذلك، كاتبنا المصري محمد جبريل في أحد كتبه عن المكان عندما تناول أعمال عدد من الكتاب المصريين، ومن بينهم بعض قصص مجموعاتي الأولى. وأعتقد أن الناقدة زينب العسال فعلت نفس الشيء في أحد كتبها. جبريل والعسال قاما بدور مهم مع كتاب “جيل” الثمانينات وكانا مخلصين لدورهما في الثقافة المصرية وللثقافة المصرية، سواء كان ذلك بالكتابة أو بالرعاية.
لا شك أن كل أشكال المسافات المادية أو الروحية أو النفسية تلعب دورا مهما في إعادة إنتاج المكان وتشكيله، وتحويله إلى قوة مادية تارة، وإعادته إلى حيزه الروحي تارة ثانية، أو إلى مساحاته الزمنية تارة ثالثة. للمكان مفهوم محدد في الفيزياء بالضبط مثل الزمن. ولكن مع سيادة العوالم الكمية وتعدد الوُقُع اتضح أن لكل من المكان والزمان أكثر من بعد وأكثر من معنى وأكثر من مفهوم. فما بالك إذا كان كل ذلك قادر على الارتباط بالذاكرة التي أرى على نحو ما أنها تمثل الحالة “الخامسة” للمادة. وهو ما تعرضتُ له في أحد الخطوط والمسارات في روايتي “رياح يناير”.
المكان في مصر له خصوصية ويتميز بالتفرد. هذا ليس تعصبا أو شوفينية أو محاولة للتمايز العنصري. المكان في الدول العتيقة والقديمة التي تنتمي لحضارات ما قبل الميلاد له خصوصية: في مصر والعراق والهند والصين والمكسيك وأثيوبيا. للمكان ذاكرة تنتقل إلى الكائنات المرتبطة بهذا المكان، سواء كانت مولودة فيه، أو عابرة، أو تقيم لفترة. الاختلاف يكون فقط في حجم ما تختزنه هذه الذاكرة وفي درجة شفافيتها وثرائها.
– شرطي هو الفرح هي الرواية الأبرز في مشوار أشرف الصباغ الروائي.. البعض يرى أنها جاءت بعد الثورة فاكتسبت هذه الأهمية، خاصة أنها تستعيد ذاكرة المصريين عبر رحلة الزمن كونها رواية أجيال. بالإضافة إلى التنوع في رصد التحولات الدينية والاجتماعية التي شهدتها مصر؟
– رواية “شرطي هو الفرح” هي ببساطة شديدة نحن في القرية وفي المدينة وفي المسافة بينهما، وتحتهما وفوقهما وبداخلهما. هي نحن بكل خيباتنا وفشلنا ونزقنا، وبكل ما نحمل من إرث وموروثات وثروات وتناقضات. هي رواية الغضب والرضا وقلة الحيلة والضعف والقوة والبؤس والزهو والنفاق والانتهازية والانكسار. إنها أيضا رواية الإنسان المصري البسيط بكل عفويته وسذاجته ونفاقه وأحط وأعظم ما فيه.
لا أستطيع أن أتحدث كناقد عن رواياتي أو قصصي. ولا يمكنني أن أجتذب أحدا لقراءتها أو أساعده في وضع يده على بعض الأمور فيها. ولكن كل ما هنالك أنها روايات المكان الذي يمثل جغرافية الروح المصرية التائهة والهائمة التي تشعر دوما بالتقصير وبالذنب فتلجأ دوما للدين والأساطير والغيبيات. وهي رواية الكائنات المصرية بكل شرها وكسلها وخبثها وعفويتها وقلة حيلتها وغضبها وحزنها وبكائها المتواصل، حيث تمثل هذه الكائنات الجغرافيا الحقيقية للتاريخ، لأنهما توأمان متلازمان منذ نشأتهما معا…
– استعادة الخرافة والأسطورة عبر العمل الإبداعي سواء في رواية “شرطي هو الفرح أو في رواية كائنات الليل والنهار”. هل هذا يأخذنا إلى تعميق الإيمان بما هو أسطوري وخرافي كجزء من تركيبة المجتمع أم أن استعادته والارتكان عليه في السرد يأخذنا إلى رفضه؟
– الإنسان، شئنا أم أبينا، ابن الخرافة وسليل الأسطورة. الإنسان ولد من رحم الأساطير والخرافات وظل لملايين السنين يحتمي بها: من قسوة الطبيعة، ومن وحشية الحيوانات، ومن ظلام الليل، ومن ضياع الطريق، ومن غدر الزمن، ومن المجهول، ومن الجوع والعطش، ومن الاشتياق أيضا! الأسطورة جزء من تكوين الإنسان، أي إنسان وكل إنسان، مهما فعل ومهما حاول التملص والهروب. أنا نفسي جزء من هذه الأساطير والخرافات، وهي جزء لا بأس به من تكويني، أشعر به جيدا وأراه عندما أسمع موسيقى أو اقرأ الشعر أو أشاهد لوحات فنية أو أتابع عروض باليه أو رقص شعبي، عندما أجلس متأملا بطن امرأة حامل، أو أطالع حركة طفل صغير يسعى لإدراك عالمه الجديد..
ننتقل إلى الأسطوري والخرافي كجزء من تركيبة المجتمع. وإذا شئنا الدقة، يمكننا أن نقول: “من تركيبة المجتمعات”. الأسطورة ولدت في نفس اللحظة التي ظهر فيها وعي الإنسان، وظلت ملازمة له حتى وهو يصنع مراكب الفضاء والسفن والطائرات، ويصيغ المعادلات العلمية، ويقف بين يدي إلهه، يصلي له ويناجيه. إن الأسطوري والخرافي يشكلان أحد أهم مصادر الخيال الذي يعيد بدوره إنتاجهما في الفن والشعر والموسيقى والحياة، وفي الواقع أيضا. إنهما كائنان حيان متغيران ومتحولان يكاد كل منهما يملك وعيه الخاص ومخزونه من أجل الإنسان. إن كلا منهما في نهاية المطاف أحد صور الوعي، وأحد صور وعي الإنسان بذاته، ولن نخطئ كثيرا إذا قلنا بيقين يشوبه بعض الشك إن كلا منهما، بمفهوم ما وبدرجة ما، ابن الإنسان، وصنيعة الإنسان وأحد أهم مصادر وعي ووجود الإنسان.
أعتقد أننا وصلنا الآن إلى إمكانية تحديد الرابط بين الأسطورة والخرافة. فما يفعله الشيخ السباعي في “شرطي هو الفرح” خرافات تسعى لاكتساب صفة الأسطورة، بينما ما تفعله محفوظة في مقام سيدي الخراشي أسطورة تسعى لامتلاك الروح وشغل حيز من الوجود. هناك أيضا المستوى الأعلى من الأسطورة، أو ما بعد الأسطورة، في عالم الحِرْش عبر فرع المياه الملعون. وهناك أيضا الأساطير (أو الخرافات) التي تحتاج للتأمل والبحث فيما وراءها، مثل البئر الذي تحبل فيه النساء بالفعل وفي الواقع، وانشقاق السماء في ليلة القدر وظهور الملائكة الذين يهبطون من السماء حاملين صناديق الأموال والذهب والمرجان.. نحن هنا لسنا بصدد إحياء أو رفض أو تعميق بقدر ما نحن أمام أسئلة تتعلق بالوجود وبالروح وبالخلود وبالاختيار بين كل هذه الطرق والسبيل.
هذه النقطة مهمة وفاصلة ودالة، وأرجو أن تكون واضحة. الأساطير والخرافات بكل مستوياتها ومصادرها وتفرعاتها تمتلك الحق في الوجود، لأنها رفيقتنا منذ ظهرنا في الكون. والمسألة ليست في تعميقها من أجل هدف ما، أو رفضها من أجل هدف ما آخر، وإنما في كيفية إدارتها وإعادة إنتاجها، وفي (وهذا هو الأهم) الاختيار بينها وبين بعضها من جهة، وبين ما نختاره منها وبين الظواهر والرؤى والأفكار الأخرى من جهة ثانية…
هذا الأمر ينسحب أيضا على “كائنات الليل والنهار”. لأن الأساطير والخرافات جزء أصيل ليس فقط من كينونة إنسان الحضارات القديمة، بل من تركيبة ووعي الإنسان بشكل عام. ذلك الإنسان الضعيف والهش والشرير والمؤذي، وربما الصالح والجيد والقوي والخلاق!!
– على يسار السلطة أي سلطة أيا كانت، كان أشرف الصباغ وما زال. هل هذا يعني أن ثمة يسار إلى الآن ولديه القدرة على الحشد والتوعية، أم أن ما يجري (فيما يخص مفهوم اليسار) مجرد استعادة وحنين للماضي؟
– اليسار ليس مفهوما جامدا أو مؤقتا أو عابرا أو مجردا أو مرتبطا بمراحل تاريخية أو سياسية معينة، إنه نمط حياة وطريقة تفكير وأسلوب لرؤية العالم. وهو في نهاية المطاف اختيار جدير بثمنه. السلطة بحاجة دائمة إلى بشر ومجموعات ومؤسسات على يسارها، حتى وإن كانت هذه السلطة صعدت من اليسار وحاملة لقيم اليسار. إن اليسار ليس مجرد مصطلح يقف على الشاطئ الآخر المقابل لليمين، بل “عملية” معقدة تنطوي على مسارات اجتماعية وفكرية متشابكة في علاقة حية ودائمة مع الواقع بكل ما يتفاعل ويتحرك ويتجادل فيه. وبالتالي، لابد وأن يكون هذا اليسار، بهذا المفهوم، موجودا على الدوام كمحرك اجتماعي، وكأداة صارمة للرقابة، ولا مانع إطلاقا من أن يكون سلطة. ولكنه في الحالة الأخيرة، ومهما حدث ومهما كانت المعوقات والعقبات والموانع، فلابد وأن يظهر “يسار” هذا اليسار وإلا ستنحرف المؤشرات والبوصلات وستتجه السفينة إلى منعطفات غير محمودة العواقب. إنه ببساطة ضمانة اجتماعية بالمعنى الواسع والعلمي لكلمة “اجتماعي”.
– العمل كمحلل سياسي يستغرق الكثير من الوقت في المطالعة والبحث.. هل هذا يأخذ من مساحة الكتابة الإبداعية والترجمة؟
– لا شك أن العمل في التحليل والبحث السياسيين يستهلكان وقتا ضخما، ويقتطعان مساحة هائلة من الوقت على حساب الكتابة الأدبية. وهما مصدر الرزق الوحيد منذ سنوات طويلة. ولكنني أطمئن نفسي وأقول إنه “لا شك أن المطالعات والمراجعات السياسية والاجتماعية جزء من العملية الإبداعية بشكل عام”… طبعا أتمنى أن أكون صادقا أو على حق، أو أن يكون هذا الكلام صحيح. ومن جهة أخرى، لا أستطيع أن أتعامل بخفة مع هذا الموضوع، لأن ذلك سيؤثر على قدراتي، وبالتالي على مصدر رزقي. وفي نهاية المطاف، التحليل والبحث السياسيين مسألتان في غاية الأهمية ويحتاجان إلى ضمير وحرفية، وحرص وأمانة، لأن المسألة ليست فقط مجرد جلوس أمام الكاميرات أو كتابة كلام فارغ. إنهما فعلا مسؤولية ضخمة توقف عليها أمور أخرى تتعلق بالمجتمع وبمراكز القرار وبمصالح هذا المجتمع أيا كان شكل الدولة أو مفهومها أو ما يجري فيها.
– قدمت للترجمة من الروسية إلى العربية العديد من الكتب في مجالات مختلفة بدء من الرواية والقصة وصولا للمسرح بالاضافة الى تقديمك للعديد من اعمال المترجمين الشباب.. هل ترى اسم الصباغ كمترجم محترف أخذ حقه نقديا ومعرفيا؟
– هذا السؤال من نوعية الأسئلة التي تستدر الدموع والأسى. ولكن أنا الآن لست بمعرض تقييم دوري وجهودي. ولست مهتما على الإطلاق بذلك. وأنا صادق فعلا فيما أقول. أنا الآن، ما زلتُ أعمل وأقدم، وأجد مصدرا متواضعا للرزق، وأعيش بشكل إنساني نسبيا. أعتقد أن ذلك كاف للغاية لكي أفلت من إغراء الإجابات التقليدية على هذا السؤال. أنا أتعامل مع كل ما سبق كهاوٍ، وأضع في اعتباري أنني غدا أو بعد غد سأغير نشاطي ونمط حياتي لأعود مرة أخرى للعمل في ورشة كاوتش أو في مصنع معدات معدنية أو في ورشة صفيح، أو مدرس علوم، وربما مدرس لغة عربية أو تاريخ وجغرافيا. كل ذلك ما هو إلا جزء من الطريق الطويل المليء بالمنعطفات والمنحنيات والمقالب والخدع…
– ماذا عن أزمة الترجمة بصفتك مترجم، وهل هناك حلول لاقامة مشروع قومي حقيقي يلاحق ما يتم نشره إبداعيا وفكريا في العالم لمواكبة ما يجري في المشهد الثقافي العالمي..
– أعتقد أن مصر ليس بها أزمة ترجمة. قد تكون الأزمة في الإدارة أو في التوجه أو في المنهج، أو في طبيعة عمل المؤسسات الثقافية والتعليمية وعلاقها ببعضها البعض وآلية عمل المجمع والدولة. إن مشروع الترجمة المصري، ربما منذ عشرينيات القرن العشرين، هو مشروع مهم وناجز ومنتج. ولكن المشكلة في أمور أخرى تتعلق بالمنهجية، وبآلية العمل، وبطريقة المصريين في إدارة مشاريعهم المهمة.
أعتقد أيضا أن الدكتور جابر عصفور قد أدى دورا مهما في الثقافة المصرية إبداعيا وإداريا ولوجستيا. غير أن المشروع القومي للترجمة كان أحد أهم الإنجازات المضيئة التي حققها المفكر جابر عصفور ليؤكد لنا أننا قادرون على تحقيق خطوا واسعة إذا أردنا ذلك.
مصر من منظور الترجمة، أو بالأحرى في مجال الترجمة، يمكنني أن أقول بفخر أنها دولة كبرى، بل وأكبر من الدول “الثرية” المحيطة والقريبة، لأنها تمتلك الطاقات والقدرات والكوادر، وجزء لا بأس به من الرؤية. يبقى فقط أن نفكر في كيفية إدارة ذلك بعيدا عن البيروقراطية والفساد المالي والإداري والتهافت والاستهتار والاستسهال و”الكروتة” المصرية المعروفة.
– ثمة أصوات تشير إلى أننا حتى هذه اللحظة الراهنة نجحنا في مشروع الترجمة إذا قيس الأمر بمفهوم الترجمة التبادلية.. نحن فقط نترجم ما ينتجه الأخر طوال الوقت. هل هذا يعني أننا بعيدين عن فكرة إنتاج ما يمكن ترجمته إلى لغات اخرى؟
عادة ما تدور الندوات والمؤتمرات والأحاديث عن الترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى، حول المشاكل التقليدية مثل اختيار النصوص والموضوعات، ولجان الاختيار ومعاييرها، ودور النشر الخاصة والمؤسسات الحكومية التي تدفع بمنتجاتها للترجمة.
هناك أيضا المنتديات والمؤتمرات الأكثر عمقا وجدية التي تتناول الترجمة كعملية ثقافية كاملة قابلة للنقل والحوار والنقد، ومن ثم تظهر الترجمة كإحدى أذرع القوة الناعمة لهذه الدولة أو تلك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الترجمة أيضا هي المادة الأساسية لعلوم الاستعراب والاستشراق والأنثروبولوجي. وهي العلوم غير البريئة تماما، وربما إطلاقا، من شبهات الاستعمار والسيطرة وفرض النفوذ والشروط.
الترجمة أيضا، هي عملية صناعة كاملة الأركان، وبالتالي، هي عملية تجارية بمعناها الاقتصادي الواسع بكل ما يحمل من مسارات وعمليات أساسية وهامشية وأرباح. وبالتالي، فهي بهذا المفهوم تدخل ضمن إطار المشروعات الوطنية والقومية التي تستفيد منها الدولة ومؤسساتها وأجهزتها، والتي يستفيد منها المجتمع في حراكه الاجتماعي – التاريخي – الثقافي – الفكري. هذه النقطة تخص الجانب الذي يقوم بالترجمة بنفس القدر الذي يخص الجانب الذي يُتَرجم منه. ولا يمكن هنا بأي حال من الأحوال أن نتجاهل أنها خاضعة لموازين القوى السياسية والاقتصادية والنفوذ.
الندوات والمؤتمرات والأحاديث تدور دوما عن الكثير من ما ذُكِر أعلاه، ولكنها دوما تتجاهل أو تنسى، وربما لا تهتم بعمليات متابعة النصوص والموضوعات والكتب التي تتم ترجمتها من العربية. أي تتوقف عملية الترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى عند صدور الكتاب بهذه اللغة أو تلك، وتبدأ عملية أخرى في غاية الفظاظة والتضليل. تلك العملية الإعلامية الفجة التي تدور حول عظمة ثقافتنا، وعظمة مبدعينا ومفكرينا وكُتَّابنا، وعالمية هذا الكاتب أو ذاك، بينما النصوص والكتب التي تُرْجِمَت “مركونة” على أرفف بعض معاهد وكليات تعليم اللغة العربية.
إن عملية تتبع المنتج والترويج له وفق المعايير المحترمة والمتعارف عليها تمثِّل أحد أهم الأهداف من عملية الترجمة، وقد تكون الحلقة الأهم في تلك العملية. وأعتقد أننا جميعا نلاحظ الجهود التي تبذلها المراكز الثقافية والتعليمية، وربما المؤسسات الدبلوماسية، الأجنبية في مصر والعديد من الدول العربية لإقامة الندوات ودعوة المبدعين والكتاب الأجانب للمشاركة في ندوات ونقاشات تتعلق بكتبهم المترجمة إلى اللغة العربية. والمهم هنا، أنه يتم اجتذاب المثقفين والنقاد والمبدعين والكتاب المصريين والعرب لإدارة هذه الندوات والمشاركة فيها والتفاعل معها.
بعض دور النشر في مصر والدول العربية تنتهج أيضا هذا المسار المهم، عبر محاولات وجهود فردية، لإكمال عملية الترجمة، ولكن ليس في اتجاه الخارج، وإنما في اتجاه الداخل. فتقوم بدعوة الكتاب والمبدعين الأجانب وإقامة الندوات والمؤتمرات، وذلك كجزء من عملية الترجمة، وكجزء من دورها في صناعة النشر عموما، والترجمة من اللغات الأخرى على وجه الخصوص. غير أن العملية العكسية متعثرة للغاية، سواء على مستوى دور النشر الخاصة أو الحكومية، حيث يتم ترك المادة أو المنتج الذي يترجم من العربية لمصيره المجهول، ونكتفي فقط بالإعلانات الوهمية عن كِتاب أو مادة تُرجٍمَت إلى اللغات الأخرى. ونبدأ بمنح الصكوك وشهادات الاعتراف الوهمية أيضا.
……………..
* موقع أصوات أونلاين، 23 يونيو 2020