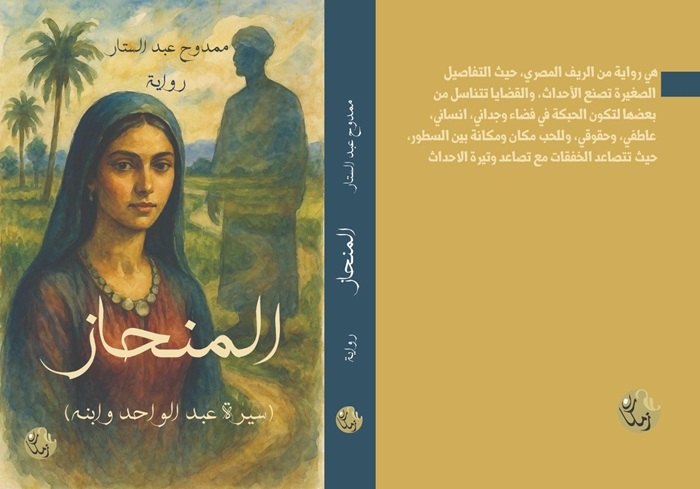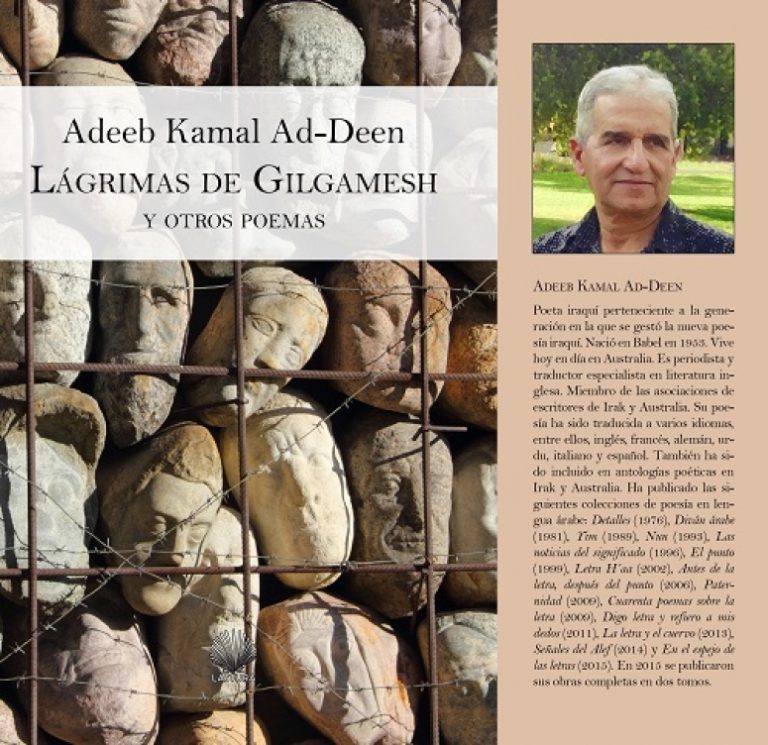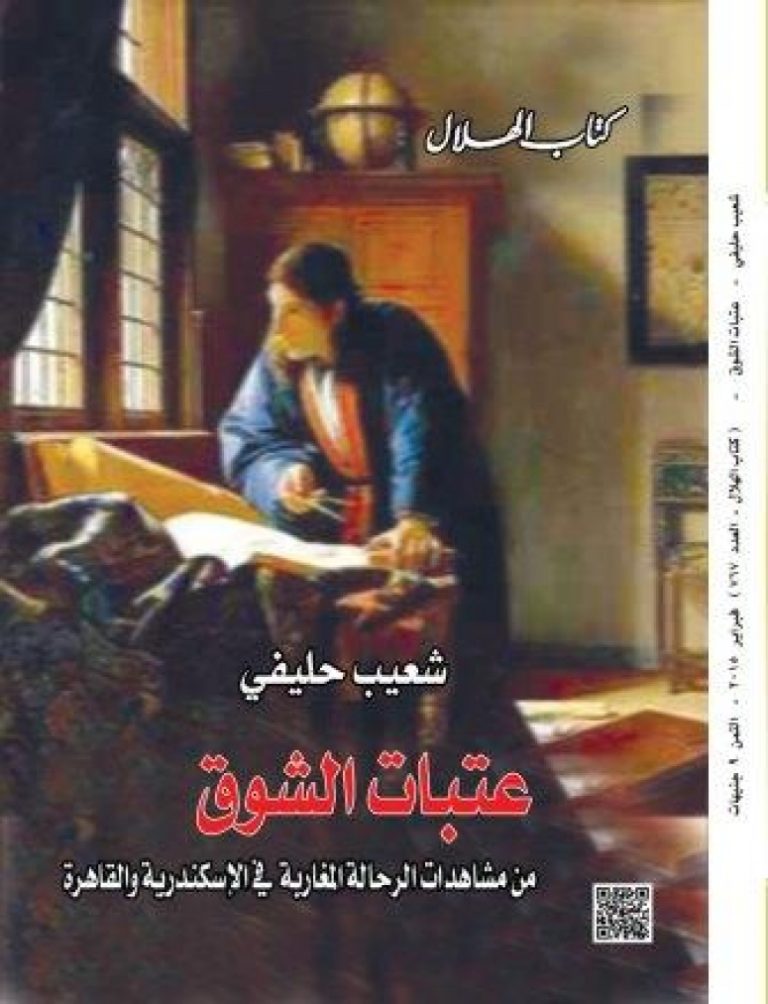2-3
تُفتتح المجموعة بقصة “مريم سيدة الهديل”، لتسرد مشهدًا عن تلك البنت الدميمة “مريم” التي يفور جسدها بشبق مروع، يدفعها إلى اصطياد الأولاد من زملائها بالمدرسة – أثناء حصة الدرس الخصوصي – فتبُثُّهم نيران شبقها المستعِر بالخرابة المتاخمة للعمارة المهجورة التي يسكنها الراوي، بوصفه واحدًا من ممارسي فعل اللذة الجنسية، وبمراقبة كل من زميليه عمرو وباسم. تدور وقائع القصة، مثل غيرها من باقي القصص تقريبا،ـ مع بدء حلول الظلام، تحت الشجرة الملعونة التي نُسِج حولها مرويات شتى، من قبيل أنها تأوي الأشباح، ويصدر بالقرب منها صرخات ليلية مباغتة تدوي في ظلام الخرابة، نتيجة عبث الأولاد بجسد الفتاة الغضّ؛ الأمر الذي جعلهم يتغلبون على مخاوفهم من الأشباح بفعل تلهف خيالهم علي تعرية تضاريس الجسد الباهر للأنثى. ومع ذلك، تنحو القصة، مثل غيرها، فضلاً عن استدعائها بعض قصص المجموعة السابقة لإبراهيم فرغلي “باتجاه المآقي”، نحو الغرائبي الذي يتحول معه الأولاد بفعل التجاوب الشبقي مع البنت مريم الدميمة إلى فِراخ حمام أو بوم ينعق في فضاء الخرابة أو فضاء الروح البشرية الخاوية لهؤلاء الصغار. إن مثل هذا التجاوب هو ما دفع الراوي بعد اختفاء طويل إلى العودة راغبًا في رحم مريم ليطفئ “حريقًا مشتعلاً في قلبه المعذّب” (ص12)، بينما ذراعا مريم تتشبّثان بجسده خوفًا من تحوله إلى فرخ حمام صغير سينزلق حتمًا من بين ذراعيها، و”لن يبقي منه في فراغ حياتها سوى كل هذا الهديل” (ص12). الأمر نفسه يحدث مع العجوز الذي يدمن المخدّرات، في قصة “تذكارات”، ويخلق خياله ما يشاء من صورٍ لإناث جميلات، مغويات وشبقات، نتيجة عزلته التي تدفعه كثيرًا إلى تأمّل تلك الصورة المعلّقة على الحائط أمام الفراش وسجائر الحشيش تحلّق به إلى حدود “خيال كان واقعًا جميلاً في أيام خلت” (ص26). لكن توحّد هذا العجوز بالصورة واصطياده، في ليلةٍ ما، فتاةً سمراء، دفعا به إلى أن “يحتضن من خلالها أحبّة في الغياب” (ص28)، وإلى بكاء كان يريع ملاك الموت الذي جاءه، حيث كان يخرج عُودَهُ وتشرع أصابعه في مداعبة أوتاره ويدندن بصوته المحشرج حتى يأخذه الوجد، فتعمل ذاكرته البعيدة ويبدأ في النشيج والغناء والبكاء.
لكنَّ صفة الدمامة التي وُصِفت بها “مريم سيدة الهديل” سوف تنقلب إلى جمال تبدو معه البنت التي تسمّى “جميلة”، في قصة “مشاهد من أعلى الجدار”، نموذجًا أنثويا مغويا، في مقابل بشاعة ذلك الدميم “الذي أحبّها سِرًا ولم تعلم من أمره شيئًا إلا بعد أن حملها بين يديه مَغشيا عليها، تنزف الدماء من رأسها، وأنفها، فور سقوطها على أرض الطريق بعد أن صدمتها سيارة مسرعة فر سائقها هاربا” (ص51)، لتفيق على صوت نشيج مَنْ كان يجلس بجوارها ويبكي إصابتها، فتتحرك مشاعرها، للمرة الأولي في حياتها، نحو هذا الدميم البائس الذي يعرِض عن سماع كلام أهل المدينة الصغيرة عن تحول (ميتامورفوسيس) “جميلة” إلى مسخ شائه يتحاشاه الناس، والذي يكشف فعل السرد، في النهاية، عن كونه هو الراوي الذي كان يحدّثنا منذ البداية واصفًا نفسه ومشاعره وأحاسيسه بحيادٍ شديد كأنه راوٍ مصاب بالشيزوفرينيا.
يحيل هذا الفضاء الذي يجمع بين الإناث والذكور، الأولاد والبنات، أو بين القبح والجمال، إلى عالم غرائبي يصل الإنس بالجنّ، ويصوغ من “مُدركات الحواس” أشباحًا تؤكّد علي فكرة القرين Double ، كما في قصة “أشباح الحواس”، حيث تصبح هذه الفتاة الجميلة مركزًا لاهتمام قرينها الجِنّي الذي كان يأتيها في صورة شيخ عجوز يسعى إلى تطهير جسدها ممن تلبّس به، بينما كانت يداه الغليظتان الباردتان، في حقيقة الأمر، تتلمّسان جسدها في تبتّل، تنكشف معه حقيقته حين يتحول جسده إلى جسد شاب قوي مثير يظلّ يلازمها بعد ذلك لسنوات، بصوته الضاحك الساخر، “كلما وجدها تسعي إليى النوم في أحضان رجل غيره” (ص 60)، ليقف بذلك حائلاً يمنع تواصلها مع إنسي مثلها.
3-3
وفي الوقت الذي تسعى بعض قصص المجموعة إلى تشكيل مفردات عالم غرائبي يجوس في أركانه المردة والقُرناء، ويمتلئ بالمسوخ والمشوهين، فإن بعضها الآخر يسعى إلى خلق عالم متناغم متصل الحلقات، يضرب على وتيرة اللذة، أو لنقل “الشهوة والمشتهى” بلغة ميشيل فوكو، أو “الليبيدو” بلغة فرويد ومدرسة التحليل النفسي. وبينما تتمثّل قصة “چين تونيك” وجهة النظر الذكورية في السرد، حيث يقصّ الراوي المتكلّم علاقته بالفتاة التي أحبّها، وضاجعها، وتركته، في النهاية، لترتبط بآخر، فإن قصةScrew Driver تتمثل وجهة نظر أنثوية تبرّر معها الراوية لنفسها ولمَنْ تروي لها أسباب انفصالها عنه، بعد أن افتُضّتْ بكارتها؛ لأنها لم تستطع أن تتجاوز الطقوس البرجوازية العفنة علي حد وصفها (ص23). وكلتا القصتين تحيل إلى الأخرى كأنهما وجهان لحكاية واحدة، بطلها الأول الليبيدو، أو تلك الرغبة الفائرة في التخلص من عبثية الحياة، المتحولة دائمًا، عبر الانتقال من أحضان فتاة إلى أخرى، في حالة من والبحث المتصل عن الاستقرار داخل “الرحم”. من هنا، سوف ينسحب وصف الراوي للذّة الليبيدية علي مفردات القصة، فذاكرة الراوي “تنتصب”، كما القضيب، وما عمره إلاّ “إيقاع رتيب لسنواتٍ عجافٍ”، قضاها مع فتاته التي لم تتركه حتى داخل الحلم، رغم انفصالهما حقيقة وواقعا منذ سبع سنوات.
إن مثل هذا التواصل الذي تخلقه قصص المجموعة، حين تحيل إلى بعضها البعض كأننا بصدد حلقة قصصية Narrative Recycle ، يتكرر بين قصتي “الغرافة الخضراء” و”ثلاث شمعات”؛ إذ يقتسم السرد فيهما راويان أولهما ذكر والآخر أنثى، كلاهما يبحث عن الآخر في مشاهد سردية تكرّر نفسها في القصتين، وفي مكان واحد تقريبًا هو “نوتردام دي باري” ولا يكاد ينكسر هذا الإيقاع المتناغم الذي تخلقه فضاءات القصص الإحدى عشرة، إلا في قصتين اثنتين، يلعب فيهما الراويان بالزمن، وبنا نحن القرّاء، في مقاطع سردية ووصفية مثيرة عن ذلك الرجل الغريب، الراقص، الذي كان يمارس طقوسه الجسدية الليلية عند اكتمال القمر مع كل شهر، فيترك المبنى الذي يقيم به مرورًا بالمدقّ الضيق المتاخم للكنيسة، ويتصاعد إيقاع جسده الراقص مع توهج سطوع القمر، ولا يهدأ إلا لحظة شحوب الضوء، وأنه مشرف على الموت. إنه راوٍ يلعب بذاكرتنا حين يتأرجح بمخيلتنا بين “الآن وهنا”، حيث الرجل الغريب بمقر عمله نهارًا في أول القصة، و”هناك حينذاك”، حيث كان الغريب أيضًا مع محبوبته منذ أيام الجامعة حتى دخولها السجن وموتها ودفنها، ثم انتهاءً باكتشافنا لراوٍ آخر هو الشاب نفسه الذي يسرد لنا الآن، والذي كان يقف بالشباك لحظة اكتمال القمر من كل شهر ليمارس طقوسه الليلية من رقصٍ وابتهال وأداء جسدي متناغم، كمن يستحضر روح فتاته الميتة منذ سنوات بعيدة، كما في قصة “قمر النشوان”. أما قصة “فارق التوقيت” فهي تؤكد ذلك الإيقاع السردي المضطرب، أو لنقل “السريإلي”، الذي لا ينتظمه قانون سوى قانون اللعب بالزمن والذاكرة، والتأكيد على عبثية الحياة ولا منطقيتها، فالأمكنة المتباعدة تتجاور، والأزمنة المتباينة تتقاطع، رغم فروق التوقيت، والواقع يمتزج بالحلم، والسرد يصيب بالدّوار.
لقد استطاعت مجموعة “أشباح الحواس”، على الرغم من تفاوت إيقاع قصصها من حيث السرد والحبكة والإقناع بعالمها، وما يكمن خلف قصصها من رؤية جمالية وأيديولوجية، تحفّز قارئها نحو مراجعة مفهوم “الأدب العجائبي” لتزفيتان تودوروف، و”بيانات السوريإلية” لأندريه بروتون، و”استعمال المتع” لميشيل فوكو، فضلاً عن قراءة فرويد ولاكان للحلم والليبيدو وغيرهما من المفاهيم السيكولوچية عن “خداع الحواس” و”النيكروڤيليا” و”فوق الطبيعي”، وكلها قراءات تؤكّد على لامنطقية الفنّ وسريإليته، ومجاوزة الطبيعي إلى ما فوق الطبيعي، والخروج من أسر الواقعي المحدود إلى فضاء المتخيل/الغرائبي الرحب، حتى وإن كان هذا العالم الغرائبي الذي نستقبله محضَ شبح أو أشباح لما تصنعه مخيلة رواة وأشخاص ذوي حواس مضطربة وممسوسة بحكم ثقل الواقع الذي يعيشون تفاصيله اليومية المتلاحقة.
…………….
جزء من مقال للناقد نشر في صحيفة عمان (أكتوبر2010)