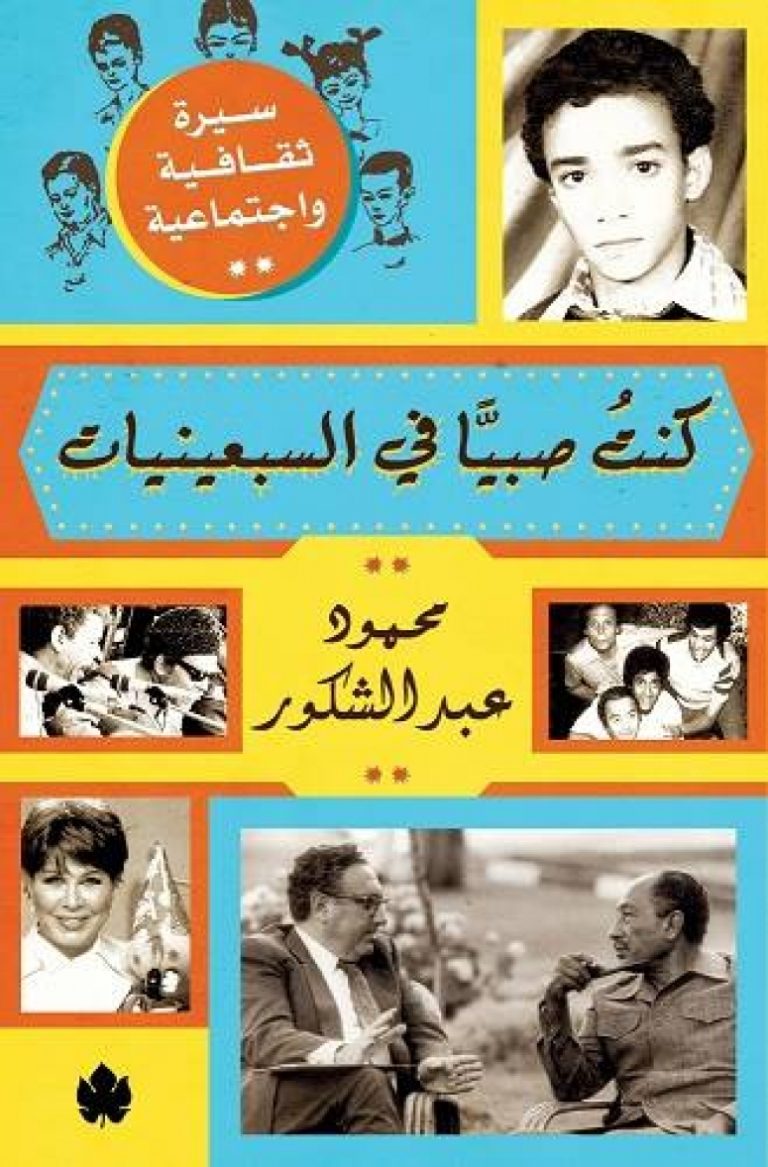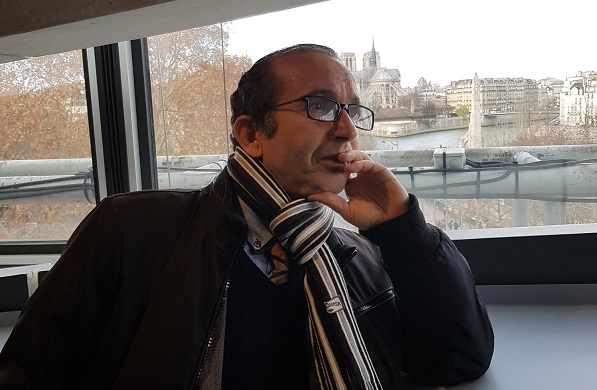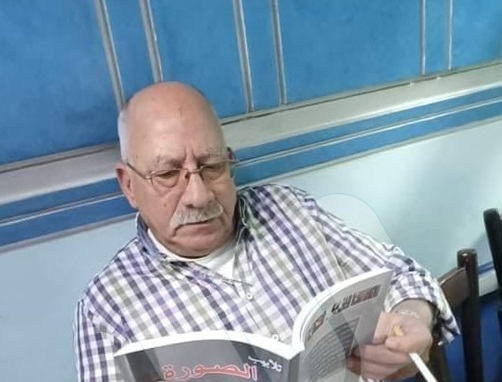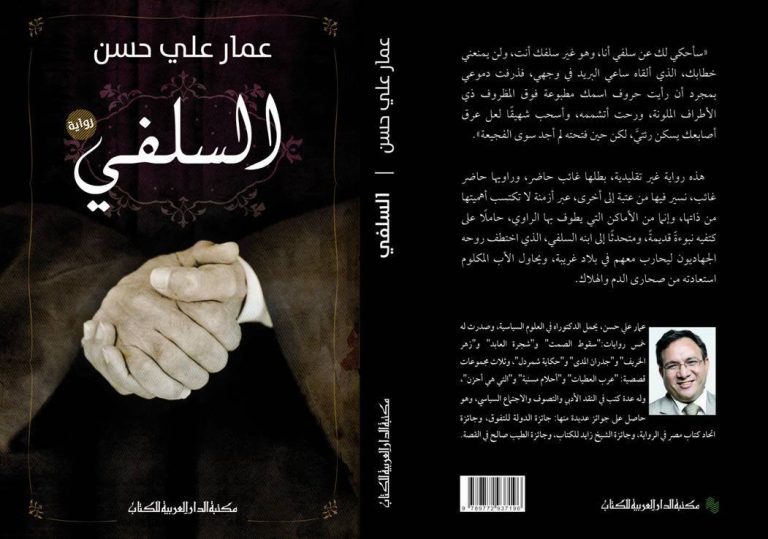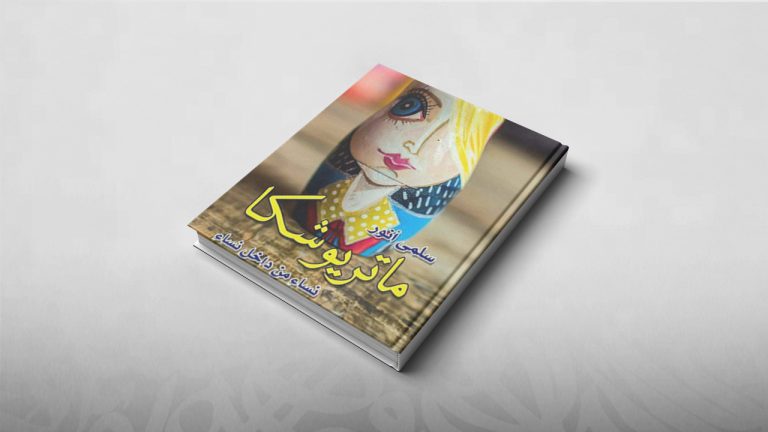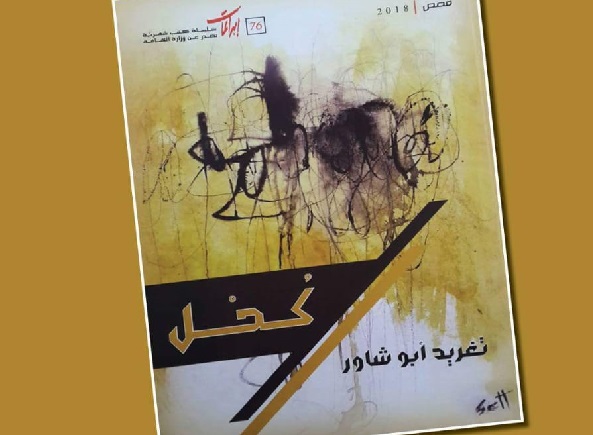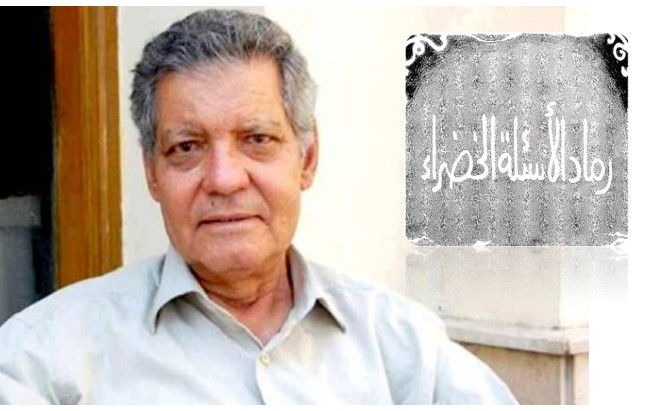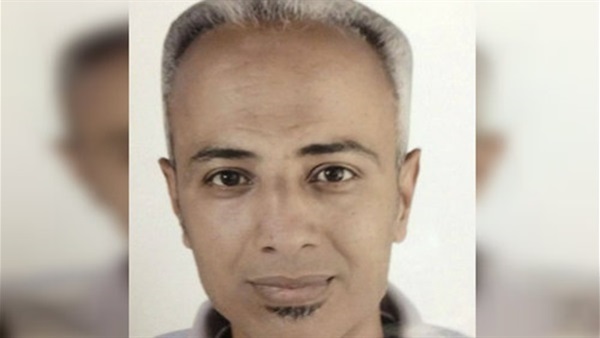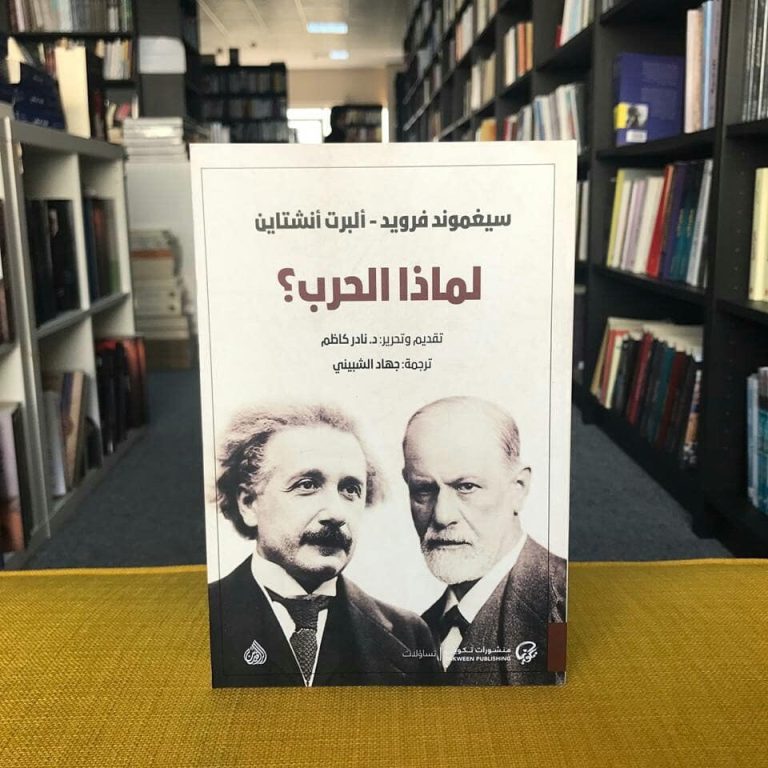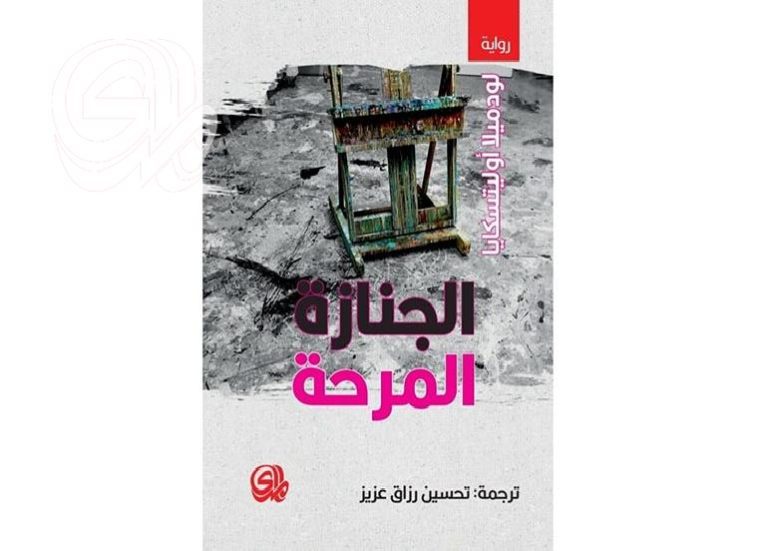د. فيصل عادل الوزان*
ما بين عُبور البِيص وعبور التّبّة سطّرَ سعود السنعوسي تاريخًا موازيًا للمهمشين في مدينة الكويت القديمة في روايته الثلاثية “أسفار مدينة الطين” (2024-2025م).
خرجت الروايةُ مفعمةً بالتراث الكويتي، عبقة بالذكريات، معتقة بخواص المفردات والعبارات، ممزوجة بالأغنيات، منسوجة بجذور الثقافة الكويتية الشفاهية والمكتوبة، المادية واللامادية. إنها رواية تجاوزت التاريخ والأدب وأضحت رواية أنثروبولوجية في أروع صورها. فهي مثال لكيفية تحويل المخزون العلمي الموروث لدى الروائي وبحثه المتأني الذي أخذ سنوات طويلة من عمره إلى نص أدبي قصصي ثري محبوك مثير للدهشة والمتعة. وهي أيضًا مثالٌ حيٌّ على روايةٍ يُقدِّمُ فيها كاتبُها الخصوصية الثقافية الشديدة لبلد أو شعب ما بشكل مفهوم ساطع الوضوح لمن لا يخبر تلك الثقافة من القراء. ورغم ذلك، فإني أدّعي أن لا أحد من القراء سيتذوقها ملتذًا بقدر القارئ الكويتي الذي لا يزال يحتفظ بذاكرة مفردات وعبارات الأجداد والجدات ورواياتهم، وكذلك من يشترك مع المؤلف في المرجعية الثقافية.
عليَّ أن أعترف في البداية أن الرواية بقدر ما هي سَلِسَة، فإنها مُعقّدة التركيب، عابرة النوع الفني، طويلة الخطوط، متعددة الأزمنة، مزدحمة الشخصيات، متنوعة الأفكار، ذات تقنيات سردية مختلفة، مُلغّمة بالألغاز بطيئة الحل. وهو ما يجعلها تحديًا للنقاد الذين سيَحَارُون في كيفية مقاربتها. وهي أيضا لعبة يخوضها باحثو تاريخ الكويت وثقافتها. سأقدم فيما يلي شتات ملاحظاتي.
تعالج الرواية عددًا من القضايا: الصراع بين التطور والتخلف وبين العلم والخرافة، وبين المثالية والبراغماتية، وقضية المنبوذين في المجتمع، والشك والإيمان، والعلاقة الوالدية، والاختيار والجبر، والميثولوجيا والفلكلور، والكرامة والاعتداد بالنفس، والعلاقات السياسية والدولية. ويتناولها السنعوسي بعناية مستفيدًا من البحث السيكولوجي والفلسفي والسياسي. وسيلحظ القارئ تركيزًا شديدًا على الخرافة والشعوذة. ولا شك أن هذا تصوير طبيعي ومناسب على اعتبار أنها بيئة المهمشين المعدمين الذين لا يملكون غير الارتباط والتعلق بالغيب والقوى الخفية.
إن خط الرواية الأساسي أو العمود الفقري للرواية السمينة هو رحلة استكشاف سليمان لذاته، ومحاولته التطهر من خطئه في حق أهله. وقد زاحم هذا الخط الدرامي خطوطٌ متعددةٌ لشخصيات لا تقل تأثيرًا عن شخصية سليمان.
إن رواية أسفار مدينة الطين في الحقيقة، رواية شخصيات أكثر منها رواية حبكة. أو أن الجانب التصويري للشخصيات وظروفهم وأفكارهم وسلوكياتهم قد طغى على الحبكة وطغى أيضًا على المدينة نفسها. وليس هذا عيبًا فيما أرى؛ خاصة في حالة روايتنا هذه. ويجب على القراء أن يضعوا هذا في الاعتبار عند قراءتها. ألم تكن رواية القرن التاسع عشر رواية شخصيات؟ وكم أعجبتنا روائع ذلك الزمن.
أما السياق التاريخي لأحداث الرواية فيأتي على فترتين متداخلتين: الأولى فترة معركة الجهراء في عام 1920م ضد إخوان من طاع الله؛ البدو المتشددين المتذرعين بذرائع دينية تخفي مطامع سياسية واقتصادية لاحتلال الكويت التي تعد ميناء نجد الأول. ويحدث ذلك في أثناء وجود أفراد الإرسالية الأمريكية المبشرين بالمسيحية في الكويت، ووجود المعتمَد البريطاني. أما الفترة الثانية فهي قبيل الغزو العراقي، صيف عام 1990م. أي أنهما فترتين مفصليتين تجلى فيهما طرفا الصراع بين الحق والباطل، وهي فترة محفزة نشطة ومثالية كبيئة سردية لأحداث صعبة، وفترة يُمتحن فيها صاحب القرار وتختبر طريقة تصرفه.
القالب الأدبي للرواية Genre:
لم تلتزم “أسفار مدينة الطين” بقالب فني أدبي واحد، فقد عَبَرَتْ ما بين الواقعية والواقعية السحرية والفانتازيا، وتضمنت عناصر مغامرة ومفاجأة وتشويق وغموض وكوميديا وتراجيديا، بشكل حولها إلى ملحمة تصارع فيها شخصياتها أقدارها التي كتبها مُخرجُ العمل وكاتبُه الضمني.
يتمثل الجانب الواقعي في تصوير وقائع تاريخية وردَ ذكرُها في كتب التاريخ والروايات الشفهية، مثل معركة الجهراء والغزو العراقي، وتضمنت أسماء وشخصيات حقيقية كالأمير سالم المبارك الصباح والشيخ أحمد الجابر والشيخ عبدالله السالم، والشيخ عبدالعزيز الرشيد وغيرهم، إضافة إلى المعتمد البريطاني مور، والأطباء القس الطبيب إدوين كالفارلي وزوجته الطبيبة إلينور (حليمة خاتون)، والطبيب ملريا، وغيرهم. وأخذت الأحداث أماكن حقيقية، وكذلك وصف السنعوسي تنظيمات الغوص بشكل واقعي علمي.
وتتجلى واقعيتها السحرية في خلق عالم مواز تخترقه العرّافات (الصّاجّات) بشكل حصري، وهو يوم السّدِيس في الأثمون. وقد رسم السنعوسي مشهد حفلة انتقال وتنصيب الصاجة الجديدة البديلة عن أم حدب مستعينا بالحبة الحمراء التي هي ربما من جنس حبة الحقيقة الحمراء التي تناولها نيو في فيلم ماتركس، فسافر إلى العالم الافتراضي كما سافرت أم حدب إلى يوم السِّدِيس.
أما الفانتازيا فكانت واضحة حين لعب الجن والعفاريت بقيادة ملكهم طوعس دورا مهما رغم صغر مساحته في بعض الأحداث، وأرجع نص السنعوسي أصولهم إلى زمن الهلينستيين ودلمون في فيلكا، فأسبغ على الرواية مسحة أسطورية فانتازية. وكذلك خلقه لمعجزة عبور الزمن بغطسة في ساحل الوطية من جنس الفانتازيا. استدعى السنعوسي أيضا شخصية الجني التراثية بودرياه وأوجد له دورا في الرواية، وهو كائن من الجن يعمل في البحر، يستدعي البحارة متمثلا لهم بصوت أحبائهم ويحثهم على القفز إلى البحر ليقتلهم، إضافة إلى حضور شخصيات لعبت دور الموسيقى التصويرية، وهم شيوخ البحر الستة.
لا يقدم السنعوسي في هذه الرواية تاريخا رسميا أكاديميا، فهذا عمل أدبي له قواعده، بل يقدم تاريخًا بديلًا للشخصيات المهمشة المنبوذة التي لم يسجلها التاريخ. وهو في هذه الرواية يقدم هجوما استباقيا على منتقديه المفترضين من الباحثين عن الدقة التاريخية الذين لا يفهمون طبيعة الروايات الخيالية ومرونتها في التعامل مع الماضي المسجل والمسكوت عنه، ولا يعترفون بصلاحية الروائي في التلاعب بكل شيء. لقد سماهم السنعوسي متهكما ساخرا بعدة أوصاف: “حُرّاس الغبار”، و”عسس الماضي”، و”حملة أختام التاريخ”. وهو هنا يكسر الحاجز الرابع مخاطبا الجمهور مباشرة. ويكرر الهجوم الاستباقي في الجزء الثالث حين تأخذ الرواية منحى بعيدا عن بنية الرواية في الجزأين السابقين، وذلك عبر حوار بين الكاتب ومُلقنه حين يثور الكاتب الضمني صادق بوحدب على الشايب حمد حمد متهما إياه بعدم منطقية البناء والحبكة، تاركا القارئ يحكم بنفسه. كذلك استخدم السنعوسي الهامش الذي كتبه محرر وزارة الإعلام للتوضيح لقرائه من “حراس الغبار” أنه هو نفسه مدرك لدخوله منطقة محظورة (تابوه اجتماعي)، وكأنه يقول: لا داعي للمزايدة.
وليسمح لي المؤلف أن أدلي برأيي في قضية تاريخية بحتة جاءت على لسان إلينور باعتبارها حقيقة، وهي أن الشيخ سالم لم يدفع أي روبية مقابل بناء السور الثالث وأن تحمل تكاليفه كان على عاتق التجار بالكامل. لكن في الواقع دلت الوثائق الأهلية المنشورة حديثا على أن الشيخ سالم أو حكومة الكويت قد صرفت مبلغ 208 ألف روبية لبناء السور (انظر عبدالله الغنيم، سور الكويت الثالث، ص. 27). ومن الملاحظات أيضا خطأ في مشهد مرور سفينة التجارة البحرية على سفينة الغوص على اللؤلؤ، لأن السفينتين في الواقع تمثلان نشاطين بحريين لا يجتمعان في الوقت نفسه، لأن كلا منهما يعمل في موسم مختلف؛ الغوص من مايو إلى يوليو، والتجارة البحرية إلى المحيط الهندي من أغسطس إلى أبريل. لكني أتفهم رغبة المؤلف في إيضاح نشاطات الكويتيين البحرية. ومن الملاحظات أيضا خروج السرد عن الدقة التاريخية، وهو أمر نادر جدا، ربما بدافع الميل نحو التسامح المجتمعي، وذلك حين صوّر إحدى الشخصيات التاريخية متحمسة للمشاركة في معركة الجهراء، وهو ما لم تذكره المصادر، بل أسندت الوثائق البريطانية إليهم سلوكًا مختلفًا. لكن هذه الهنات لا تقلل أبدا من براعة العمل.
تقنيات السرد
استخدم السنعوسي عدة تقنيات للسرد، أولها الراوي الضمني ممثلا بالكاتب صادق بوحدب، وكأن الرواية نقل لنص كتبه هذا الشخص. ولا يتوقف السنعوسي عند الراوي الضمني الواحد، فإن هذا الراوي الضمني ينقل بدوره عن راوٍ آخر هو خليفة الذي يعد شاهدا على الزمن الذي يرويه، مستعينا لما لا يعرفه من أخبار وأحداث بشيخ الجن البرقاني، المارد طوعس.
ويوظف السنعوسي أيضًا تقنية الراوي العليم كلي العلم، وتقنية الراوي المتكلم في بعض الأجزاء الخاصة بكتب المذكرات الشخصية والمونولوغ، وتقنية الراوي المخاطِب. بالإضافة إلى استخدامه للميتا سرد، حيث يتحاور فيها الكاتب الضمني مع بعض شخصياته.
إن هذا التنوع السردي أتاح للمؤلف توظيفه ككاميرا سينمائية تلتقط المشاهد من زوايا متعددة. وبالتالي أصبحت الفصول تُسرد على هيئة المناظير المتعددة للشخصيات POV.
يدخل السنعوسي كتابين حقيقيين في نص روايته، لكنه لا يقتبس منهما اقتباسا مباشرا، بل يوهمنا بذلك. الكتاب الأول هو “تاريخ الكويت” الطبعة الأولى للشيخ عبدالعزيز الرشيد والذي استلهم منه قصة العباءة، عباءة بودرياه التي حاول السنعوسي أن يجعلها برمزيتها محور الرواية. والثاني هو كتاب “كنت أول طبيبة في الكويت” لإيلينور كالفرلي (خاتون حليمة)، وهو ترجمة My Arabian Days and Nights. والنص المنسوب إلى إلينور يُقدم في الرواية بخط مختلف، شبيه بخط الآلة الكاتبة المستخدمة قديما، لتزيد من الإيهام وتشعر بالحميمية وتعكس حيرة الطبيبة وشكوكها في مجتمع غريب عنها. كما وظف السنعوسي أيضا بعض أعمال الشعراء: أحمد مشاري العدواني ود. خليفة الوقيان، ومحمد الفايز، وخالد سعود الزيد وسليمان الفليح وغيرهم. وقد شكل السنعوسي من الفلكلور الغنائي والميثولوجيا الكويتية مادة طينية لتشييد سرده الضخم.
يتصف السرد بقلة العُقَد في بداية العمل، وطول المشاهد. وهذا في ظني مبرر لرغبة المؤلف في عرض الثقافة الكويتية بمفرداتها وأفكارها وسلوكيات أهلها، ولتأسيس الشخصيات قبل أن ينطلقوا في مغامراتهم. ويعد الجزء الأول السفر التأسيسي الذي يضع فيه المؤلف قواعد اللعبة السردية. ثم يأخذنا السنعوسي في الجزء الثاني إلى التطورات الشديدة في مسارات الشخصيات. ويرتحل السنعوسي بنا في الجزء الثالث من الرواية في رحلات مكوكية بين عامي 1920م و1990م، وتسير الأحداث بشكل تصاعدي حتى نصل في الصفحة الأخيرة من العمل إلى ذروة الأحداث.
الشخصيات
خلق السنعوسي مجموعة كبيرة من الشخصيات وأسكنها في أحياء مدينة الكويت القديمة الثلاثة: شرق وجبلة والمرقاب، بالإضافة إلى بلدة الجهراء وبادية وارة وبرقان، علاوة على جزيرة فيلكا، وقريتيها: سعيدة والقرينية. وأسكن مجموعة أخرى في الفترة المعاصرة المناطقَ الحديثة: الفيحاء والشامية وكيفان، والزور بفيلكا. وكانت سفن الغوص وقيعان مغاصات اللؤلؤ في الخليج مسرحًا للشخصيات أيضا.
اخترع السنعوسي فئة الصّاجَّات، أي الصادقات، وهي كائنات لا إنسية ولا جنية، تلعب دورًا رئيسًا في الرواية، اشتقها من كلمات أغنية تراثية “يا صاجة ويا صاجة ما صدقتي”، التي غنتها المغنية الشعبية الشهيرة عودة المهنا. هؤلاء الصّاجّات وهن عرّافات ثماني، تترأسهن صاجة ورثت صولجان العَرافة جيلا عن جيل وترتبط بالجن لالتقاط الأخبار. وتمثلُ دور كبيرةِ الصاجات في هذه الرواية: أم حَدَب؛ وهي مُحَرِّكةُ الأحداث، التي تعيش آخر فترة في حياتها الممتدة إلى قرن كامل قبل أن تسلم منصبها إلى كبيرة صاجات أخرى، وهي أم صنقور؛ صاجة مقام الخضر في فيلكا. خلال الرواية تلجأ إليهما النسوة الجاهلات والساذجات، بل ويصدقهن بعض الرجال، الأمر الذي تسبب بكوارث وتحولات جسيمة في حياة من صدقهن. وهذه الفكرة تذكرنا بأول قصة كويتية كتبت عام 1929م وهي قصة “منيرة” لخالد الفرج.
أما شخصية سليمان، ابن سهيل وشايعة، فهو شاب غواص مستجد فقير يحمل ديونه وديون أبيه المتوفى لصاحب سفن الغوص ابن حامد، توافقت مهنته مع دوره الدرامي في البحث عن الذات وعن أسرته التي تاهت عنه. هو شخصية ساذجة وضعيفة مثل أمه وزوجته، سهلة القياد، مرة يؤثر فيها صديق السوء، ومرة يقوده شيخ البحارة، ومرة ينقاد إلى الصاجات. تنهار عائلته وتتبعثر حين يترك هو وأمه شايعة وزوجته فضة للصاجة أم حدب أن تقرر مسارات حياتهم. لكن شخصيته تستقيم في النهاية لتكمل تحولها الدرامي.
ثم نأتي إلى شخصية خليفة، الشاب الأمرد المنبوذ من عائلته الصغيرة والكبيرة والمجتمع عموما، وذلك بسبب شكله القريب من الإناث، فأطلق عليه لقب البرنثى (لا ذكر ولا أنثى). عانى خليفة من علاقة والدية سيئة تركت بصمتها على سيكولوجيته، فكَرِهَ الأطفال، وتبنى القطط، والتزم خدمة الصاجة أم حدب وآمن بها وبخوارقها. لم يقبله المجتمع لا في صغره ولا عند كبره. وما وجد له مكانًا يتنفس فيه قليلا سوى في حوطة سعدون التي ضمت المنبوذين والأقليات، مثل الأرمني المسيحي واليهودي العراقي، وبغايا رميلة (بنات حمدية). يضارعُ دورُ خليفةَ في الرواية دورَ سليمان وأم حدب بصفته لاعبًا في الحكاية وشاهدا وراوية. وخطه الدرامي هو الأكثر اشتباكا مع الخطوط الأخرى. ورغم انحدار مكانته الاجتماعية إلا أنه امتلك في نهاية المطاف قوة اكتسبها من وراثته لأم حدب وأم صنقور وصولجان المارد طوعس، فأمسى متحكما في السرد برمته. أما دافع خليفة لإملاء القصة على صادق بوحدب فهي – فيما يبدو لي – رغبته في الخلاص ورفع الحاجز عن الموت الذي لن يأخذ روحه قبل أن تُسَجَّلَ هذه الحكاية، فهو مثل مستور المصوقر الذي امتنع عليه الموت حتى قام بتسليم الجزأين الأول والثاني من الرواية إلى متسلمها بشكل قدري محتوم. إن نص السنعوسي هنا يُعلي من شأن التاريخ، ويضعه في منزلة تساوي الموت والحياة. فالشعوب ميتة ما لم يُكتب تاريخها.
ومن الشخصيات المميزة شخصية سعدون، أصغر أبناء أبي السواعد ذي الأبناء التسعة، سعدون ضحية تعنيف أبيه وحجره على فكره وتساؤلاته المشروعة إلى درجة تعرضه إلى كيِّ رأسه؛ العملية العلاجية الشعبية التي أجرتها له الصاجة أم حدب. وقد ألجأت قسوة الأب سعدونا إلى ثورة عارمة على المجتمع وأفكاره ومقدساته. فطرده أبوه من البيت واعتزل في حوطة بمنطقة المرقاب أسماها “المنسى”. عاقر فيها الخمر الذي يجلبه له صاحبه عاموس اليهودي، وصار مجلسه مجلس المنبوذين كما قلنا. واكتسب سعدون سمعة سيئة في المجتمع. لكن سعدونا تميز بحبه للكتب وبقراءاته المتنوعة، وبكثرة مونولوجاته الفكرية، وحواراته القاسية، ونزقه، وإيمانه بالعبثية أو العدمية، يتمنى الموت ويعد له العدة. يمثل سعدون في السرد الصوت الصارخ المضاد للقمع الأبوي والتقاليد المحافظة والنظام الاقتصادي الذي يسيطر عليه التجار الذين أحالوا البحارة الأحرار إلى ما يشبه العبيد عبر الديون الموروثة التي يستحيل سدادها في الغالب.
أما شخصية الدكتورة إلينور كالفارلي، فأدت دور الداعية المسيحية الحائرة، المتشككة بجدوى عملها في مجتمع إسلامي محافظ، اللاهثة خلف الإنجاز، والطبيبة المعالجة بالأدوية الحديثة. تقودها صدماتها المتعددة إلى تحول خطير تمثل في انهيارها أمام الصاجة أم صنقور وعلاجاتها الشعبية. لقد أراد نص السنعوسي – ربما – التعبير عن فكرتين من خلال دور إلينور في الرواية: أولاً، تبيين فشل الإرسالية الأمريكية في التنصير بالكويت. ثانيًا، أن المنطق ينهزم أمام الخرافة في البيئة الكويتية.
واحتوت الرواية أيضًا على مجموعة أخرى من الهامشيين من مثل الأرمني سركيس اللاجئ للكويت هربا من مجازر العثمانيين، وشخصية عاموس اليهودي الذي لا يجد له صاحبًا في الكويت غير طائره البلبل البصري، ويقاسي أزمة هوية ثقافية دينية، وشخصية صنقور القْصَاصَة الذي عانى نقص هرمون النمو فكان يبدو طفلا رغم تجاوز عمره الثلاثين. وثمة شخصيات للعبيد مثل مبروكة التي تعاني نفسيًا جراء ظروف خطفها على يد النخاسين وبيعها وتفريقها عن أمها. بالإضافة إلى الأخوين عطا الله وساطور ابني بخيتة عبدي الشيخ سالم اللذين ينشدان حرية يتوهمان وجودها عند إخوان من طاع الله، فيدفعان ثمن استبدال الواقعية بالمثالية المتوهمة. علاوة على شخصية عزوز الهذار وزوجته أمينة البيعارية العاقر، وشيخ البحارة أبوهولين الذي قاسى هول البحر وهول البر. أما شخصية غايب الباحث عن أمه وأبيه فبدا مشوه الوجه كانعكاس لتشوه القيم والظلم المجتمعي المكوي بالجهل على رأسه. ونجد أيضا شخصية الملا المتشدد المنافق كريم العين وغريمه الملا عبدالمحسن المرن المتفهم. تؤول مصائر الشخصيات في غالبها إلى مآلات مأساوية، ما يعكس تراجيدية العمل في نهاية المطاف.
تمكن السنعوسي من رسم الشخصيات بحرفية، فميز كلا منها بشكل خَلقي خاص، أو بأثر معين على أجسادهم، وبلازمات كلامية، يستحضرها دائما عند تحريك الشخصيات وإنطاقها. وهو ما ولد ألفة شديدة بين القارئ والشخصيات الكثيرة فسهل استذكارها أيضا. وقد حرص على تقديم خلفية لماضي هذه الشخصيات ليبرر سلوكها، بل قام المؤلف بتطويع سلوكيات ومآلات الشخصيات لتعطي المعاني التي أرادها.
لغة الرواية وخصوصيتها الثقافية الكويتية
امتازت الرواية بلغة مصقولة، سهلة ممتنعة، أقرب للشعرية دون تكلف. تدعو القارئ للتصفح ومتابعة الحوارات والأحداث دونما ملل. قدم لنا سعود السنعوسي درسًا في أهمية التفرغ التام للعمل الفني والأدبي، ودرسا آخر في أهمية التحرير والمراجعة والصقل اللغوي وعدم الاستعجال في النشر.
تمر بنا في طيات الرواية مفردات وعبارات كويتية، من أوصاف وشتائم جمعت عددا قليا منها مثل: المكوي على رأسه؛ أي الأحمق، والثور الأبتر، والبرنثى، والعَرْد، والحبارى، متكودين (أي مجتمعين) وبخور السوق (لمن لا يؤتمن على سر)، والخرمس (الظلام الشديد)، ينحاش (يهرب)، عفّط، أشق حلقك، جزت عيناك عن النوم، مهدودة الحيل، بانت فيلكا (أي تبينت وشوهدت لا أنها ابتعدت، وتستخدم عند اتضاح حقيقة الأمر)، وأمثال كويتية مثل: الطول طول نخلة والعقل عقل سخلة، وتشبيهات كتشبيه (عجوز سُرِقَ عشاها)، وغيرها من كلمات وعبارات تستحق الذكر وأضفت على العمل خصوصية جميلة.
احتوت الرواية أيضا على تصوير متقن لطقوس الكويتيات في عدة مناسبات، مثل انتظار النساء لرجالهن الغواصين في فترة القفال أو عودة السفن إلى الكويت بما تضمنته من أغان ذات كلمات غير مفهومة الدلالة والسياق حين نقلتها لنا الفنانة الشعبية عودة المهنا في إحدى لقاءات تلفزيون دولة الكويت. فقام السنعوسي بخلق سيناريو رائع طرز فيه هذه الأغاني مع عادة إغراق القطط وما إلى ذلك في سيناريو وسياق رائع. كذلك استعمل قول الكويتيين عن الشخص المهووس بعمل شيء ما، ولنقل الصلاة والعبادة: مدفون سره في المسجد. فطوره وصور دفن الأهالي لسرر أولادهم حين يولدون في المساجد أو في أماكن أخرى يرغبون لولدهم أن يرتبط بها. ونرى عادة شك الدبوس الحديدي في الملابس لرد العين الحاسدة، وغيرها من سلوكيات شعبية.
لقد أحسن السنعوسي تصوير مهنة الغوص وتبيين نظامه وممارساته بشكل درامي جميل، فحوَّلَ كتابات سيف مرزوق الشملان وغيره من مجرد معلومات جامدة إلى مشاهد حية معبرة لهذه المهنة القديمة وما صاحبها من أغاني النهام والبحارة على متن السفينة وعلى الساحل. وكذلك نجد وسائل العرافات لعلاج مشكلة العقر عند النساء، وكانت إحدى هذه الوسائل عبور البيص، أي أن تخطو العاقر فوق قاعدة السفينة التي لما تصنع بعد فترزق بالحمل لكن على حساب حياة البحارة الذين سيبحرون على متن هذه السفينة في المستقبل. ولم ينس السنعوسي الإتيان بالألعاب الشعبية كلعبة خروف مسلسل، ولعبة التمثيل برُّوْي وغيرها. وأرفق في روايته أيضا مشاهد من حفلات الزار، وأغان للعرضة الحربية، وإيقاعات فن السنكني البحري.
بنية الرواية
تنتمي الرواية إلى مدرسة ما بعد الحداثة، وبنيتها ومعمارها شبيه بمخططات زها حديد، جميلة لكن لا نمط واضح متكرر لها. في بداية العمل يحاكي السرد – إلى حد ما – شكل التوراة وشروحاتها، هذا ما بدا لي. فالمؤلف استخدم مصطلح سفر وأسفار، لكن ليس لهذا السبب فقط، فلأسفار مدينة الطين كتب ملحقة به تعد بمثابة الشروح لها، مثل: كتاب كائنات مدينة الطين، وروزنامة مدينة الطين، وحوليات مدينة الطين، وأمثال مدينة الطين، وربما غيرها من كتب وهمية يستعين بها المؤلف في الهامش لتوضيح ما يبهم من معاني المفردات. وهذا يشبه كما قلنا الكتب المقدسة التي لها كتب ملحقة وشارحة لها.
واستعان المؤلف بالهوامش ليشرح ما صعب من المفردات والعبارات الكويتية الخالصة، لكنه نسب معظم الهوامش إلى محرر وزارة الإعلام مستفيدًا من ظرف كون الرواية عملا مطبوعًا مراجعًا من قبل إدارة الرقابة التي منعت نشره. يُذكر أن إحدى أعمال المؤلف كانت ضحية من ضحايا هذه الإدارة التي منعت روايته “فئران أمي حصة”. لقد أعطت هذه الوسيلة في شرح المصطلحات تبريرا فنيا لإلحاق الهوامش بجسد الرواية ومساواتها بالمتن. فالهامش والمتن واحد عند السنعوسي. ألم يكتب هذه الرواية منتصرا للمهمشين؟
ونجدُ في الرواية أيضا في أحد المواضع محاكاة للكتب الدينية التي تتحدث عن معتقد الحلول والاتحاد، كما عند النصارى والصوفية.
أما الجزء الثالث فيأخذ طابعا مختلفا metafiction، نقترب فيه من ظروف كتابة الرواية نفسها، وظروف الكاتب وعلاقته بمصدره، وحيرته ومصيره، انتهاءً باكتشاف تاريخه الشخصي ونسبه.
أصالة الرواية
يعلم الدارسون للميثولوجيا الكويتية أنها وصلتنا ناقصة، منسية التفاصيل، مقطوعة من شجرة، أو مقطوعة من ثياب، أو جزء متبق من حكاية كبيرة كتصور عالم الميثولوجيا جوزيف كامبل. فثمة شخصيات خيالية متعددة مثل الطنطل وحمارة القايلة وأم السعف والليف ودعيدع وبودرياه وغيرها مما لا قصص متكاملة لها تماثل قصص التراث الألماني التي جمعها الأخوان غريم. ولكي لا أظلم شعبنا قد تكون هذه الشخصيات قد ولدت بالفعل هكذا دون قصص، أو ربما ضاعت التفاصيل مع موت الأمهات في سنوات الطاعون عامي 1831-1832م وغيرها من سنوات الأوبئة. وعلى كل حال، وجد السنعوسي فرصته كي يطور هذه الشخصيات، فخلق لها سياقا وأوجد لها مكانا في القصة الكبيرة وخاطها ضمن سرده فأحالها ثوبا جميلا. وصارت هذه الشخصيات الخرافية عاملا مساعدا لتحرك أحداث الرواية وشخوصها وأدت دورها في بيئة العمل.
ويعلم الدارسون لتاريخ الكويت، أن سِجِلَّه يصب في مصلحة علية القوم والأعيان من الناحية التوثيقية، والأعمال المتاحة زاخرة بذكر سير الشيوخ والتجار والعلماء والأدباء. أما الطبقات الأخرى من عامة الناس فلم تجد لها من يكتب عنها ما يكفي من المعلومات. وهي في الواقع مشكلة تاريخية عند جميع الشعوب. ولذلك ظهرت دعوات منذ ستينيات القرن العشرين للتركيز على الطبقات المهمشة، وظهرت مذاهب “التاريخ من الأسفل”، “والتاريخ الجديد” و”التاريخ الشفاهي” و”دراسات المرأة والجندر” و”دراسات التابع”. وفي كثير من الأحيان يسألني بعض الناس باعتباري باحثا في تاريخ الكويت لماذا لا تكتبون عن الغواصين والبحارة والبدو والمرأة وذوي الإعاقات؟ فيكون الجواب هو عدم وجود ما يكفي من مصادر. ولذلك، فإن الحل أو التعويض يكمن في هكذا أعمال خيالية تستند إلى التاريخ الشفاهي.
أفكار الرواية ومعناها العام
أودعت رواية السنعوسي أفكارا وتحليلات سياسية، فعلى سبيل المثال، أبرز تأثير موقع الكويت الجغرافي على سياسة حكامها، بحيث فرضت عليها أن تعيش دوما ما بين دفاع ومهادنة. وكذلك أشار المؤلف إلى التنافس البريطاني الأمريكي على الكويت. وتساءل عن سبب عدم مطالبة إخوان من طاع الله بطرد المعتمد البريطاني من الكويت أسوة بأعضاء الإرسالية الأمريكية، ملمحًا إلى التحالف البريطاني النجدي. وقارن بين موقفي القيادة الكويتية خلال زمنين مختلفين (1920م و1990م) تجاه نفس الأزمة الوجودية التي تمثلت بخطر الغزو، مستحضرا منطق سحابة الصيف في الحالتين. فقبيل معركة الجهراء يقول المؤلف على لسان المعتمد البريطاني الذي خاطب أعضاء الإرسالية الأمريكية: “لعلكم تقنعون الشيخ سالم بأن تلك المشكلة ليست سحابة صيف يترك أمرها للريح، ولعله من الحكمة أن يطلب مساعدتنا.. وعليه أن يكف عن أوهامه بأن مشاكل العرب يحلها العرب”. وبالفعل يطلب الشيخ سالم الصباح بحكمة (في الرواية وفي التاريخ) مساعدة الإنجليز – بحسب اتفاقية الحماية. فأرسلوا طائراتهم إلى إخوان من طاع الله دفاعا عن الكويت فكف الله شرهم. وفي موضع آخر في الرواية عند فصل من فصول صيف 1990م قبيل الغزو العراقي ينقل نص السنعوسي من صحافة تلك الفترة مانشيتات صحفية كويتية من مثل: “الكويت تحتكم إلى العرب”، وبالطبع كانت نتيجة ذلك الاحتكام معروفة.
ثمة فكرة قدمتها أسفار السنعوسي لكن ازدحام القصص الفرعية أنستنا إياها، وهي عباءة بودرياه التي يمكنها أن تحجب الشمس (النور) عن الكويت والتي كان إخوان من طاع الله حريصون على أخذها. وهذا الخط إما إنه غير مكتمل أو غير واضح بالنسبة لي.
خلال قراءتي للرواية برزت لي القناعة الشخصية التشاؤمية لنص سعود السنعوسي والتي تعد حجر الزاوية فيها، وملخصها أن الكويت رغم جمالها وعراقتها ورجالها العظام فإنها بلاد ينتصر فيها الجهل، وتتألق فيها الخرافة، وتتجه نحو المجهول.
وأختم بالقول أن سعود السنعوسي بنى مدينة الطين من ميثولوجيا هذه الأرض فأبرز أصالتها وعراقتها وتجربتها الإنسانية. ويصعب على من يقرأها أن ينسى تفاصيلها. فرواية أسفار مدينة الطين بلا شك حقل خصب للدراسات الأدبية الأكاديمية. إني أجزم أن السنعوسي قد رفع سقف الرواية الكويتية بهذه الرواية الرائعة.
……………………….
- أستاذ بـقسم التاريخ والآثار، جامعة الكويت