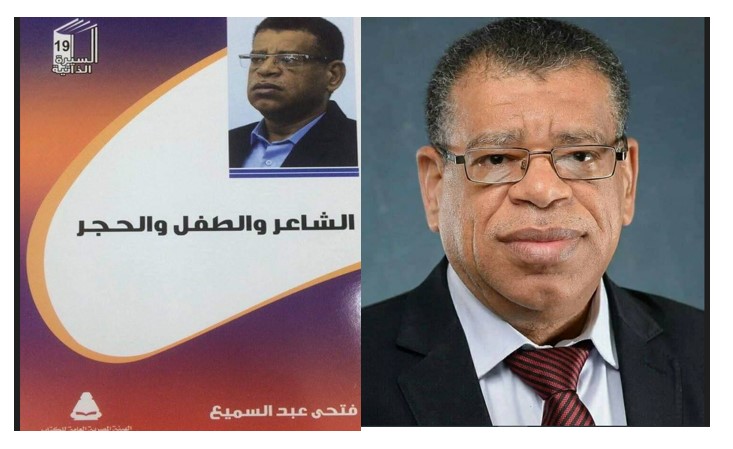حاتم رضوان
منتصف ثمانينيات القرن الماضى كنت طالبا فى كلية طب عين شمس، أتهجى أولى خطواتى فى كتابة القصة القصيرة، سمعت مصادفة عن ندوة جريدة المساء، كنت رفقة زميلى ورفيق الدرب د. محمد إبراهيم طه، سألنا عن العنوان، شارع زكريا أحمد، بوسط البلد، مبنى عتيق، مدخله مظلم، أخذوا هوياتنا فى الاستقبال، وصعدنا إلى الدور الأخير، جلسنا حول مائدة طويلة، مستطيلة، وجدنا هناك من سبقنا، معظمهم مثلنا طلبة فى الجامعة، والقليل من هم يكبروننا فى العمر، شهد هذا اليوم أول لقاء لى بالأستاذ جبريل، وخطوتى الأولى من طريق طويل امتد لنحو أربعين عاما من الصحبة والمحبة على المستويين الإنسانى والإبداعى، رأيته جالسا على رأس المائدة، يوزع ابتسامته الجميلة وتعليقاته على الجميع، يدير الندوة بهدوء وحب، يستمع للأعمال التى يقرأها الحاضرون ولآرائهم باهتمام، ويختتمها برؤيته ورأيه فيها، التقط وجوهنا الجديدة وتعارفنا، لم أكن قد التقيت به، أو قرأت له من قبل، لكننى أدركت من أول لحظة كم هو إنسان جميل وودود، ولمست مدى قربه من كل واحد من الحضور على المستوى الشخصى والإنسانى، هؤلاء الأصدقاء المتألقون الآن، من تربوا فى مدرسته، وارتقوا سلم الإبداع فى الشعر والقصة والنقد انطلاقا من ندوة المساء، وأصبحوا نجوما لامعة، أذكر منهم: سيد الوكيل وياسر الزيات ومؤمن أحمد وعماد غزالى ويسرى حسان ويسرى السيد ومحمود الحلوانى ومسعود شومان وأشرف الصباغ وسمير درويش ومحمد عبد الحافظ ناصف ونجلاء علام ومنال السيد وصفاء عبد المنعم ومحمد إبراهيم طه وعبد المنعم الباز وسمير فوزى ود. عمار على حسن ومحسن عبد العزيز وكثيرين غيرهم من قائمة طويلة من أجيال متتابعة، وأستطيع أن أجزم أن ندوة جبريل هى المدرسة التى شكلت جيل الثمانينيات والتسعينيات.
كنا مثل الدراويش حول شيخهم، نستمع إليه، ونستفيد من آرائه وتعليقاته، ونتعلم منها، وأعجبنى تعبير الأستاذ محسن عبد العزيز فى مقال رثائه له فى جريدة الأهرام، أن جبريل هو خيمة تظللنا من هجير القاهرة، واحة أمان فى لحظة قلق يعيشها المبدع وهو يخط حروفه الأولى إلى عالم الكتابة السحرى العجيب بدروبه ومزالقه.
أدين له أنه أول من نشر لى قصة قصيرة فى صفحته بجريدة المساء بعنوان مركبة الشمس، وتلاحقت بعدها قصص أخرى، وأول من كتب عن مجموعتى القصصية الأولى عندما فازت بجائزة سعد الصباح عام 1992، لتستمر بيننا علاقة صداقة وأبوة حقيقية على مر السنين، مليئة بالأحداث والذكريات الجميلة، لم تنقطع، أتواصل معه على فترات قد تطول أو تقصر، بالزيارة أو الاتصال التليفونى حتى أيام قليلة من رحيله.
فى الفترة التى توقفت ندوته فى جريدة المساء، وانتقلت إلى نقابة الصحفيين، شغلنى العمل فى المستشفى، ودراسة الماجستير عن الحضور، لكننا خصصنا أنا وصديقى د. محمد إبراهيم طه صباح يوم الثلاثاء من كل أسبوع، يمر علىَّ بسيارته فى المستشفى، بعد انتهائى من الدوام، ونتوجه لزيارة الأستاذ جبريل، نعقد ندوة خاصة بنا، نتكلم ونتناقش فى الأدب وأمور الحياة.
كان يعرض علىَّ بفرح آخر ما كتب، ويسألنى عن آخر ما كتبت، أترك له قصة أو رواية، وانتظر رأيه وملاحظاته الدقيقة، كان يوصينى بالدأب وعدم الكسل ومواصلة الكتابة، لأنها والقول له مثل العضلة كلما استعملتها نمت وقويت وإن أهملتها ضمرت وضعفت، ودائمًا ما كان يسعدنى بإهداءاته الجميلة لآخر أعماله، ويسألنى عن أسماء أولادى، ليكتب لهم إهداءات رقيقة عليها.
أعمال جبريل الإبداعية الغزيرة وإسهاماته النقدية والثقافية تقدم نفسها وغنية عن التعريف، يمكن لأى باحث أن يجدها، تذيل آخر صفحات أى عمل من أعماله، وكل ما كُتب عنه من دراسات أو مقالات نقدية أو رسائل ماجستير أو دكتوراه موثقة، ومتاحة للدارسين، لكن ما أهم ميزة فى جبريل هى علاقاته الإنسانية وتواصله وكرمه وأياديه البيضاء على الجميع، يمد يد العون لأى واحد منا فى محنة، أتذكر زيارته الرقيقة لى فى المستشفى ومعه زوجته دكتورة زينب العسال ووفد من رواد ندوة المساء عندما تعرضت لحادث كبير، هذا الحس الإنسانى هو ما جعل الكل يجمع على محبته، ليظل بيته مفتوحا للأصدقاء حتى آخر يوم فى حياته.
شهدت عن قرب محنه المتعددة مع المرض، وتابعته فى كل منها، وحزنت كثيرا لما لاقاه من إهمال، وحاجته للعلاج بالخارج، المطلب الذى لم يتحقق، فلم يجد مفرا من إجراء جراحة فاشلة بالداخل على نفقته الخاصة، تركت مضاعفاتها أثارها عليه حتى آخر يوم فى عمره، لكنه رغم معاناته كان قويا، يقاوم المرض بالكتابة، هذا العشق الذى لا يعنيه شىء من الحياة غيره، يحول بإرادته كل محنة منها إلى تجربة، يسجلها ويوثقها بلغة أدبية ناعمة فى كتاب، أو قصة أو سيرة قصصية.
أستطيع أن أطلق على الأستاذ محمد جبريل راهب الأدب، عاش من أجله فقط، لم تشغله الصحافة رغم تفرده فيها عن الكتابة، أذهب إليه فى بيته بشارع سليمان عزمى فى مصر الجديدة، الذى يشبه مكتبة كبيرة، فأراه جالسا إلى مكتبه أمامه شاشة الكومبيوتر يكتب مقالا أو يكمل قصة أو رواية أو يقوم بتحرير صفحته فى جريدة المساء، يكتب بدأب وحب لما يكتب، لا يهمل موضع حرف أو فاصلة أو نقطة أو جملة اعتراضية، وكثيرا ما كنت أراه يقرأ ويدون ملاحظاته على هوامش الصفحات، أو يعطينى قصة جديدة له طالبا منى قراءتها، ورأيى فيها، حيث كان بتواضع العلماء والكبار لا يخجل من أن يأخذ آراء أصدقائه المقربين فى مخطوطات أعماله قبل النشر.
كان على تواصل دائم مع كتابات الأجيال الجديدة، يقرأ ما يصله منها، ويكتب عنها دون معرفة مسبقة، لم ينتمِ لجماعة أو شلة، أعماله هى ما تقدمه، أزعم أنه يملك مشروعا أدبيا تمتد خيوطه فى معظم رواياته وقصصه القصيرة سواء على مستوى المكان أو المضمون نلمس فيها رائحة المقاومة بأشكال مختلفة، تلك الرسالة التى حملها وضفرها فى أعماله بنعومة وفنية عالية ودون صخب أو مباشرة.
ومن حسن حظ القارئ العربى فى أى مكان أن أعمال جبريل متاحة بالمجان على موقع مؤسسة هنداوى.
كما أننى أعلم أن لديه على ذاكرة الكمبيوتر أكثر من خمس روايات جديدة، أتمنى أن تجد سبيلها للنشر، سواء من دور نشر قومية أو خاصة، عرفانا لما قدمه للمكتبة والثقافة العربية، لأنه عاش مترفعا، يكتب فقط، ولم يسعَ يوما إلى النشر، أتذكر كلماته عندما أقول له أن هناك دار ما للنشر تقدم إليها بروايتك أو كتابك يقول لى أنا جبريل هم من يسعون إلىَّ ويطلبون منى النشر.. أنا لا أسعى إلى أحد.
ورغم حصوله على جائزة الدولة التشجيعية فى مرحلة مبكرة من مشواره الأدبى فقد تعرض لظلم بين، حيث تأخر حصوله على جائزة الدولة التقديرية، وسبقه إليها كثيرون ممن هم دونه فى الإبداع كما وكيفيا، والتى أراها أقل مما يستحق، لأنه يستحق بجدارة أن يتوج بجائزة النيل.
لقد ودعنا جبريل من أيام قليلة وفارقنا بجسده ماضيا إلى الشاطئ الآخر، لكن أعماله باقية كأعمال العظماء الذين فارقونا لن يمحوها الزمن.