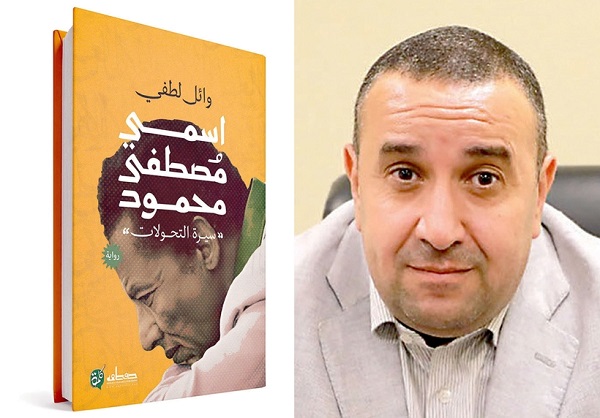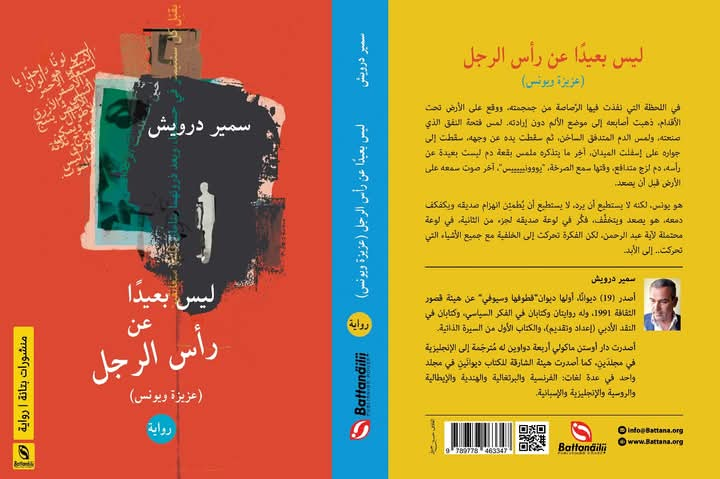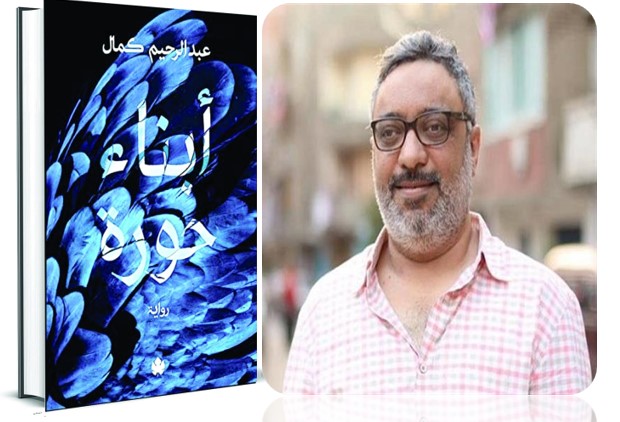د. حمزة قناوي
التنقيب في التاريخ على غرار “حفريات ميشيل فوكو”
أدب المنفى وذاكرة فلسطين وتجلي الذات في «رسائل الشتات» لبيسان عدوان
«الأدب مرآة المجتمع»، تلكَ المقولة التي صارت من المسلَّمَاتِ الثقافية، والتي ما نزالُ نرددُها في كل وقتٍ وحين، وعلاقة الأدب بالمجتمع إحدى العلاقات التي تناولها كثيرٌ من الجهود والدراسات والبحوث الثقافية، وكذلك لم يغفل الأدب عن جانبِ العلاقةِ الذاتية بين المبدع وإبداعه، بين الذات والموضوع الذي يتم تناوله، ومع تطور الأزمان، وتبدل وتغير الأحوال، ظهرت ظروفٌ وأحوالٌ إنسانيةٌ واجتماعيةٌ وسياسيةٌ خاصة، وهذه الأوضاع الخاصة تولَّد عنها أيضاً أدب خاص، له سماته وأبعاده وخصائصه، وكعادة النقد الأدبي لم يغفل هذه الظواهر وبحث فيها لكي يستخرج منها سماتها وخصائصها.
ومن بين هذه الأوضاع الخاصة، والمأساوية أيضاً، ما ظهر في أواخر النصف الثاني من القرن الماضي من ظاهرة تعددت تسمياتها بين المنفى، أو الشتات، أو اللجوء، أو غيرها من المسميات التي تختص بذلك الإنسان الذي يضطر للعيش بعيداً عن مكانه الأصلي الذي يُفترض أن يعيش فيه، وأيّاً كانت الظروف التي قد تختلف من حالةٍ لأخرى، فإن السمات العامة من مشاعرَ إنسانيةٍ خاصة بتلك الحالة التي يعيش فيها الإنسان نوعاً خاصاً من الشقاء والمعاناة الخاصة به، ومن هذه الزاوية ننظر لـ: «رسائل الشتات: سردية المنفى والوباء» لـ(بيسان عدوان)[[1]] على أنه عمل ضمن هذه النوعية الخاصة من الأدب التي لها سماتها وظروفها وخصائصها وحالتها المكانية / الزمانية/ السياسية/ الاقتصادية/ الاجتماعية الخاصة به.
وقد شهدت الفترة الأخيرة اهتماماً شديداً بأدب المنفى، منذ أن استوجبت الحالة السياسية العربية في نصف القرن الثاني من القرن الماضي، ومع رحيل أجيالٍ متلاحقةٍ من العرب عن أوطانهم، واستقرارهم في المهجر أو المنفى، وإطلاق (إدوارد سعيد) مع نقاد آخرين مثل (بيل أشكروفت) و(هومي بابا) و(إعجاز أحمد) و(جياتري سبيفاك) وغيرهم، مناهج النقد ما بعد الكولونيالية، التي كشفت عن ظاهرة عالمية في أدب الشتات أو أداب المنفيين، ومن هذا المنظور يقول (إدوارد سعيد): «فكان على المنفيين، والمهاجرين، واللاجئين، والمغتربين المجتثين من أوطانهم أن يعملوا في محيط جديد، حيث يشكل الإبداع، فضلاً عن الحزن الذي يمكن تبينه فيما يعملونه، واحدةً من التجارب التي لا تزال تنتظر مؤرخيها، على الرغم من أن كوكبة مدهشة من الكتاب تضم شخصيات مختلفة مثل سلمان رشدي وف.س. نايبول كانت قد وسعت شقة الباب الذي كان كونراد أول من حاول فتحه.» [[2]]
إذن فأدب المنفى نوعٌ من الآداب الذاتية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤلفها، ويصعب هنا اتباع أيٍّ من مذاهب النقد الحديث التي تنادي بـ «موت المؤلف»، أو «النقد المنكفئ على ذاته»، إذ إن حالة التعبير الخاصة هنا عن تلك التجربة من الحياة الإنسانية المعاصرة، يرتبط التعبير عنها بشكل أساسي بالتجربة الإنسانية الخاصة بصاحب التعبير عنها، وعند تطبيق ذلك على (بيسان عدوان)، نجد أنها تتحدث بشكل مباشر عن تجربتها الشخصية الخاصة بها في منفاها، في رسالتها الخامسة عشرة تقول:
«في المنافي تطاردك البلاد، تزعجهم فلسطينيتنا لأنها تذكرهم دائماً بعمق خياناتهم. والكنعانيات من حجر حين تقع الحرب، فيافا ليست تل أبيب، الهجين الذين استوطن البلاد. يافا هي اسم البنت المشتهاة، نورميدا التي نامت على الساحل لتنجب في كفّها الله، فكانت البلاد.» ص143
هنا تعبيرٌ واضح عن الجو النفسي في خلفية هذه الرسائل التي تقدمها لنا (بيسان)، فهي رسائل منطلقة من «فلسطينيتنا»، رسائل تحمل في خلفيتها الانتماء، وهذا الانتماء حجر زاوية تنطلق منها، وهي ظاهرة أساسية لدى كتّاب المنفى، فكلما شعر المنفِي بأنه بعيد عن وطنه، تمسك به أكثر، حمله بين جنباته وفي طقوسه اليومية وفي أحلامه، واتخذ من التشبث به، وبأمل العودة يوماً، اتخذ من ذلك وقوداً يواجه به معاركه اليومية، يقول (محمد الشحات): «المنفى، إذن، إبعاد عن الوطن، ونبذ، ونزع للألفة. والمنفى “منزلة بين منزلتين”، زمكان مؤقت يقع بين زمكانين، أحدهما ماضٍ صيغت ملامحه في الوطن المبعد، والآخر وشيك الحدوث في المستقبل القريب (= الموت). هكذا يكون المنفى هو “البرزخ”، أو هو ذلك الاستثناء بين الحياة والموت، إنه الحياة البينية لكثير من البشر والفنانين والكتاب في مجتمعاتنا المعاصرة.»[[3]]
وهذه المعاني وتلك التأويلات سنجدها بتفصيلاتها في كتاب (بيسان عدوان) هنا، وهي ظاهرة تكرارية، أن المعاني ذاتها- لكون التجربة ذاتها واحدة- متكررة عند كل من حاول الكتابة عن تجربة المنفى، أو عن الشتات، ولكنّ الاختلافَ من كاتب إلى آخر، هو الطريقة والأسلوب والكيفية التي عبر عنها، فالمعاناة التي يعيشها الإنسان في منفاه، وحمله هم الحياة اليومية البسيطة؛ إذ تصبح أبسط متطلبات الحياة اليومية كأنها مهمة مستحيلة، وتصبح أبسط الحقوق الممنوحة لكافة البشر، لا يتم التحصل على بعضها إلا بعد حرب شرسة، وكفاحٍ جاد، نابعٍ من تشبث المنفي ببقايا إنسانيتهِ وحقه في الحياة، تلك هي السمة الأساسية لكل من تعرض لتجربة النفي، ولكن ما يعنينا من الناحية الإبداعية، هو الطريقة الفنية التي عبر عنها المبدع عن معاناته، والكيفية التي نقل بها هذه المعاناة إلى القارئ.
وفي هذا السياق نجد أن (بيسان) اتبعت أسلوباً جديداً في هذا الإطار، فهي لم تقدم لنا عملاً روائياً من أبطالٍ وأحداث وأصوات مختلفة نسمعها عبر الفضاء النصي، أو حتى لم تقدم لنا قصائد إيقاعيةً رفيعةً مثل قصائد (محمود درويش)، وإنما اختارت فن الرسائل، وهو اختيار يحمل في طياته أصالة من ناحية، وتجديداً من ناحية أخرى، فرغم أن هذا الفن يعد من الفنون «المهجورة» نسبياً في الكتابة العربية، إلا أن إحياءَهُ بهذه الطريقة، وإيداعَ كلِ هذه المعاني العميقة، والتجربة الدامية لها، هو نوع من التجديد الإبداعي الذي يحسب لها، وكذلك يحسب أيضاً التجديد في اختيار العنونة، والمرسل إليه.
فالعنونة: «رسائل الشتات: سردية المنفى والوباء»، تعبر بشكل واضح ومباشر وقوي عن الموضوع الأساسي الذي تتناوله (بيسان)، لم تختر عناوينَ جانبيةً، أو ترميزاً مكانياً أو زمانياً، بل وصفت مباشرةً الحالة العامة لمجمل رسائلها، التي تنطلق من المعنى الفلسطيني الخاص لمفهوم كلمة: «الشتات»، وهو تضاد الاستقرار والألفة الشعور بالأمن والأمان، ثم تلى ذلك إعادة تأكيد على هذا الشتات بأنه شتات متولد من: «المنفى»، فالشتات / المنفى وجهان لعملة واحدة، وتأكيدهما في العنوان نفسه يعد نوعاً من تأكيد مقدار الوجع المتولد في روح الكاتبة، من دون مواربة أو الاختباء خلفَ أنا ثانية أو شخصية ثانوية، تقدم المؤلفة لنا رسائلها بشكل مباشر منها إلى مرسل إليه سوف نتطرق إليه لاحقاً، لكن لا نغفل هنا أنه يجتمع مع هم الشتات/ المنفى، هم الوباء، في إشارة إلى جائحةِ «كورونا»، وما نتج عنها من وضعٍ حزين وحياة صعبة على البشرية جميعاً في جميع المجتمعات البشرية الطبيعية المستقرة، فترى كيف مرت هذه التجربة الأليمة على المنفيين والمشتتين والذين يعيشون في مجتمعات غير مجتمعاتهم الأصلية، كيف عاشوا تجربة الحظر والوباء ومواجهة الموت في بلدانهم البعيدة؟ تلك هي التجربة المضافة إلى تجربة المنفى التي ترويها لنا الكاتبة في رسائلها هنا.
تقول (بيسان): «بدأ العزل يحاصرنا أكثر فأكثر؛ بعد أن كان عزلاً ذاتياً صارَ حظر تجول. في البداية، تخشى على الآخرين، ولكن سرعان ما تحول الأمر إلى جحيم.. كل شخص لديه جحيمه الخاص، أن تعلق داخل جسمك، تقاوم لإيقاف نسغك وتتوقف عن القتال، حينها تبدأ بمسايرة الوباء.. تخاف.. تبتعد.. تنعزل .. تتأقلم ثم تبدأ القتل. تظل الكوابيس الشيء الإنساني المتبقي في زمن العزل.» ص32
فالحالة الثقيلة الأخرى التي تقاسم المنفيَّ عذابات المهجر، هي تلك الحالة التي سببها وباء «كورونا» من عزل ثم حظر تجوال، مقاومة جديدة تضاف إلى سلسلة مقاومات النفي، تتمثل في مقاومة المرض، ومحاولة النجاة بالنفس من هذا الوباء، وكأن الكاتبة ومعها كل المنفيين، ومن ورائِهم أعداؤُهم من الصهاينة وأنظمة دول ترى فيهم إزعاجاً، يحتاجون إلى عدو إضافي، ليأتي هذا الوباء، كحمل ثقيل الوطأة يضاف إلى المعاناة التي يكابدها الإنسان الفلسطيني المشتت المنفي، وفي ظني أنه لم يكن في ذهن الكاتبة أن تكون الرسائل على هذه الصورة منذ بداية الرسالة الأولى، التي جاءت رقيقةً تتحدث عن صعوبة عشق «لاجئة»، وهو حديث بقدر ما فيه تحذير من الوقوع في عشق «لاجئة»، فإنه يستدر التعاطف معها، ويحمل في طياته صرخات حول مزيد من الحرمان الذي يقع على كاهل «اللاجئة»، بأنها تُحرم من الحب، ولا تكون صالحة لأن تُحِب أو تُحَب. تقول (بيسان) في رسالتها الثانية:
«لا تعشق لاجئة، لأن حقيبتها تمتلئ بمفاتيح البيوت البعيدة، والأوراق الثبوتية، وبضع ملامح من المنافي تخفيها خلف الصور الباهتة في محفظتها، وبعض من أقاصيص كتبها حبيب لها ذات مساء ” أمطرت الدنيا وأنت لست معها” لا تعشق لاجئة، فلن يعجبك صمتها الذي يشبه كاهناً إغريقياً…» ص 15-16
بهذه الروح الأنثوية الشفيفة، التي تحمل بداخلها توقاً شديداً للحب، لكنها في الوقت نفسه تحمل على عاتقها مصيرها المقدس من كونها «فلسطينية»، نواجه ترتيباً خاصاً للأولويات، وسِجالاً طويلاً من المقاومة المستمرة، سواء في الوطن الأم، الذي تم استلابه على يدِ المحتل الصهيوني، أو في المنفى، طوال الوقت يعيش الإنسان الفلسطيني نوعاً خاصاً من المعاناة المركّبة، ونوعاً خاصاً من المقاومة أيضاً، ورغم أن (بيسان) لم تُشِر لذلك كنقطةٍ جوهريةٍ، من اختلاف حجم معاناة المرأة عن الرجل، لكن لا شك أن المرأة تعاني أكثر، وجراحها أكبر، لكن هذه المسألة، لم ترتكز عليها الكاتبة كثيراً، لتجعل من نفسها صوتاً عالياً للقضية الفلسطينية. تقول في الرسالة الثالثة:
«أن تكون فلسطينياً يعني أن تصاب بشقاء جميل لا تقدر على الفكاك منه، أن تصاب بلوثة أمل زائفة، أن تحول أي هزيمة كبرت أو صغرت إلى حجارة تتكئ عليها للصعود، أن تُبقي مستوى الموت مرادفاً لمستوى الحياة، أن تصاب بهذا القدر الغرائبي الذي يلاحقك كعاصفة صغيرة كلما غيرت اتجاهك لتنجو، تلاحقك، تراوغها مرة بعد أخرى، لكنها تتبعك؛ قدراً يشبه لعنتك، تلك اللعنة التي تشبه رقصة مشؤومة مع الموت ….» ص37
إذن تصنع المؤلفة من رسائلها صوتاً مسموعاً للقضية الفلسطينية، وتعيد تناول الجرح الفلسطيني الغائر، وظلاله على النفوس العربية، من خلال هذه الرسائل. لقد قدّمت رسائلها في عشرين رسالة، حملت أرقاماً من الرسالة الأولى، إلى التاسعة عشرة، أما الرسالة العشرون فجاءت تحمل الرقم «صفر»، وهو ما يفترض بداهةً أنه يجدرُ أن يتم قراءتها قبل قراءة باقي الرسائل، فلماذا جاءت هذه الرسالة بهذا الرقم؟ وماذا يحمل الرقم صفر من دلالة؟
في اعتقادي أن هذه الرسائل لم يكن مخططاً لها أن تكون كتابا مجمّعاً، أو سرديةً خاصةً بنفسها ككتاب، ربما تولدت كخواطر ذاتية، تعبيراً عن حالة خاصة عاشتها الكاتبة في حلها وترحالها، لكن مع الوقت- خاصة أننا نشاهد بدءاً من الرسالة الخامسة اتساعاً كبيراً في الفضاء النصي لكل رسالة- بدأت الفكرة تورق وتنضج وتتضح الأهداف الخاصة بالرسائل، وما ترغب في أن توصله الكاتبة إلى المتلقي، والفعل الأساسي لها هنا هو التنقيب في التاريخ، على غرار «حفريات المعرفة» لـ(ميشيل فوكو)، تنقب (بيسان عدوان)، في التاريخ بشكل انتقائي، وهي تحفر في تاريخ كل شيء، المدن والأماكن، والأحياء، وأرواح البشر، وروحها هي، كل شيء يصبح محل تساؤل من ناحية، ومحل تنقيب تاريخي من ناحية أخرى.
إذن فالبوح أحد أهم أهداف الرسائل هنا، وكأنها تصنع من قارئها متعاطفاً وجدانياً مع تاريخها الحزين، ومع حياتها التي اتسمت بالحزنِ دون تدخل منها، وبطريقة بندولية، تتردد ما بين التاريخ الذي فيه تم احتلال فلسطين، فتعود تنقل لنا من ذاكرة جدتها تلك اللحظات المأساوية، وتنقل لنا ما حدث مع والدها من نفي وطرد وتهجير، وهو ما كان سبب تسميتها باسم بلدها (بيسان) تطلعاً إلى الخلود ومقاومة المحتل الإسرائيلي، وفي الناحية الأخرى من البندول، تحفرُ في واقعها الجديد، في منفاها الذي يتحول مع كثرة المشردين والمنفيين إلى ظاهرة كونية، تقول عن الحي الذي تعيش فيه في الرسالة السادسة عشرة:
«أتعرف أن حي “كرتولوش” يعني حي “التحرير” أو “الخلاص” وله معانٍ تركيةٌ منها “المهرب” أو “المنجي”. كان اسم الحي في الماضي “تاتافلا” يسكنه اليونانيونَ الذينَ هُجّروا منه بعدَ اتفاقية 1923، ومذاك حزن الحي كثيراً على ساكنيه، وفي العام 1929، اندلع حريقٌ هائل عند تقاطع شارعي “آية تاناش” و”ديمرجي أليكو”، والتهم حوالي نصف بيوت الحي المتجاورة والمبنية من الخشب وأحالها رماداً، وكانت كنيسة الروم من بين ما طالته ألسنة اللهب. كان الحريق تاريخياً، وأسس لمرحلة جديدة في هذا الحي، وأثار أزمة بين البلدية وفرق الإطفاء التي اتهمت بالتقاعس في السيطرة عليه.» ص146
طبيعي أن تشغل الجغرافيا اهتماماً خاصاً عند من يعيش تجربة المنفى، فهو في جزء منه يحاول أن يجد لنفسه وطناً بديلاً، يحاول أن يتأقلم مع الجغرافيا الجديدة، والشوارع الجديدة، يحاول أن يجد متشابهات مع الأماكن التي كان يعيش فيها، ولكنه يفاجأ مع مُضي الوقت أن مبتغاه مستحيل، وأن ما يحدث هو النقيض، فالأماكن التي تتقارب مع وطنه تعيد عليه ذكرى النفي، وتحيي شعوره بالغربة أكثر، وكردِ فعلٍ لا إرادي يجد المنفي نفسه متعاطفاً مع الفئات المتشابهة مع حالته وتجربته، فيجد نفسه صوتاً تعبيرياً عن الفئات التي تعيش ذات التجربة وقريبة من الظروف ذاتها، لذا نجدها تقول:
«ثمة شيء له جاذبية خاصة في الحي لم أستطع تحديده، ربما لأنه حي مختلط يسكنه الأرمن والأكراد والأفارقة والعرب، غالبيتهم من العراقيين الأشوريين والسوريين، إلى جانب الأتراك وأغلبهم من الجنوب التركي، أي من ماردين وأنطاكية وأضنة.. كل ذلك الخليط وفّرَ على الكثيرين النقاش والجدل. جنبني تلك التساؤلات حول سبب وجودي هنا أو توقيت عودتي، فالجميع هنا غرباء وخائفون» ص147.
ومن قلبِ الخوف، تتولد الصداقات، ومن رحم المعاناة تُخلَقُ ألفة غريبة بين أولئك المنفيين وبعضهم بعضاً، فعلى نحوٍ غريبٍ ومُخاتل، يصبحون على نحو مغاير قومية مختلطة متداخلة جديدة، يغلب عليها التشكك في كل شيء، والخوف من كل شيء، والبحث والتنقيب في جذور التاريخ، وقراءة المدن والأماكن والأحداث على نحو مغاير.
إن جانباً نفسياً في شخصية المنفيّ يلقي بظلاله دائماً على كل كتابة من تأليفه. يقول (فخري صالح): «إن من الصعب بالفعل أن نرسم شبكة لمعنى المنفى وأدب المنفى ضمن هذه الظروف المعقدة من عمليات النزوح والشتات والاغتراب والاقتلاع والتشريد والنفي والرحيل الطوعي أو الهجرة بحثاً عن الحرية أو الرغبة في تحسين الأوضاع المعيشية؛ فبينما كان الارتحال فردياً في العصور السابقة، أو أنه يتضمن مجموعات صغيرة، صارت هناك مجتمعات الشتات كاملة. تبتعد، طوعاَ أو كرهاَ، عن أوطانها الأصلية. وبعض مجتمعات الشتات هذه أجبرت لا على ترك أوطانها فقط بل على التخلي عن لغتها الأم، وثقافتها الأصلية لتصبح جزءاً مزاحاً من المجتمعات والثقافات الجديدة، مثل الأفارقة الذي يعيشون في فرنسا، والهنود والباكستانيين الذين يعيشون في بريطانيا. وهؤلاء ينتجون أدباً مهجناً لكنهم يتخذون من الفرنسية والإنجليزية لغة يعبرون بها عن أنفسهم، بما يتضمنه ذلك من مصاعب في التعبير عن الذات وانشقاقات في الهوية.» [[4]]
ويضاف هنا إلى ما قاله (فخري صالح) تجربة جديدة في تركيا، حيث منفى جديد بسِماتٍ جديدةٍ مختلفة قليلاً عن تجربة النفي في بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا، ومع هذه التجربة أيضاً تجربة مغايرة للبشرية جميعاً في مواجهة الوباء، وهذا ما تفردت به (بيسان عدوان) في كتابها هنا.
يظل تساؤلٌ أخير: إلى من كانت (بيسان) توجّه هذه الرسائل؟ وعمن كانت تتحدث؟ ومن تريد أن يتلقى هذه الرسائل؟
تقول في نصٍ يثيرُ الدهشة في “الرسالة صفر”:
«عزيزي… الذي لا أعرفه ولا أتوقف كثيراً في السؤال عنه، في الرسائل الماضية كنت تتجلى في صور متعددة ومتنوعة، تارة تكون الله الذي أبحث عنه في كل شيء وأنتظر لقاءه لأخبره كل شيء، لأخبره عن قسوة تلك المنافي ، والوحدة و القهر، لأخبره ماذا تعني كلمة لاجئ في هذه البلاد القاسية، الأخيرة بهذا الوجع الممتد …» ص181.
وتتنوع الخطابات، لنكتشف أنها كانت تقصد بـ «عزيزي»: الله، والوطن، والأب، والجد، والحب، والغرب، والنورس، وحتى اليمامة والنضج ذاته، كل تلك معانٍ أعادت (بيسان) البحث فيها واكتشافها، ومحاورتها على نحوٍ من التداعي الحر، الذي يتم فيه الإسقاط الداخلي من شخصيتها المكلومة بنار الغربة، والمكتوية بمرارةِ اللجوء، لتوصل هذه المشاعرَ كصرخةٍ إنسانيةٍ صادقةٍ ومرهفة، اتسمت ببعدٍ توثيقيٍّ دقيق وصياغة فنيةٍ وجماليةٍ رفيعةٍ جوهرها الصدق والمعايشة ومساءلة الضمائر.
……………………………………………….
[1] – بيسان عدوان: رسائل الشتات/ سردية المنفى والوباء، دار ابن رشد، إسطنبول، 2021
[2] – إدوارد سعيد: تأملات حول المنفى ومقالات أخرى، ترجمة: ثائر ديب، ط2، دار الآداب، بيروت، 2007م، ص 19
[3] – محمد الشحات: سرديات المنفى: الرواية العربية بعد عام 1967م، دار أزمنة، عمان، 2006م، ص 23
[4] – فخري صالح: معنى أدب المنفي، مجلة الكلمة، عدد 10، أكتوبر، 2007م، ص 2