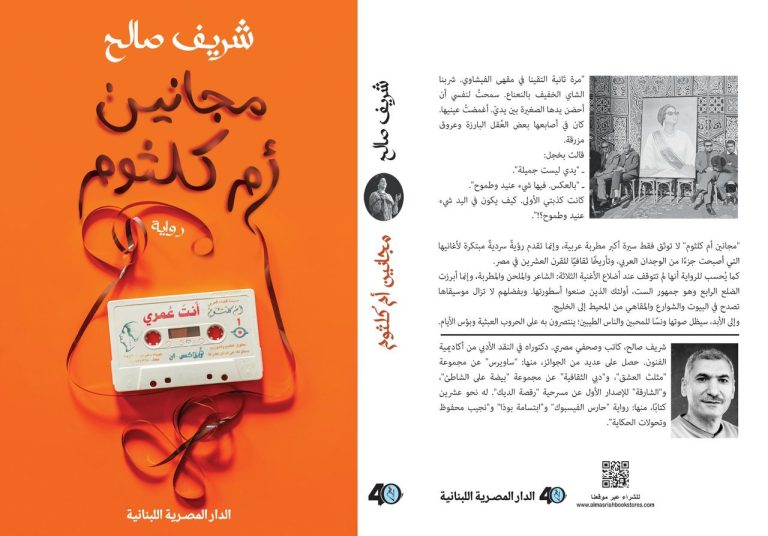جمال السعيدي
كلّما نظرت إلى أخي مراد، بدا لي شخصا ناجحا مرموقا ببدلته المكوية بعناية، وشعره المُصفّف المدهون، وفي يده حقيبة المحاماة تهتز مع كل حركة.. في كل مرّة أراه فيها وأملأ عينيّ من مظهره الأنيق، تحملني الذكريات إلى أيام الطفولة وحياة المدرسة فأضحك، أتذكر تلك الواقعة فأضحك.. لكن شعورا مريرا بالندم على ما فرّطت في دراستي يغمر قلبي كلما فتحت نافذة الماضي، ورأيت أولاد الناس ومعهم أخي مراد يواظبون على المدرسة ويمهدون طريقهم في الحياة، وكنت أنا منصرفا إلى عالم غريب؛ أمضي يومي هائما في الأحراش القريبة من حيّنا، أحاكي فتى الأدغال، أجمع الكلاب من حولي وأنطلق بها في بحث دؤوب عن القطط الضالة، نلاحقها ونروّع أمنها.. أيام أذكرها فتستيقظ في نفسي مشاعر الحسرة والعار فأقسو على نفسي باللوم أيّما قسوة، أحاسبها على حماقات أنفقتُ صباي وزهرة عمري أخوض في حقولها الجرداء العقيمة، ولم أكن أحسب حساب هذه اللحظة، وكأن الحياة ميدان فسيح خُلقنا لنركض فيه ونلهو. هكذا كنت دائما، عشت حياتي أحمل بين كتفيّ رأسا ليس فيه عقل يعمل ولا أذن تسمع.. ولكن، لماذا أجلد نفسي الآن على هذا النحو العنيف؟ أردت الحديث عن أخي مراد، وعن تلك الواقعة المُسلية، فإذا بي أخوض في خيبتي المريرة. لنعُد إذن إلى تلك الأيام العذبة:
في يوم من أيام الصيف الأولى، وكان يوم الأحد، وهو اليوم الوحيد الذي يشاركنا فيه والدنا مائدة الإفطار، أما في باقي أيام الأسبوع فلا ندركه أبدا، كان ـ رحمه الله ـ يغادر البيت مع انبلاج الفجر، ولا يعود قبل حلول الظلام.. يظلّ يركض طوال النهار لأجلنا، في خط دائري لا نهاية له كان يركض، وبالكاد كان يسدّ رمقنا.
لم ينل والدي من زينة الدنيا سوى ولدين لا ثالث لهما. هذا إذا جاز لي أن أعدّ نفسي زينة تنعّم بها والدي في حياته البائسة. كنت الأصغر والأذكى؛ شيطانا حقيقيا كنت في صباي، أتعبت أمي حدّ الإنهاك، كانت تداري عليّ وتحول ما وسعها الجهد والحيلة بيني وبين قبضة أبي السوداء المعروقة. وأنا بدوري لم أكن أرعوي، لا تثنيني رقتها الناعمة ولا يردعني بطش والدي العتيد. لطالما مزقت حبل الود بينهما وكدّرت عليهما لحظات الصفو على قلتها. وحتى أكون منصفا، فالعقاب الذي كنت ألقاه من والدي في تلك الأيام الغابرة كان مردّه في الغالب إلى شكاوى يتلقاها من جيراننا أو من معلّميّ في المدرسة. وكانت العلامات السيئة التي عادة ما كنت أجني ثمارها الجافة، كفيلة بأن تخرج أبي عن طوره وتفقده أعصابه. أمّا أمي، آه يا يمّا.. كم أنا حزين من أجلك‼ لو تدركين قدر الندم الذي ينهشني الآن وأنا أذكر حماقاتي، تلك التي جعلت من عيشتك شريطا من كدر موصول.. كانت تفلح أحيانا في كبح غضبه وإخماد أعصابه إذا أضرمت فيها النار، ولكنها كانت تخفق في الكثير من المرّات.
على رقعة مائدة خشبية مستطيلة يغطيها قماش تقاطعت عليه خطوط بنّية وبيضاء، كانت صينية الشاي موضوعة بعناية، يتوسطها برّاد معدني عتيق لمعت على كرشه البارزة نقوش قديمة، وعلى مقبضه الحارّ وضعت أمي منديلا نظيفا مطرّز الحواف، وحوله أكواب مملوءة إلى النصف بالشاي الأحمر القاني. ولم يكن بجوار الصينية سوى صحن دائري أبيض تلمع فيه حبات الزيتون السوداء داخل بركة من الزيت بلونه الأخضر الزجاجي.. جلسنا نأكل في حضرة أبي يلفنا صمت ثقيل، فقط أنا وأخي كنا نتبادل لغة العيون، أما والدي ووالدتي، فكان كل منهما منصرفا إلى ما يشغل باله.
انتهينا سريعا وقمنا إلى مخدعنا الصغير. مرّت دقيقتان فقط، وتناهى إلينا صوت أمّي: مراد.. آ مراد..
- نعم.. ها أنا‼
وهبّ مسرعا يلبّي طلبها دون إبطاء. كان أخي مراد على النقيض مني تماما؛ منطويا خارج البيت على نفسه فلا يكاد يُرى برفقة أحد، وكان خوّافا خنوعا يؤثر السلامة ويعتذر لمن يهينه، وهو دائما على استعداد للفرار من المواجهة. ولم يكن يطلع العفريتُ القابع بداخله إلاّ عليّ، يقف في وجهي ويعاركني بشراسة كما تفعل القطط في الشارع. أما في المدرسة، فكان احترامه للمدرسين عظيما جدا، وإذا دخل الفصل، اعتدل في جلسته خاشعا كأنه في صلاة.
وسمعت أمي تخاطبه برقتها المعهودة:”امش عند البقال إبراهيم وأحضر كيس ملح. لا تأتني بالخشن كما فعلت في المرة السابقة، أريد الملح المسحوق..”ثم تناهى إليّ صوت انصفاق الباب الحديدي. بعد قليل، هزني صوت والدي:” وليد.. آ وليد..‼”
ـ ها أنا..! نعم آ بابا..!
قفزت متهيّبا إلى صحن الدار، فوجدته يمسك بين أصابعه ورقة النتيجة. عرفتها من لونها الأصفر الباهت، مع أنها كانت مطوية في يده. أدركت أن أخي سلمه بفخر كبير نتيجته كالعادة، أمّا أنا فقد هداني شيطاني الصغير حينها بأن أخفي ورقتي. لوّح بالورقة في وجهي وقال بغضب:
ـ هذه نتيجة أخيك.. أين نتيجك؟
ـ ها.. النتيجة..‼ ضاع.. ضاعت مني.. لا أدري.. لعلها سقطت مني في طريق العودة!
كذلك أجبت متلعثما وعيناي تحدقان إلى أصابع قدميّ. لم أجرؤ على النظر إليه، كنت أعلم أنه يبحث كالعادة عن بريق الكذب في مقلتيّ الصغيرتين. وتفجّر الغضب من فمه ومن عينيه ومن سائر ملامح وجهه الشوكي الذي لم يحلقه بعد:
ـ ضاعت منك آ الجرو‼
وبحركة سريعة خاطفة مدّ يده إلى شعري الناعم وأمسك بخصلاته الأمامية، فتردّدت صرختي في أرجاء البيت، أحسست بألم فظيع؛ كأن فروة رأسي تنسلخ عن العظم. وانطلق بي إلى حجرته المهيبة يجرّني كما يُجر التيس العنيد. وفي طريقه إليها كان يسبّ ويلعن اليوم الذي جئت فيه إلى الدنيا، ثم دفع الباب بركلة عنيفة وطوّح بي فوق السرير.
تكوّمت على نفسي واتخذت شكلا حلزونيا. وكنت لكثرة ما تكرر هذا المشهد قد اهتديت بالفطرة إلى أن هذا الوضع هو الأمثل في تلقي الضربات دون أضرار كبيرة.. لكن والدي لم يقترب مني، ظلّ ينظر إليّ مباعدا بين ساقيه ويداه تستريحان على وسطه. وامتدّ الزمن فيما كنت أترقب خطوته التالية، واستطالت لحظة الصمت المخيف كأنها هوّة بلا قرار، وهو يتفحصني بنظرات حائرة، ثم قال بصوت خافت حزين:
ـ لا تريد أن تدرس..
ـ …
ـ هذه رغبتك إذن..
ـ …
ـ حسنا..! وسكت من جديد. بدا حائرا في تلك اللحظة، كما لو كان يبحث عن شيء ما. ثم صرخ بجنون:
ـ لن تذهب إلى المدرسة بعد اليوم! من الغد.. سأسلّمك إلى “المعلم احمد”. سترى كيف أسحبك إلى ورشة النجارة كما يُسحب جرو قذر.
ما كنت لأهتم بهذا القرار الخطير، لا نبرة التهديد في كلمات والدي، ولا الحسرة التي ملأت عينيه هزت شعرة في جسدي الصغير. وحدها تلك الجملة القصيرة” لن تذهب إلى المدرسة بعد اليوم” ملأت روحي وتردد صداها في دماغي واختلط مع الصدى الذي خلّفه انصفاق الباب الحديدي إيذانا بانصراف والدي. ألقيت بنفسي من أعلى السرير كما تفعل القرود، وفي قلبي فرحة لو تقاسمها أهل الأرض لوسعتهم جميعا، ودخلت على أخي مراد، كان قد أحضر الملح وجلس ينتظر عودتي. قفزت أمامه قفزتين متتاليتين وأنا أصفق بيديّ على نحو سعيد.. فجحظت عيناه. كان يعلم السبب الذي دعا والدنا إلى أن يغلق علي في الداخل، وتوقع أن يرى الدموع في عينيّ. ففرّت لمسة التعاطف من وجهه المورّد الوسيم، وحلّت محلها نظرة بليدة مستفسرة. قلت قبل أن يسأل عن سرّ سعادتي:
ـ خرجت من المدرسة.. خرجت من المدرسة‼
لازلت أذكر إلى اليوم ذلك اللحن الطروب الذي نطقت به تلك الكلمات. وتساءل مراد بلهفة كأن أمرا عظيما فاته ولم ينل حظه منه:
ـ كيفااااش.. شكون.. شكون قالها لك؟
ـ غدّا.. غدّا غادي نخدم عند النجار.. عند المعلم احمد.
ـ فاين مشى بابا؟
ـ ما نعرف.. خرج!
كان بيت الأسرة الصغيرة يقوم في نهاية درب مرهق ينحدر من الأعلى إلى الأسفل، فانطلق مراد يركض نحو رأس الحيّ ركضا عنيفا لعله يدرك أباه. وتحقق رجاؤه، ما إن وصل إلى نهاية الدرب، حتى لاح لعينيه هيكل أبيه المتهدم ومشيته المنهكة، فصاح ينادي عليه بنفس متقطع: بابا.. آآ بابا..!
التفت الرجل إلى مصدر الصوت، وتكدرت ملامحه لرؤية ولده. والحقيقة أن موضوع النتيجة وتهاون ولده في المدرسة لم يكن جديدا عليه حتى يوقظ في نفسه كل هذا الغضب.. لم يستلم أجرته بعد، ولم يكن يملك فلسا واحد، هذا ما دفعه إلى المبالغة في إظهار سخطه، وأثار تلك الزوبعة داخل البيت، لعل أم العيال تتهيّب من مزاجه العكر فلا تطالبه بمصروف هذا اليوم. وهو الآن يتوقع من مراد أن ينقل إليه رسالة أمه “هات المصروف” فصرخ في وجهه:
ـ مالك.. آش كاين..؟
وردّ الولد بكلمات متقطعة لاهثة:
ـ حتى أنا.. حتى أنا..
ـ آشنو.. آشنو حتى أنا؟
ـ حتى أنا باغي نخرج من المدرسة‼
وكان أن فرقعت على خدّ الغلام صفعة مدوّية شرخت سكون الحي الخامل، تبعها صوت مسعور:
ـ امش.. امش آ ولد الكلاب.. حمّقتوني يا المساخيط..