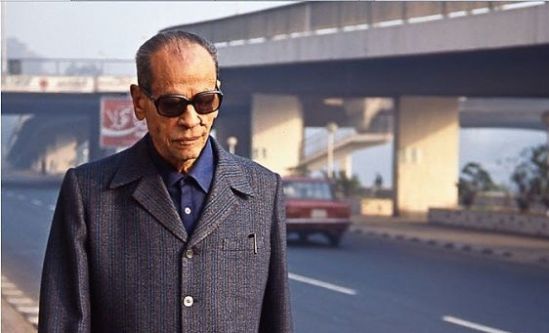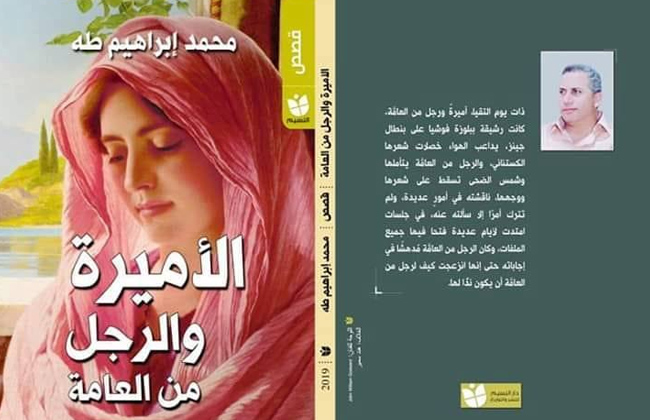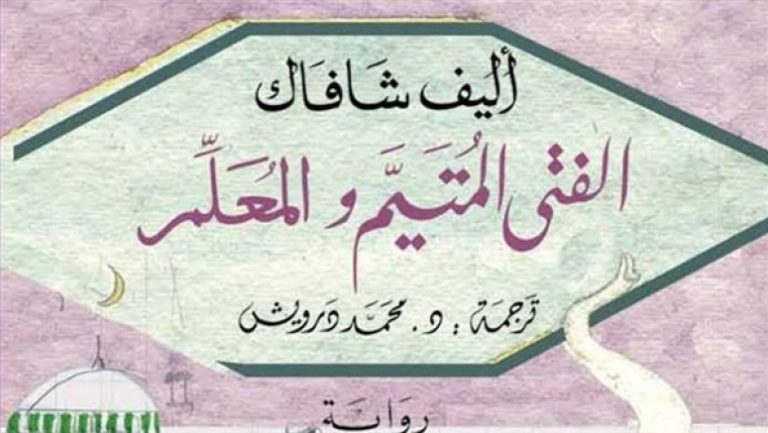د.. محمد بدوى
فى شعر أحمد عبدالمعطى حجازى ـ بنوة واضحة القسمات للرؤيا الرومانسية للعالم كما أسستها الرومانسية العربية بجناحيها المصرى والشامى، قلق وجودى وسعى إلى استبدال الأسئلة الوجودية بطمأنينة الشعرية الكلاسيكية التقليدية، ورفضه تقليص التفاصيل فى جمل مكتنزة موقعة وتحويلها إلى “حكمة” تصلح للترديد وتزيين “النثر” بها.. فى هذا المفهوم الرومانسى الشعر تعبير وبوح عن ذات متفردة، علاقتها بالجماعة مشوبة بالتوتر، لأن الذات منحت هبة إدراك للعالم دون الناس “المسرعين الخطو نحو الخبز والمؤونة” على حد تعبير صلاح عبدالصبور، لأنها غير معنية بتوافه الأمور، الشاعر غير البشر الفانين الراضين عن الكون كما هو، لأنه يرى ما لا يرون، ويسمع ما لا يسمعون، فهو كائن ممتاز، امتيازه كامن فى “هيبة الطبيعة” التى جعلته مختارا، لا لكى “ينظم” و”يقرض” الشعر فحسب، بل ليتصل بمنابع الإلهام، التى تجعله قادرا على قول ما لا يمكن لأحد سواه أن يقوله، لا المؤرخ ولا حتى القاص الروائى، لأن الشعر كلام سام مكثف موقع مجاوز حتى لما يقرره النحاة من قواعد، وإذا رأى بعضنا أن هذه الأيديولوجية الشعرية تصلح للفن كله وللشعر بخاصة، فإن الجديد فيها هو تناقضها مع المفهوم “الاحيائى” السابق عليها، والإفراط فى الحدية، أى الذهاب إلى نهايات الأشياء، حيث الذات مركز العالم، بحيث نصبح مع الذات وقد أضحت مطلقا فلسفيا.

لكن حجازى ليس رومانسيا خالصا للرومانسية العربية السابقة عليه، إنه رومانسى فى عالم يتغير، أو ينطوى على عناصر، تجعل التغير حتميا، لدينا عالم قديم متداع راكد، ولكن ثمة ما يخرج من رحمه العلاقة بين المدينة والريف تفقد تجانسها القديم، أبناء التعليم الحديث من الأفندية يبحثون عن نصيبهم فى الثروة والسلطة، حتى اللغة القديمة العجوز تتجدد وتغير جلدها وتشهد بنيتها اهتزازات وتوترات.. ذلك كله تجمع وتكثف فى صعود سلطة جديدة هى سلطة يوليو، التى استبدلت بالديمقراطية النخبوية أيديولوجيا الإنصاف، وبالتفاوض مع الاستعمار أيديولوجيا المقاومة، لاسيما بعد نكبة فلسطين.. هنا جاوز حجازى الرومانسى مرحلة تدريبه الشعرى الرومانسى التقليدى إلى رومانسية ثورية، تحاول تجاوز الهوة بين الذات المتمزة والجموع، بجعل الذات تكثيفا لأهم ما تملكه الجماعة من صفات تكونت عبر التاريخ، لكن هذا التحول لم يحدث فى شعر حجازى بغتة، فالذات الرومانسية لا تتحول سريعا، إنما تنقب عن العناصر الكامنة فيها، عناصر لم تكن فى حالة غياب، إنما فى حال من الإمكان.. ذات شاعر ريفى فقير، تكتشف أن “هبة الطبيعة” لا تفصلها عن ذوات أشباهها من أبناء “الوطن” الفقراء، ملح الأرض، وموطن الأصالة، وهكذا أعلن الديوان الأول موهبة مؤكدة، شاعر له لغته وله ما يحبذه من المجازات وبحور الشعر، وفى هذا الديوان وما تلاه مفارقة عميقة بين ولادة عالم جديد والحنين إلى عالم سواه، لنتذكر ـ مثلا ـ المفارقة بين الفضاء الذى تخلقه قصيدة مثل “عامى السادس عشر” وقصيدة “سلة ليمون”، فى القصيدة الأولى الذات المتوحدة المتنحية عن عالم الواقع النثرى المستقر، وفى القصيدة الثانية فضاء وعامته المشهد اليومى لكائن صغير هامشى، حيث السرد المكثف لتفاصيل مادية يعزلها الشاعر عن “النثرى”، ويفجر فيها الشعر.
وهكذا تغادر الذات فضاءها الضيق إلى فضاء أرحب، حيث اكتشاف الجمال فى اليومى الواهن.. الشاعر هنا لا يتخلى عن الذات، ولكن يوسع من عالمها، فعينه أضحت قادرة على التحديق فيما ظنته ـ يوما ـ لا عمق فيه ولا إمتياز يؤهله للدخول إلى جنة الشعر.

الرومانسى الثورى تجاوز رومانسيته التقليدية إلى رومانسية تمجيد الحياة والاحتفاء بتفاصيلها.. الأحرى أننا إزاء انشقاق على الآباء الشعريين الذين رفعوا الذات إلى مرتبة البنوة، وأنتجوا شعرا تبهت فيه التفاصيل وينتفى فيه “التعدد” تعدد الوجوه والأجساد واللغات.. فالشاعر لا يقف على رصيف الحياة، بل ينغمس فيها، ولكى يؤكد الشاعر هذا الانغماس توحد مع الحياة، مع الكائنات الصغيرة التى تكثفت فى صوت الزعيم البطل المحرر، بعبارة أخرى لم تعد وظيفة الشاعر أن يغنى الفقراء “والمخلص من أى ديانة” فحسب، بل أن يكون “حادى الثورة” يرثى الشهداء ويبشر بالغد الآتى، هذا واضح جلى فى رثائه لعدنان المالكى وبن جلون وآخرين، فالعالم فى هذا المنظور منقسم إلى استعمار وشعوب، أغنياء وفقراء، خونة ومخلصين… الخ.
لكننا نخطئ لو بسطنا الأمر على هذا النحو، صحيح أن حجازى جعل من نفسه “منشد الثورة”، فكان صوته احاديا، والعالم بسيطا، بل إنه غنى حتى مؤسسات الدولة السياسية، طالبا من “الاتحاد الاشتراكى” أن يكون له سيفا ونشيدا، لكنه فى الوقت نفسه لم ينجح فى التمويه على خوفه، الخوف من المدينة التى لا قلب لها، والخوف من هؤلاء المجهولين “الذين يخرجون فى الليل ينادون الأسماء”، والخوف من “السجن” الذى قضى جيله الشهيد “ليلة فيه”.
بجوار الصوت المجلجل المنشد المبشر، ثمة صوت آخر هش وضعيف ومرتعش خوفا، وسرعان ما افترق المغنى والزعيم، وأعلن الشاعر ذلك الفراق فى إحدى قصائده. لم يغير الشاعر جلده، بل ظل مخلصا لشعريته، لكنه تحرر من “وهم التوحد مع الزعيم” والحقيقة أن هذا التوحد بالغ التعقيد، لأن فى شعر حجازى ـ حتى فى هذه المرحلة، ما ينقضه مثل قصيدته الشهيرة “مرثية لاعب سيرك” وقصيدته “اغتيال” التى كتبها إثر اغتيال وصفى التل. حيث لم يعد يتصدر المشهد وجود القاتل للمقتول الموضوع فى مرتبة الخائن، بل يهيمن على القضاء الخوف، خوف القاتل وارتباكه حتى العجز عن رؤية عينى المقتول إنه خوف قديم غائر، يتجلى حتى فى الحب “أحبك / عينى تقول أحبك / ورنة صوتى / تقول وصمتى الطويل (….) أحبك حين أزف ابتسامى/ كعابر درب يمر لأول مرة / وحين أسلم ثم أمر سريعا / لأدخل حجرة / وحين تقولين لى: ارو شعرا / فأرويه لا أتلفت خوف لقاء العيون / فإن لقاء العيون على الشعر يفتح بابا لطير سجين / أخاف عليه إذا صار حرا / أخاف عليه إذا حط فوق يديك فأقصيته عنهما”.
على أى حال، يبدو أن العلاقة بين الشعر والسياسة فى مرحلة يوليو عبدالناصر أكثر تعقيدا من الإشارة السريعة هنا، لأن الظاهرة لا تخص شاعرا بعينه ـ بل تخص أكبر شعرائنا مثل صلاح جاهين وصلاح عبدالصبور وفؤاد حداد، كما أنها لا تحدد أهمية شعر الشاعر أو عدم أهميته.

حجازى شاعر كبير فى حدود شعريته، أى فى حدود أفق هذه الشعرية وطبيعتها ووظيفتها، نحن مع شاعر يملك لغة خاصة به لها سماتها الأسلوبية ولها معجمها الشعرى، وله عالمه الأصيل الذى يأخذنا إلى نمط من الإدراك للعالم بما ينطوى عليه من رموز وتفاصيل وسوف أقترح لتفسير أهمية شعر حجازى أننا إزاء شاعر لذة أو متعة.
أقول على نحو مرتجل إن اللذة هنا ليست اللذة الجنسية، وإن كانت الأخيرة بضع منها، إنما أعنى باللذة المبدأ الأخلاقى الذى يرد مختلف مطالب الإنسان الأخلاقية إلى تجنب الألم، بمعنى أن النزوع إلى السعادة قوة أساسية للإنسان وضعتها الطبيعة فيه، ومن ثم تحدد كل ما يقوم به من فعل أو سلوك أو إحساس. واللذة هكذا تعنى نظرة مادية إلى الأخلاق باعتبار الإنسان فردا حتى لو كان نتاج عوامل معقدة متعددة، اجتماعية و ثقافية وسياسية.
شعرية اللذة لا ترى الشاعر عارفا أو معلما، بل تراه فردا يدرك العالم إدراكا حسيا ماديا. وهذا يعنى أن اللذة علاقة بالوجود، بل هى رغبة فيه واحتفاء بطبيعته وقبول بجسدانيته، حتى لو انطوى على نقص. لغة حجازى نفسها تؤكد ذلك، فثمة عمل على اللغة بتحرير علاماتها من تراكم الدلالات الناتج عن التاريخ الطويل لاستعمالها من قبل الآخرين، مما يعنى التوق إلى لغة طقسية، جمالها كامن فى نضارتها لا فى تبرجها، وهذا ما يجعل الجملة قصيرة واضحة الحدود بعيدة عن الاقتباس.
أما الألفاظ فهى مادية الدلالة، وحسية، وأنيقة، لأن المهم ليس أن يقوم الشعر بتأويل العالم بل المهم فى الشعر استعمال العالم، هذا العالم يتم اصطفاء لحظات منه ويقوم الشاعر بعزلها ونفى زوائدها وتثبيتها، لكى تتحرر منه النثر والتقصى والشرح وإشباع الدلالة. ولأنه شاعر يغنى وينشد فإن إدهاش سامعه يبدأ بمباغتته وكسر توقعه، وتنهض بهذا المهمة بداية القصيدة، كما تقوم بمهمة أخرى نهاية القصيدة التى تشبه الجملة الأخيرة فى القطعة الموسيقية التى تجسد الصمت.
هكذا يمكن القول إن شعرية اللذة قوامها علاقة شبقية بالوجود، لكنها ليست رغبة محددة فى فعل شبقى محدد، بل إن الشبق قوة أساسية محركة للكائن، ولذلك لا يمكن تحديدها بمدى زمنى معين، ولا بموضع معين، فهى منتشرة فى فضاء القصيدة، بل هى قوة أساسية طبيعية فيه.
وبرغم أن إدراك الوجود على هذا النحو المادى الحسى واضح فى قصائد الفرح بطبيعة الحال، إنه ماثل فى قصائد الحزن والمراثى وقصائد الهجاء السياسى، ذلك أن شعرية اللذة ليست مجموعة من خصائص لغوية فحسب، بل هى أولا وأخيرا إدراك للوجود، على نحو يجعله موضوع رغبة واشتهاء.