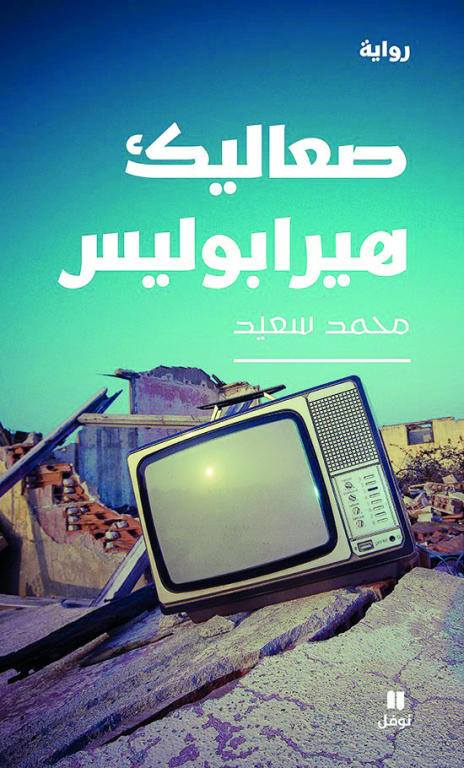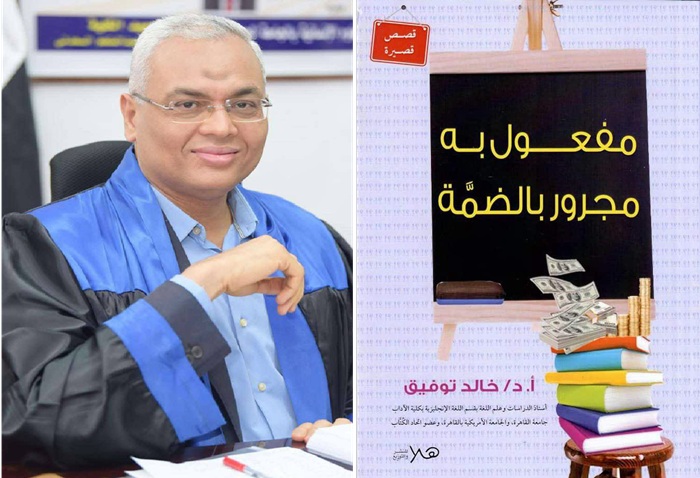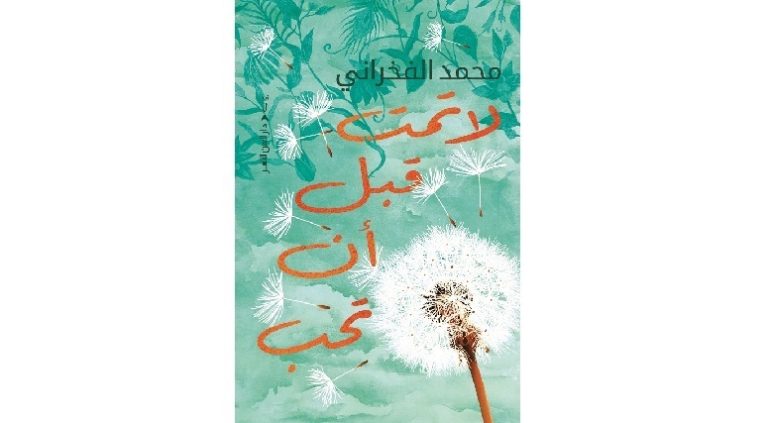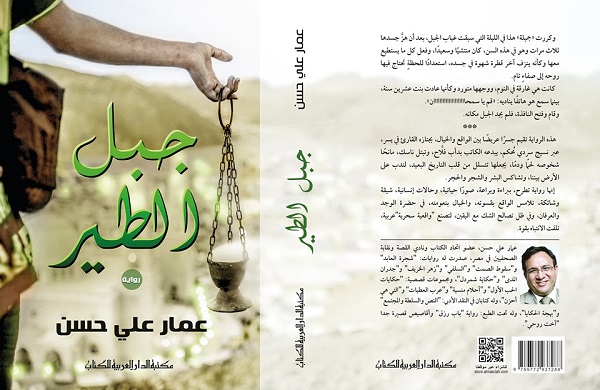“الشخص الذي أنتج في مجال الأدب العمل الأكثر تميزاً في الاتجاه المثالي”
هذا وصف “ألفريد نوبل” للمستحق لجائزته القيِّمة مادياً ومعنوياً. نستلقي فوق أسرتنا ونتأمل كلماته.. فتظهر كوة بيضاء في سقف العالم. نجلس ورؤوسنا معلقة ومأخوذة بالكلية ونحن نبحث في الفضاء الحليبي عن معنى: الأكثر تميزا في الاتجاه المثالي.
تحصل الروائية والكاتبة “آني إرنو” على نوبل 2022، فأتسحب خارج حيز المثالية المزعومة، وأكتب يوميات تجسد الاشتباك مع ما أقرأ من أعمالها.
اليوم الأول:
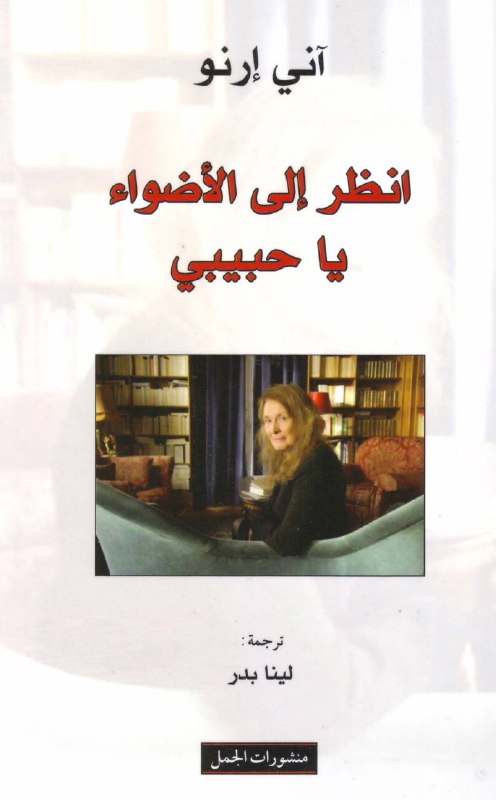
“انظر إلى الأضواء يا حبيبي”
أتململ في جلستي، وأنا أقاوم النعاس، فاللغة تقريرية ووصفية من دون أحداث أو ملامح مميزة. علاقتي بالمولات التجارية الكبيرة سطحية للغاية فأنا أبتاع احتياجاتي من الأسواق الشعبية، تنتشر أمامي “مشنات” ممتلئة بالخضروات والفاكهة، فتتسخ كفيّ وأنا أقلب البضائع للحصول على أفضلها. أشتبك مع البائع المنزعج من عشوائيتي التي تخرب الصفوف المتراصة. أفتقد تلك الحميمية الممتزجة برائحة العرق والتراب. أكاد أجن من شعوري الطاغي بالسأم.
فجأة يتكشف خلف ستار الملل والتكرار واللغة الجافة صورة ذكية لتحليل ما وصلت إليه البشرية من حالة توحد تفرضها طريقة عمل تلك المتاجر الكبرى. تمرر ببساطة أخبار حقيقية لحوادث قتل فيها عمال من عدة مصانع في دول العالم الثالث كإشارة إلى أن تلك الرفاهية التي يعيشها أولئك المستهلكون ثمنها باهظ، فربما كان ثمنها دماء وأعمار بشر يسكنون في طرف العالم يحلمون بقطعة خبز نظيفة أو ملابس لائقة أو حتى انتباه إنساني حقيقي.
“أليس المجيء إلى المركز التجاري طريقة لتكون مقبولاً في المشهد الاحتفالي، ولتغطس بشكل فعلي –وليس من خلال شاشة التلفزيون- في الأضواء والبحبوحة، كي تكون لك قيمة الأشياء نفسها” ص69.
اليوم الثاني:
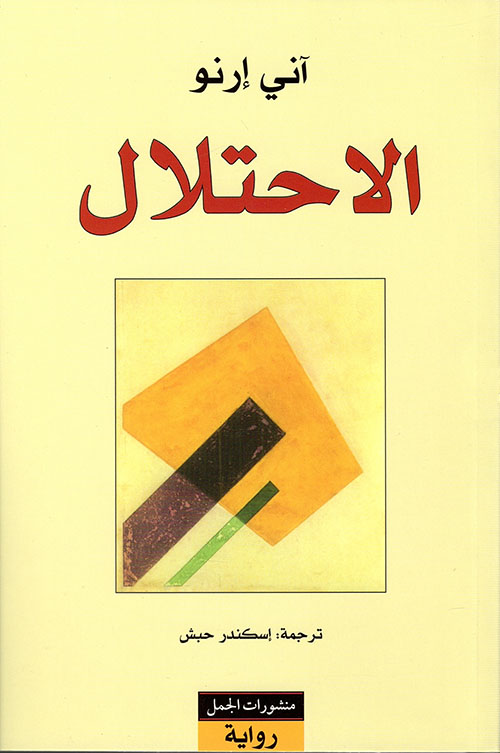
“الاحتلال”
بدأت أنسجم وأنا أتتبع جزءاً من روحها الخاصة المتعلقة بالكتابة. كيف نتتبع أسباب تحولنا لأشخاص لا يشبهننا، أتذكر لماذا توقفت وعدت مرة أخرى للكتابة.
المثالية التي طمح إليها “نوبل” تدفعني إلى اكتئاب حاد، وقلق مرضي واجهته منذ ثلاثة أعوام، وكدت أن أفقد أنفاسي خوفاً من لحظة موت مفاجئ. بعد الحادث بعامين أحضرت “اللاب” يوم 14 يوليو 2021 وكتبت:
بأي طريقة تحبين الموت؟
كيف حكمت على كتابة “ن.” أنها رديئة، رغم أنني لم أقرأ روايتها جيداً؟
من السيء أن نحكم من منظور الغيرة وربما الجشع باعتقاد خاطئ أننا أفضل. كيف لم ألاحظ أنني لم أنضج، وأن كتابتي ركيكة؟
كيف أعيد الزمن للوراء وأحاول الإنصات جيدا؟
يقال أنّ لنا زوج من الآذان لنسمع أكثر مما نقول، إلا أننا نحب الثرثرة أكثر من الاستماع. فنحن نتحقق ونتصدر بؤرة الأحداث عندما نثرثر حتى وإن ادعى من حولنا بالاستماع فقلة قليلة تلك المنصتة، كنز لا نجده بسهولة في عالم يتسع فمه ليبتلع الوقت والفكرة. فكرة أصيلة عن الوجود وأصله تضيع في بئر من الخيالات المشوشة.
أعرف أن أيامي تتآكل في اللا شيء، وأخشى مما تكسبه يدي من شعور غير مبرر بعدم التحقق فأنا السبب في ذلك؛ كسلي وتخاذلي وعدم جديتي في التعبير عن نفسي بعمل جيد، ولكن لمن؟
ما الذي تملكه امرأة عادية في عالم يقدس الشاذ؟
لحظة خوفي من الموت المرضية، تخيل ما الذي خشيته حتى الموت؟
كيف سأقابل الله و”بوتوجاز” بيتي متسخ؟
شعرت بتقصير لا حد له تجاه الأوساخ المتناثرة فوقه؟
لم أفكر في الكتابة وما فاتني، فكرت فقط فيما أعتقد أنه واجبي وما سأحاسب عليه؟
تخيل هذا ما أفكر فيه.
هل تهتم جارتي المتجهمة “الجلياطة” بشكل مستفز، ومن حولها خمسة أطفال في قراءة كتاب مثلا؟ ما الذي تضيفه الروايات؟ بالنسبة لي تضيف حياة جديدة تعيش معي بالتوازي مع حياتي الصغيرة ولكني محاطة بعادية لا تغتفر أو هذا ما أتحجج به.
كيف تتحول اللحظات العادية إلى لحظات فريدة تشعرنا بالامتنان لأننا هنا نتنفس؟
سألني زوجي عمّا أريد الكتابة عنه، وهل هناك فكرة في رأسي؟
هل أحتاج فقط إلى الفضفضة، وهل هناك ما يمكننا مشاركته مع العالم، هل يحتاج العالم إلى قصة من قصصنا الخرقاء، فمن أين أبدأ تجربتي وفكرتي؟
“وبدأت أمزج بين تناقض الألم العائد للكتابة وبين نهاية شعوري بالاغتصاب والغيرة”ص43. “كانت الكتابة بمثابة طريقة لأن أنقذ ذاك الذي لم يكن واقعياً أبداً ” ص88.
اليوم الثالث:
“المكان”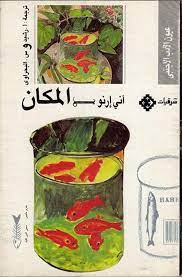
تتغلغل في عمق قلبي من دون استئذان رواية خاصة عن علاقة ابنة بأبيها، وأنا ابنة أبيها الذي رحل، وترك في قلبي حفرة فارغة لا يمكن ملئها.
اندمج من أول كلمة، ابتسم، أبكي، أحلم، وانتظر بشغف لأعرف كيف ستصف كل ما مررت به من فقد وحزن لا يمكن ترجمته أبدا، مهما كتبت ففي قلبي أكثر.
ألاحظ تماس ظروف أبيها العامل الكادح مع ظروف أبي الذي عمل وهو في عمر الثامنة. كم قاسى هذا الجيل الذي بذل دمه وعمره في عمل جاد مرهق، ولم يجد من يعلمه أو يرشده. ارشدتهم الحاجة وأصقلهم الشارع ولكن لم يأخذ إنسانيتهم او إصرارهم على تعليم أبنائهم وتجنيبهم ذلك الشقاء والبؤس الذي مارسته الدنيا عليهم.
كان أبي قليل الكلام، وهذا ما أضفى عليه نوعا ما من الحكمة والغموض، خصوصا أنه كان مهوسا بفكرة التعلم، وحريصا على تعليمي وإخوتي مهما كانت ظروفه المادية.
يجلب لنا كتب الأطفال والقصص والمجلات في طفولتنا بعكس كل أقراننا من أقاربنا اللذين نحتك بهم.
لولا إحساسه بأهمية القراءة وسعادته البالغة عندما كنت أشترك وأختي في مسابقات الإلقاء، نظرا لقوة صوتينا ومخارج حروف لغتنا السليمة، لولا تمسكي بأذيال هذا العالم الرحب، الذي تعلمت من خلاله كيفية التداوي بالكتابة، واكتشفت أثناء قراتي لأعمال “آني إرنو” لماذا أتسمم عند التوقف عنها.
فأنا أريد بقائي الشخصي بصمتي ولحظتي المميزة، ربما نوعا ما من النرجسية أو هو شعور إنساني منطقي نتشارك جميعا فيه، وكل منا يحاول فعله بطريقته الخاصة.
“أن تكون فلاحًا يعني أنك لست متطوراً، دائماً متأخرا عما يجري، في الملبس واللغة والمظهر ص47″. ” دخل أبي في فئة الناس البسطاء أو المتواضعين أو الناس الطيبين” ص52.
عمل أبي سائقا، ولكنه لم يكن سوقيًا أو فظًا أو بسيطًا. سلوكه غاية في التهذيب. وفر لي حياة إنسانية واجتماعية لا تليق بابنة سائق يعيش في منطقة عشوائية، لهذا وأنا أقرأ كلمات “إرنو” بعكسها، لا أشعر بالخجل الذي عايشته في سنوات مراهقتها، بل أشعر بفخر ومحبة خالصة.
اليوم الرابع:
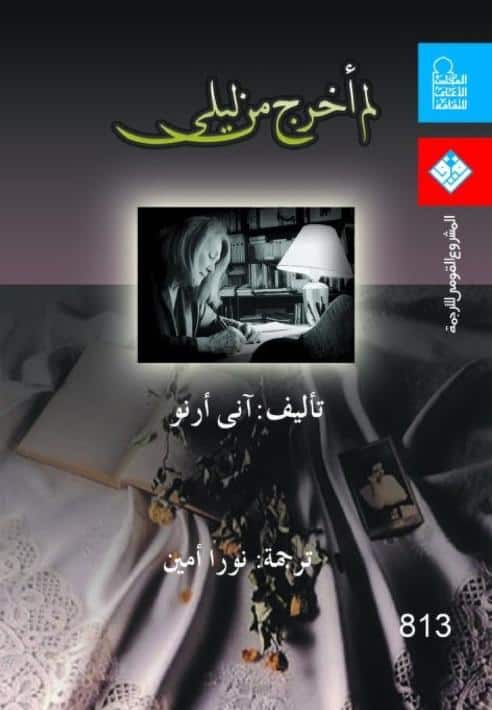
“لم أخرج من ليلى”
يبدأ الأطفال في بعثرة الأكل، وتوسيخ ملابسهم، أيديهم، وجوههم، ولا تشعر أبدا أغلب الأمهات بالاشمئزاز، بل ربما نغرق في كثير من الأحيان في نوبات ضحك هيستري على شكلهم. مثلاً: أخذت ابنتي وعندها عام ونصف علبة “النيسكويك” من فوق الرف وبعثرت مكونته عليّ وأنا غافية فوق الأريكة بملابس خروجي في انتظار حضور زوجي، وعلى وجهها وشعرها وملابسها النظيفة بعدما تحممت واستعدت هي أيضًا للخروج.
كان منظرنا يهلك من الضحك رغم ما عانيته في التنظيف إلا أن الموقف لا يستدعي بداخلي غير البهجة.
في حين أن وصف “آني إرنو” لوالدتها وهي ترتد بعقلها وسلوكها لنفس المرحلة من العمر تشعرني بالانقباض والخوف والرهبة من تلك الحالة… كتبت فيما مضى –جزء- من قصيدة بعنوان “ضل ف صورة”، في ديواني الأول “فركة كعب” المجلس الأعلى للثقافة سلسلة الكتاب الأول 2007:
أتوبيس هيعدي وفيه أحبابك
ريش متنطور ع الجنبين
مناديل متحوش فيها دموعك،
بإيدين بتهدهد قلبك طفل سعيد
وإيدين اتعازمت مين هيشيل الكهل الماشي في آخر الليل…
فنحن نستقبل متاعب الصغار بفرحة، ومهما تعبنا تبقى بداخلنا لمحة الأمل والمحبة لهذا الحضن الدافئ المفعم بالحياة وأوج تدفقها، بعكس الكهولة فهي تذكرني بالفناء، بالحمل الذي يسحبنا إلى الانكفاء في حفرة ضيقة، لهذا أشعر بألم “إرنو” فتلك الأبيات كتبتها عند ملاحظتي وقتها لجدتي ومقارنة مشاعري تجاهها وتجاه ابنة أختي الصغيرة.
كيف أمشط شعر الصغيرة وأغني وألعب معها من دون ملل، وأنفر من عبء تحميم جدتي وتسريح شعرها –وإن كنت لا أبين لها أي سخط- بدافع برجماتي بحت، فدائما كنت أذكّر نفسي بتلك المعضلة؛ ربما سأكون في نفس مكانها، كما كنت في مكان ابنة أختي يوما ما.
وربما لا يتعلق الأمر فقط بالتضاد ما بين الطفولة والشيخوخة، والأمل واليأس، والحياة والموت، ولكن يتعلق الأمر بقدر لا بأس به من العجز، كيف نوجّه من كانوا يوجّهوننا، ونتعامل معهم من فوق؟ كيف نتقبل تلك الرِدّة المرعبة لوعي وقدرة لا تتخطى وعي وقدرة طفل في جسد كبير متصلب؟
ربما كمن الخوف في العجز.
“إنها في مكانها مرة أخرى، مربوطة في كرسيها، متصلبة، تحاول النهوض من دون توقف… لا يمكنها أن تأكل وحدها، يدها اليمنى تبحث عن يدها اليسرى. أقول لنفسي فجأة: إن الاتجاه الذي يسير فيه العالم بعد عشرين أو خمسين عامًا لن يحتفظ فيه بمخلوقات مثل أمي على قيد الحياة.. ص56″.