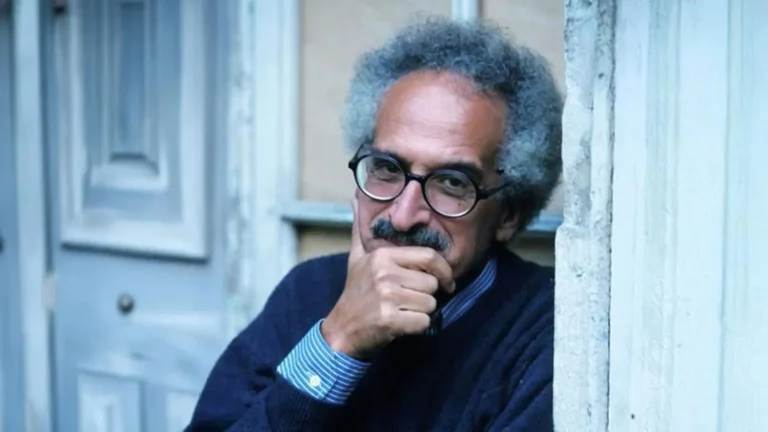أبدأ يومي بقهوة سوداء مرة، وأختتمه بمثلها، وما بين الاثنين، تتسرب الساعات، لاهثة، من بين يدي، بينما أحاول أن أنجز أعمالا، تبدأ بقراءة الصحف، ورقيا وإلكترونيا، والبريد الإلكتروني، وإعداد مادة لصفحة الكتب بالأهرام، أو مادة للترجمة، وتجهيز خطة صفحة المدونة بالطبعة العربية بالأهرام، ثم إنجاز أعمال الصياغة بمجلة البيت، وإنجاز مقابلة لصفحة من صفحات الأهرام الثقافية، أو قراءة كتاب يحتاج لعرض، أو موضوع لوكالة الأهرام للصحافة.
وبين هذا كله، ربما تصلني رسالة من الصديقة جمانة حداد لكتابة موضوع عاجل للنهار. فأبدأ في تجرع جرعات إضافية من القهوة، ومحاولة السيطرة على توتري، الذي تزداد حدته، تدريجيا، مع ما اتلقاه من اتصالات هاتفية من ناشرين، وأصدقاء، وزملاء، وأصحاب كتب يتأكدون من وصولها إلي، وموظفون بجهات ثقافية أجنبية يؤكدون مواعيد فعاليات وأشطة يدعونني للمشاركة فيها، أو لتغطيتها صحافيا.
أنشغل بالإيقاع اللاهث هذا عن الرهاب الذي يصيبني كلما قرأت خبرا عن ظاهرة فساد، أو اعتقال للمتظاهرين، أو واقعة من وقائع تعذيب المتهمين في السجون المصرية، أو العراقية، أو حتى في جوانتنامو على السواء.
في الشهور الأخيرة زادت حالة الرهاب، إلى نوع من جنون الارتياب، وأصبحت كل الأخبار المتعلقة بالسياسة، الدولية والمحلية، الفضائية والمقروءة، تزيد من إحساسي بهذا الرهاب، وهو ما دعا طبيبتي أن تطلب مني التوقف عن مطالعة الأخبار السياسية على وجه السرعة، فامتثلت؛ معلنا احتقاري التام لكل ألعاب السياسة؛ التي لأجلها نعيش في أوحال المهانة العربية التي نعيشها الآن وهنا. مكتفيا بقراءة صفحات الثقافة، ومتابعة الفضائيات؛ التي تبث الأفلام السينمائية والبرامج الترفيهية، بلا أدنى شعور بتأنيب الضمير، مستدعيا ساعات طويلة كنت أجلس خلالها أمام الفضائيات متنقلا من قناة لأخرى، على أمل، أن أشاهد أو أسمع خبرا، واحدا فقط، يرد لي روحي، أو يقلل إحساسي بانعدام الأمل وقلة الحيلة، بلا جدوى.
في ذروة الإحساس بحدود الوقت مقابل ما ينبغي إنجازه؛ أستدعي، فورا، صورة صديقي مصطفى ذكري، الذي قرر اعتزال كل شيء والتفرغ للكتابة، وسماع الموسيقى والقراءة، ومقاتلة الوقت، الذي يفيض عن احتياجاته، بلا رغبة في الخروج من المنزل، أو مواجهة الحياة بالشكل الذي نرتضيه، أنا وأمثالي من اللاهثين خلف أمور الحياة اليومية.
أتساءل: كم من الكتب المتراصة التي تنتظر الوقت المناسب للقراءة، يمكنني أن أقرأ، إذا ما تيسرت لي مثل تلك الرفاهية؟ وكم من مشروعات للكتابة، تتعطل بسبب ضيق الوقت سأتمكن من إنجازها. وكم من أفكار تحتاج بعض الوقت لتأملها ونقلها من ضباب الخيال، إلى واقع التلقي، لو توفرت لي ساعات إضافية أعبر عنها باحتياجي إلى أن يصبح اليوم 48 ساعة.
لكني، بعد دقائق قليلة من التمني، أرتطم، بحجر الوقت، ممثلا في رسالة على هاتفي، تتعجل موضوعا، أو اتصالا يذكرني بموعد عمل، أو بزوجتي؛ تذكرني بضرورة العودة مبكرا للذهاب بابنتنا، ليلى، إلى الطبيب، أو حتى، لحضور مناسبة اجتماعية لا يمكن الاعتذار عنها، فألملم نفسي، محتشدا، لإنجاز ما ينبغي إنجازه، مستدعيا طاقة التركيز بأقداح القهوة ودخان السجائر وأدوية الصداع بالتعاقب.
في أغلب أيام الأسبوع أعود إلى البيت لأجد زوجتي وابنتي نائمتان. أتأمل غفوتهما راضيا، شاكرا الأقدار على انتظام صوت تنفسهما، وملائكية ملامح صغيرتي، التي ربما كان رهابي هذا قلقا على غد، أتمنى أن يكون أفضل حالا لها من حالنا، وأقل مهانة.
وعلى صوت أنفاسهما الهاديء، أجلس في غرفة المعيشة لأقرأ قليلا، أو أستدعي فكرة من أفكار روايتي الجديدة، ما تيسر لي من جهد، وفي الثالثة صباحا، أجهز قهوتي الأخيرة، وأستمتع بها، مع سيجارتي الأخيرة، خاتمة ليوم عصيب، كنت أظنه لن ينقضي، ثم أطفيء الأنوار، على أمل أن يكون الشروق أول ما أبدأ به يوما آخر في دوامة التوتر، والانشغال المقنع في انتظار ما لا يأتي.