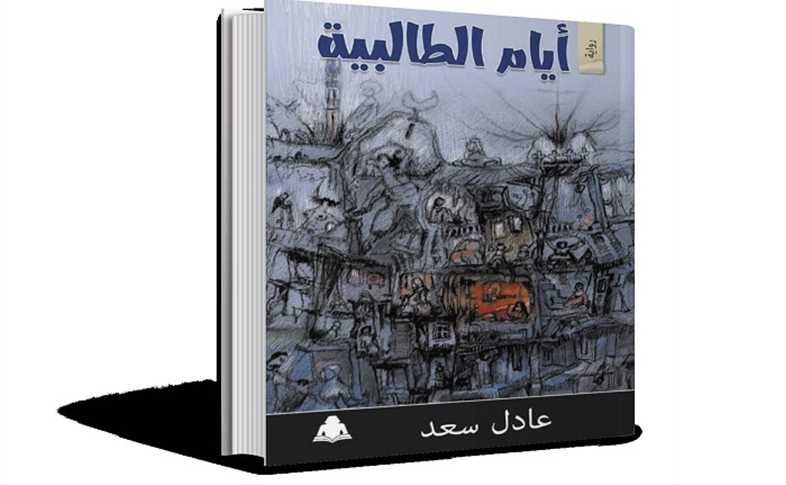شوقى عبد الحميد يحيي
على الرغم من أن روايتى الكاتب عادل سعد “الأسايطة”[1] ثم “ايام الطالبية”[2] تشيران إلى أن العمل سيتناول بالدرجة الأولى منطقة جغرافية محددة، الأمر الذى قد يتصور المتابع أن الكاتب قد غير وجهته عن الرواية الأولى “رمضان المسيحى”[3] والتى تشير إلى تجربة إنسانية، حيث خرج فيها عن الحدود الجغرافية للوطن، فتناولت خروج المصرى إلى العالم الخارجى، ترك فيها دينه، كى يستطيع المواءمة مع الحياة الجديد، إلا أن الوطن يسكن بداخل جلده، وليس بإمكانه التملص منه. لنجد أنفسنا فى النهاية أمام تجربة الإنسان، ذلك الذى سنجده أيضا فى الروايتين التاليتين، الأمر الذى يشير بالضرورة، أن الكاتب يحمل هم الإنسان، وليس الإنسان فى عمومه، وإنما الإنسان المصرى، ومعاناته أمام سلطة الدولة، الفارضة عليه كل أنواع القهر، عن طريق ذراعها الأمنى (الشرطة)، بما يمارسه من تسلط، غير خاضع لقانون معين، غير قانونه الخاص. ذلك الذى تجلى بصورة مباشرة، فى خروج الجماهير، لتعلن عن رفضها، وانفجار غضبها فى يوم عيد الشرطة، فى الخامس والعشرين من يناير.ذلك الذى يمكن إعتباره هو جوهر رواية “أيام الطالبية” للمبدع المتنكر فى صورة الصحفى “عادل سعد”. والذى إذا كان فى أولى رواياته “رمضان المسحيى” قد جعل من العالم الخرجى، بإتساع أفقه، مسرحا لتحريك شخوصه، فقد انتقل إلى المكان الأقل إتساعا فى “الأسايطة” حيث كان المسرح، ليس صعيد مصر بأكمله، وإنما تخير محافظة واحدة، هى بؤرة الدوامة التى دخلتها مصر منذ العام 1952. وفى روايته الأحدث “أيام الطالبية” ضاقت المساحة الجغرافية أكثر، لكن الرؤية إتسعت – كما هى العادة فى الروايتين السابقتين- لتشمل هم الوطن بأكمله. وكأننا نتمثل مقولة النفرى” كلما إتسعت الرؤية ضاقت العبارة، “.
كما يشير ملمح آخر، إلى تلك الكنية التى أشرنا بها إلي عادل سعد –المبدع-، هو أننا سنلحظ تطورا، ليس فى لغة السرد فقط، وإنما الشكل الذى قد نعتبره هو المضمون فى “أيام الطالبية”. فإذا كان السرد قد سار فى الروايتين السابقتين، سيرا متصاعدا- حتى لو لم يشمل قصة واحدة، بما يمكن القول بأنه الإسلوب السلس. إلا انه فى هذه الرواية الأحدث، جاء الإسلوب أقرب لتيار الوعى، الذى ساد كثيرا فترة ما بعد 67، نظرا للضباب الذى غلف الرؤى حول المشهد حينها. وحيث إختار مسرح عملياته فى هذه الرواية، منطقة يصعب فيها التمميز، أو التقسيم، فلا تستطيع أن تحدد فيها غنى عن فقير، متعلم أو جاهل، ولكن ناسها تجمعوا جمعيا، فى مخرطة واحدة، لتخرج مزيجا ، يشبه حى الطالبية الشعبى. فضلا عن أن هذا الإسلوب. جعل المنطقة منفتحه على كل التيارات، وكأنه السجن، أو المعتقل، والتيارات الدينية المختلفة، والرؤى السياسية المتنوعة. كما شهدت خروج الكثيرين من أبنائها، إما إلى السجن، وإما إلى الصحافة، وإما إلى الجامعة، أساتذة أو طلبة. ومنها تخرج الأعمال الخيرية والمشروعات المجيدة، ومنها تخرج البنات والنساء اللائى لم يجدن شيئا يبعنه غير الجسد. فتأرجح الإسلوب بين الداخل والخارج، دون مقدمات أو دون فواصل. فبينما الحديث يدور داخل الطلبية، نجد أنفسنا وسط المعتقل والسجون وناسها، سواء المعتقلين، أو القائمين عليه. وكأن الطالبية تم فتح حدودها لتشتبك معها، أو أن السجون والمعتقلات، ما هى إلا حجرة فى بيت واسع يسمى الطالبية، فتماهى المكان، مثلما خبا وتماهى الزمان، فى كثير من الأحيان، حيث تعيش شخصياته، بين الواقع المعيش، وبين الذكريات، التى تجعل من الماضى .. حاضرا، ومؤثرا. ثم نجد الإسلوب تحول إلى السرد المتتابع والمنطقى، عند الحديث عن ثورة يناير، وما حدث بالميدان، ، وكأننا وصلنا إلى بر الأمان، ووضحت الرؤية، فاستقام الإسلوب، ووضعنا أقدامنا على الأرض.
لمحة أخرى – وأظنها متعمدة من الكاتب- وهى بداية الرواية بثلاثة فصول معنونة، وبأسماء شخصيات ثلاثة، ثم انفتحت الرواية بعد ذلك ، وتاهت الفواصل، وكأنها فصل واحد. وقد يفهم ذلك على الذوبان فى المجموع، فالمجموع كتلة واحدة. وربما أن الكاتب أراد أن يحدد لنا تلك الشخوص الأساسية فى العمل، وهم:نادية – صديق – زينات. وإن كان قد منح المرأة ثلثى التقسيمة، فعلى دورهن المثمر فى مسيرة الحى، ودورهن فى تسيير الحياة، حيث اختفى الرجال، إما فى أقسام البوليص، أو فى المعتقلات، أو فى المعارك، فضلا عن دور المرأة، غير المنكور، فى ثورة الخامس والعشرين من يناير، فأراد الكاتب أن يعطى المرأة ما تستحق ، وأن تخرج من تلك الصورة التى كانت عليها{البيت ثلاثة أدوار لكنه ضيق على كل هذا الزحام، والأنجال تسابقوا على إنجاب الرجال، والإناث يتظاهرن بأنهن بدون نهود، يرغبن فى أعماقهن أن يكنّ ذكورا. للرجال الحشيش والقذف والجنون وليس أمامهن سوى الكنس والمسح ونيل الصفعات}ص180. وبعد ذلك الفصل الذى طال، استعرض فيها الكاتب مراحل الثورة- كما سنبين- وحتى تكتمل حبكة الرواية- وهو ملمح آخر لاختلاف هذه عن تلك – نعود فى النهاية لنقرأ الفصل الرابع “عوض” ليعود بنا إلى الطالبية مرة أخرى، ولنكتشف أن حالها لم يتغير. فيلعب الشكل هنا دور المضمون، الذى يرى فى الثورة، وكأنها حلم، مر، ولنستيقظ على الواقع لنجده كما هو. إن لم يكن للأسوأ، وأن كل ما مر لم يكن سوى حلم . فكان هذا الفصل –الرابع- هو قرار الجواب، وفق الحركات الموسيقىة.
وملمح آخر تميزت به “أيام الطالبية” عن سابقتيها، وهى سيادة اللغة الشاعرية، باستخدام الكنايات، وهى اللغة التى تضيق فيها العبارة، وتتسع الرؤية. والأمثلة على ذلك كثيرة. منها على سبيل المثال:
{نام معها .. وصحا وحيدا مبلولا.. وكان لا ينتظر أن تسقط أرغفة السماء}ص44.
كناية عن أنه حلم بمن كانت معه، لأنها بعيدة المنال، ولا يملك الاقتراب منها. فلم يكن أمامه إلا الحلم لأنه يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة.
{كانت تضربه ليشرب اللبن ويضحك، ضربته كثيرا ولم يضربها أبدا فى أول مخالفة لشيوخ الإسلام}ص50. لتفتح آفاقا لأحاديث الشيوخ عن ضرب الزوجة، وكيفية ضربها، وكأنه واجب مقدس.
{ كان الليل المتعجلء إلى غد يجرى صامتا، وبعض الكلاب تنبح مختفية فى الظلام}ص93.
ففضلا عن الصورة الشاعريىة فى سير الليل متسارعا، فى الوقت الذى يخاف فيه المرء من الغد. فيسرى لديه الإحساس بسرعة الجريات، بينما هو يسألأه التأخير. فلتفتح الجملة الأخيرة الرؤية حول ماهية الكلاب، والتى يقصد بها هنا أناس ينهشون لحم الإنسان، وكأنهم الكلاب المسعورة، أو المدربة، حيث كان الحديث عن الوجود ذاخل السجن، وللكلاب، الحيوانية والبشرية، دور فيها.
(كانا بلا أسماء.. سجينان فى حفرة تموت لو سكنتها البهائم}ص49.
{خاضت طريقها وسط نسوان يملأن العبايات السوداء}ص85.
{فى قاعة الاحتفال عروس لا تنزل من على حسنها العيون}ص117. وغير ذلك كثير.
المهم أن الروايات الثلاث، معجونة فى تراب التجمعات الشعبية، بلغة ناسها، وطباعهم، وتصرفاتهم. حتى ليشعر القارئ بأن الكاتب ينقل من واقع الطبيعة الضيق، ليتسع بها إلى عالم الوطن، وهمومه.
ففى “أيام الطالبية” –التى تمنيت لو أسماها “ليالى الطالبية” حيث كان الليل فيها أطول من النهار، وحيث ترسخ فى ذهن القارئ أن “أيام” تعنى النهار، حتى لو كان “اليوم” يشمل اللي والنهار. [ وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة][4]. فكل ما سردته الرواية يمكن أن نطلق عليه “ليل” مع استثناء بارقة النهار، فى إنشاء الحضانة والحديقة.
وهنا نشعر وكأن الكاتب حمل الكاميرا ليصور فيلما عن أوضاع تلك المنطقة، التى تكتظ بالناس من كل الأشكال والألوان، الأمر الذى معه يُنظر إليها على أنها منطقة عشوائية، لتقودنا فى النهاية إلى أن مثل هذه الأحياء، وما يعيشونه، وتعامل الدولة معهم، هم مفجرى الثورة، وهم وقودها.
يأخذ الكاتب مشهد خارجي لمنطقة الطالبية، وكأنه يلقى نظرة عامة للموقع، قبل الدخول إلى التفاصيل: {كانت السماء تمطر منذ يومين لكنها توقفت، وبقيت الأوحال فى عرض الطريق……سائق ميكروباص يسب الدين، ودراجات وصاجات فوق الرؤوس وفلاحات وأفندية وشيوخ وعجائز وتراب وأرصفة تهدمت ومحال أحذية وملابس مستعملة ولعب أطفال وجنون بيع مخدرات وموز وبرشام وفريك أخضر وبيض}ص85. فكأننا أمام فرقة موسيقية “تدوزن” أوتار آلاتها، فتتداخل الأصوات، لنعلم أنهم يستعدون لبداية العزف. فيبدأ الانتباه، والتعبير عن ذلك التكدس العشوائى، والتحذير {لو كنتَ من سكان الطلبية لا تتغيب كثيرا، لو رجعت بعد شهر أو شهرين ستصدم بأن مائة من معارفك قد ماتوا، ومائتين راحوا المستشفى، وعشرات قد اختفوا، الموت هنا وهناك واحد، لكن الزحام يزيد احتمالات الكوارث. أهلا بك وسط هذا العجين من البشر}ص137.
ثم تتحرك الكاميرا لتصوير مشهد داخلى، حيث نتعرف على معيشة ناس الطالبية: { مات صديق وانفتح بطن غرفته عاريا من الأثاث. مراتب سرير يبست كالحجر ومخدات كالحة اللون. على الجدران صور فاتنات وعلى كتف السرير ينام نهد جرئ لحسناء. تراجعت لمياء باكية وهم يلفلفون هلاهيل تعلقت على مسامير بالجدران وبقايا السجائر وصينية صدئة وأكواب الشاى وموقد الكيروسين}ص82. ثم نتعرف على أحوال ناس الطالبية وكيف هى حياتهم، وممارستهم لها، بين السرقة والبلطجة، وتجارة الحشيش، وتجارة الجسد. إلا أنه رغم هذا البؤس، وتلك الحياة، وفى غياب الدولة عن دورها، تُضاء شمعة، فيتولى مجموعة من نسوة الطالبية، وبناتها، فى استئجار شقة لٌاقامة دار حضانة، وتنظيف الخرابة أمام المبنى، ليقام بها حديقة وملهى لأطفال الحضانة، وبكل نفس راضية أعلنت زينات عن تمويل المشروع، الذى مطلوب لإنجازه 30 ألف جنيه، كانت قد جمعتها من بيع جسدها للحوت، بعد أن لم تجد غيره تبيعه، وقد دخل زوجها السجن، فذهبت إليه تستجديه أن يطلقها، لكنه يرفض { طلقنى يا فتحى… طلقنى… أنا بحبك … وإنت عارف.. طلقنى أنا فى عرضك… يا ريت عندى بضاعة أبيها غير نفسى.. سامحنى.. أنا مش قادرة أكون لراجل .. وأنا مراتك}ص21. وهو ما يتسسب فى إصابتها بالألم الداخلى، والانفصال عن ذلك الجسد المهان {هذا البدن المُهان، تحمله وتعيش بداخله. مطرقة الحوت الأعرج تهزها من ساعات هروب نومها. تستيقظ مختنقة من جسمها العائد للنوم معها على السرير}ص130.
ووسط دهشة ورفض أم مارى، التى عارضت ابنتها “إنجيل” حين عرضت عليها الفكرة، لضيق ذات اليد، تتطوع زينات بالمبلغ. غير أن عصابات الطالبية، تهمهم الخرابة، حيث يمارسون فيها، ومنها مخالفاتهم المعهودة، فيسعون لإيقاف المشروع، أمام عجز النساء فى مواجهة (البلطجة)، غير أن صوت الطفلة يفعل، ما لم يستطعن فعله {“بابا .. بابا” هتفت “أحلاهم” عند رؤية المجرى، لكنه لم يلتفت.. ولوح بالنبوت وضرب غرس شجرة بقدمه فاقتلعها وخلع بابا بكتفه، فانهار وتوقف الأولاد والبنات وانكمشت زينات. معه ثلاثة من الأعوان، وعلا الصراخ وارتد الطلاب خائفين للداخل. انهارت أحلاهم وعلا صوتها بالبنشيج. صبيان المعلم بدءوا فى تدمير المكان، وقامت أحلام من مكانها، وتوقفوا عند رؤيتها مترددين واصطدمت عيناها بالمجرى. وهرولت أحلاهم تحتضن أقدام أبيها ، وصاحت: “لايا بابا.. لأ يا باباب” فأوقفهم وانصرف غاضبا}ص70. فنجدنا أمام لحظة نفسية، تغلبت فيها العاطفة على الشر، ولتقول أن هؤلاء ليسوا شرا صرفا، وإنما هم مدفوعين للشر. فينتصر النور على الظلام، ويتكاتف كل من يحمل بصيصا من نور مع المشروع، ف{مطبوعات حضانة حمادة ومارى وحديقة أحلام توزعها الكنيسة، وهتف الراعى داعيا الرب بالمباركة والشعب بالمشاركة. وطاف حمادة وأصحاب المدرسة دانيال والقط وصابر بالأوراق على بيوت الطلبة}ص73.
و{جاء الحاج عبد الله مهنئا بالأحفاد، وتوافدت الأمهات لمعاينة المكان بعد زيارات حمادة وأصدقائه للبيوت بالصور وأوراق الدعاية. أحلاهم وأحفاد الحاج عبد الله أو التلاميذ، ورحبت زينات بالصغيرة نسمة ابنة زعيم أولاد على مع أمها عندما دخلت من الباب.. مع بداية أغسطس كان العدد لا يقل عن أربعين وعند نهايته كان بالحضانة مائة وخمسين}ص75.
وسط هذا الفرح والنجاح، كانت، من كانت السبب فى إقامته، غائبة عن الوجود، يعتصرها الألم والمرارة، لإضطرارها أن تفعل ما لم تكن تريده {وقعدت رئيسة الحسابات مارى تضبط الإيرادات والمصروفات، وبدأت أم مارى تبتسم وهى مجهدة، ولكنها تراقب فى صمت لأن زينات غائبة عن الوجود. اغتصبها الحوت الأعرج آخر مرة فى أماكن لا تليق. كانت تُغمض عينيها لتتركه يفعل ما يريد حتى لا تراه، لكنه آلمها بشدة وبكت، وقالت إنها لن تعود.. فثار وغضب وهددها}ص76.
ثم يبدأ الاشتباك مع السجن. فنرى كيف الطريق إليه، حيث كان فتحى {معتقلا بلا قضية، ولا يعرف لما يجرى نهاية}ص59.وحيث يتم خطف نسمة.. وصديقتها أحلاهم تقود الرجال لمعرفة طريق البنت المخطوفة: {على حافة الموت فى ركن بغرفة منعزلة رفّت عين نسمة، كانت مقيدة اليدين والرجلين بإحكام ويسد فمها خرقة، وابتسمت لرؤية صديقتها ……. حمدان كان هيموتنى بكره يا بابا.. وحملها المجرى مهرولا للمستشفى}ص86. (قبل ذهابها للمستشفى هتفت باسم حمدان، هذا الشقى الذى رباه أبوه على صغيرا كان يقتل ابنته، لتعود المعارك مع المجرى وتزداد أهميته}ص87، وبالطبع سوف تنتهى هذه المعارك، وهذه الحوادث لقسم الشرطة، أو المعتقل، والذى فيه نتعرف أنواعا غير مسبوقة من التعذيب ، فنرى{فتحى ينحنى بالقرب من القدر وهو ما زال يتقيأ، فتحوا بلعومه وذراعيه، وبدأ اثنان من العساكر يقذفون بالعدس داخل فمه ليشرب.غرقت سترته ورقبته، وهو مصلوب مفتوح الفم. راحت الدنيا، واختنق، لكن العدس لم يتوقف. لم يعد يشعر بحريق على صدره. لم يعد يشعر، ولم يعد يرى أحدا}ص51.
ومن داخل السجن نتعرف على المزيد مما يحدث بين الفاصائل المتباينة. حيث يضم اليمين واليسار، وتطول فتراته، حتى يرى من به أن علاقتهم بالحياة قد انتهت، فلا مخرج منه. فحين يتمنى “نادر” الموت، يأسا أو راحة مما يواجهه، يقول “فتحى { وهناك كانت عيون المساجين تتغذى على القادم الجديد .. نادر الشيوعى.. نحن نخاف ممن يصمت، وهذا الذى لا يقول شيئا}. ثم يهتف {أنا كافر.. ألا يوجد فيكم مؤمن واحد ليقتلنى؟}. ( وقال فتحى لنادر الشيوعى فى قنوط: تريد أن تموت .. لا تتعب نفسك .. مطلبك تحقق .. نحن لم نعد أحياء}ص96. حيث تتكشف حقيقة ما بالداخل، ومن هم من يدخلون هذه السجون{ أسوأ ما فى المعتقلات أنها أيام بلا ملامح، أيام لا يمكن اختراق ظلامها}ص97.
ويدور الحوار:{منذ متى وأنت هنا؟
لا أعرف … نحن فقط نعرف الذين نجوا وعاشوا وحتى هؤلاء موتى لا يعرفون أنهم ماتوا.
وأنت، سأله فتحى
أنا وكيل وزارة الزراعة.. منعت فاسدا من سرقة الأراضى والاختلاسات، تحولت للتحقيق واُعتقلت قبل أن أتقدم بقضية جنائية بيوم واحد.
وكيف عرفوا؟
تسألنى أنا؟!
نصف شعبنا مخبرين والنصف الآخر تحت المراقبة}ص98.
وحيث جمع المعتقل كل من اليمين واليسار، فكان حتما أن يدور الحوار الكاشف عن حقيق المتأسلمين {يا ابنى أنتم طول عمركم بشتغلوا عند الأمريكان. مع السادات ضربتم الناصريين والشيوعيين وقتلتوهم لعيون أمريكا، وفى أفغانستان حاربتم روسيا، لأنها تحتل بلاد الإسلام فلما خرجت واحتلتها أمريكا اختلفتم على الجهاد. أكبر بلد معجب بيكم أمريكا}ص105.
فيرد المتأسلم{يقولون ما نفعله الإرهاب، ونحن نفتخر لأن ديننا أمرنا بأن نرهبهم}ص109. – استشهادا بالآية [وأعدو لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تُرهبون به عدو الله وعدوكمِ][5]-
صاح نادر:”لو كان رسولكم محمد فى قيد الحياة لعلقكم على أعواد المشانق.. تقتلون الناس بدون ذنب.. وأنتم تعملون عند الأمريكان؟”}ص110.
وما كان يدور فى حجز القسم، باهون مما يدور فى المعتقلات،، وكأنها حطب جديد يضاف إلى الموقد ليزداد اشتعالا: {عند المساء حضرت زينب ملهوفة. الشرطة اختطفت صابر من الشارع ، جاءت مارى واتصلت برئيس قسم الحوادث بالجريدة، بعد ساعة ونصف كانت مع زميلها فى مكتب نائب المأمور وخرج ناصر. عيناه مليئتان بالصديد ووجهه متعب. الحجز داخل القسم مائة وخمسون من المجرمين والأبرياء ، فى غرفة خانقة بلا تهوية منذ شهور مع صفائح للتبول والتبرز والتدخين والعرق}172. ولكى تزداد النيران وهجها، يطلعنا الكاتب على ما يكون من أمر القائمين على تلك المعتقلات، وذلك الحجز، وكأنه يرينا الوجه الآخر للمشهد: {هناك الضابط الشلقانى يلقى بالعظم من الشباك. وبدأت الكلاب تتجمع. امتلأ شبعا وبدأ يرمى قطع دجاج كاملة}ص87. فما لا يطوله ناس الطالبية، يرمى به –كفائض- للكلاب. وكان حتما أن يتم التحول، وكأنه الانفصال عن الذات. حيث بدأت زينات نسيان فتحى ف{لم يعد فتحى ينام معها عندما ترقد تحت أنفاس الحوت،ولم يعد معها أحد ولا حتى ذلك الجاثم فوقها}ص132. وكأنها فقدت إنسانيتها، وتحولت إلى ماكينة، لا تحس ولا تشعر.
ويتضافر الداخل مع الخارج، فلم يكن ما يحدث فى قاع المجتمع، المتمثل فى الطالبية، ولا ما يحدث فى السجون والمعتقلات، وحجرة الحجز بأقسام البوليس، وما يأتى به الكثير من المهيمنين عليها، بكاف لتشتعل الثورة، فقد كان ما يحدث خارج هذا النطاق، مثلما حدث مع وكيل وزارة الزراعة، كان هناك من يمثل الفساد، الغائب عنه أعين الشرطة، حتى داخل الجامعة {جربت “مارى” أن تخرج مع بنات الأغنياء. سلوى تبين أنها تزوجت فى السر منذ سنوات. افتض بكارتها زميلا، ولما صارحت أمه بما حدث أجبرته على الزواج منها. لكن كليهما لم يتحمل الآخر وشعر بالسأم. وأسعدهما الطلاق، لم تعرف أسرتها بزواجها ولا بطلاقها. ولا بأنها تنام مع الرجل مقابل خمسة آلاف جنيه، لم تكن أبدا فقيرة، لكنها تردد فى تلذذ إنها تنتقم من صنف الرجال. هاجمتها ريرى عندما قالت ذلك ضاحكة:”تنتقمين.. وماذا فعل هؤلاء المساكين؟ حتى حكايتك عن زميلنا محسن أشك فى روايتها.. هو لم يفتض بكارتك.. وأعتقد ما حدث كان العكس، وأنه كان حصورا بتولا قبل أن يعرفك}ص161.
وهو ما أقنع مارى بضرورة العودة إلى القاعدة، إلى “الطالبية”، حيث تجد فيها الآمن والسلامة:
{عندها حق من الصعب الابتعاد عن الطالبية. والضحك من القلب مع حمادة وفاطمة. والاصطباح بالوجوه الصافية لأم مارى وزينات}ص163.
وليتحول كل ذلك إلى الخرسانة التى صبها الكاتب، لينصب عليها صاروخه المنطلق فى الخامس والعشرين من يناير، فكانت الثورة حتمية. وقد استخرج – الكاتب- تلك الثورة من تلك القاعدة، وكأن الضوء يتسلل رويدا رويدا من عتمة الظلام، ليحين آذان الفجر، وبزوغ الأمل.
ولا يملك القارئ إلا أن يضع كلمات الرواية فى سياقها، فهى أكثر تعبيرا عن تلك المراحل، التى تتدرج مع خطواتها، من الفرحة والأمل، إلى الخيبة والخسران.
فيمهد الكاتب للثورة بمشهد من السجون: {لقد أذلونى بطرق لم أستطع تحملها.. لم يعد العالم سوى السجن الممر المظلم والسور الذى يحدد نهاية العالم والزنازين الخانقة والقضبان}ص186.
وعلى الجبهة الداخلية، من الطالبية”، حيث كانت زينات {منذ الصغر كانت وحيدة، تركها والدها وهى قطعة لحم صغيرة فتولت أمها تربيتها برغم الفقر والظروف. لم تتذكر طفولة سعيدة ، تتذكر فقط ذلها وذلك المصباح الوحيد وهى تخيط الملابس ليلة وراء ليلة. كانت وحيدة . والظل هو رفيقها الوحيد كان الكلام قد نفد ولم يعد فى فمها شئ}187.
ثم بزوغ الأمل من وراء الغيب و{خلف صف البيوت تسمع صوت اليمام. وكانت مشتاقة لرؤية النهر والماء. والسماء مرسومة على سقفه}ص187.
ثم البشارة { اختفت الأبواب وحمادة يدخل مندفعا: “” الثورة .. الثورة…يا مصر}ص188.
ثم تبدأ الثورة بالميدان:{انعزل –دانيال- بعد المدرسة طويلا فى ركن المسيحيين. لكن مع الثورة خرج بدون انتظار لإذن آباء الكنيسة. يرافقه الإنجيل ويقف على رءوس المسلمين ليحرسها عند الصلاة .. تبدلت الفصول وصار الشتاء ربيعا.. يومها وسط الزحام صرخ حمادة عند رؤيته”دانيال” واحتضن كلاهما الآخر}ص189.
وبدأت الحشود:{لوحات لبشر وحشود الملايين. انسدت الشوارع الجانبية بالأمواج. من كل صوب لتصب داخل نهر لن يجف أبدأ}ص193. {كانت الثورة قد استوت وكأنها سفينة نوح، ولا أحد يعرف من أين جاء كل هذا الطوفان}ص194.
وكانت الثورة هى نقطة الماء، بعد طول العطش، لناس الطالبية: {كانت زينات تقف مذهولة ودموعها تتسرب على ناصية الميدان. لهيب على وجهها تطفئه الدموع والأناشيد وصوت الهتاف “عيش .. حرية..عدالة إجتماعية” تناولت من مارى جرعة ماء}ص196.
وتدور النقاشات داخل الميدان فقالت ليلى{لا حل يا مارى إلا ببناء أحزاب قوية ليدافع من خلالها الناس عن أنفسهم ويراقبوا الحاكم”}ص191. وصاحت هند الصباغ صديقة مارى:{إنها عجائب.. نحن منذ ستين عاما نعيش داخل حكومات تحارب الإرهاب وترعاه}ص192.
وكأن الثورة، ثورة على كل الأوضاع المرفوضة، ويأتى فى مقدمتها الإعلام المضلل: {ولوحت مارى من بعيد للصحفية تحت التدريب جميلة الأشرف. صحفية تحت التمرين، وواحدة من شباب خريجى الإعلام الذين تسأل أحدهم عن تخصصه، فيرفع رأسه فى إعتزاز قائلا: “صحفى ميدان”. قالت لدانيال: ” هؤلاء فخر إعلامنا المختبئ خلف المكاتب المكيفة وأعمدة المصالح المصبوبة الجاهزة، ولم يعد العمل بالنسبة لهم مجرد صحافة بل .. قضية}ص196.
وتسفر الثورة عن الفوضى: {لم تعد هناك شرطة مرافق بل حكام للشوارع، ولكل ميدان كبير، ولكل رصيف إدارة. والبلاطة ب120 قرشا يوميا و10 جنيهات لكل 8 بلاطات، رئيس جمهورية وسط البلد كتيبة جيش من المجرمين}ص212.
ثم بدأت المحاكمات، وكأنها بداية الخوف والترقب، وبداية التوجس فيما حدث، وما يمكن أن يحدث. فتقول ليلى الوكيل: {أولاد الرئيس حكمت عليهم المحكمة بسرقة أموال البورصة. لكنهم وفقا لقانون التصالح أقروا بما فعلوا وسددوا الجنيهات وخرجوا براءة.. هل هناك قانون مثل هذا فى العالم؟}.
ويبدأ اليأس يتسرب للنفوس من جديد { الحوت أمضى شهورا دون قدرة على النوم متواصلة، وكل يوم قضايا تكفى واحدة منها لإعدامه لكنه خرج براءة. سيطارده الناس، وستتكاثر الأدلة الواضحة لاتهامه، ولكن لن يكون بإمكان أحد أن يُثبت عليه أى شئ}ص227.
وتنتهى الثورة حيث نعود إلى المعتقل من جديد مع “فتحى” وقد وصل حد اليأس، وفقد الأمل فى الخروج، وكأنه ممثل الإنسان المصرى فى مواجهة الثورة، قبلها وبعدها، فانطلق لسانه:
{ الدودة فى أصل الشجرة، والمقهورون لا يستطيعون أن يصنعوا نصرا ولا حتى أن يحلموا به.. مصر تطلقت بالثلاثة من حكم العسكر. يلزمها محلل. وابن العياط تحالف معهم”… وقتها وصل الموت إلى الزنزانة بخطوات ثابتة}ص225. حيث تم قتل فتحى، دون أن يعرف أحد من قتله، أو لماذا قتله، وكأننا أمام عملية القنص التى شاعت فى الميدان، على الثائرين{كان فى السجن من يصنع الموت}ص230. وكان بالميدان من يصنع الموت، ويخرق العيون، ويصنع العاهات. فخلفت شعبا، مات، حتى لو كان يتنفس.
وتعود الطالبية إلى حيث كانت، وكأن شيئا لم يحدث، سوى قتل وإصابة الثوار، فيعود أهل الطالبية منكسى الرؤوس{زينات نظرت خلفها وواصلت سيرها للأمام، كانت البيوت هناك تطفو والأضواء تتماوج آخر الليل فى بحر الأيام. وأم مارى.. راحت الكنيسة وبكت وطلبت من الآباء أن يصلوا لأجلها. أخذتها مع مارى من يدها فى أول أيام الثورة. كان العالم كله يمتد تحت قدميها، ويومها كانت الناس بلا أسماء كأنهم ملائكة. ويكلم الناس أنفسهم:
لماذا يثور الناس؟
لأنهم أغبياء
إنهم فى بلد مدين ولا يجد ما يأكل ومن أجلكم كان الرئيس يتسول}ص226.
و{حماده شبه الغائب عن الوعى على سريره يبكى. مات من مات وسُجن من سُجن.. وهل عُوقب أحد غير الثوار… المجتمع أخفق فى وضع الدولة فى موضع المساءلة، ولهذا أضحى فريسة لها ونحن نعيش تحت وصاية كاملة}ص232.
وأُخذ دانيال إلى السجن، عامين، للتظاهر بدون تصريح.{لغة الكلاب لم تتغير كثيرا، نفس النباح وهز الذيل ورفع الأرجل للتبول ابتهاجا برؤية الأسياد}ص237.
وكان حتما أن يتدخل الكاتب، كواحد من أبناء الشعب الذى خبا أمله، ليعلن يأسه، بالمنطق والتاريخ، فيعرض حياة رجب الأعرج، ذلك المعمر، الكاشف فى مسيرته، مسيرة الثورات {من المرجح- لأن رجب يحمل بطاقة مزورة- كان ذلك فى العام 1923 وبمجرد أن خرج بدأت إرهاصات ثورة 1919 تشتد، ولما تورط فى الزواج فى 1952 حدث انقلاب حركة الجيش، ومع استمرار قفزه على امرأته وصراخها من محاولات فض بكارتها انقلب الانقلاب إلى ثورة يوليو، وأنجب أولاده الثمانية ما بين ثورة يوليو وثورة التصحيح وثورة الجياع فى 1971، وجاء أولاده مثل كل الثورات يصعب الاعتماد عليها .. رجب لا يعرف اسم رئيس الجمهورية، ويحافظ على صحته يتعاطى الحشيش، ولذلك عاش وعمر حتى ثورة 25 يناير المجيدة}ص215.
ولنصل، لا إلى محاكمة الثورة ومن قام عليها، وإنما إلى محاكمة التاريخ يهتف دانيال غاضبا:
{ هل هناك من يخبر هيكل بما فعل فى مصر فى 1967؟}ص197. وكأننا أمام نكسة جديدة، فكلاهما عاش الناس الأمل والفرح فى البداية، وفى النهاية، كان اليأس والحزن والبكاء.
وبعد أن هدأت النفوس واستقر الوضع على ما هو عليه، بعد ثورة من أنبل الثورات العربية، والتى تشبه في مسيرتها الثورة الأم، ثورة 1919 فى زحف جميع طوائفها، الرجال والنساء، مسيحيين ومسلمين، متناسين المصالح الشخصية، ليرتفع صوت الوطن فوق كل صوت، تأملها عادل سعد، بموضوعية، وبتأمل، فى معزوفته الروائية البديعة “أيام الطالبية”، ليسترجع مسيرتها، أسبابها ونتائجها، ليصبح العمل سجلا تاريخيا، واقعيا، يحمل من الواقع أكثر مما يحمل من الخيال. عله يكون درسا للمستقبل، لا يخلو من المتعة، لما إتكأت عليه من صيغ شاعرية، تطرب لها النفس، فيقرأ القارئ، وكأنه يسمع… لا يزال… ذلك الصوت الصارخ “عيش .. حرية .. عدالة إجتماعية”.
……………………………………………………
[1] – عادل سعد – الأسايطة – روافد للنشر 2018.
[2] – عادل سعد – أيام الطالبية – الهيئة المصرية العامة للكتاب ط1 2021.
[3] – عادل سعد – رمضان المسيحى- روايات الهلال – 2015.
[4] – سورة الإسراء – الآية 12.
[5] – سورة الأنفال. الآية 60.