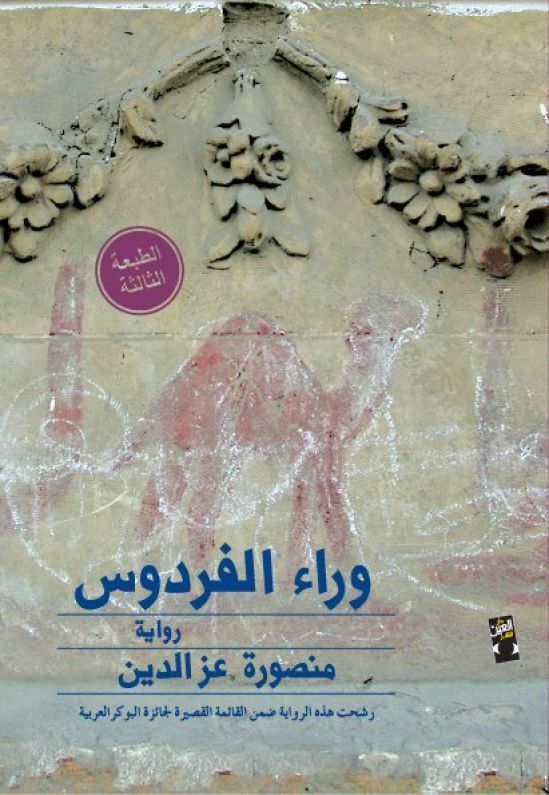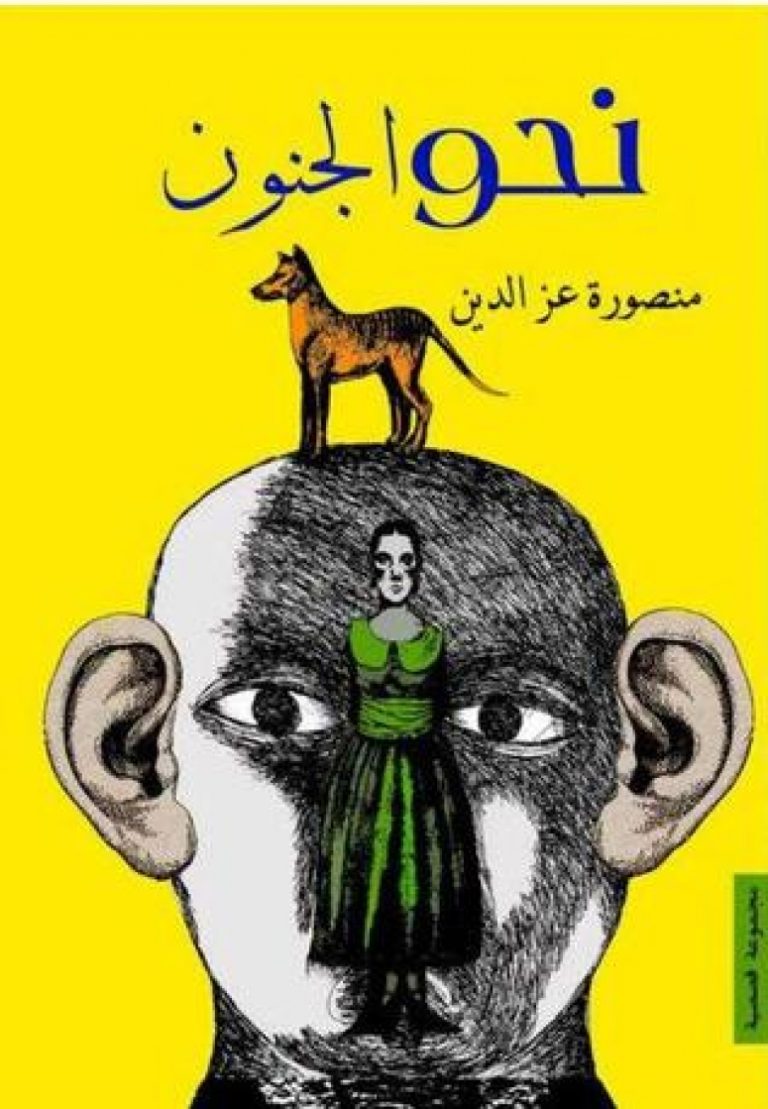هكذا نجد روايته الجديدة أحمر خفيف وهي تجترح طرافتها المميزة في العنوان والمطلع والختام وكل الصفحات, إذ تسجل في الورقة الأخيرة المقاهي التي كتبت عليها ابتداء من مقهى السقيفة بتونس, لصاحبته نجوي, التي تعلق غلاف رواية ألعاب الهوي ـ وهي عمله السابق ـ على الحائط و تحكي للزبائن كل ليلة أحد ـ أي في سهرة الاسبوع ـ عن المصراوي الذي كتبها ، وكأن كاتبنا بهذا التفصيل الزخرفي الموشى يحاكي الفنانين التشكيليين, وهم يرسمون في ذيل لوحاتهم بورتريها مصغرا لهم.
يورد المؤلف عقب ذلك اسماء المقاهي السبعة التي شهدت مولد روايته في تونس وقطر, المفارقة البارزة في هذا المشهد ان هذا النوع من الكتابة علي وجه التحديد من العسير ان نتخيله وهو يتخلق وسط الضجيج وحضور الآخرين في المقاهي, فهو استقطار لعطر الماضي, واعتصار لثمالة الذاكرة, وتعتيق لعوالم الواقع المتوهم إنه كتابة سردية مغايرة للمألوف, تحكي عن أشخاص وأحداث مغلفة بالأسطورة ومشبعة برذاذ الشعر, لنعد الى مطلع الرواية الذي يمثل مشهد احتضار طويل, يمتد عبر النص بأكمله, فيجعل من البطل كائنا خرافيا عجيبا شهور تمر ومحروس كأنما اختار المستشفى مقرا أخيرا, بيتا ومقبرة, لا يزيد ولا ينقص, المحاليل معلقة, الخيوط مفتوحة يبن جسده والحياة, واصلة بين روحه والموت, والقرية تركت حالها ومالها ونفرت اليه.. شهور يدعون له, كبير البلد, حبيبها وحاميها, والكبير لا يهان حتى ولو من موت, نشف الزرع والبهائم علي وشك الهلاك, تعطلت مصالح الخلق, والدعوات ترفع في الصلوات وخطب الجمعة, الدعوات التي كانت تصله بالشفاء صارت تكال له بالراحة والرحمة. وأهل القرية علي قدم وساق, مأزومون كثور يدور بعيون مفتوحة في ساقية, كغريق يتعلق بعود قش.
ودعك من ابنته إنصاف وهي تناجيه وتطارحه العزيمة كي يطرد ملاك الموت, والطبيب الذي حار في ذلك الكيان الأسطوري الخارق لقوانين العلم في مقاومته للموت واحتضاره الذي يجعل من حياة القرية مجرد هامش على صفحة الوجود بدونه.
البلاغة القروية:
تتوالي إثر ذلك فصول مروية علي لسان الراوي العليم, لكنه لا يوظف صيغة الغائب. بل يعمد الى خطاب القارئ وكأنه يريد أن يضفي مسحة ملحمية على القص, فصول دموية ممعنة في عنفها, لإخوة يحترقون, ورجال جبارين يحترفون القتل والسرقة واللعب بالحياة, وفصول أخري غزلية تطفح بالشبق, وتحفل بالاشارات الجنسية الفاضحة للرجال والنساء, للزيجات والاشواق والاهواء, في فضاء بعيد المرمي, شاحب الملامح, تتردد فيه اصدقاء الاسماء, والصفات ذاتها, مثلا فرج الاسود الذي يبرر لونه بأطرف قصة عن جدينا سام وحام, وكيف ان كلا منهما ـ في زعمه ـ قد هطل عليه المطر وهو يمضي في الطريق يحمل نسخته المخطوطة من المصحف الشريف, أما حام فقد خبأها في طيات ثيابه فنجا بلونه الابيض, لكن سام فقد صوابه, ووضع المصحف علي رأسه يحتمي به من المطر, سال الحبر على وجهه وجسده, ومن يومها وقد دمغ السواد بشرته وذريته الي الأبد.
تتوالي النماذج والحالات العجائبية الاخري, مثل عزت حركات أو الدكتور عزت الذي لا يشبع من معشوقاته الحقيقيات والوهميات, كان مولعا على وجه الخصوص بالممرضات وقد خلعن عليه لقب الطبيب دون أي دراسة او شهادة ـ لكنه لا يرتدع, وحتى إن شبع تتقلب بطنه فجأة, يشعر بزوجته دودة تلعب في بطنه, وان خبأ, وحتى ان تنقل, ينتقل سريعا من وردة لأخرى, عزت برق لمع, يقطع الوعود والوفاء لأخريات, وعيادات الاطباء اكثر من الهم علي القلب, وهن غادرنه, إن كن موجودات أصلا, رغم كثرة الصور ونفحات الجبن القديم والعسل
ولا تقتصر الفتنة على الرجال, فهذه غزلان أرملة طروب علي الطريقة القروية, … وجهها الحليب راح ينشف منذ وفاة زوجها حبيبها, زوجها عشيقها, رفعت الطرحة الشبكية أعلى فمها, فتركزت الاضواء علي العيون والحاجبين والمناخير النبقة, وتركت لفمها أن يعلن اكتمل البدر حتى ترخي الطرحة لأسفل.. بعود ملفوف لا تتغنج قاصدة, لكن اشياءها تكاد تنفرط منها في كل اتجاه فتخلب لب الرجال.
بيد أن ابرز ملامح هذه الكتابة السردية أنها توغل في مسارين متوازيين على ما بينهما من مفارقة واضحة, اولهما صناعة النماذج البشرية وأسطرتها وتحويلها الى رموز تجاوز دلالتها المباشرة في كثير من الاحيان, فمحروس يكاد يطير من غرفة الانعاش الى أفق الزعامة, وفرج الاسود المصاب بالجذام يرمز لليل, وعزت علامة الشطارة والجسارة, اما المسار الموازي فهو هذا الاسلوب البليغ نصف الشعري, بجمله المكثفة, وعباراته المجازية, ومطالعه المأثورة وسطوره المنقوصة, مما يطرح مساحة كافية للدهشة من تجاور هذين المسارين وما يشفان عنه, عالم القرية الموغل في عاميته, وعالم الصور التعبيرية المسرف في فصاحته, وتظل متعة التراسل بين هذين الطرفين منبعا ثرا للشعور بالطرافة التي لا تصل الى الفكاهة, والمتعة التي تنبثق من الفن الطازج الجميل.