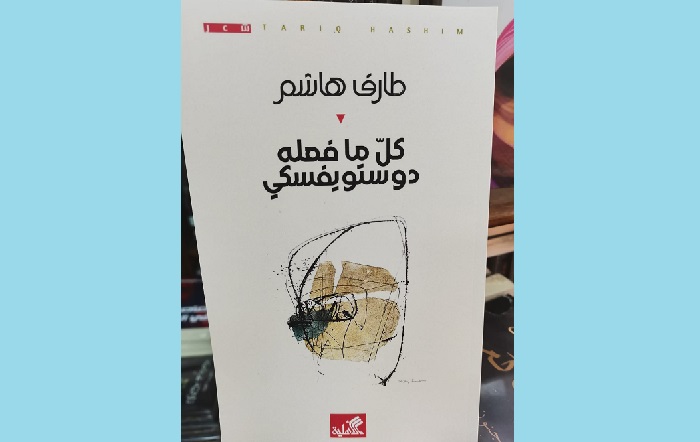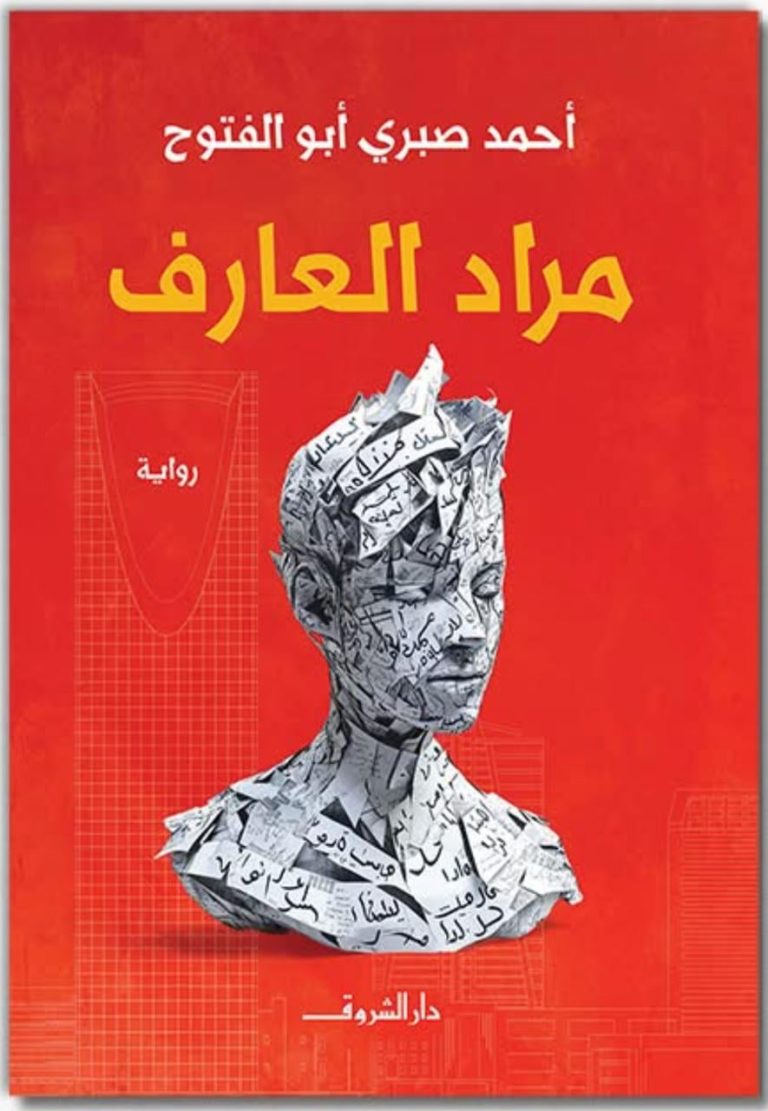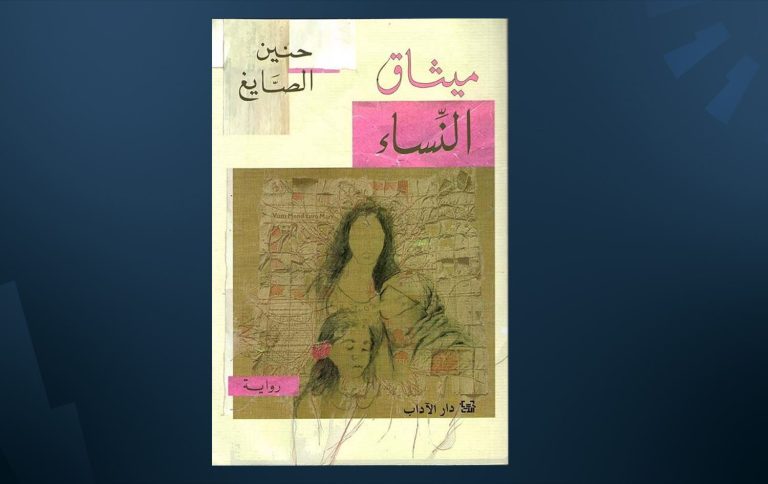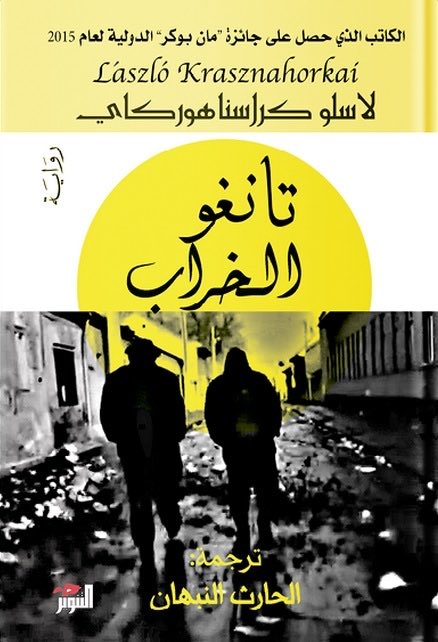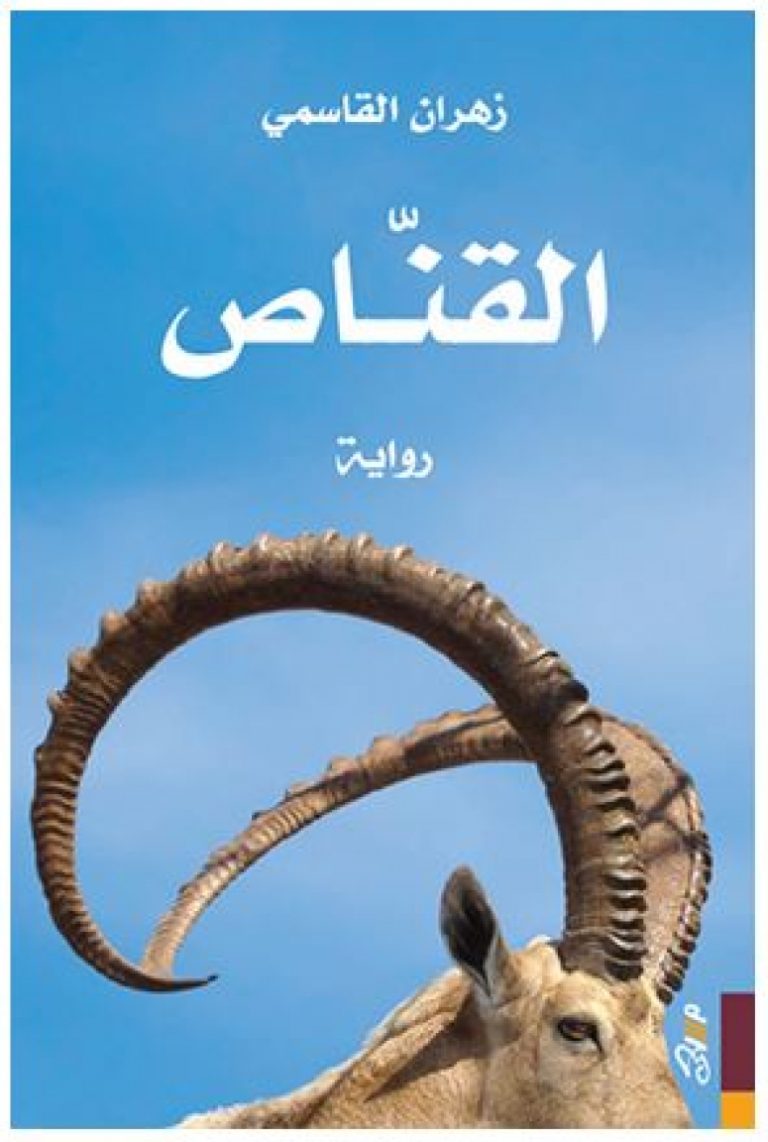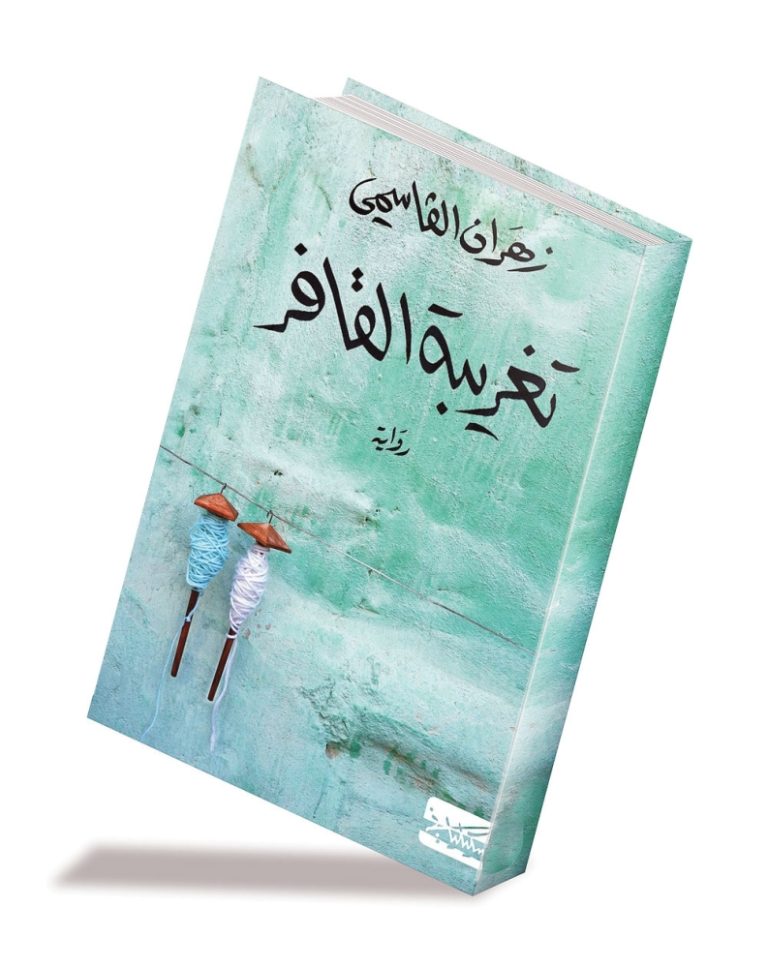“وَحِيدًا، في لقطةٍ ليليَّةٍ
أخْرُجُ منْ القصِيدَةِ؛ لأدْخُلَ
جَحِيمَهَا
مُتدثِّرًا بهوَاءِ النِّهَايَاتِ
وَمُمتلِئًا بِعُوَاءِ ذِئْبٍ دَاخِلِي
وَبِحَشْدٍ مِنْ الأيَائِلِ وَالضِّبَاعِ
على مَقرُبَةٍ مِنِّي جُثَّتِي
في نَوْبةٍ شَرسَةٍ مِنْ السُّعَالِ
تَعْبُرُهَا المَنازلُ.”
وقوله:
“أينَ أنْتَ الآنَ يَا جَسَدِي؟
، أنتظِرُكَ على قارعَةِ الظَّلامِ، وَحْدِي
بلا مَأوى أوْ رَفيفٍ
وَأشْعُرُ أنَّني مُحَاصَرٌ
، بَيْنَ ضَحِكَاتٍ مَكتُومَةٍ تتقافَزُ مِنْ حَوْلِي
، وَرَوائِحِ شوَاءْ.”
وقوله:
” جُثَّتِي تُلوِّحُ في العَرَاءِ
لِغَيمَةِ لا تَرَاهَا.”
وقوله:
” تَتَفَجَّرُ أحْجَارٌ
في كلْيتِي.”
وقوله:
“ بعيدًا حَتَّى عنْ جَسَدِي
أجْلِسُ على شَاطِئِ البَحْرِ وَحْدِي
بريئًا منْ كُلِّ مَا يَحْدُثُ.”
هذا الجسدُ الفاعلُ بقوَّةٍ عبْرَ الدِّيوانِ، والمساهمُ مساهمةً قويَّةً في هذه الكشوفِ الذَّاكراتيَّة؛ حيثُ يشعر الشَّاعرُ بجسدِهِ وليمةً تُنْهَشُ، وهو أيضًا يُساهمُ في هذا النَّهشِ، وهو مَن يتلقَّى الضَّرباتِ المُوجِعةَ؛ لذلكَ يصرخُ رعبًا من هذا الجَسَدِ، وفي هذا الجَسَدِ، وعلى هذا الجَسَدِ؛ الذي هو عُرْضَةٌ للتَّحلُّلِ والانهيارِ والتَّمزُّقِ والانفجارِ والتَّهاوي؛ لذلكَ ظهرتْ القصائد في بداياتِ الدِّيوان، على مُستوى البناءِ، أشبه بشظايا، بروقٍ، التماعاتٍ، شُهُبٍ:
“جُثَّتِي تُلوِّحُ في العَرَاءِ
لِغَيمَةِ لا تَرَاهَا.”
“الحَرَائقُ تنهشُ جُثَّتي
وَأنَا أُقهقِهُ في العَرَاءْ.”
” تَتَفَجَّرُ أحْجَارٌ
في كلْيتِي.”
” قِطَّةٌ
تَتَمَسَّحُ بعوائِي.”
” أيَّتُهَا السَّمَاءُ:
إلى أينَ يَتَوَالى سِحَابُكِ
بالرِّفاقْ؟.”
” تَتَهَشَّمُ المَرَايا في ضلوعِي
كُلَّمَا صَاحَ طَائرْ.”
” فَوْقَ رَأسِي سَحَابَةُ دُخَانٍ، تَتَّقِدُ.”
” تَتَسَاقَطُ أدْمُعِي
مِنْ سَحَابَةٍ على هَيْئَتِي.”
“هَوَاءُ القيامَةِ
يَحْمِلُنِي إلى الأقاصِي.”
“في الكَوَابِيْسِ
دَائمًا
وَحْدِي.”
ويقترنُ بهذه الوحشةِ حنينٌ دائمٌ إلى عوالم العائلة والطُّفولة؛ بتواريخِهِما التي لم يعد لها أثر في الواقع المعيشِ الرَّاهن:
” أمَامَ بيتِنَا القدِيْمِ
في انْتِظَارِ الصَّبيِّ الَّذي كُنْتُهُ
قادِمًا على نَبَضَاتِ أمُّهِ
في الحَارَةِ القدِيمَةِ الَّتي كَانَتْ هُنَا.”
غيرَ أنَّ هذا الواقع الذَّاوي ليسَ الفردوسَ المفقودَ للذَّاتِ الشَّاعرةِ؛ فهو واقعُ محنةٍ، في معظمِهِ؛ لذلك تتخايل فيه وقائعُ البؤسِ مُجسَّدَةً في العنفِ الرَّمزيِّ/ الجسديِّ من الجدَّةِ / الأمِّ؛ حيثُ تمَّ حرقه بالنَّار؛ لأنَّ الأمَّ لم تصدِّقْ أنَّه لم يُشعِلْ النَّارَ في بيتِ الجيرانِ، وظلَّتْ تفاصيلُ هذا الواقع الأليم مطمورةً، فترات طويلة من العمر، حتَّى أشرقتْ في هذا الدِّيوان البديعِ:
” لمْ أكُنْ بينهُمْ وهُمْ يُشعِلُونَ النَّارَ في المنزلِ المواجِهِ
كُنْتُ جَالِسًا على عتبَةِ الدَّارِ وَحْدِي
ولكنَّهُمْ أخبروكِ بأنَّني أنَا الَّذي أشْعَلْتُ
كيفَ هنْتُ عليكِ إلى هذَا الحدِّ
ولمْ تُصَدِّقي رُعْبِي ورَجَائِي وصُرَاخِي
وأنْتِ تُشعِليْنَ في يدَيَّ ورِجْليَّ نيرانًا وتقولينَ:
سَأُريكَ مَا الَّذي تَصْنَعُ النَّارُ يَا شَريفُ؟
كيفَ مَرِضْتُ أيَّامًا، ومَرِضْتِ بي، حتَّى النِّهايَةِ، يا أمِّي؟.”
” حَرَامٌ عليكِ واللهِ يا أمِّي
يَشْتُمُونَ فأشتمُهُمْ؛ فلا يعنيكِ سِوَى أنَّني أشتُمُ
ولا تَسْتَمِعِيْنَ إلى أيمَاني،
وأنْتِ واثِقَةٌ أنَّني لسْتُ أكذِبُ.”
وعلى الرَّغم من هذه الشِّدةِ في التَّربيةِ والتَّنشئةِ، فقد كانَ يرى المحبَّةَ خلفَها:
” لنفترضْ مثلاً يا أبي أنَّني أخْطَأْتُ
يُخْطِئُ العيِّلُ ويجرِي إلى أحْضَانِ أبيهِ
ألسْتُ ابنَكَ البِكْرَ الَّذي تمنَّيتَنِي
وطلبتَنِي منْ اللهِ؟
وعلى الرَّغمِ منْ أنَّكَ لمْ تأخُذْني إلى أحْضَانِكَ مَرَّةً
أو تأخُذْني إلى رِحْلَةٍ
– كمَا يحدُثُ في المُسَلْسَلاتِ والأفْلامِ –
فإنَّني لمْ أُخْطِئْ يومًا الطَّريقَ إلى محبَّتَكَ.”
كذلكَ كانَ العُنفُ في المدارسِ:
” مُدرِّسُ الألعابِ
البدينُ
ذو الكِرْشِ
والعَصَا الغليظَةِ والسِّبابِ
الَّذي يتصوَّرُ أنَّنا نُصدِّقُ أنَّهُ بَطَلُ الجمهوريَّةِ في المصَارَعَةِ
لمجرَّدِ أنَّهُ مُدرِّسُ الألعَابِ!
هُو الَّذي هَوَى بعَصَاهُ على ذِرَاعِي يا أمِّي
لمجرَّدِ أنَّني – أثناء طابورِ الصَّباحِ – تعلَّقتْ عيناي بطائرٍ
ينطلِقُ إلى الأعَالي
واللهِ مَا تَشَاجَرْتُ مَعَ أحَدٍ
ولا ضَرَبَنِي عيِّلٌ مِنْ العِيَال.”
ويبدو حضورُ الجدَّة والأبّ والأمّ والطُّفولة على نحوٍ كثيفٍ، وتتبدَّى الجدّةُ في مقدّمةِ هذه الشّخصيَّاتِ، كما في هذا النَّصِّ:
“تجعلينَ مِنْ فخذِكِ وسَادَةً لي
تمسَحِينَ على رَأسِي
وتقُصِّينَ عليَّ حِكَايَاتٍ مِنْ طفولتِكِ
ثمَّ طفولةِ أخْوَالي وأمِّي
تأخُذِينني إلى السُّوقِ دائمًا مَعَكِ
في كلِّ مرَّةٍ تُحْضِريْنَ لي كوبًا مِنْ السُّوبيا المثلَّجَةِ
تحمِلِينني في الزِّحَامِ
تأخُذِينني في زيَارَاتِ المقابرِ
وفي الأعْيَادِ والمناسَبَاتِ
وكُلَّمَا اسْتيقظْتُ في الليْلِ عَطْشَانَ يَا جدَّتي
تكونيْنَ في انْتِظَاري؛ فَتَسْقِينَني كَرَضِيْعٍ
تتعلَّقُ عيناهُ بحنانِكِ الزَّائدِ،
ثمَّ تُعِيْدِينَني إلى النَّومِ مِنْ جَدِيدْ.”
وكما في هذا النَّصِّ:
“ممدًّا على سَريرِكِ النُّحاسِيِّ، وفي يديْ كتابٌ
أوْ جَالِسًا على الأرْضِ جنبكِ يا جدَّتي
أتكشَّفُ عَوَالمَ لا تنتهِي
في تهاويْلِ الحائِطِ الطِّينيِّ المتسَاقِطَةِ عنْهُ ألوَانُ الجِيْرِ.”
” تجعلينَ مِنْ فخذِكِ وسَادَةً لي
تمسَحِينَ على رَأسِي
وتقُصِّينَ عليَّ حِكَايَاتٍ مِنْ طفولتِكِ”
أو
” وَضَعَتْنِي أمِّي في ليْلَةٍ شَاتيَةٍ
كَانَ صَوْتُهَا مُنْشَرِخًا، وَكَانَتْ تُلاحِقُنِي
بعينيْنِ دَامِعَتيْنِ وَمُعَذَّبتَيْنِ
كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ جَدَّتِي
أتَعَذَّبُ بالضَّوءِ، وَالشَّيخُ الَّذي
دَخَلَ في المشْهَدِ فَجْأَةً، وَتَسَلَّمَنِي
غَمْغَمَ في أذُنِيْ بكَلامٍ،
ثُمَّ تَفَلَ في فَمِي
، وَكَبَّرَتْ جَدَّتِي.”
أما ضرباتُ الموتِ المُوجعةِ التي تُلاحِقُ الذَّاتَ الشَّاعرةَ فتحتلُّ المساحةَ الأوسعَ منْ الدِّيوان؛ حيث موت صديقُ الطُّفولةِ، وموت الأخ، وموت الأم ،وهموم المرضِ الذي يجتاحُ هذه العائلةَ, وهو ما يتجسَّدُ من فاتحةِ الدِّيوانِ، في الاستشهاد بلسان هارولد بنتر:
” العَالمُ على وَشَكِ أنْ يتخلَّصَ منْ كُلِّ نورِهِ وَبَهَائِهِ
لِيَحْشرَنَا في حُفَرِ عَتْمَتِهِ الخَانِقَةِ.”
يقولُ في موتِ الأمّ:
” أكْثَرُ مِنْ هَذِهِ الأزْمَةِ مرَّتْ وعُدْنا إلى بيتنَِا مِنْ جَدِيدٍ
كانَ صَدْرُكِ يعلو وينزلُ معَ أنفاسِكِ الَّتي تَتَسَارَعُ
رِجْلُكِ اليُمْنى اسْتقامَتْ بجانبِ اليُسْرَى
كَمَا كانَتْ في البِدَايَةِ
وَجْهُكِ أصْبَحَ أكْثَرَ إشْرَاقًا
وتوارَتْ مِنْهُ عَلامَاتُ المواجِعِ
كُلَّمَا وَضَعْتُ يدِي على جبينِكِ تنتفِضِيْنَ
رغوةٌ ناصِعَةٌ بدأتْ تتسايلُ منْ جانبِ فَمِكِ المُغْلَقِ
جَارَةٌ دَخَلَتْ تتشهَّدُ،
نحَّتْنِي كشَيءٍ، وفرَدَتْ عليكِ الملاءَةَ
وكُنْتُ كصَبيٍّ ينتظِرُ أمَّهُ ولا يَقْوَى على الحِرَاكِ.”
وعلى مدارِ الدِّيوانِ الذي لا يخلو مشهدٌ فيه من ظلالِ الموتِ، أو واقعةٍ رمزيَّةٍ تُشيرُ إلى سطوةِ وعنفِ الموتِ؛ وإنْ كانَ قد استطاعَ أنْ يفلتَ؛ محتفلاً بالحياةِ في كثيرٍ منْ القصائدِ، وبخاصةٍ ما يتعلَّقُ منها بالجسدِ، و منها:
” المرعِبُ في المسْألَةِ أنَّهَا كانَتْ صَدِيقَةُ أمِّي
الجَارَةُ الَّتي اسْتَوقَفَتْنِي في طريقِ عَوْدتِي
وَأنْبَأتْنِي أنَّهَا سَتَصْعَدُ لِي
لأكْتُبَ رِسَالةً إلى زَوْجِهَا
المرْأةُ الَّتي أهْمَلَتْ الرِّسَالةَ، وَحَرَّرَتْ جَسَدِي
وَقَادَتْنِي إلى مَجَاهِلَ، لمْ أزَلْ أتَخَبَّطُ فيْهَا.”
محنةٌ هيَ الحياةُ, حيثُ قسوة الشَّارعِ، وقسوة البشرِ، ومحنةٌ هيَ القصيدةُ – كما قال الشَّاعرُ الرَّائد محمد عفيفي مطر- لذلك جاءت القصائد كانفجاراتٍ، وشظايا، وطلقات، كأنَّ الرُّوحَ لم تعدْ قادرةً على احتوائِها ؛ فتدفَّقتْ إلى الخارجِ؛ مُنصهرةً في لغةٍ بديعةٍ رهيفةٍ تُقلِّلُ من الكآبَةِ والحُزنِ العظيمِ الذي يلمُّ بكيانِ الشَّاعرِ ويُكبِّلُ روحَه.