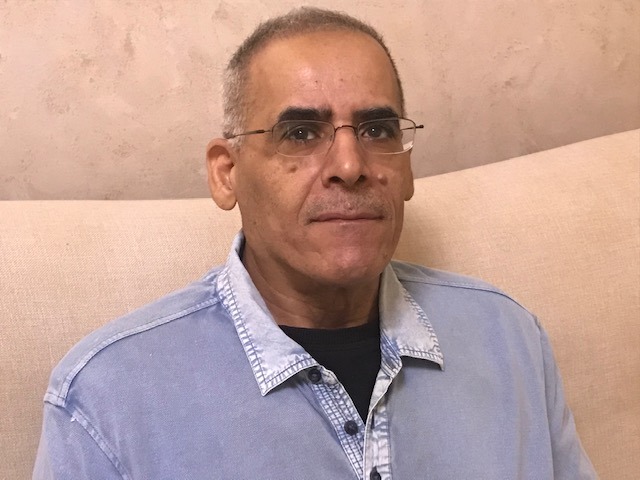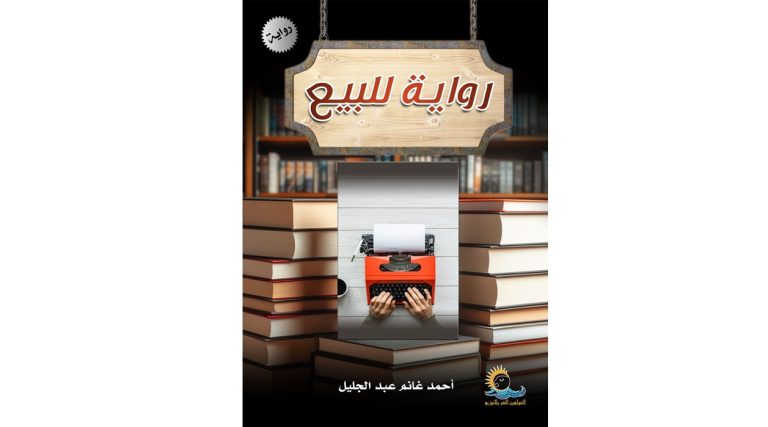محمد أبوالدهب
أرتجف من البرد، ولا أعرف أحدًا من الجالسين، وقد ازدحمت بهم الغرفة، بعد أن أُجبِروا على النزول من السيارة نصف النقل، التي حملتِ الجميع تباعا من البيوت كخرافٍ بطيئة مُطيعة، وهم منقسمون إلى مجموعات صغيرة، ثنائية وثلاثية، يتكلمون همسًا فيما يشبه استعادة ذكريات بعيدة مشتركة، ويبتسمون طوعًا كأنهم اعتادوا الأمر ويدركون عاقبته الروتينية التي لا تستدعي مشاعر القلق، ولم يكن تكدسهم يعطيني أي انطباع بالدفء كما ارتجيت.
أرتعش من البرد والخوف، وأحاول كبْت ارتعاشاتي حتى لا يستضعفني الموجودون، وأنظر بين لحظة وأخرى إلى الباب الكبير، المُوصل إلى داخل المَقرّ. وكانوا أدخلونا من الباب الصغير، المفتوح دائما على الشارع الجانبيّ الذي أمشي فيه وحيدًا مرتين كل يوم، لأصل إلى -وأعود من- الإدارة الاجتماعية، دون أن أتخيل اضطراري إلى الدخول منه يومًا. أنظر أيضا إلى القابع وراء المكتب، يلف رقبته بكُوفيّة حمراء ويكبس رأسه بطاقية سوداء من الصوف، منهمكًا في لعبةٍ على محموله، ويظهر أنه حقق فيها درجات متقدّمة لأن ملامحه منبسطة راضية، وهو كان أخذ تليفوني وبطاقة الرقم القومي بمجرد أن أوصلني إليه دوري في الطابور، ومدّ يده وهو جالس ليضعهما على رفٍّ بخزانة صغيرة على الحائط، وقال: “ارجع”، مُشيرًا إلى الكنبات التي ترسم مستطيلا غير مكتمل يبدأ وينتهي عند المكتب، ولم ينظر إليّ مرةً ثانية، وأنا تعلّقت بالتطلّع المُلِحّ نحوه متلهّفا إلى خبرٍ يخصّني. وسمعت أحدهم يناديه: “يا عم عطا يا سيد الكل”
**
رنّ جرس تليفون المكتب، وكنت لمحتُه في أثناء وقوفي بالطابور وحسبتُه محطوطًا كديكور، فانتفض عم عطا وألقى محموله في الدرج المفتوح. رفع السماعة وتحوّل وجهه جادّا مذعورا، وقال: “أفندم”. انتفضتُ أيضا، شاخصًا إليه، وبدا لي أنه يصغرني بست أو سبع سنوات، غير أني سأقول (عم) مثلما يقول الناس. أنصتَ بتذلّل لمحدّثه، وطرفتْ عينه ناحيتي، فانقطعت أنفاسي، ولم أعرف إن كنت مُقبلا على ضحكٍ أم بكاء. قال: “حاضر”. وضع السماعة واستأنف اللعب على تليفونه، فتقلّصتْ معدتي، وأردت أن أسأل: “خير يا عم عطا؟”. لكنّ لساني مات، ثم إنني لم أستبين منطقًا للسؤال، وتوقّعت أن يزجرني لأسكت للأبد، ونظرت إلى الآخرين، فوجدتُ أنهم أغمضوا أعينهم. ناموا جميعا، أو يتظاهرون بالنوم لسبب أجهله، كأنما دار بينهم اتفاق سريع بغمزات العيون، إذ لم يتكلّم واحدٌ منهم منذ فترة، وعم عطا يتحكّم بالأمور، متخفّيا وراء انشغاله باللعب. وتصوّرتُ أن يوم القيامة قد تحدث فيه مواقف مشابهة، وأني أخوض من ساعتي دورة تدريبية مكثّفة بهذا الشأن، وعليّ الاستفادة منها بقدر المستطاع، من أجل المستقبل المجهول. وتراجعَ قليلا مؤشر إحساسي بالبرودة عند هذا الحدّ.
**
بينما استغرقني التفكير في أخطائي الماضية، أوّلها وآخرها، باطنها وظاهرها، أحقرها وأعظمها، ممالئًا يقيني القديم بأن التواجد هنا مرتبط بالوقوع في الأخطاء، ليُعتَرَف بها طواعية فيصير التنكيل عن استحقاق، قاصدًا لم أزل الوجه نفسه الذي عاد منبسطا راضيا بعد أن جرّبَ القهر لثوانٍ معدودة، ظهرت امرأة وتسمّرتْ في وقفة عسكرية عند فتحة الباب الكبير. جاءت من داخل المقرّ، تحدّق إلى عم عطا بجمود وثبات كأنما تنتظر أوامره فتلبِّي أو تنتظر أن يسمَعها هو فيطيع. أشار لي إشارة هيّنة بكفّه التي لا تزال أصابعها تتنطّط على محموله، فانخلعتُ عن الكنبة، من بين النائمين، وتوجّهت، حسب مسار الإشارة، نحو المرأة. لم تتزحزح، حتى حين صار تلامسنا احتكاكا صريحا، ولم أفكر مطلقا في التراجع لئلا أُغضبها أو أغضب عم عطا. أمسكتني من كتفي بضغطةٍ قوية، ووجّهتْني ضغطتها لأخطو إلى اليمين خطوة أو اثنتين، ثم الوقوف ملاصقا الحائط الذي يسند إليه، في اللحظة نفسها، المتظاهرون بالنوم مؤخرات رؤوسهم. رأيت حوشًا واسعًا يمتد أمام المبنى ذي الطوابق الأربعة، وكنت أشاهد أحيانا النوافذ الزجاجية المغلقة دائما والطلاء الرمادي للطابق الأخير، في أثناء مروري بالشارع، حين تصيبني نوبات شجاعة نادرة فأطلِق أفكاري بلا رادع. وإلى اليسار مظلّة كبيرة، تصطف تحتها ثلاث سيارات جديدة وفخيمة. قالت كأنما بأدب: “اخلع نظارتك”. وتهيّأ لي أني أبصرت شجرة عالية بفروع طويلة متدلّية ومُورقة، بعيدًا في نهاية الحوش من جهة معرض الموبيليا في الشارع الموازي، قبل أن تَشدّ المرأة، بعافيةٍ وافرة، المنديل القماشي الذي أخرجتْه من جيب بنطلونها. كانت عقدت عُقدتين، والثانية آلمتْني جدا فشببتُ على قدمي حتى لا أستعطفها: “آاه، بالراحة شوية”، فتسقط فرائض رجولتي من عينيها. وتخيّلت لوهلة أنني كنت مخدوعًا في طبيعة عمل المقرّ طيلة السنين الفائتة.
**
سحبتني المرأة، واستكانت يدي في يدها. يدُ أنثى، مهما تغيّرتْ أحداث الفيلم تبعا لشطحات كاتب السيناريو! زدْ على ذلك أن نهدها لطم جبهتي أكثر من مرة. لا ألومها بالطبع، فقد كانت حريصةً على ألا أتعثّر، وعلى ألا أهرب. وكانت أطول مني بوضوح، وتكبرني بعامين أو ثلاثة. في الشهور الأخيرة، اكتشفتُ بي مَيلا مندفعا ومُربِكا نحو العجائز، صِرن عضوات دائمات في أحلام صحوي؛ ربما لأني نفسي صرتُ أفكر طويلا بما أُلتُ إليه من شيخوخة. ولم يخطر لي قَطّ أن المقرَّ يوظِّف النساء. قالت مرة: “أسرَع شوية”. ومرة: “حاسب، اطلع أربع درجات”. ثم: “هنطلع سلم طويل على باكيتين”. كنت أستجيب على نحو أظنه أعجبها، خاصة حين تقارن بيني وبين مَن تسحبهم كل يوم. وكان دور الأعمى يليق بي، من زمان. قالت أخيرًا: “اثبت مكانك”. نبرتها الأخيرة حاسمة، رغم ما خالطها من وهَنٍ أنثويّ راقَني. طرقتْ ثلاث طرقات على بابٍ قريب جدا من جسدي؛ لأن رجْع صوت الطَّرقات هزَّ أحشائي. وعُدتُ أرتجف من البرد والخوف.
**
قادتْني إلى الداخل. أربع خطوات، ثم أوقفتني. جذبتني من ياقة الجاكت لأدور إلى اليسار قليلا. حلّتْ منديلها عن عيني، وخرجت مسرعة بعد أن حكّتْ نهدها بجبهتي حكّة أخيرة وأغلقت الباب. وغلبتْ فرحتي اضطرابي حين أحسستُ تعمُّدها. وضعتُ النظارة، التي كانت لا تزال في يدي، على عيني، وفكرتُ أن المرأة ستظلّ مرابطة، بوقفتها العسكرية، عند الباب في انتظار الأوامر. وشعرتُ بضياع عابر لابتعادها عني. بدت لي الحجرة، على نظافتها ونظامها، كسيّارة مدرّعة، منفصلة عن العالم الخارجي. على الأقل لا يمكن أن تخرج منها أو تدخل إليها أي أصوات. قلت إن حجرةً كهذه جديرة بالمقرّ، رغم أن محتوياتها لا تزيد على محتويات مكتب مدير إدارة أو بالأنسب مدير عام في مصلحة حكومية. فوجئتُ بامرأة جالسة خلف المكتب الذي يشغل نصف الحجرة تقريبا، تتأمّلني دون انطباعات معيّنة، وذراعاها مشبوكتان على سطح المكتب المصقول اللامع. منعتْ هي ابتسامةً لما استشعرتْ فزعي من وجودها المباغت. وأنا كنت تراجعت للوراء مع رؤيتها، ولا علم عندي إن كانت جالسة، على منظرها، عندما أدخلتني المرأة الأخرى، أم أنها تسلّلت من فتحةٍ سرّية، بعد إدخالي. قالت: “هل تعرف خطأك؟”.. ألقتِ استفهامها على طريقة الأمهات حين تشرع إحداهن في تبكيت طفلها المدلّل. وقدّرتُ أني يجب ألا أنساق وراء مخاوفي. كانت هيئتها، وإيماءاتها والطريقة التي تُنطق بها الكلمات من بين شفتيها، تدلّ على أنها من طبقة أعلى بمراحل من طبقة المرأة التي تنتظرني الآن خارج الباب، وكانت تصغرها بما لا يقلّ عن عشر سنوات، لهذا ظللتُ محافظًا على إخلاصي ووفائي للمرأة العتيقة. لاحظتْ هي حيرتي، وأنا متأكدٌ أن أخطائي كثيرة وجسيمة غير أني لا أدري عن أيّها تسأل، فقالت موضِّحة: “كاميراتنا رصدتك، وأنت تتلكأ أمام المبنى، أثناء عودتك من الإدارة الاجتماعية، والأنكى أنك وقفت، وانحنيت تتظاهر بعقد رباط الحذاء، ثم رفعت رأسك ناحية الباب، هل تريد أن تلعب؟”.. لم أكن أريد أن ألعب، وأخفضت رأسي خجلانَ، وأذكر جيدا أن رباط الجزمة ضايقني يوم أمس، طول اليوم. كانت عُقده تنفك وحدها، دون سبب ولا مُسبّب. ثم إنني وقفت مراتٍ أمام معظم مباني الشارع لأفعل الشيء نفسه. وتعاظمَ تقديري للمقرِّ الذي لا يغفل صغيرة ولا كبيرة، وإن لم أشكّ في ذلك من قبل. ضغطتْ زرّا على المكتب، فدخلت امرأتي في التوِّ، تلوّح بالمنديل.
**
عندما كانت تستردُّ منديلها من على عيني، ضحكتُ من أهواء روحي إذ تمنّيت الحصول على رقم تليفونها لتعقد لي رباط الجزمة كل صباح. واشتقتُ للطمةٍ وداعيّة من نهدها لجبهتي أو حتى لقفاي. دفعتْني في ظهري، فانضممتُ إلى حيازة عم عطا. والكنبات صارت شاغرة. وميّزتُ تليفوني وبطاقتي أمامه. أزاحهما ناحيتي دون أن يتحوّل عن شاشة تليفونه.
في الشارع، كان الصبح قد ظهر، والمصابيح الكهربية لا تزال مضاءة. وقفتُ أخطّط للوصول، فيما تبقّى من سنوات خدمتي، إلى الإدارة الاجتماعية من شوارع أخرى. وانحنيتُ نصف انحناءة، متظاهرًا بعَقد الرباط الذي لم ينفكّ، ورفعت رأسي ناحية المبنى، محاولا اكتشاف مكان الكاميرا.