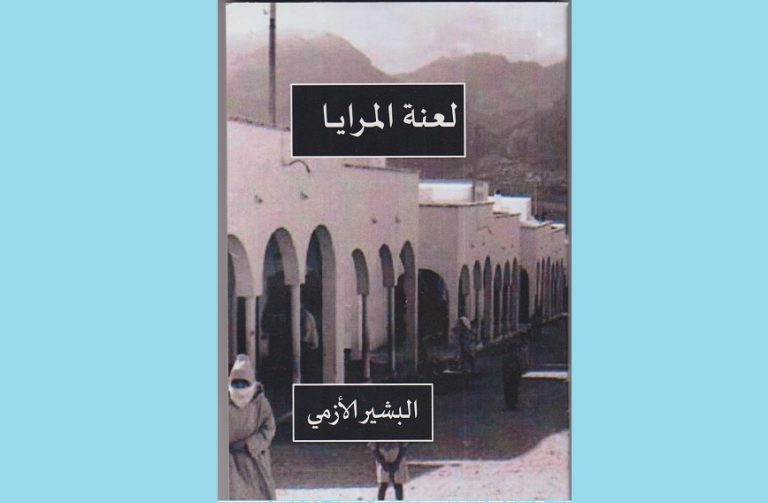عبد الغني محفوظ
وضعت المظروف أمامي على تابلوه السيارة واتجهت جنوبا كما قيل لي. كانت حرارة الظهيرة تسوط الهواء الساخن الثقيل المندفع من نافذة السيارة. بدا العنوان غريبا فلم أر أبدا من قبل خطابا بدون رقم صندوق البريد، ولكن هذا العنوان كان مكتوبا بخط متعثر يحاول الإتقان وحروفه الكبيرة تملأ جانب المظروف كأنه خط تلميذ صغير يتعلم الكتابة “درب الإرياني متفرع من شارع الأعشى في منفوحة – الرياض – بقالة الوادي الجديد وشكرا لساعي البريد.”
وصلت شارع الأعشى دونما عناء. كانت به، في بدايته، نقطة المطافئ تحيط بها بيوت قديمة متآكلة جدرانها بفعل المطر والشمس، تتوكأ على بعضها البعض تربض أسفلها بعض محلات إصلاح إطارات السيارات والبقالات الصغيرة. أشار احدهم إلى حارة ضيقة وقال: هذا هو درب الإرياني.
كان الدرب ضيقا للغاية مسدودا في نهايته وبه بعض الصبية الأفارقة الذين انكمشوا في الظل أمام بعض البيوت وفى مداخلها يرتدون ملابس رثة وينتظرون حتى تخف حدة الحرارة لينطلقوا للجري واللعب في الشوارع. ولمحت في جانب من الحارة الضيقة اسم البقالة الصغيرة مكتوبا بحروف باهتة على لوحة غطاها التراب حتى أوشك أن يطمس ملامحها. واقتربت من الباب فرأيت رجلا ضخما يرتدى جلابية بيضاء وغترة حمراء وبيضاء ويحتل المساحة الضيقة في وسط البقالة التي اتخذت شكل المثلث المحتشد بالبضاعة. كانت ملامحه مصرية وان صعب على أن احدد من أي منطقة أو حتى أجزم بمصريته بعد أن تكلم. سألته عن عباس القناوي فقال وهو يتفحصني في ريبة:
“لماذا تريده؟”.
“لدي رسالة له”.
“ضعها في الصندوق”.
وأشار إلى علبة صغيرة من الكرتون ملتصقة بجانب الجدار فيها كومة من الخطابات كلها موجهة إلى البقالة.
“ولكني أريد أن أبلغه رسالة شفهية”.
“أنا لا أعرف أين يسكن بالضبط ولكنه في بيت من هذه البيوت على الجانب الأيسر”.
كانت خمسة بيوت قديمة مبنية بالطين يخيل إليك أنها هناك منذ الأزل، تتصدرها أبواب حديدية صدئة متآكلة. طرقت الباب الأول فلم يجب أحد. أعدت الطرق بكلتا يداي ولكن أحدا لم يجب. هززت الباب بقوة حتى كدت اخلعه. اقترب منى صبي صغير من الجالسين وقال لي:
“هذا البيت لا يسكنه أحد”.
وأشار إلى الجنزير الضخم وهو يستطرد في سخرية خفيفة: “انظر انه مغلق”.
ونظرت إلى الجنزير والقفل المتآكل في خجل..واتجهت إلى الباب الثاني..ويبدو أنني قد طرقت الباب بشدة فقد أجابني صوت في غضب:
“اطلع ..اطلع”.
ودفعت الباب الذي أصدر صريرا عاليا وهو ينهزم إلى الداخل ثم يعود ليرتطم بالإطار محدثا دويا هائلا.
رأيت أمامي درجا ضيقا وحادا من الطين تآكل منتصف درجاته وغارت إلى أسفل من أثر الأقدام. لم يكن بالطابق الأرضي إلا باب مغلق. وبدا الدرج مثل أنبوب مائل. عندما وصلت إلى مصدر الصوت وجدت ثلاث غرف متناثرة كالأكواخ في فضاء السطح تربط بينها أسلاك الكهرباء وأحبال الغسيل التى تدلت منها بعض الجلاليب الصعيدي ذات الأكمام الواسعة والسراويل البيضاء وصديرى يزينه صفين من الأزرار الصغيرة. وبعثرت على أرضية السطح بعض أدوات البناء والجواريف وشكائر الأسمنت الفارغة وطست قذر وأوان منزلية أخرى. وفي ركن ربض موقد فحم كبير تراصت على جانبيه الأحجار الفخارية مخروطية الشكل واستندت إليه الشيشة يتدلى طرف مبسمها من مشبك حديدي صغير مثبت بماسورتها.
توقفت حائرا لا أدرى من أين أتى الصوت الذي دعاني للصعود. وبينما أنا واقف قال الصوت:
“تعال..تعال..من هنا”.
كانت الحجرة التي تقع على يسار الدرج واستقبلني الرجل على بابها في جلباب صعيدي وهو يتثاءب ويمسح النوم عن عينيه.
“أهلا وسهلا..تفضل يا أستاذ”.
وأجلسني على مقعد صغير بلا مسند قرب باب الحجرة الواسعة وكان جهاز التكييف الصحراوي يئن أنينا متواصلا. لم يكن بالحجرة سوى سرير صغير ومرتبتين ألقيتا على الموكيت القذر يتمدد عليهما شخصان مستغرقين في نوم القيلولة يرسلان صهيلا عاليا يبتلعه صوت المكيف، بينما ازدانت الجدران بجلاليب وسراويل وسبح معلقة على مسامير.
أمسكت يده قبل أن تمتد إلى عدة الشاي فلم يستجب لي إلا بعد عناء.
“هل أنت عباس القناوي”.
“لا..يا أستاذ..هذا هو عباس القناوي..أنا حمدان ابن قريته وزميله في العمل”.
وأشار إلى أحد النائمين..كان وجهه يلتحم بالمرتبة القذرة الرطبة ومنخريه يتحركان مع تنفسه.
“كلفني صديق يسكن معي بأن أوصل له رسالة لأنه مريض اليوم”.
“أين الرسالة؟”.
سلمتها له فقال:
“سوف أعطيها له عندما يستيقظ قبل العصر ليذهب إلى العمل”.
“ولكني أريد أن أبلغه رسالة أخرى”.
نظر إلي وهو يتثاءب:
“ما هي؟”.
وترددت للحظة ثم ملت عليه هامسا:
“لقد مات أبوه منذ خمسة أيام”.
وبوغت الرجل للحظة ثم هز وجهه الأسمر في أسى.
“لا حول ولا قوة إلا بالله..الله يرحمه”.
عندئذ تململ النائم الآخر وتباعدت المسافات بين زفيره وشهيقه ثم بدأ كرة أخرى من الشخير العالي.
طالع حمدان وجه عباس النائم للحظات ثم قال:
“سوف أبلغه بذلك عندما يستيقظ”.
وتركته وهو يحتج بأنني لم ادعه يقوم بالواجب. وعندما هبطت الدرج وبدأت اسحب الباب فوجئت به فوقى يناديني:
“يا أستاذ..يا أستاذ”.
تطلعت إليه وجسده الضخم يسد فتحة الدرج:
“نعم؟”.
“كيف مات أبوه؟”.
أجبته في حنق:
“كما يموت كل الناس”.
كان يلوح في فتحة الدرج ضخما وهائلا وهو يتحدث بتوسل وحزن:
“لا مؤاخذة..أقصد هل مات غرقا.. لدغه ثعبان…قتل في ثأر؟.”
“يقول صديقي إنها أزمة قلبية”.
قال في استسلام:
“الله يرحمه..مع السلامة يا أستاذ”.