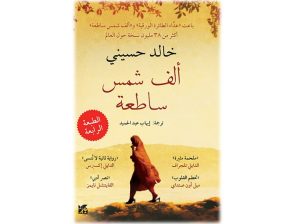الظاهر والباطن
تحفل رواية وراء الفردوس بعالمين متوازيين, ملتحمين بدافع القرية الجاثمة في حضن النيل, أحدهما عالم المصانع الطوبية التي أقيمت في السبعينيات ابتغاء الكسب السريع طبقا لايقاع عصر الانفتاح وآثارها المدمرة التي أدت إلي تخريب الارض وتحويل الفلاحين الحكماء إلي صناع محرومين من الكفاءة والخبرة في التعامل مع الأفران والآلات, وتعرضهم للحوادث الفاجعة والقتل العشوائي كما حدث لصابر في الرواية, وعالم آخر من المعتقدات والأساطير الكامنة في أعماقهم حول لعنة الدم والاضاحي البشرية التي تتطلبها الالات, وأشباح العفاريت التي تظهر في مواقع مصرعها والجنيات اللائي يسبحن في البحر أي النهر ويخطفن الشباب, الطريف أن أحدا لايشك في واقعية هذا التلاحم بين العالمين وتعبيرهما عن ضمير الناس, علي أن الكاتبة تستخدم تقنية الراوي الخارجي المحيط بكل شيء علما, في الوقت الذي نجد منظورها فيه قريبا جدا من شخصية سلمي التي تقرأ روايات ماركيز وبورخيس, وترتبط بالثقافات العالمية, مما يجعلها ترمق الاشياء والاشخاص بطريقتها الخاصة, فهي تفتتح الرواية بمشهد مثير, عندما تنزل إلي حديقة المنزل الريفي بعد اعتكافها في حجرتها لتحرق محتويات صندوق كبير من الاوراق خلفه لها أبوها الراحل وكأنها تدفن معه أسرار الآخرين لتبعث من جانب آخر أسرار طفولتها وعلاقاتها المتشابكة, ويلاحظ أن هذه الراوية الخارجية المتجاوزة لشخصية سلمي تمنح العمل فرصة استيعاب المشخوص والاشياء والأحداث, بقدر ما تحرمهم من فرصة التوحد مع اللحظات الحميمة والمشاعر الباطنية وأسرار الانوثة التي قد يعد بها النص, فتحاول الكاتبة تعويض ذلك بان تبث في ثنايا سردها قطعا حميمة من مذكرات سلمي, تنفث فيها أشجانها وخلجات روحها من حين لاخر, فنقرأ ضمن هذه المذكرات مثلا بوحها كثيرا ما أشعر بأنني غير طبيعية مجنونة بشكل أو بآخر, أنا وحدي أشعر بهذا الجنون الأليف الذي ينمو بهدوء ودأب بداخلي, يبدو كسرطان كامن يأكلني من الداخل, بالاحري جنوني ليس هو السرطان الذي يتغذي علي انما أنا نفسي ذلك السرطان الذي يتوغل في ذاته أصبحت خلية نشيطة في جسد ضعيف.
الوعي القائم
تكتب سلمي في أوراقها وهي تصف ترددها الحارق بين الوهم والحقيقة بوعي قائم أنها حين تكبر ستكون مهمتي اختلاق عالم يحدث, وخلط الواقع بالاوهام, وسد ثغرات الذاكرة بالمراوغة غير أنها تمتلك عينا ثاقبة, قادرة علي رصد مظاهر التطور الاجتماعي في قريتها بدقة شديدة, فاغلاق مصانع الطوب الاحمر وتدارك خسائره تم عام1985, لتحل محلها مصانع الطوب الطفلي المتطورة, ودخول الكهرباء إلي القرية لايحدث إلا بمساومات ورشاوي فاضحة, كما أنها قادرة علي تحليل شخصية أبيها رشيد, وان كانت تغفل أحيانا دورها التخيلي في بناء الرواية لتمعن في توثيق التفاصيل الخالية من الجدوي الفنية.
غير أننا نعثر في الرواية علي لفتات ابداعية ممتعة تنتبه لخصوصية المخيال الريفي النشيط, حيث يحول بعض أحداثه إلي أساطير رمزية, ففي تاريخ كل عائلة كبيرة يكمن مصير فاجع لاحد أفرادها الخارجين عن القوانين, يجعل ذكره محرما علي الألسنة, فتتداوله الاجيال بالكتمان تنبيها إلي عواقب الخروج الآثم علي الناموس الاخلاقي, تنجح منصورة في نصب هذا الشرك ببراعة في تلافيف روايتها, ممعنة في تجسيد حكاية لولا خالة سلمي التي تحاك حولها الأناشيد شعرك طويل يالولا وقع في البير يالولا, نزلت أجيبه يالولا, قابلني البيه يالولا… الخ مع المهارة في استدعاء شذرات غامضة من هذه القصة بطريقة لم يحدث التي تعكس التجاهل الرسمي لحكاية حمل السفاح ومصير الانتحار, مما يبث روح الشجن واللوعة, وربما كانت تكسرات الزمن في الرواية مربكة قليلا للقارئ العادي, إذ تبدأ من الختام الذي يتطلب قدرة عالية علي سد الفجوات بتناسق جمالي لايتأتي بسهولة, غير أن زخم الحياة الذي يضج في عروق الرواية وحجم الحمولة المعرفية, والوجدانية لشخوصها, خاصة الانثوية منها ومعتقداتها الحميمية في الاشباح والاحلام, كل هذا يمنح النص كثافة شعرية فائقة تزيد من واقعيته, بما ينبئ عن كاتبة لم تعد واعدة, بل أصبحت متحققة.