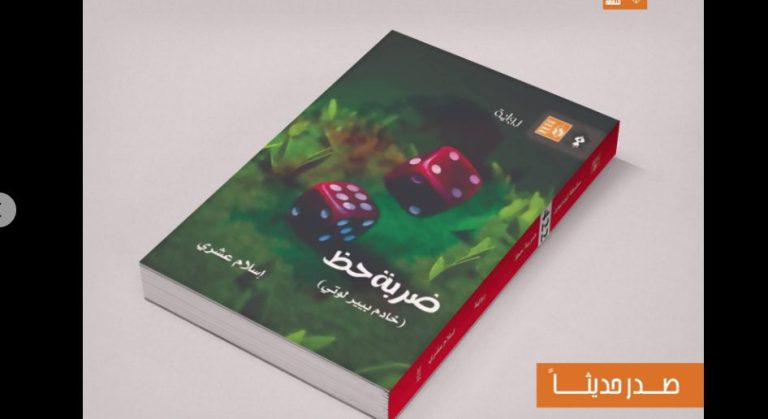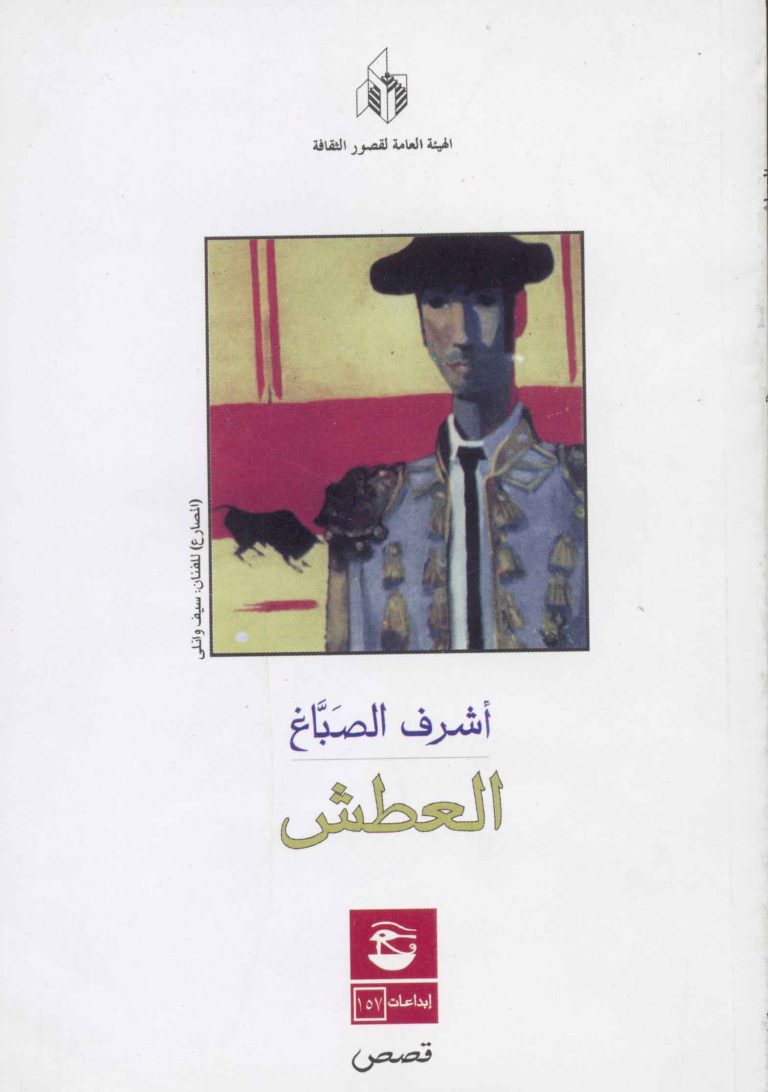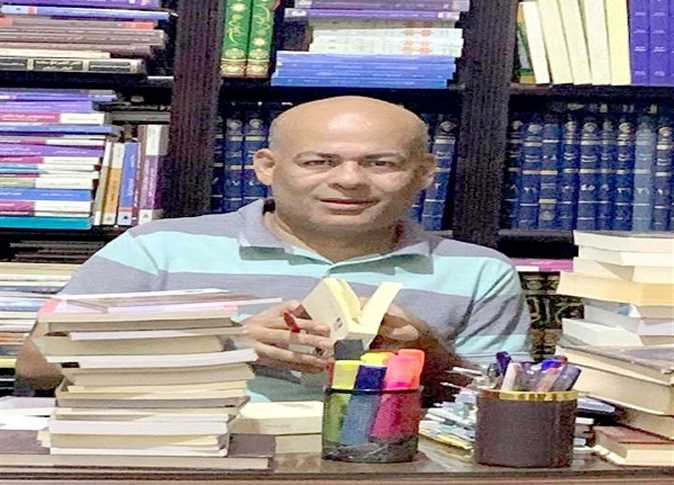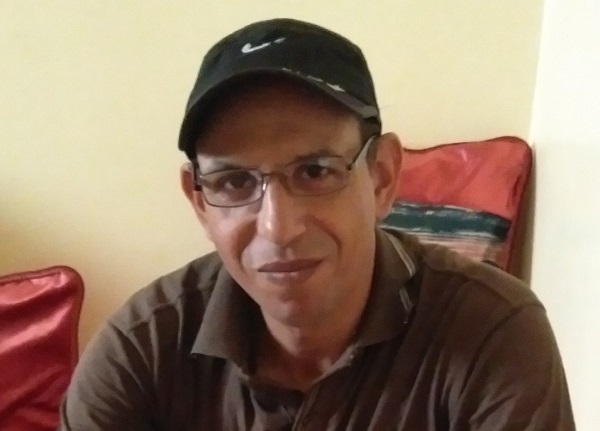عمار علي حسن
(1)
الأقدام الغليظة التي تدوس العشب لن تعيق نموه طالما المطر ينهمر. غلق النوافذ لن يمنع الرياح من الانطلاق، إن جاء أوان هبوبها. الستائر السوداء السميكة لن تحرم نور النهار من معانقة الغرف الحبيسة. الزمن يجري سريعاً، ويجرف أمامه كل شيء لكنه لا يقدر على تبديد الحكايات.
نزع “آل صابر” حكايتهم من قبضة النسيان. أورثوها لأولادهم قبل المال. وضعوها في أرحام النساء قبل نطف البنين والبنات. أطلقوها في مجرى النهر فحملها الماء إلى الآذان والنفوس، بعد أن غنَّاها القوَّالون على الرباب وهم يغلبون دموعهم، ويلقون في مجراها الطويل عبارات وألحان جديدة.
كما تنمو الذرية تكبر الأساطير، لكنها لا تشيخ، ولا تموت. كيف يموت من يسكن الحناجر المشبوبة بالأناشيد والغناء؟ كيف يتلاشى ما تردده الألسنة من جيل إلى جيل في الأوجاع والمسرات، وساعات السمر على المصاطب أمام بيوت الطين الخفيضة، وفي الحقول وقت القيظ؟
يتوه الناس فينطلق لحن من الزمن القديم، وينشد القوَّالون وعيونهم مغمضة:
“صابر والزمن غدَّار .. يعانــــــــــــد اللي يريده
بيده كاس مُر دوار .. كل ما ينقص يزيـده”
(2)
سرى عزف الرباب يجرح نسائم الليل، وقلوب الساهرين، وينذر بما هو آت في قادم الأيام. دار في الفضاء قليلاً، وعاد إلى آذان السائرين والجالسين والنائمين. هز الفلاحون العائدون من حقولهم في المساء رؤوسهم ألماً. رقصت النسوة دامعات في البيوت. دار الصغار حول أنفسهم موزعين بين ضحك وبكاء. هاجت البهائم في الحظائر، فاختلط الثغاء بالنعير والنهيق. نقنق الدجاج، وزبط الإوز، وهدل الحمام، وهو ينظر إلى سماء طليقة حانية، شاهدة على الغربان والثعابين والتماسيح والضباع التي تفكر وتنطق، وتزرع في الأرض شراً في طريق من يشدون عربة الحياة الثقيلة إلى الأمام.
(3)
كان الناس نائمين حين غضب الماء. تصادم السحاب فوق الهضاب البعيدة، وتدفق الموج غزيراً من بين الصخور، فجرف أمامه كل شيء. لم يصلهم خبر ما جرى هناك حين ذهبوا إلى مخادعهم البسيطة، يتوسدون أذرعهم التي كلَّت من الكدح نهاراً في الحقول، ويحلمون بصبح لا يختلف عن المساء.
شق صراخ قلب ليلة صيف صافية في “نجع المجاذيب”، سبقه نباح الكلاب. انتبه صاحب أول بيت على طرف النجع، فهب مفزوعاً، يفرك عينيه، ويرسلهما إلى عمق الظلام، وهو يقاوم التثاؤب، لعله يتبين من يصرخ، لكنه لم يكن في حاجة إلى هذا، حين سمع الكلمة التي يعرف ما يأتي بعدها: “فيضان .. فيضان.”
كررها الرجل في صراخ يشتد. ضربت قدماه التراب الذي سيصير بعد قليل طيناً، فأثار عجيجاً خلفه، وهو يجري في الشارع العمومي. مرق صراخه من النوافذ الضيقة، واقتحم الغرف المقبضة. سمع أزيز أبواب البيوت وزمجرتها، ثم شاركته الصراخ، واحدة، فاثنتان، فثلاثة من النسوة اللاتي يعرفن جيداً ما ينتظرهن.
زاد العدد في ثوان معدودات، آتياً من كل الشوارع الضيقة والأزقةـ، مختلطاً بعويل ونحيب، وأصوات صغار بدت كثغاء عنزات جوعى. فرقع دق الطبول، لينبه الناس، فأدركوا أن كبيرهم قد وصله الخبر. كان قد أطلق خفره وخدمه ينبهون، على طريقة سيدهم، من لا يزال غافلاً من أهل القرية.
انفتحت أبواب الدور عن آخرها، واندفع منها الفلاحون وزوجاتهم وأولاده. كل واحد يسحب ما لديه من ماشية، بقرة كانت أو جاموسة، وحماراً لا غني عنه في أي بيت. بعضهم كان لديه قليل من الضأن والماعز، فساقه أمامه. جرت الكلاب فالتحقت بأصحابها، تبعتها كلاب الشوارع وقططها التي لا صاحب لها. الكلب سارت إلى حيث يمضي الناس خائفين.
حملت النسوة ما قدرن عليه، من الأواني الرخيصة والطعام. من كانت لديها شيء من ذهب أو فضة طوقت به معصميها أو عنقها على عجل. حتى الصغار حملوا ما استطاعوا من أشياء البيوت القليلة.
كانوا يعرفون إلى أين يذهبون، فتزاحموا نحو الجسر، حين بلغه أولهم كان آخرهم ينسحب من طرف الشارع المؤدي إلى الزروع. لم يفكر أي منهم في أن يقف لينظر خلفه، فيرى ما إذا كان الماء الهادر قد اقترب أم لا، فأخطار الطبيعة في لحظة المداهمة لا تحتاج أحياناً إلى مواجهة، إنما هروب، ولا شجاعة في البقاء داخل بيوت إن بلغها الماء عفيّاً لن تصمد سوى ساعة ثم تنهار، كأنها لم تقم ولو دقيقة واحدة من نهار أو ليل.
كانت أقدام السابقين تثير الغبار على اللاحقين، فيتصاعد كثيفاً، ويحجب النجوم الزاهية، لكن أحداً لم يتوقف بحثاً عن نسمة صافية شاردة، فيمد إليها أنفه، ويلتقط أنفاسه المبهورة. كان عليهم أن يسبقوا خطواتهم ليبلغوا الجسر، فيضعونه بينهم وبين الماء الذي لا محالة بالغه بعد وقت قصير.
تجمعت النساء والصغار في الخلف، وعلى الطرف الأيمن دقت الأوتاد للبهائم، وأُدخلت الأغنام والماعز إلى حظيرة واسعة من الجريد، ووقفت أمامها الكلاب تحرسها، بينما استعدت الحمير لمهتمها الخالدة.
يضرب رجال فؤوسهم في الأرض، ويرفعون التراب إلى المزابل المنصوبة فوق ظهور الحمير. آخرون يجمعون القش، وأعود الذرة الجافة المكوَّمة على الجانب الأيسر، ثم يُرمى هذا فوق الجسر، ويُهال عليها التراب، لعله يرتفع قليلاً، في المكان الذي يحتمي فيه الناس من هجوم الماء.
بينما هم غارقون في عرقهم، انشقت الأرض عن الشيخ “غنوم الصابر” فوق جواده، يلهب حماسهم بقوله الذي اعتاد تكراره في المُلمّات: “الهمة يا رجالة.”
(4)
أكل الماء النجع. راح كأنه لم يكن كما تركه الأوائل، واحتفظوا باسمه معتقدين أنه يأتي إليهم بالبركة ونعمة العيش ولو على الحافة. وحده قصر السيد الذي بقي واقفاً، يصد عنه سور صلب، ومعه بيت “آل الجابر” الذي كان نصف جدرانه من أحجار الجبل. شارك النخيل والأشجار العالية هذين البيتين الصمود، ومعهما مئذنة الجامع الذي كان الجد “رضوان” قد بناه بالأحجار قبل خمسين عاماً أو يزيد.
اختفت المعالم التي ألفتها العيون سنين عددا، ولم تتراءى لها سوى الحسرات على ما ضاع. انقبضت القلوب بالمخاوف من الأيام الآتية، وكاد أن يقتلها القلق العارم. لم ينعقد الرجاء سوى في كرم صاحب القصر، الذي يعرف الناس كيف يجود بكل ما يقدر عليه حتى تنزاح الغُمة.
للقصر طريق أخرى إلى الجسر، لا يصل إليها الماء، فتصبح هي الرئة الوحيدة التي تتتفس منها القرية طوال أيام الفيضان. ينفتح الباب الخلفي عن العبيد والخدم، وهم يحملون قفف الخبز، وبلاليص الجبن القديم والعسل. ينبعثون وسط الناس، يوزعون عليهم ما حملوه.
الشيء الوحيد الذي لم يتغير في حياة المنكوبين هو قضاء حاجاتهم، إذ لم تكن في بيوتهم أكنفة ولا مراحيض، فكانوا يتسللون إلى الغيطان. يحفر كل منهم التراب تحته، ولمَّا ينتهي، يهيل التراب على ما أفرغه، فيصير للزرع سماداً. النسوة كنت قد اعتدن إمساك ما في البطون، حتى يجن الليل فتتسللن إلى الزروع، أو تقضين حاجتهن في أحواش البهائم، أما الرجال فلهم النهار والليل كالعادة. الصغار، الذين يتبولون في الشوارع، فلم يكن شيء يمنعهم عن التقدم نحو الجسر، فيقضون حاجتهم الثقيلة على طرفه فرحين، وكأنهم ذاهبون إلى اللعب.
مع الأيام غاض الماء. جاء بغتة، ورحل على مهل. وقف الفلاحون فوق الجسر، ينظر كل منهم إلى زرعه الغارق والماء ينجاب عنه رويداً رويداً، حتى ينحسر. اقتلع الماء كثيراً من الزرع، وأفسد ما تبقى، لكن هذا كله كان في نفوسهم، على قسوته، مقدوراً عليه. أما ما لا طاقة لهم به فهو غياب البيوت. تهاوت جدران الطين اللبن واستوت، وجرف الماء بعضها، فصارت أرضاً أخرى صالحة للزرع، ورعي الماشية، وقت أن يعود إليها النبات من جديد.
وقف فلاح على أعلى نقطة فوق الجسر، رفع إصبعه وغمسه في الخلاء، وقال: “كان هنا بيتي.” تبعه الجميع، وكل منهم يتحرى موضع بيته بين الغرقى، ووجوههم يكسوها الأسى من فرط خوفهم مما ينتظرهم من جهد في سبيل إعادة القرية التي صارت أثراً بعد عين. حتى الأطلال حرمهم الماء منها، ولم تبق سوى الذكريات الحارة الحيَّة.
سرى بينهم خبر، وهم يتابعون انحسار الماء في رجاء وحسرة، أن سيد القرية سيختار لها موضعاً آخر، خلف الجسر، من أرضه الفسيحة. أشاع شيخ الخفر بينهم ما تقرر، وهو يقول: “سيبنيها سيدكم من ماله، والجهد عليكم.”
هللوا، ورفعوا الأكف إلى السماء داعين له بطول العمر والبركة. لاحت في عيونهم أيام جديدة، بعد أن أجيبوا على سؤالهم: “متى نبدأ؟” فقيل لهم: “اليوم، قبل الغد.”
قسَّم المَسَّاح الأرض. أعطى “الصوابر” المكان القريب من القصر على اليسار في وجه النسيم. عن يمينهم بيوت “الجوابر”. أعطى “آل بخيت”، الذين منهم عبيد السيد وخدمه، قطعة أرض في الخلف، إلى جانب بيوت النصارى. كان في القطعة الأخيرة شارع صغير فيه مكان للمزين، والنجار، والحداد، والمقرقرين الذين يذرون أجران الحصيد، وكانوا من النصارى. أقيم دكان بقالة يتبضع منه الناس ما يأتي به من البندر صاحباه “اسحق” و”باراك”، وهما اليهوديان الوحيدان في القرية، مع زوجتيهما، ولهما أربعة، ولدان وبنتان.
حدد المسَّاح الشوارع والحارات، وحرص على أن تكون مستقيمة، على خلاف ما كانت في القرية الغارقة. لم يحرم كل واحد من جاره عن اليمين والشمال، وفي الأمام والخلف، وكان كل هذا ليس خافياً على من يمسك قصبة القياس، ويرفعها ثم يحطها على الأرض ليقرر مصير الناس.
……………………………..
*نقلًا عن جريدة “أخبار الأدب”، مقطع من رواية تصدر قريبًا في ثلاثة أجزاء عن الدار المصرية اللبنانية.