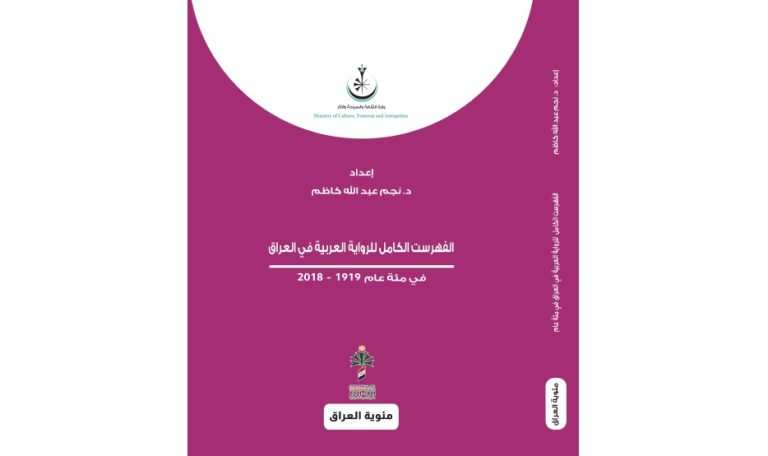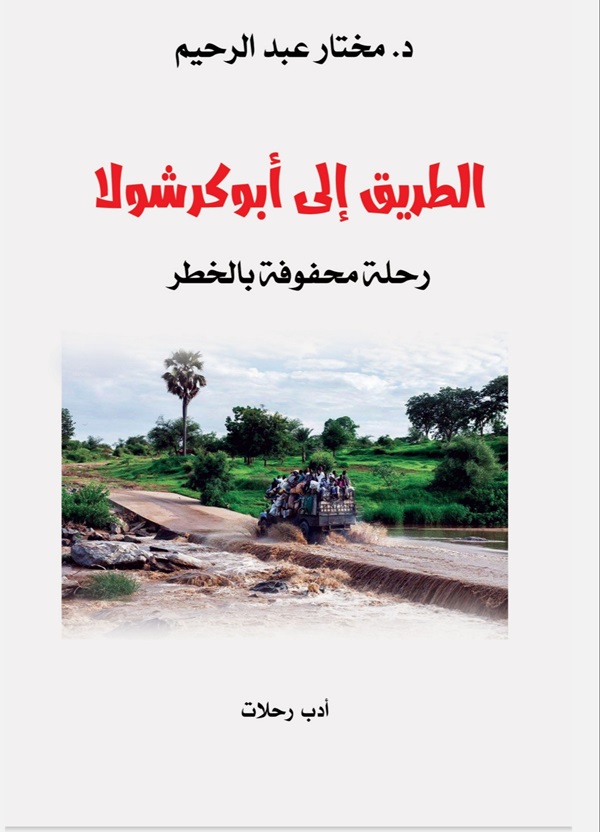.ولا يكفي أن نطلق على هذا النوع من القص اسم «رواية الحساسية الجديدة» أو ما تنطوي عليه من «كتابة عبر نوعية»، على نحو ما قد يفعل إدوار الخراط مثلاً، فمسمَّى «الحساسية الجديدة» أصبح أقدم وأضيق من أن يستوعب مثل هذا القص، خصوصاً داخل تعقد المشهد الروائي، الآن، شأنه في ذلك شأن مصطلح «الكتابة عبر النوعية» الذي تجاوزته تحولات الرواية العربية المعاصرة إلى ما هو أوسع منه، خصوصاً في تراكمها النوعي وآية ذلك أن السرد في «مسألة وقت» أقرب في بنائه وتحولاته إلى طبيعة «المدينة المسحورة» التي يتحدث عنها الشاب في نص «ألف ليلة» الذي تفتتح به رواية منتصر، وذلك بما يجعل من النص المقتبس شبيهاً بالعتبة التي نعبر منها إلى غيرها الذي يغدو نتيجة لها بمعنى من معاني التدفق السردي الذي يتحرك فيه الزمن كالبندول، ذهاباً وإياباً، إلى الأمام أو الوراء، أو يتحرك السرد حركات متناثرة، متشظية، على نحو يزيل الحواجز بين الحلم واليقظة، الغموض والوضوح اللذين يتبادلان الوضع والمكانة وأخيراً، السؤال الذي ينقلب إلى جواب والجواب الذي يغدو سؤالاً في دوامة السرد الذي يتدافع في تجسيده حبكة بسيطة ظاهرياً، لكن لا يظهر منها إلا مثل ما يظهر من جبل الجليد، أصغره ظاهر للعيان، ومعظمه مغمور تحت الماء أو تحت سطح الوعي بلا فارق أما الصوغ اللغوي فيتجه إلى هدفه مباشرة، من دون إطناب أو حلي مجازية مزخرفة، فالسرد كله يميل إلى الإيجاز، مقاطعه صغيرة، متتابعة، كأنها أضواء متقطعة على ضفيرة الوعي التي لا تعرف سوى الحوارات البسيطة التي تومئ إلى المسكوت عنه من الكلام غير المباح أكثر من المعلن عنه من الكلام المباح، إذا استخدمنا لغة «ألف ليلة» منجم الأسرار الممزوجة بالسحر وتنبني، عبر المقاطع المتتابعة للرواية، شبكة دوال لا تكف عن توليد الالتباسات، كأننا في حضورها الملتبس، قاب قوسين أو أدنى من متاهات بورخيس ومراياه التي لا تزال تفتن منتصر القفاش، وتجذبه إليها، بل تعود به إلى بعض تقنياتها في السرد الذي يبدأ بسيطاً، لكنه سرعان ما يغدو متاهة، ندخل إليها من أي مكان شئنا، لكن من دون أن توصلنا إلى نهاية محددة ولذلك فالحبكة تميزها البساطة الخادعة التي تنتهي بك إلى ما يشبه البداية، لكن مع تراكم الأسئلة، في مدى الحيرة التي لا تجعلك تركن إلى نتيجة، تهدأ معها رغباتك الفضولية، بل تتزايد هذه الرغبات، فتغدو، أيها القارئ، صانعاً للمزيد من الأسئلة، مشاركاً في تأويل اللغز الذي تنبني عليه الرواية فليس في مثل هذا النوع من الروايات دلالات تريح القارئ الكسول، أو حلول نهائية، فكل شيء متحول، في فعل القراءة الذي يتحول إلى تأمل في زمن سيَّال، لا سبيل إلى الإمساك به، أو تثبيته، أو إيجاد حلول سهلة لمراوغاته التي تجرّ القارئ إلى رمال متحركة من الالتباسات.
والبداية بسيطة يحيى، موظف حسابات في مركز توزيع يديره لواء سابق، يرسم دوائر التوزيع على خريطة القاهرة كما كان يرسم مواقع جنوده على ساحة معركة أعجبه من يحيى ذاكرته التي تحفظ كل شيء، فلا يقدر على خداعه أي من المندوبين الذين يقومون بتوزيع المنتجات وقبل عمل يحيى مباشرة، أو أثناءه، لا ندري تحديداً، يُعرض عليه أن يقوم بتدريس مادة الرياضيات لطالبتين، إحداهما رنا، فيبدأ التدريس لهما معاً، ولكنه يفاجأ برنا تحضر إليه، وحدها، في بيته الذي يقطنه مع أمه الأرملة، وتقتحم عليه الغرفة في جرأة لم يعهدها، وتمارس معه الجنس، على رغم ذعره من دخول أمه عليهما في أية لحظة، وتم كل شيء بسرعة خاطفة، وتركته في صدمته، لكن بعد أن أعارها قميصه بعد أن اكتشف أن «بلوزتها» ممزقة من الظهر. وتمضي الساعات التي تترجع، كأنها موجات زمن ملتبس، فيأتي إليه خبر موتها، غرقاً في المعدّية التي تصل بين شاطئيّ نهر النيل. وإلى هنا، فالحدث عادي في ظاهرة، بسيط ومألوف وقائم على منطق الاحتمال والضرورة، حسب نظرية المحاكاة الأرسطية خصوصاً، والكلاسيكية عموماً، ولكن سرعان ما ينقلب ذلك رأساً على عقب، كما لو كان بفعل السحر، فعندما يذهب يحيى للعزاء في تلميذته يكتشف أنها غرقت وماتت قبل الوقت الذي كانت معه في غرفته وعندئذ نفارق عالم الوضوح إلى عالم لم يعد فيه وضوح، عالم لا سبيل إلى مواجهة اللغز الذي يطرحه سوى وضع اللغز نفسه موضع المساءلة، ووضع الزمن، بدوره، الموضع نفسه ويزداد لغز الموت التباساً كالزمن الذي وقع فيه سواء بسواء ولا يبقى من رنا سوى بلوزتها المقطوعة من الظهر، كأنها دليل مادي على أن وجودها لم يكن حلماً أو وهماً، وإنما أمنية مستحيلة يمكن أن تحدث، مصادفة، على نحو لا يقين فيه، فهل يتحرك الموتى بعد موتهم ليحققوا رغباتهم المقموعة التي حُرموا منها في حياتهم؟ وهل يتحرك الكائن الحي الذي مرّ بهذه التجربة حركة من عانى شيئاً حقيقياً أم وقع في نوع من السحر الذي وقع على الملك، في نص «ألف ليلة» المفتتح للرواية؟ والسحر تحويل للكائن من حال إلى حال، ومخادعة للوعي بما يجعله يتوهم ما لم يحدث، فيدخل الدوامة التي يختلط فيها الزمان والمكان، وينتقل البطل من عالم الواقع إلى عالم الوهم الذي يبدو كأنه ليس وهماً، بل لغزاً يفرض نفسه على السرد، ويجذب العناصر المتناثرة إليه كما يجذب حجر المغناطيس ما يتجانس وإياه ويتلاعب الكاتب الماكر باللغز الذي يصبح هو صدارة السرد، يتوزع عمودياً بمقاطعه القصيرة التي هي أقرب إلى تتابعات ضوئية، متغايرة الملامح، كما يتوزع أفقياً بين شخصيات ترافق البطل في رحلة البحث عن حل اللغز، مثل ناهد التي هي مرآة رنا والموازي الرمزي لها، فضلاً عن غيرها الذين تجمعوا في دائرة إدراك «مسألة الوقت» أو «مساءلة الزمن» مثل والد يحيى الذي توفي، وأمه الأرملة التي تكتب ما تريد منه شراءه في ورقة كي لا ينسى مثل أبيه، وأخيراً صاحب العمل الذي يفيد من توقد ذاكرة يحيى، فينيبه عنه.
ويعني ذلك أن دال الزمن يتعامد على دال الذاكرة التي تختزن الزمن في مداها الإدراكي، والتي تعاني من لغزه على السواء، خصوصاً إذا التبس عليها فهم الزمن، فلا يبقى لها سوى مطاردته والسعي إلى اقتناصه، كأنه الطريدة التي لا يصل إليها الصائد إلا بالتدقيق في كل احتمالات حركاتها مقدماً، وتذكر التفاصيل الصغيرة التي قد يفيد تذكرها، مهما صغرت، في اقتناص الطريدة، وذلك في مدى الإدراك الذي يخايلنا بوضوح موضوعه، وحاجته الدائمة إلى الكشف عن ما يظل، دائماً، في حاجة إلى الكشف، مهما كان وضوحه ولذا تبدو صديقة رنا وجهها الملازم لها، في التهوس بالتفاصيل الصغيرة، سواء في حياة رنا، أو بعد موتها.
ولكي يكتسب السرد المزيد من ملامحه، في المجرى الملتبس الذي يمضي فيه، تتضمن شخصية البطل، السارد بضمير المتكلم، بعض صفات القارئ المثقف، فهو يقرأ كتاب «ألف طريقة وطريقة لتحفيز نفسك» وهو الكتاب الذي يرافقه منذ زمن طويل، ليس فقط بسبب أنه ألف طريقة، بل لقراره تنفيذ إحدى هذه الطرق التي أكد الكتاب أهميتها «لا تسرع في قراءة ما يفيدك» ولم يكن يحيى أول من قرأ هذه النصيحة أو ذلك الكتاب بالقطع، فكثيرة هي الكتب التي قرأها عن تنمية النفس أو تطويرها أو تحفيزها ولكن توقفه أمام هذه النصيحة، الطريقة، يعيدنا إلى تعامد الزمن على الذاكرة أو العكس، فالبطء في قراءة ما يفيدنا يعادل القدرة على اكتمال الفهم بالتأنّي إزاء ما نقرأ، وجعله، مرات ومرات، موضوعاً للتأمل الذي يضيف إلينا، كل مرة، ما يكمل اكتشاف طبقات المعنى التي قد لا تكون ظاهرة في القراءة الأولى أو الثانية، فكل ما نقرأ، مهما كان انكشاف معناه، يظل في حاجة إلى المزيد من الكشف، ذلك لأن كل نص مكتوب ككل حدث، يخادع من يقرأه أو يدركه بوضوحه أو بساطته الظاهرة على مستوى السطح الذي يخفي أكثر مما يبين ولذلك يتحد يحيى القارئ بشخص الكاتب الذي ما إن يقول «أنت» حتى تصبح هذه «الأنت» «أنا» يحيى الذي يتطابق، وجداناً وعقلاً، مع الكاتب، ويكاد يسمع صوت فرحته بأمثلة الكاتب حتى لو كانت مستحيلة، ويظل كل مثال هو «أنا» يحيى الذي تخيل هذا المثال من قبل، ولم يخبر به أحداً، وحرص على إخفائه داخله، فصار مثل شخص لم يجد مكاناً آمناً، يخفي فيه مفتاحه السحري فابتلعه، ومضى عارفاً أن الكنز في داخله، لكنه يجهل الطريق إليه.
هل هذا ما حدث ليحيى مع رنا، ابتلع حضورها المادي، رمزياً، أو استعارياً، وأحاله إلى حضور كنائي، ألقى به في أعماقه، كأنه الكنز الذي يحتويه القارئ داخله، من دون أن يعرف طريق الوصول إليه، أو استعادته؟ الأمر ممكن وغير ممكن في الوقت نفسه، فلا تفسير حاسماً في رواية منتصر التي تومئ بكتاب «ألف طريقة وطريقة» على سبيل التناص إلى كتاب «ألف ليلة وليلة» التي تجمع ما بين السحر وحضور كائنات هي نوع من غياب الحضور وليس لدينا، بعد تجاوب دلالات التناص التي لا تفارق دال الزمن، سوى علامات مثل جملة «فارق التوقيت» التي قالتها زميلة في العمل للبطل الذي لم تطق انتظاره حتى يستعد للزواج فأعلنته بانفصالها عنه، بعد أن ظل يطلب منها انتظار التوقيت المناسب، مؤكدة له أن فارق التوقيت بينهما كبير ولكن هل هذا الفارق هو الذي أضاع منه رنا إلى الأبد، مع أن حضورها الذي يشبه الغياب، وغيابها الذي يشبه الحضور لا يكفان عن مخايلته، كأنها في داخله وخارجه، فتبدو أشبه بالذكرى التي تدخلها الذاكرة إلى زمن الديمومة، أو الزمن الذي تبتلعه الذاكرة وتخلفه في أعماق الكائن الذي أضاع مفتاح ذاكرته ولذلك يظل يحيى يسعى، طوال الرواية، إلى البحث في ما يشبه السراب، بلا دليل ظاهر، أو علامة محددة تهدي السائر في طريق لا يعرف سوى علامات ملتبسة.
ويلزم عن ذلك، أنه لا يوجد في رواية منتصر أكثر من الأسئلة التي تتوالد ذاتياً، من دون إجابة نهائية لماذا زارته رنا؟ وكيف جاءت إليه بعد موتها؟ وكيف تحولت إلى حضور في حياته؟ ولماذا لا يكف عن الحديث عنها كما لو كانت موجودة فعلاً؟ ولماذا يتقرب من صديقتها كأنها امتداد مرآوي لها؟ ولماذا تحافظ صديقتها على خصال المرآة التي تعكس ما لم يعد أمامها؟ ومن المفيد استرجاع رمزية المرآة المسحورة التي تظهر ما لا وجود له، وتفتح الطريق إلى عوالم سحر، لا سبيل إلى التيقن منها.
ولا يماثل كثرة الأسئلة سوى كثرة الأمنيات والرغبات المقموعة، لكن بما لا يجعل مبدأ الواقع يهيمن على مبدأ الرغبة، ويناقل بينهما إلى الحد الذي يقلب كل وضع ويحيله إلى نقيض له، وذلك في مدى الرغبات التي تبدو نهاياتها كأنها سراب والنتيجة ما يتمناه يحيى من إمكان حدوث هذه الحكاية التي لم يسع إليها أصلاً ولم يفكر فيها ابتداء، وبدلاً من انتهائها عند حد زيارة رنا المفاجئة له، يتمنى لو لم تتسع وتتشبه بما يحدث كل يوم، وتفرض عليه أن يتتبع خطواتها خطوة خطوة ويتخيل إمكان أن تغمره كل الأحداث دفعة واحدة، بلا تمهّل ولا انتظار، فلا تتيح له أي وقت ليفهم كل جزء على حدة، فيبدو حاله حال من يحلم حلماً مستحيلاً، يلهث فيه، ويتحمل ما لا يقدر عليه لكنه في النهاية يستيقظ ويسند رأسه إلى حافة السرير مستعيداً ما يراه من دون قلق، معتقداً بأن الوقت متاح بين خطوة وأخرى، وكل حدث يختبر مدى ردود فعله ليظهر له الحدث التالي، كأن الحكاية تغوي يحيى قبل أن تغمره بكل قوتها، كي يمضي إلى النهاية، حتى لو ظلت النهاية غير معروفة.
ولا تتوقف الغواية كالأسئلة والرغبات، فالغواية مقرونة بالسحر في رواية منتصر التي تنتهي بأن يتساءل بطلها عن إمكان أن يكون هو المسحور الذي لم يقدر على رؤية من حوله، أو من دخلوا إلى متاهات الغواية ومراياها وتدفعه رغبة تخلّصه من سحر الغواية إلى التأكد من الناس حوله، فالمسحور يظن دائماً أن الآخرين هم من سُحِرُوا، غير مدرك أن السحر فيه لا في غيره.
ولكن هل مضت حياة يحيى على منوالها، كما تمنى في الأسطر الأخيرة من الرواية؟ غالب الظن أنه سيظل كالوتر المشدود ما بين الوهم والواقع، مذبذباً بين الاثنين، الأمر الذي يتسع برُقْيَةِ السحر الذي دخل إلى عالمه، عبر متاهات المرايات التي تجعل من حضور صديقة رنا حضوراً متصلاً، يوازي غياب رنا التي أصبحت حضوراً لا غياباً، ويحمل يحيى بعض صفات أبيه، أو يتقمص المؤلفين الذين يقرأ لهم فيغدو إياهم، ويتحد مع رنا وصديقتها في جنون البحث عن التفاصيل، داخل كل خبر ينتقل إليه، أو في كل حدث يدركه والنتيجة هي أن اتساع رُقْيه السحر تبتلعنا، نحن القراء، بعد أن أدخلتنا إلى عوالم لا ننتبه إلى حضورها مع أنها فينا وقائمة بنا، وتبقينا كالكاتب وتراً مشدوداً ما بين نقائض كثيرة، تنداح حدودها التي يدفعنا تلاشيها إلى معاودة النظر في عالم المتاهات والمرايا الذي أصبح فضاءنا في عالم ما بعد الحداثة عالمياً، وعالم ما بعد التخلف عربياً، وما بينهما برزخ نهيم فيه، بلا وعي، تائهين ما بين زمن يبدو كسراب، وذاكرة لا تنشغل إلا بما مضى، حالمين بما يحل اللغز، أو يبطل السحر، فيتكشف المخبوء الذي لا نعرف الطريق إليه، فنحن كالكاتب في مقام الحيرة التي يزيدها توالد أسئلة الوجود الذي لا نعرف عنه إلا ما يزيدنا حيرة وتيهاناً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ناقد وأكاديمي مصري