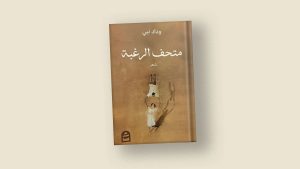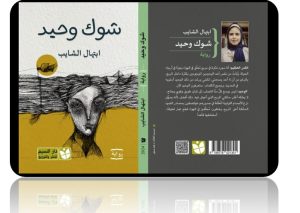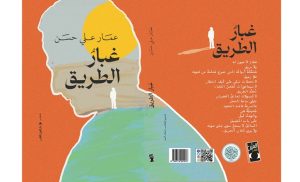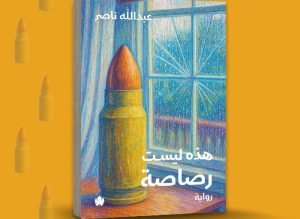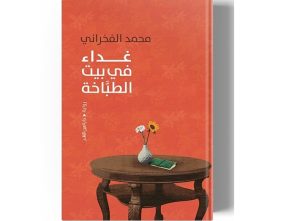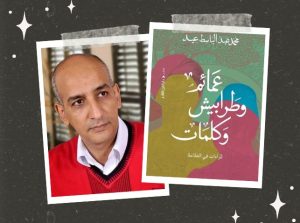أسامة كمال أبوزيد
ولد مدحت منير مطلع الستينيات في مدينة تطل من نوافذها على القناة، وتحمل في نسماتها سيرة الذين مرّوا من هنا، وغنوا وسكتوا، أو حفروا أسماءهم في الرمل المبلول بالملح. ولم يكن هو بعيدًا عن هذا النشيد الصامت. فمنذ بداياته، بدا كما لو أنه مشدود إلى نبرة غائرة في القلب، قصيدة تمشي على قدمين، لا تشبه أحدًا، ولا تريد أن تشبه.
ظهر مدحت في مطلع التسعينيات مع جيل طليعي مغامر، جيل كان يبحث عن صوته في الصمت، وعن شكله في المرايا المكسورة. من بين رفاقه: مجدي الجابري، محمود الحلواني، كوثر مصطفى، مسعود شومان، مصطفى الجابري… جيلٌ بدأ مغرمًا بقصيدة النثر العامية، مغرمًا بشوارع القاهرة الخلفية، وجدران القرى، وبصوت الجنازات والفرح، لكنه تخلى عن هذه القصيدة لاحقًا، تباعًا، كأنها نزوة مرت، فيما بقي هو، وحده، على العهد، حارسًا لجمرة هذه القصيدة، لم يخنها يومًا، ولم يساوم على نبرتها.
منذ بداية التسعينيات، كتب مدحت منير قصيدة نثر العامية، ولم يتخل عنها أبدًا. ظل يطاردها كأنها حبيبته الأولى، أو ظله الأخير، حتى حين تبدل المشهد الشعري، وتغيرت الذائقة، واستقرت المؤسسات على شكل شعري سائد، ظل هو يكتب قصيدته كمن يحفر نفقًا سريًّا للضوء.
لكنّ تلك الملاحقة لم تعد مشروطة بشكلٍ واحدٍ أو قيدٍ سابق. فالشاعر الذي ظل وفيًّا لقصيدته، لم يعد أسير تسمياتها، بل صار ينحاز، في السنوات الأخيرة، إلى القصيدة بوصفها فعل اصطياد للدهشة، واستنطاق للمعنى، لا مجرد انتماء شكلي. لم يعد معنيًّا بإثبات هويّة القصيدة، بل باكتشاف فن الشعر حين يمر، خفيفًا أو كثيفًا، ناثرًا أو موزونًا، مادام ينبض.
إنه، ببساطة، لم يغادر القصيدة، لكنه وسّع بيتها.
في دواوينه الستة التي طُبعت ونُشرت حتى الآن، تظهر نبرة الشاعر الذي يكتب من قلبه، لا من مكتبته. شاعر يعرف شوارع المدينة، لكنه يعرف أيضًا عتمة القلب، وبراح الوحدة، ولهذا فإن قصائده لا تستعير صوتًا، ولا تتكئ على مرجعية نظرية، بل تشبه جملة قيلت في لحظة حبٍّ مهدد، أو همس أمٍّ في وداع ابنها.
في ديوانه المدهش «مبروك.. خسرت الانتظار»، يُعلن الشاعر عن خساراته، يعلنها كما هي: لينة، طازجة، وعارية. لكنه لا يبكي، بل يكتب فى قصيدة:
ماحدش أذكى م الأيام
فتحت لي أحلامها
في وش الفجر
ودخلت انا ..
أمسح بإيدي التراب
من سقفها العالي
وأبعد..
سلام الورد
عن قلق الرفوف
قالت : ياصاحبي
سيب الحياة
تشيل وتحط براحتها
ده مهما غّمت عينيها
هانفضل ..
جوه مرايتها
واديها بترتب صورنا
حسب ماتشوف
فمشيت أنا والفوضى فى البراح
شايلين معانا الحكاية
من بدايتها
سايبين حروف النهاية
يزرعها الفضا
وتحصدها الظروف
تلك القصيدة، كما معظم نصوص الديوان، لا تقوم على الإيقاع الظاهر، بل على إيقاع داخلي عميق، إيقاع النفس وهي تتنفس تحت الماء. واللغة هنا ليست وسيلة، بل هي الكائن نفسه. العامية المصرية تُفتح هنا على أفقٍ وجدانيّ شاسع، لا تَزْجِيها العبارات المألوفة، بل تعيد اكتشاف الكلمات، وتحررها من استخدامها العابر.
ديوانه الآخر «مكان مريح للحزن» هو حقل دلالي لتجريب الحزن كمساحة للعيش، لا كمناسبة للندب. في هذا الديوان يبدو كمن يجهّز سريره للدموع، لكنه ينام في هدوء. أما في «عنف ومحبة»، فالصراع بين القلب والعالم يُصاغ في نبرات عاشقٍ يجيد الرفض بقدر ما يجيد الحنين. نصوصه تمضي كمن يُلقي حجارة صغيرة على سطح بحيرة، لا يريدها أن تفيق، بل أن ترتجف فقط.
في «كان لازم نرقصها سوا»، يتحول الجسد إلى مشهد شعري، حيث الرقص استعارة للحياة نفسها، وللخذلان أيضًا. أما «بالقميص الكاروهات»، فهو أقرب إلى المذكرات العاطفية، نصوص قصيرة كتبتها الأصابع وهي تلامس قلبًا لا يهدأ، ومُحيت سطورها بدمعة لا ترى.
في «مبروك.. خسرت الانتظار»، يعود إلى لغة الصدمة، كأن كل كلمة تمشي فوق سلك كهربائي، أو كأنها اعتراف أخير في عزلة قاسية. القصائد هنا متقشفة، لكنها دامية، تذهب إلى الجملة القصيرة كما يذهب الجريح إلى الممرضة، بلا مواربة:
عابر سبيل
حكم عليه المطر
يغسل جبينه من الوصايا
وفضل كده
شفاف
فى روح الزمن
من قبل ماندخل
لأطلال الحياة
وفضلنا كده
عايشين بفكرة
إننا صحاب الحكاية
وإلى جانب دواوينه المنشورة، لدى الشاعر ديوانان جديدان قيد الطبع: «ستوديو حرارة للتصوير»، و« شيخوخة بالألوان»، اسمان يكشفان عن قدرته على المفارقة والاختراع، تلك اللغة التي تجمع بين الكاميرا والذاكرة، بين البروفة والرحيل، بين الشعر وتحوّلات الجسد والزمن.
لا يُمكن أن نقرأ مدحت منير كما نقرأ باقي شعراء جيله. هو لا يكتب ليثبت أنه شاعر، ولا ليكون في واجهة المشهد. هو فقط يكتب، لأن القصيدة لا تمنحه مهربًا، أو لأنه اختار – منذ البداية – أن يكون فى قلب النار، لا على هامشها.
ربما لم يُكرَّم كما ينبغي، ولم يُحتفَ به كما يستحق، لكنه – في كل مرة يكتب فيها – يؤكد أن القصيدة، حين تخرج من قلب حيّ، لا تحتاج إلى صخب، بل إلى قارئ واحد فقط، يصدق.
وهو، في ذلك، مثل نهرٍ صغير، يسير في الظل، لا يراه أحد، لكنه يصل دائمًا. أو كغيمةٍ تأخرت في السماء، لكنها وحدها من تمطر.