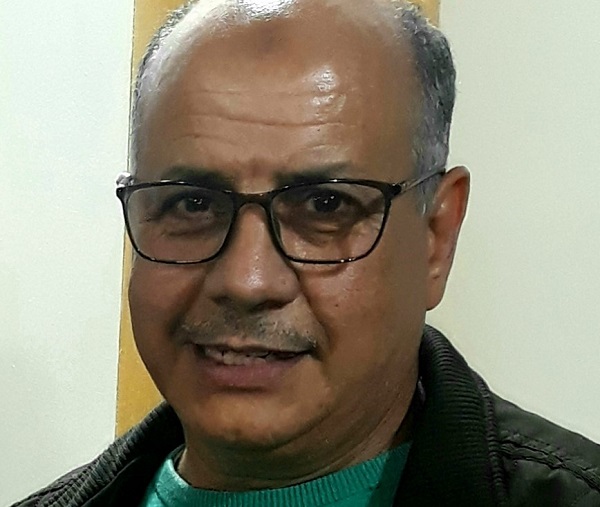جزء ميت
يدين له الجسد بكامله
بتلقى جرعات زائدة من المهام الخشنة للبيوت
بالانزواء في الظل
بتصدر مسيرة الجسد نحو الفناء
كانت تسير في الشارع
وشعرها المصبوغ يطير في هواء العشرينيات
أما قدمها
فكانت تسبح في زمن آخر .
ماراتونات ضاحكة
كان يعمل بواباً لإحدى العمارات المجاورة
يقطع كل يومٍ ماراتونات ضاحكة للعيش والخضار
بجانبى كانت هناك محطة ظليلة،
مجموعة من القلل علقها جارى لعابرى السبيل
لا يستطعم بأى ماءٍ
إلا بهذا الماء الجماعى.
دائماً أحذيته تفوق قدمه عمراً و طولاً .
لسيره صوت خشن،
ولكن هذه الغفوة في القدم
هى أكثر ما تشعرنى بطيبته
هى وغفوة في لسانه
يتكلم فتهرب الحروف بغير رجعةٍ .
فى إحدى المرات، أشار إلى جزءٍ من سبابته
و أخبرنى بأن حبة بحجم الفاصوليا
نبتت في رأس زوجته.
أعاد علىّ ما أخبره به الطبيب.
الطبيب أيضاً كان يرى الحقول
التى يحتفظ بها في يده وتحت أظافره .
أثناء مروره، أستوقفه
و أسأله عن مصير حبة الفاصوليا.
يهز يده يميناً و يساراً
كقارب منسى وسط المياه.
يده المرتعشة كانت أكثر حكمة .
من سيره بدأت أحدس بمصير تلك الحبة،
أحياتاً أستوقفه
أحياناً أتركه يكمل رحلة الجمع والطرح إلى البيت.
و لكن في كل الأحيان
لم ييأس من حبه للمياه والظل .
صار سؤالى محطةً لى أيضاً
شهور والقارب يمتلىء بالمياه
تميل اليد’ إلى ناحيةٍ واحدة.
فى يومٍ أزهرت حبة الفاصوليا
و عاد برأس زوجته إلى موطنها في الحقول.
9شارع قرداحى
كل عدة أعوام،
عندما تخفت في خزانتها لمعة الذكرى
تحزم حقائبها وتتكئ على العصا المعدنية
و تأتى للإسكندرية،
للبيت الذى عاشت فيه مع والديها؛ 9 شارع قرداحى .
مازالت الفيلا قائمة حتى الآن
ربما لكى لا يخذلها شئ واحد في الحياة.
تمسح بمشيتها البطيئة
كل التفاصيل التى غابت عن عينيها
تجذب كل معادن الذكرى.
تقف أسفل البيت
تشاهد النافذة االتى أطلَّت منها وهى طفلة
لترى خيوط المؤامرة تتجمع في الحديقة
كان الشارى الجديد يقيس أرض طفولتها بالأمتار.
بكت حينئذ،
بكاءَ الأبنة الوحيدة،
كانت أصغر من أن تغلق النافذة على دموعها
أو تهيم فوق الذكرى وتكبر معها كأخٍ حميم.
يعرفها أهل الشارع جميعاً
و يفسحون مكاناً لبكائها.
كنت الغريب عن ذكراها،
عن نافذة الدموع التى لم تغلق أبداً في خيالها
منذ غادرت الإسكندرية إلى نافذة أخرى مرصعة بالثلج في سويسرا .
لم يكن بيننا ما يسمح بكل هذه الأسرار
سوى أنى أصبحت جاراً لنافذة الطفولة .
كان علاجها الناجع، أن تعودَ
و تنظر إلى بيتها القديم .
تركتنى و صوت العصا المعدنية
يرسم حدود الذكرى
صوتُ رتاجٍ يُغلق لباب كبير .
حرارة الغناء في الستينيات
كنت أرى السعادة في غرفة المطبخ لبيت صديقى. الأجساد الكثيرة التى تروح وتجىء، الصدامات المتكررة بدون اعتذارات أو انتظار لها، برطمانات المخلل والأطعمة الحريفة، أرغفة الخبز الرقيقة.
كل وجبة كانت احتفالا، بالخيط الذى يربط بينهم، بالطعام، بالكلام المهم والفارغ، بالثرثرة .
سور واحد كان يفصل بيننا، في نهاية اليوم كنت أتسّمع من غرفتى لصوت اخته الرخيم، وهى تغسل الصحون وتغنى حافية. كانت تحب عبد الحليم ونجاة وأم كلثوم . تحاول أن تظهر جذوة النار التى تسكن خلف أصواتهم.
انقطع حبل الغناء في بيت صديقى . مات الأب وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم . تزوجت البنات وأخذن لبيوتهن حرارة الغناء في الستينيات. تزوج صديقى وأنجب، أصبح مدمناً لميراث البيت من الأغانى العاطفية. اختار عملا مناسباً، يتيح له أن يؤجل عودته للبيت، اشترى تاكسياً بمسجل يابانى، واطلق لحيته. يدور في الشوارع والأحياء الشعبية، ينحنى للرزق، وللبيوت التى يتصاعد منها الغناء القديم.
شىء قاس أن نظل أصدقاء حتى العقد الخامس، بدون سنوات ساقطة، ينسب لها ماأخفق من أحلام. منذ كنا صغاراً وصديقى يحلم بمعجزة تغير حياته. لكى تطلق نبوءة وأنت صغير، يجب أن تقتل كل من شهد عليها. كنت الشاهد الوحيد، والتمس له العذر، وهو يتحاشى أن ينظر لى، وأنا أعدّ السنوات المتبقية من حياته وحياتى، متسائلاً هل تكفى لكى تتحقق المعجزة ؟
مازلت أؤدى دوراً حزيناً
بينه وبين قبرها، المسافة أقرب منه إلى السرير، حيث ترقد وتنادى ملائكة الموت، وهو مستسلم، يجلس أمامها بدأب،يؤرجح عينيها بحكاياته، صامتاً قدر الإمكان، حتى لآيؤلب الملائكة أكثر بنحيبه. منذ أن تجاوز الأربعين، وهو يفكر بدور جديد له في الحياة. عشرون عاماً يفكر، خذلته الأمومة، يضغط الموت ضغطة خفيفة على قلبه، فيفر إلى أعوامه الستين ليستنجد بها، بالكرامة المفروضة لبياض شعره ،يردد وهو يعبر الممر الضيق إلى غرفته: مازلت ابناً ، مازلت أؤدى دوراً حزيناً في الحياة .
عندما ازدحمت الغرفة بالمياه، ولم يعد هناك رفيف لأجنحة ليقاومه، خرج بهدوء لا يلوى على شىء. نزل إلى الشارع الكبير ليند س وسط جموع حزينة، ساعات وهو يحمل جثمان امه في عينيه.
فرغ الشارع من الحنان، فعاد إلى البيت، كانت الغرفة خالية تماماً. بعدها كلما هم بنزول الشارع والسير وسط الجموع شعر بحزن كبير يطارده، بخيط من المياه يجرى وراءه.
سنوات الطفولة العمياء
صديقى من أيام الطفولة
صديق الابتسامات البعيدة
والإيماءات المقتضبة،
ترك التعليم وترهل جسمه ترهل المستسلمين،
واختار أن يعمل كمسارياً
ليضيع وسط الزحام.
مثلى لم يبرح الحى
وسيكون لكلٍ منا ذكرى ينحنى لها.
أراه كل يوم ببدلته الرمادية
وبعض السندويتشات في يده
للوجبة المخطوفة وسط ركام العملات الورقية.
لا يشعر بأى غضاضة من لون بدلته المميز،
من موقعه السائب في الحياة.
كان هدفاً لدعاباتنا.
فى يوم من الأيام،
طوح أحدنا بيد الطفولة العمياء
حجراً مسنوناً استقر في رأسه.
وضع يده على الجرح بقوة
وأزاح عنه أيدينا المطببة،
كأنه لايريد لأحد أن يتدخل في أموره الشخصية.
وسار إلى بيته
حتى غاب عن أعيننا
وأخذ بكاءه معه إلى البيت.
يومها بكينا جميعا بدلاً منه.
أثناء خطوه اليومى،
يمد وراءه خيطا رفيعا من الدماء.
ربما لوتتبعت هذا الخيط
لفقدت الأمل باستعادة أى ذكرى
من سنوات الطفولة العمياء.
سنواتى الجميلة
أعيش الآن سنواتى الجميلة
لا أعرف أى مدار كونى يرعى حياتى
أى نجمة شاردة تبعث في هذا الأمل.
ولكن وأنا مسافر،
هناك خيوط تنسل من ثيابى،
تتعلق بمسمار، بحائط،
بكرسى قديم أريقت عليه الكثير من الحكايات.
تُجرح الثياب لكى تستمر الذكرى.
ولكن في كل شارع أو بلد مررت به
هناك كرسى جلست عليه،
وسيجارة أو أكثر دخنتها بشغف
وحديث كان يؤجل علينا طلوع النهار.
عاملة النظافة
داخل أى فندق أحلُّ به
لا أفكر إلاّ بعاملة النظافة
التى تأتى أثناء غيابى
و تطَّلع على حياتى الداخلية.
بالتأكيد هى ترسم صورة لكل نزيلٍ
و ربما تحتفظ بأثر لا يُلحظ
لكل أصدقائها الغائبين.
أتحاشى أن ألتقى بها،
بكل من له القدرة على التطلَّع إلى نفسى
إلا لمرة واحدة.
ليس هناك سر .
و لكن الحياة الداخلية شفافة أكثر مما يجب .
حياة تسير على الجدران
مع كل جهازٍ كهربائى يُضاف
إلى أرشيف البيت،
سنة بعد أخرى،
تكثر الثقوب في الحائط،
المسامير المنسية لوصلات قديمة،
ولأطراف مبتورة .
الأرض وهى مفروشة بتلك الأغصان الملتفة،
من كل غرفة تخرجُ فروع دقيقة،
تتسلق هواءً لا نصل إليه بذكرياتنا.
فى صمت الليل و نحن نائمون،
هناك حياة تسير على الجدران وفي الزوايا،
أزيز كصوت الحقول .
أى بيت مهما تعالت جدرانه
مكشوف أمام نقطة حنين قادمة.
كلما فكرت أن أترك هذا البيت
تراجعت أمام هذا النسيج الحى من الأسلاك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
– دار شرقيات- القاهرة 2006