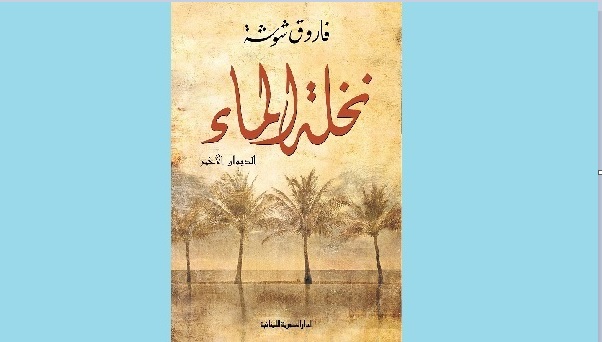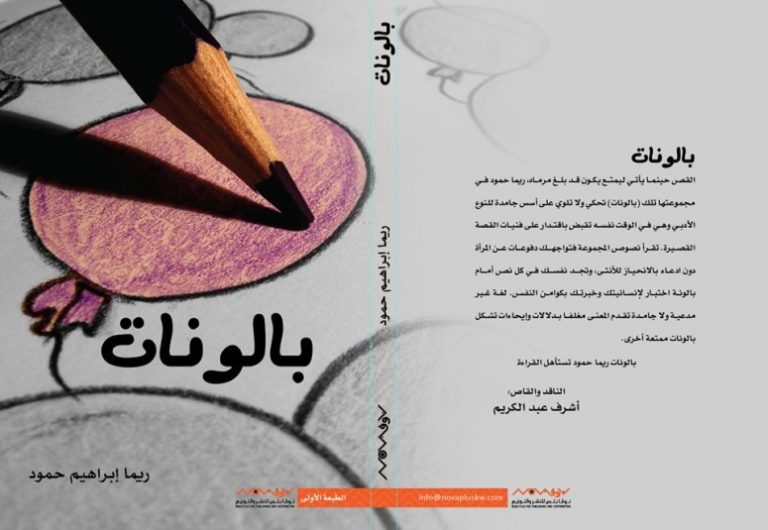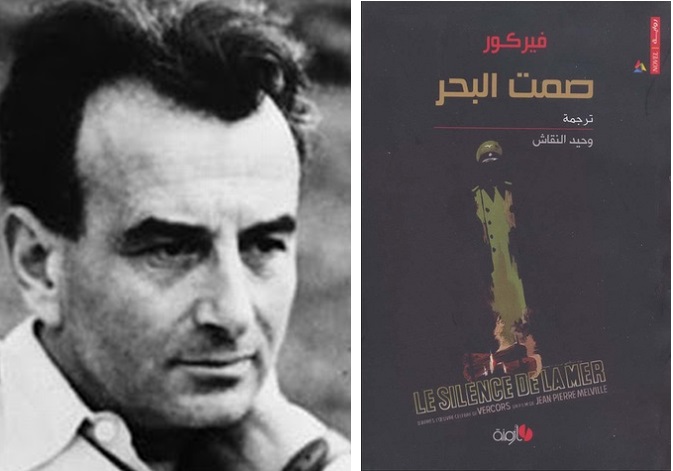جمال القصاص
أن تكون غريبا أو مختلفا في واقع لا يعتد بالاختلاف والتنوع ويضيق ذرعا بوجودك، هذه مغامرة محفوفة بالمخاطر، خاصة حين تفرض عليك أن تلوذ بالصمت، تتخذه جدارا ، تدرب فيه حواسك على التقاط صدى صوتك وهو يرتد إليك ككرة مطاطية مثقوبة، تأمل كل يوم ألا يتسع الثقب، حتى لا يضيع الصوت والصدى معا، ولا يتبقى سوى نثار لثنائية بليدة من الحضور والغياب، توهم أنها تدل عليك، لكنها في حقيقة الأمر تخفي أثرك في المرآة .
تبدو لي هذه التوطئة التخيلية بمثابة ضرورة، أو عتبة أولي للكلام عن مغامرة الشاعر محمد عيد إبراهيم الشعرية؛ فمنذ البداية انشغل بما يمكن أن أسميه وعي “المُخْتَلِف”، وانطلق منه إلى معرفة ذاته والآخر من حوله، ورفد هذا الوعي المبكر بمخزون معرفي متنوع ، في شتى قضايا الفكر والعلم والأدب والفن. لقد أراد أن يكون مختلفا يبحث عن شيء يخصه، في فضاء شعري، يلوك تماثلات الحداثة، وبرفع شعاراتها من التجريب والتجاوز والقطيعة، والحساسية الجديدة، وغيرها من التماثلات الفكرية، التي شكلت العتبة الأساس لشعرية السبعينيات في مصر .
في هذا الفضاء كان محمد عيد إبراهيم حذرا إلى حد ما، فلم ينجرف في مد وجذر هذه التماثلات، وأظن أنه بوازع من هذا الوعي ( وعي المختلف)، كان يعي أنها تحت وطأة الهوس بالنموذج الغربي الوافد والغالب، تحولت إلى مجرد قشرة خارجية، لم تخلخل النص الشعري داخليا، وتَنْحت له وجوده الفعليّ المستند على مقوماته الذاتية، أو بمعني أدق على حداثته الخاصة.
كنا نستغرب هذا الصوت المغرّد خارج السرب، الذي يبدو وكأنه طالع من كهوف اللغة والتاريخ ، يبحث في اليقين عن اللايقين نفسه، كان صوتا نيئا آنذاك، لكنه مع ذلك يمتلك القدرة على اختبار ذاته داخل نصه، ويضع هذا النص دائما في المنطقة الحرجة، على الحافة والمحك، مسكونا برؤية طفلة مركبة، تضع الموت والحياة في سباق معا، وكأنهما ملعب مفتوح أمام النص، الذي يتراءى ويومض من بعيد كظل مقبرة، كنقطة غائمة في المجهول. أذكر هنا تحديدا أجواء ديوانه الأول “طور الوحشة” 1980، والذي راكمه بحجر أشد تعقيدا، أو بمعني آخر، بانحرافة حادة ، وذلك بعد نحو عشر سنوات في ديوانه الثاني ،” قبر لينقض”. حيث الاعتصار الحاد للغة، ومحاولة خلخلة وزحزحة تراتبها وعلائقها المنطقية، بالبتر والحذف والإضافة، إلى حد تشتيت وإقصاء الدلالة، واعتبارها ثمرة محرمة على النص، وكأن ثمة وحدة سرية وجمالية تتخفي وراء هذه الزوائد، ولا سبيل للإمساك بها سوى هذا الانقضاض المباغت.
لكن البحث عن هذا الوعي المختلف، لم يكن مهمة يسيرة في تلك الفترة ، وريما كانت تتطلب أن تكون ساحرا، أو لاعب أكروبات ماهر، تحسب بعناية فائقة فراغ جسمك، وهو يتلوّى ويتكوّر كفراشة ملوّنة في الهواء. فليس سهلا أن تكون مختلفا في المختلف نفسه، أو أن تكون هامشا في الهامش نفسه، وكلتا الركيزتين، المختلف والهامش، ظلتا هاجس النص السبعيني، على اختلاف مشاربه وتقاطعاته الشعرية والجمالية.
أدرك محمد عيد إبراهيم هذه المعضلة، فهو متورط في النص السبعيني، وقصيدته النثرية لا تصنع قطيعةً باتّةً مع متن هذا الخطاب ، التفعيلي الأعم ، كما أنه عضو في جماعة” أصوات” التي شكلت مع جماعة “إضاءة” ، رأس الحربة لحركة هذا النص، لكنه ببصيرة ثاقبة وصبورة احتمي بنصه، لم يتورط في التضادات الحارقة، أو الصور المنغلقة على وحشيتها وحوشيتها، وإنما ظل، وبلغة المنطق الصوري على عتبة “الدخول تحت التضاد”. وقد وفرت له هذه العتبة مساحة من التربة الرحبة، ليترك بذور وعيه المختلف تنمو بشكل طبيعي. وظل نصه آنذاك يراوح بين مرايا الغموض والوضوح، بين أقصى فضاءات التجريد وفراغاته الصلدة التي تختزل الوجود الإنساني في شبكة لا تنتهي من الرموز والعلامات،وبين التجسيد كنقطة مضيئة وكاشفة للحضور الإنساني بتجلياته المختلفة، في اللغة والذاكرة والحلم، وتعرجات الزمان والمكان .
في هذه المراوحة احتفظ محمد عيد بصوته الغامض، لم يكبحه، أو يهذبه، أو ينثر حتى في عثراته، خمائر التكيف، بل اعتبره بمثابة صَلاته الخاصة في معبد قصي ، وحده يعرف كيف يجرحها، وكيف يخفف من ثقل عتمتها وغموضها، ليقذف الكرة أبعد من ظلها المعلوم.
من فوق هذه العتبة قفز إلى ديوانه “فحم التماثبل” الصادر عن دار شرقيات 1997، فكان بمثابة جواز العبور لفض بكارة هذه الفوضى المستترة ، بين تخوم المرئي واللامرئي، لاستنطاق صمت النص، وفي الوقت نفسه استنطاق صمت اللغة والتاريخ ..بل التعاطي مع الصمت، ليس كفراغ أجوف، بل لغة، غير منطوقة تبدأ فعاليتها بعدما تنتهي لغة النص المكتوبة، وهاهو في القصيدة نفسها التي وسمت عنوان الديوان، يقول مخايلا فكرة السفر بمظانها الواقعية، وكأنها رحلة مكاشفة روحانية، وطاقة بصيرة في تخوم الداخل والخارج معا :
” سافَرتُ ذاتَ يومٍ، أتفرّج على جَمالِ الخليقةِ
وهي تُعفِيني من المجهولِ، في قِطارٍ بزَحامٍ مُرتَخٍ. على
مَطلعِ الفَجرِ، غَمغَماتٌ من امرأةٍ تحتلّ أوراقي “لا
تَشتَغلْ بي…”، حيثُ جَمعي قد احتَشَد ـ للشفاءِ المعاكسِ،
كغُبارٍ على يدي، فَرقَعَ الآلامَ وهو يدوسُ حرّيتي،
*
ريثما كنتُ صغيراً، نقيَّ العظامِ، استَعبَدَتنيَ جارةٌ، بنداءِ
العناصرِ في جسمِها، لأُلصقَ بالحُمّى. وكالمعتادِ
يَطعنُني الانتباهُ من ابنِها الهامسِ خلفَ بابٍ، مُتسلّياً وسطَ
أحلامهِ، فآخذُ مِطواةً أشقّ بها كِتفَ عابرةٍ
تتهادَى كبارجةٍ لغزوِ العالمِ…
*
تعَطّلتُ، كأنّي مَرهَمٌ فاسدٌ، وذَرّانيَ اللهُ آكلُ أحلامي
خلفَ شجرَة، بقليلٍ من الصبرِ، دونَ أن أستدلَّ من التجاويفِ
التي تَصْفِرُ في نَخرِ أسناني على أيّ خيرٍ يؤدّي إلى الهلاكِ…
ضربةُ شمسٍ تهزمُ الملاكمَ، ورِسالاتُ حُلقومٍ هنا
كالكلبةِ الدائخة ـ من حِبرِها المشحونِ.
*
قبلَ توتّرِ الصياحِ، روحي تقُصُّ لُعبتَها مع الزمن،
كمُخلِّصٍ شدّ سَوطاً في فُكاهةٍ، ليجلدَ القافزَ داخلَ جُثّتهِ
الاعتباطيّةِ. مثلَ توسّلِ المتنبّي إلى حُمّاهُ، أو امتثالِ عفراءَ
على قبرِ عُروةَ. يرتطمُ القطارُ، بساعةٍ جنائزيّةٍ، أولَ
الصباحِ. هاجسٌ يوقظني ـ أريدُ أن أَقتُلَ”!
هي إذن لعبة الزمن، يحاول النص أن يفك عقدها وفواصلها السميكة، في تعارضات الجسد والروح والعناصر والأشياء، وفي مخيلته المراوغة ؛ ليصل إلى زمنه الخاص.. هنا، يبدو لي أن نقطة الوصول إلى هذا الزمن هي المفتاح الذي من أجله تحصّن الشاعر بوعيه المختلف، وتمسك به، حتى أصبح بمثابة تابو، وأيقونة، يلوذ بداخلها، كلما اشتدت شرور العقل والحياة من حوله.
تنوعت أبواب هذا المفتاح في دواوينه اللاحقة، خاصة في ديوانيه ” خضراء الله” و”عيد النساج “، حيث أصبح التغير سمة أساسية لخلق ما يتشابه ونقضهِ في الوقت نفسه، وأصبحت الذات الشاعرة لديها القدرة إلى الدرجة التي يمكن أن تصنع نفسها بطاقتها الذاتية المجردة، لتنأى عن المُفْتَعَل بإيهاماته الخارجية، والذي لا يعدو كونه نسخةً مكررةً ، إن لم تكن مشوَّهةً، عن أصل ما، في مرايا الآخر المختلِف، أو الذي يسعى إلى الاختلاف، وهو ما خبره شاعرنا عن قرب بانشغاله الواسع بالترجمة، حتى أصبحت ترجماته إلى العربية بمثابة مكتبة خاصة، غنية بصنوف شتى من روائع التراث الإنساني في قضايا الفكر والأدب والشعر .. لقد أدرك من فوق جسر هذا الاشتغال بالترجمة أن العالم متعدد الذوات، وأنه لا يسكن الذات المبدعة فقط ، كما أدرك على نحو خاص ، أن عمق الحداثة لا يكمن في تقويض الماضي أو الحاضر بكل تماثلاتهما المستقرة ، وإنما يكمن هذا العمق في البحث عن معادل ما لمعني الحياة في النص.. وكما يقول الشاعر نفسه مخاطبا حبيبته في ديوانه ” خضراء الله”:
“يا حبيبتي
ينبغي اكتشافُ الخطأ، لا الحقيقةِ
فالحب واقعي بعقل مفتوح، والعقل المغلق
يلعب بالشك”.
تحية لـ محمد عيد إبراهيم شاعرا مختلفا، وإنسانا جميلا، وهو يوثق شهادة براءته كطفل في عباءة الستين، ثم يرحل تاركا لنا هذا الزاد الذي لا ينفد من الشعر والمعرفة والحب.