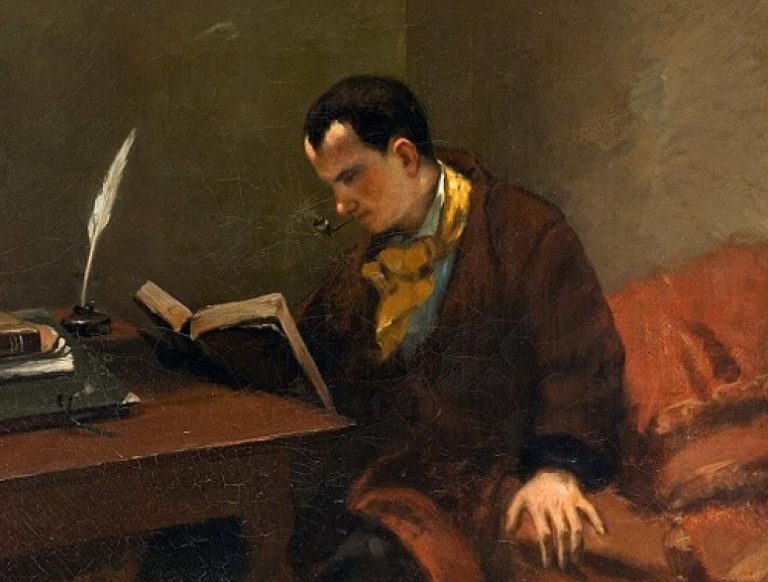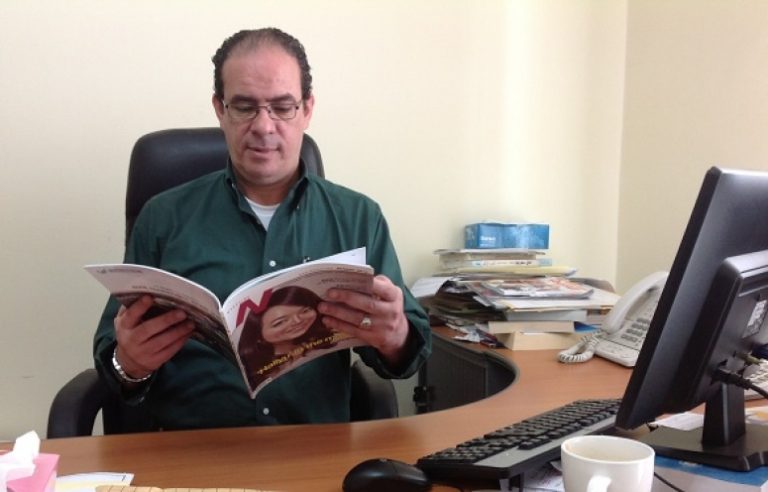كريم عبد السلام
فى العام 1995 تعرفت على كتاب “نشيد بحرى” للشاعر البرتغالى فرناندو بيسوا (1888-1935)، بترجمة الشاعر المغربى المهدى أخريف، والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة – سلسلة الترجمة التى كان يشرف عليها الشاعر الراحل محمد عيد إبراهيم، وكان الكتاب بقصائده الثلاث المنسوبة لألبارو دى كامبوس “نشيد بحرى / تزجية الوقت / طبكيرية”، اكتشافا بالنسبة لى، فقد ظل فريدا بين الكتب التى تتكوم على رفوف مكتبتى وعلى الأرض حول مكتبى يوما بعد يوم، وتمكن -بفعل قوته الغامضة- من الانضمام إلى مكتبة المكتبات، المكتبة الصغيرة التى تلازمنى وموضعها إلى جوار فراشى وتضم مجموعة قليلة من المؤلفات لشعراء وكتاب خالدين، هم الأصدقاء والخصوم الحقيقيون، خصوم شرفاء لا يكذبون ولا يخونون ولا يسرقون أوينتحلون، من أعود إليهم فى أزماتى وفتراتى العصيبة ومن أتسامر معهم فى سهراتى الليلية.
أقمت احتفالا خاصا لفرناندو بيسوا، فلا يدخل “مكتبتى الصغيرة” شاعر أو كاتب كل يوم، وعندما أكتشف أحد الخالدين، أقيم له احتفالا خاصا، يشاركني مائدتي وشرابي، وأقرأ له ثلاث ليال متتابعة، ثم تبدأ رحلة البحث عن مؤلفاته وكتاباته لألتهمها التهاما مثلما يفعل الهنود الحمر بآبائهم إذ يأكلون أجساد الآباء حتى تحل فيهم لحما ودما وروحا ونسغا حيا لا يموت، ومن ثم تتبعت رحلة الشاعر فرناندو بيسوا وأنداده الثلاثة ألبرتو كاييرو و ريكاردو رييس وألبارو دو كامبوس، والأنداد الأقل شأنا مثل برنارد سواريش وبارون تيف والمحقق كواريشما.
عندما قرأت بيسوا، كنا نحن شعراء تلك الفترة- أواخر التسعينيات وبدايات الألفية الجديدة- فى سجالات كبرى حول ضرورة تكوين رؤية فردية للقصيدة وللشعر عامة، وكنت وما زلت أرى أن ما يروج من كليشيهات عن طبيعة أو مواصفات القصيدة ما بعد الحداثية وضرورة أن تتخلى عن كذا وأن تكتسب كذا من الجماليات الأسلوبية، كلام فارغ مكانه سلة القمامة، أو على الأقل تأمله باعتباره مجالا لدراسة حماقات الحمقى، فى تلك الفترة أدركت ما فعله بيسوا وكان جبارا ومذهلا. لم يكن بيسوا ينادى بضرورة أن يكون الشاعر فردا مثل نهر يشق طريقه وسط الصخور، بل إنه فاض بفرديته على الكون كله وخلق أندادا متفردين فى مواجهة ذاته
قلت لنفسى: توقف عن تضييع الوقت فى سجالات لا طائل من ورائها، لأنك لن تستطيع أن تمنح الوعى لأحد، كما أن الوعى ليس شيئا يمكن نقله، بل هو عملية روحية وتعليمية شاقة لا تربح خلالها شيئا إلا عن طريق المثابرة والصدق فى البحث والتفكير وساعتها يمكن أن تنفتح أمامك اكتشافات جمالية لا تكون إلا لك وحدك، بل أحيانا لا تستطيع أن تشرحها أو تبررها نثرا لو أردت، وإنما يظهر داخلك طريق تسير فيه ونور خافت تهتدى به، وعليك أن تكون مستعدا لتلقى الهبات والومضات الجمالية بطاقتك القصوى.
أدركت أيضا أن الاستعراض ليس ملجأ إلا للضعفاء، وأن مقولة “الإلحاح الإعلامى الضرورى” لا تطيل عمر شاعر ولا تمنحه إضافة إذا كان منجزه لا يستحق البقاء، ماذا تفعل جلسات التصوير وبناء الشخصية الزائفة وترويج الأكاذيب لشاعر محدود! كثيرون أنهكوا أنفسهم فى محاولة رسم صورة نمطية كاريكاتورية عن أنفسهم لتسويق منتجهم الشعرى، ومنهم المتصعلك والأراجوز والانعزالى والوقح والمضطهد، لكن الزمن دائما ما يعرى الصور الكاريكاتورية ويختبر جواهر الجميع بمعمدانية النار.
الحلول الإبداعية التى كان يجترحها فرناندو بيسوا، ومنها بالطبع الأنداد الذين يكتبون بأساليب مختلفة وشديدة التميز، كلها محاولات للإجابة عن الأسئلة المرتبطة بسؤال الوجود المركزى: من أكون؟ كيف أوجد نفسى؟ لكن فى هذا السياق، المفترض أنه نظرات فى قصيدة النثر المصرية الحديثة، يشغلنى على نحو خاص تلك الفردانية المطلقة التى تفيض على الوجود، هى ديدن الشاعر ومسار خطاه وتحقيق شخصيته، هذه الفردانية تتجلى أوضح ما يكون فى الموت والحب، لا يمكن أن يشارك إنسان إنسانا آخر موته، كما لا يمكن أن يقتسم إنسان حبه مع أحد سواه، الموت مصير منفرد نسعى جميعا بوعى أو بدون وعى إلى صده وتأخيره والفوز بأكبر قطعة من الحياة دون جدوى، فهو فى النهاية سيصل إلينا فى بروجنا الوهمية، والغرام قدر لا يمكن تثبيت الزمن للإمساك به، فلاتبقى معنا لذة الحب اللحظية مهما حاربنا لنطيل أمدها، بل تنتهى ويأتى معها حزن ما بعد الغرام حتميا لاذعا يفتح عيوننا على تراجيديا الحياة.
لماذا بيسوا إذن دليل ساطع على حتمية الوجود المنفرد للشاعر؟ لأنه الشاعر الذى أوجد نفسه عدة مرات وكان يؤمن بأن التعدد حياة وعمق وتنوع. فإذا وضعنا هذا النموذج المثال، أمام تصور عن قصيدة مشاع يكتبها عشرات الشعراء فى زمن ومكان واحد، تتضح المفارقة التى نريد إضاءتها، فالشعر ليس له مواصفات محددة تروج فى وقت من الأوقات ويهرع إليها الشعراء مثل قطيع نحو حقل من البرسيم، والقصيدة بعيدة جدا عن أولئك النقاد الذين يتعاملون مع الاتجاهات الجمالية بمجموعة من المؤشرات إذا استوفاها الشاعر صار حداثيا أو ما بعد حداثى أو ما شاء لهم أن يطلقوه عليه من الأوصاف التى تؤكد مواكبة الشاعر للعصر ومفارقته للقديم المعتاد من الأساليب . ليس هناك شئ هكذا فى الشعر ولا فى تناوله ونقده، إن هى إلا مصائر تحفر طرقها فى نفوس أصحابها وتتجلى وفق إرادة أصحابها وتصوراتهم الذهنية وانفعالاتهم وجنونهم واختياراتهم وتصوراتهم عن مواقعهم فى العالم ومعنى وجودهم وقدراتهم التعبيرية واللغوية.
الشعر فعل مقاومة ضد الموت تحديدا، والموت كثير ومتعدد، الموت فى الأصولية، الموت فى التكلس والركود، الموت فى القمع، الموت فى العبودية وإن كانت مختارة ومستساغة، الموت فى عبادة الأصنام، الموت فى التعميم والتشابه، الموت فى الإقصاء، الموت فى التقليد الأعمى أو المبصر، الموت فى الغفلة عن قوانين الزمن، الموت فى تشييئ الإنسان،الموت فى الكيتش النقدى، الموت فى الإعلان الساذج عن موت الإنسان، الموت فى موجة النهايات الفارغة التى اجتاحت دوائر الفلسفة والنقد الثقافى والعلوم السياسية والنقد الأدبى، الموت فى تسليع الأدب والشعر.
وفى ظنى أن الشاعر له مهمة أساسية فى هذا العالم عبر العصور، ألا وهى إيجاد معنى المعنى للعالم وللأشياء، عدته فى ذلك الخيال الخلاق والأحلام وصناعة السياقات والخطابات التى تبدو فيها قوة الإرادة الشعرية قادرة على إنهاء الصراع المفتعل بين الكلمات والأشياء وإنتاج خطاب إبداعى، يحمل طبقات من المعانى ومستويات من التخييل والاشتباك مع مختلف العناصر المحيطة، من خلال إعادة ترتيب وحدات اللغة فى علاقات جديدة ومبتكرة
لكأن فرناندو بيسوا بتجربة حياته وإبداعاته التى حققت فائض الوجود المستمر بعد رحيله، يكشف لنا فائض المحو والغياب الإرادى الذى يختاره كثير من الشعراء بأنفسهم ولأنفسهم عندما يذوبون فى شعراء آخرين، أو فى وصفات سريعة وجاهزة للكتابة بدلا من المجاهدة لإدراك الجماليات فى الذات، متى يدرك الشعراء أن الشعر بجمالياته فى ذواتهم، هم القادرون على إيجاد أنفسهم وفرض وجودهم الجمالى على العالم ؟ بيسوا بأنداده وأقرانه وشخصياته المتخيلة الأكثر واقعة من كثيرين يسعون على أقدامهم، يكشف لنا أنه لا مفر للشاعر من زهوره الحقيقية، أن يكون نفسه ووجوده وليس مجرد ظل تابع سرعان ما يزول ويمحى.