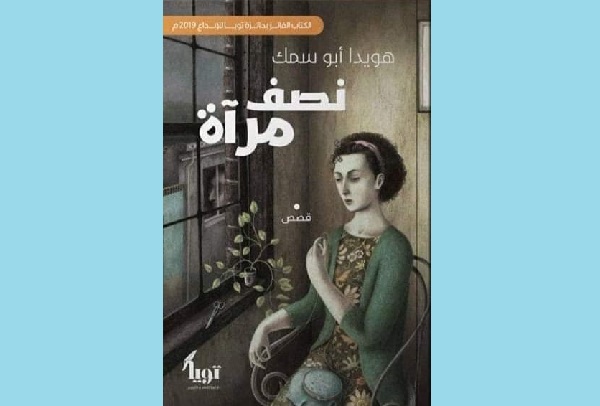سوسن الشريف
بدأت بعض النسمات الليلة تلطف من حرار الجو، تجاهد لإثبات وجودها وسط الرطوبة الخانقة، وقد خف زحام الشارع إلى حد ما؛ لتعدي الوقت العاشرة مساء، مما أتاح الفرصة للسير بهدوء إلى محطة الباص. أضحك في داخلي وأنا أتخيل جاري الرجل المُسن الذي يقابلني ليلًا أغلب الأحيان، ويسألني عن سبب خروجي ووجهتي بغرض الاطمئنان، فأرد “ذاهبة لحضور ندوة أدبية”، يتحول وجهه إلى علامة تعجب بحجم بُعد السماء عن الأرض. يزداد الأمر صعوبة عندما يقابلني وقت عودتي في العاشرة مساءً أو بعدها قليلًا، ويسأل ذات السؤال بقلقٍ واضح، أجيب ذات الإجابة، فيشيح بوجهه عني، وكأنما يهزم تخيلات لا تكف عن مهاجمته، ولما أشفقت على كلينا، صرت أقول أنني ذاهبة إلى عمل، أو إلى أحد أقاربي.
ها قد حضر باص فارغًا تمامًا، جلست في مكاني المفضل على كرسي منفرد بجوار الشباك، انسابت أغاني فيروز وقد اختارها السائق بعناية، تسللت معها نسمات صيفية منعشة، ألقت بداخلي بردًا وسلامًا. ابتسمت في شيء من الهزيمة الحلوة وأنا أتذكر ندوة الليلة من القراءات الحرة لعدد من الكُتاب، وقد توسطت المنصة تلك الناقدة المعروفة في الأوساط الأدبية، بجوارها جلس كاتبًا معروفًا اقتصرت وظيفته على تقديمها، وتنظيم القراءات.
انعكست عليها الأضواء، وقد انتشر شعرها الأصفر الناري حول وجهها، مما أضفى على ملامحها شيئاُ من قسمات وجه وهالة “ميدوسا”، ننظر إليها بخوف، متجنبين التحديق في عينيها، إلى أن اكتشفنا أن ذلك لم يكن كافيًا. فصارت تقذف سهامها على كل من يتجرأ ويتقدم ليقرأ نصًا، فيتجمد في مكانه، تتحجر ملامحه، يحاول جاهدًا رسم ابتسامة نصف ميتة على وجهه الممتقع الخائف إلى الأبد. بدت وأنها أقسمت على إثبات جدارة مكانتها كناقدة، فانطلقت كلماتها لاذعة حادة، أحيانًا رافضة تمامًا، وعلى الدوام غير راضية.
ها هو كاتب يقص قصته بطريقة آلية خالية من المشاعر، لكنها لم تلتفت إلى هذا الجانب، بل ما أزعجها أن كلماته تنتمي إلى الكتابة النظيفة، الخالية من أية مشاهد ساخنة، وكانت قصته تدور حول علاقة الجد بحفيدته، ارتسم أخيرًا على وجهه شيئًا من مشاعر صارخة بسؤال “كيف أصنع مشهدًا ساخنًا بينهما؟!!”.
بدأت كاتبة في رواية قصتها عن سيدة عجوز تعاني من الوحدة وتموت في النهاية، وذكرت أن قبل نومها الأبدي أدت فرض الصلاة، مما أزعج الناقدة كثيرًا، فأمطرتها بكثيرٍ من علامات الاستفهام “لماذا تصلي البطلة من الأساس، ما فائدة الصلاة في السياق الدرامي للأحداث…..؟!”، تجمدت الكلمات والدموع في عين الكاتبة، وعادت إلى مقعدها تجر أذيال الخيبة.
توالت القراءات وسهام “ميدوسا” لا ترحم عزيز ولا غريب، مال عليّ أحد الأصدقاء قائلًا “ماذا ستفعل بنا إذن؟؟ أظننا سنموت بينما نقرأ..”، قاطعه صوت المُنظم ينادي اسمي، تقدمت بخطى مترددة، وبدأت أتلو سطور نهايتي، وقد اخترت نصًا عن الكلاب، أشاد به آخرون من قبل. أنهيته بسلام، وقد اندمجت في الأحداث، ثم رفعت عيناي إليها فيما يشبه الانتصار، لاحت على وجهها لثوانٍ علامات من الرضا، ما لبثت أن تبدلت، وتحجر صوتها وهي تلومني على ذكر الكلاب بما لا يليق بهم، ضحكت من نفسي في تشفٍ واضح “ها قد أصابتك السهام يا منتصرة!!”.
الزميل الخائف كان آخر من قص قصته، بدأ القراءة بصوتٍ جهوري، لا يتناسب مع الأحداث ولا صغر المكان، شعرت كأنه يصيح فينا ليزيد من أشباح الخوف المسيطرة بالفعل. بدأت نبرات صوته تعلو أكثر فأكثر كلما تملكه الخوف، كلماته ألقت على الجميع صمت مقيت، وأجهزت على ما تبقى من ذرات الأكسجين، كل العيون تبحث عن مخبئ ما تحت الأرض، نكاد نصرخ طالبين منه التوقف على الفور. لم يكن ما قرأه نصًا أدبيًا، بل مجرد مشاهد غير مبررة لليالٍ ساخنة بين كل الأبطال، أطفال كانوا أو كبارًا، حتى الحيوانات لم تتمكن الهرب من كلماته، سجنها مع البشر في غرف حمراء قاتمة. أغشى عقله الخوف من النقد للكتابة النظيفة، أو ذكر الترانيم والصلوات، حتى أفاق على كلمات الناقدة، التي بدا وأنها وصلت إلى أقصى درجات النفور، وهي تصف كتابته ب “البورنو الصريح”، وأن هذه ليست كتابة أدبية، وربما للمرة الأولى في هذه الليلة أتفق معها في شيء.
توقف الباص قريبًا من المنزل، لم أرغب في ترك صوت فيروز وتلك النسمات اللطيفة، وبينما أسير على مهل، انطلق صوت عبد الحليم من مكانٍ ما بأغنية “جواب”، لم تكن ليلة سيئة كما بدت إذن، ها هي أجهزت على آخر أثر ل “ميدوسا”، والتي لم تكن أقل خوفًا منا.
في اليوم التالي طلب مني أحد النقاد مشاركته إدارة جلسة للقراءات الأدبية، أخذت موقعي على المنصة، بدأ كل كاتب يقرأ، بينما أعلق …
“ينقصها الواقعية”، “ليست دقيقة علميًا”، “كتابة صريحة ومباشرة”، “الرمزية مبالغ فيها” …