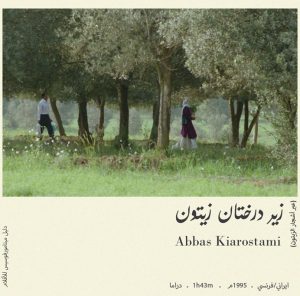مريم منصور
يتفق الجميع تقريبًا في هذه المرحلة على الأهمية الخطيرة التي يمثلها فيلم “الناظر” في مشوار السينما المصرية، خاصة مع صدوره في بداية الألفية مما يجعله فيلما واعدا في بداية عصر متوعك. وهو واحد من الأفلام التي منحتها القراءات والمشاهدات الجديدة تقديرًا من نوع خاص. فلم يعد مجرد فيلم كوميدي من صناعة فريق مميز، بل صار درسًا في طرح كل المعاني الكبيرة، مثل أهمية التعليم وأزمة التربية والفروقات بين الجنسين؛ دون تشنج. قال الناظر كل الأشياء القاتمة بينما يضحك ويضحكنا.
واحدة من تلك المعاني الكبير هي أثر كل تلك الأحداث على العنصر الأنثوي. لم يكتفي الناظر بطرح المشكلة مثل كتلة، ولا تصوير مشكلات مدرسة عاشور للبنين وكأنها نفس المشكلات في مدرسة الإخلاص للبنات، ذلك أنهم لم يعيشوا أبدًا نفس التجربة. “الناظر” مدرك لذلك، ويستخدم إدراكه في رسم الأحداث منذ البداية المبكرة للفيلم، التي تعرض بدورها البداية المبكرة للزمن والأزمة.
أولًا: جارية تعامل كجائزة

بدأت مدارس عاشور منذ فجر التاريخ، سابقة في مجالها مؤسسة له. ولكن حتى قبل دخول الهكسوس ومع تدهور الأحوال فإننا نرى أن المعلم يعلمهم الكلمات “مزة حلوة” “مش مزة خالص” من خلال عرض الفتاتين على جمهور من التلاميذ الذكور، كما عرض من قبلهم البطيخة والخروف كمواد تعليمية جمادية.
ننتقل فيما بعد لعصر آخر بعدما مرت “سنين كتير أوي”. تغيرت الأحوال، يتحدث مرتادو مدارس عاشور بلغة مختلفة الآن، ويرتدون أيضًا طراز ملابس مختلف. حتى معلمهم لديه نوايا حديثة ستظهر وتنتشر فيما بعد تتعلق بتعقيدهم بالأسئلة الاستحالية التي ليس لديهم علم بها؛ بهدف الاحتفاظ بالجوائز لنفسه بدلًا من تمريرها إليهم.

هنا نرى العديد من التغييرات لكن ليس في أحوال الجنس الآخر. فلا مرتادات لمدارس عاشور بعد. وهم ليسوا مواد جمادية الآن ولكنهم جوائز يحوزها الطلبة بالإجابات الصحيحة. المثير في الأمر أن المعلم يخبر تلاميذه أن هذه “الهدايا” مرسلة من أهاليهم، ربما يتجنب الكاتب أحمد عبد الله بهذا التفسير قول أن الجواري ترسل للطلبة من الدولة، وأن شرعية هذه الممارسة قانونية، ولكنه يستبدلها بالشرعية العائلية، أهالي الطلبة في مدارس عاشور هم من يمنحونهم الجواري. وربما يكون في هذا تمهيد لما سيصير الأمر الواقع فيما بعد. حيث تصبح القاعدة أن التعليم لا يصبح وسيلة لتلقي المعلومات وفهم العالم، بل يصبح هو العقبة التي تقف بين الطالب وبين حاجاته البيولوجية والإنسانية. فلا ينالهم إلا بالإجابة على الأسئلة وخوض الامتحانات، لكن في نفس الوقت، الأسئلة لم تصمم ليكون لها إجابات.
ثانيًا: لا تغيير يذكر
يكون الدافع الوحيد للمعلم والطلبة للتوحد والتخلي عن هذه التعقيدات السخيفة هو دخول المحتل، وبعد مرور “سنين كتير” أخرى يكون هناك محتل آخر، موتيفة المحتل تتكرر في الثلاثة اسكتشات. وبرغم أن طلاب مدرسة عاشور ومعلميها يقفون ويقاومون في كل مرة، لكننا لا ننفك نتخلص من واحد حتى يصل آخر. هذا التكرار يصاحبه تكرارًا آخر في تصوير الدور السلبي للنساء في كل عصر. فمع كل نظام مجتمعي واهي، يصبح وصول المحتل حتمية تاريخية.
نلاحظ أن الاسكتش الثالث لا يحتوي أي وجود نسائي. إنهم ليسوا أي شيء الآن، لا جوائز أو جمادات، أيضًا لم يصبحن طالبات أو معلمات.
والواقع أن التغيير الأكبر في هذه القضية يجري بين نهاية الاسكتش الثالث وبداية الفيلم. أي بالتحديد؛ الفترة التي يختار الفيلم عرض نتائجها وليس تفاصيلها العديدة.
ثالثًا: الثورة.

في الاسكتش الثالث يختار الفيلم أن يعرض فترة مضيئة إنما بتصوير ضبابي. فهو يصور ثورة 1919 التي جلبت مع السنين التالية لها ثورة أخرى في الفكر والثقافة المجتمعية. وخرجت المرأة فيها للمشاركة في صنع القرار والتنديد بالمحتل. وساهمت في فتح نقاشات واسعة حول قيمة الوطن ومدى حاجته لكل أفراده.

أما واحدة من أهم أعمالها تكمن في إبراز مكانة التعليم كحق أساسي وليس وجاهة ارستقراطية. بالتالي؛ بدأ مصطلح “تعليم المرأة” يظهر على السطح.
الاسكتش الثالث لا يعرض كل ذلك. ولا يهتم حتى بتصوير الفترة كلحظة انتصار متفائلة. بداية من “يعيش الوطن واحنا مش مهم” وحتى اصطفاف جنود الاحتلال أمام المدرسة حائلين بينهم وبين استكمال المسيرة، فينصاعوا مباشرة “لف وارجع تاني”
إذًا؛ وطبقًا للـ”الناظر” فحتى هذه الثورة الكبيرة انتهت نهاية خائبة. ومع دخول العصر الحالي وظهور سور المدرسة المحوط بالسلوك الشائكة، وملابس الطلبة الداخلية عالقة بها، نتأكد أن تلك الخيبة فاقت كل التوقعات.
رابعًا:
– عليّ صوت الميكروفون على الآخر.
= مهو عالي على الآخر!

هكذا يبدأ الفيلم الأساسي طارحًا كل نتائج الماضي في وجه المشاهد، فالنساء لم يعدن جمادات أو جوار، بل أصبحت لهن مدرسة كاملة لها مديرة ووكيلة وطالبات. نقلة كبيرة بالطبع! ومع تتابع المشاهد سرعان ما تتضح الصورة.
مدرسة الاخلاص للبنات هي مبنى يفصله سور عن مدرسة عاشور، يبدو أنه ظهر حديثًا، ويبدو أيضًا أن هناك تناحر واضح بين ناظرة المدرسة وبين ناظر مدرسة عاشور. برغم أننا نراهما في الطابور الصباحي يمارسان الفعل نفسه، وهو تهديد الطلبة والطالبات.
في حالة مدرسة الأولاد، يأتي التهديد من المستقبل. حيث يخبرهم المدير أن مدرسة عاشور كما أخرجت الأطباء والمهندسين، فقد أخرجت أيضًا الحرامية. وبالتأكيد، يمكن أن يكونوا هم الخريجين الحرامية إذا لم يلتزموا بالتعليمات والقواعد. أما في مدرسة الإخلاص يتعلق التهديد بالوشاية. حيث تصرح المديرة أنها ستستدعي ولي أمر أي فتاة تخرج عن حدود الأدب. لا نعرف بالتحديد ما هي “حدود الأدب” المقصودة لكن يبدو أن التهديد بالسلطة المنزلية نافع في مدرسة البنات مقارنة بمدرسة عاشور، التي يضرب التلاميذ فيها لأنهم اشتكوا لأولياء أمورهم من الضرب في المدرسة، فيتوعد لهم المدير “طب هتضربوا أنتو وأولياء أموركم”
فيما بعد، تتحول مديرة مدرسة البنات لتكون العقبة أمام الابن “صلاح” بعد وفاة والده لإنقاذ المدرسة واسترجاع أمجادها، ويتأزم الوضع أكثر في ظل مكائد الأعداء الداخليين. لكن تصوير المديرة والأب على أنهم “أعداء متكافئين” لم يحدث أبدًا. فالناظر عاشور يتعمد التشويش على ميكروفونات مدرسة البنات حتى يتسنى له تهديد الصبيان في مدرسته بأعلى صوت ممكن. ونرى المديرة تطالب وكيلتها بتعلية صوت الميكروفون لتسمعها الطالبات (حتى تتلو عليهم نفس خطاب التهديد) لكن الوكيلة تخبرها أن ذلك هو أعلى صوت ممكن.
مع استمرار أحداث الفيلم ترد لنا معلومة أن مدرسة عاشور ضمت البنات بين جدرانها في يومًا ما. وهو ما يمكن استيعابه تاريخيًا في سياق ما لم يذكر في اسكتش “ثورة 19”
لقد سمح للبنات فعلًا بدخول مدرسة عاشور والتخرج منها والافتخار بالانتماء لها. لكن كل ذلك أصبح ماضي في ظل وجود المدير “عاشور صلاح”
الآن، مدرسة عاشور للصبيان فحسب ووجود العنصر الأنثوي فيها محدود ومبغوض إلى حد كبير. فعندما يلتقي صلاح عاشور الابن بـ معلمة الموسيقى “وفاء” تخبره أنها لا تملك كرسيًا في غرفة المدرسين، ليس فقط لأنها تدرس مادة تعتبر “ثانوية” بالنسبة لإدارة المدرسة، بل كذلك لأنها عنصر نسائي متسق مع نفسه. وهو نموذج نرى النقيض له في “مس انشراح” التي لا تظهر أي خصلة أنثوية داخل المدرسة، وتعامل الطلبة وعناصر التدريس بالصوت العالي والهستيريا، لكنها تتصرف برقة ولطف عندما تلتقي ب “عاطف” مما يعني أن تصرفاتها في المدرسة هي وليدة تجربتها داخل المدرسة.
خامسًا: المسابقة.
إننا نتفهم / نتوقع كمشاهدين الأداء الذي قدمه طلبة مدرسة عاشور في الجولة الأولى من المسابقة التي سوف تعقد بين المدرستين.
ذلك أننا نرى بأنفسنا أن الجو العام في مدرستهم لا يؤهلهم للدراسة أو حتى الاهتمام بالتعليم. وعندما نسمعهم يقولون شيء مثل “ابراهيم ناجي يا بيه كان تبع مدرسة لُلو” أو نشاهد أدائهم في المسابقة الموسيقية، لا نستغرب ذلك أيضًا، أما وعلى الجانب الآخر، فما نراه من تفوق وانضباط ساحقين لفتيات مدرسة الإخلاص هو حدث بحاجة للمراجعة.

في بحثهما المعنون بـ “أوه! إنها ذكية للغاية” تسلط الباحثتان ريبيكا رابي وشونا بوميرانتز الضوء على أزمة “الكمال” الذي تشعر فتيات جيل ما بعد المساواة أنهن مطالبات بالإلتزام به. ليس فقط كرد فعل على الأصوات التي لازلت تجادل في مدى استحقاق النساء لتلقي التعليم، بل كذلك في أوساط ما بعد نسوية تضغط على النساء ليثبتن هذا الاستحقاق بما يفوق طاقتهن ويعزز ما يعرف بـ “متلازمة المرأة الخارقة”
إن الفتيات في مدرسة الإخلاص هن الجيل الذي نشأ بعد أن تم منع وجود الفتيات في مدرسة عاشور. وهي الفترة التي عاصرت “وفاء” نهايتها وبسبب حداثة سنها ونشوء العلاقة العاطفية بينها وبين “صلاح” فلقد هضمت مرارة الإقصاء وقررت المساعدة في استرجاع أمجاد المدرسة. لكن هناك جيل أكبر من وفاء له وضع أكثر حساسية، إذ أنه عاصر الأوقات التي لم يكن تعليم الفتيات فيها فكرة مطروحة على الطاولة، ومر أيضًا بفترة الحريات والتغيير، ثم عاد ليرى مدرسة عاشور تصبح كيانًا حصريًا للذكور، أي أنه خاض تجربة الإقصاء مرتين.
ذلك هو الجيل الذي تنتمي له “مدام هدى” مديرة مدرسة الإخلاص. يتوصل هذا الجيل – أو يتم توجهيه- إلى حل من المفترض أنه نهائي. فينشأ كيان مستقل للإناث كما هو كيان الذكور، وتوضع الميكروفونات في مواجهة بعضها البعض. وينعدم الاستماع.
ما يثير الدهشة هو أن المديرة التي انفصلت عن هذا النظام التعسفي التمييزي تقتبس أساليبه، فتستغل طابور الصباح في التهديد، وتكرس فتيات مدرستها لهدف التفوق على مدرسة عاشور. ومن هنا تتبدى لنا اجابة السؤال السابق.
فتيات “مدرسة الإخلاص” لا يتفوقن لأنهن يولدن نابغات، ولا يسمح لهن بفعل ذلك بدافع الشغف الشخصي، وبالتالي يصبح التفاوت في التحصيل والالتزام مقبولًا. بل أنهن مضطرات لإثبات الجدارة حتى بالنسبة للنظام النسائي الذي يضمهن.
تشير الإحصائيات لتفوق نسبة إقبال النساء على التعليم الجامعي، والنسبة مرتفعة كذلك في الالتزام والانضباط المدرسي. فتيان مدرسة عاشور يخاطرون بالعبور فوق الأسلاك الشائكة لأنهم فقدوا إيمانهم بالمؤسسة التعليمية، وعندما يخبرهم المدير الجديد “صلاح” أن الباب مفتوح لهم لو أرادوا الخروج، يسارعون بالهرب والبحث عن الحرية في الخارج. أما في حالة مدرسة الإخلاص فالهروب غير متاح. ويبقى التعليم هو الوسيلة الوحيدة الممكنة للخروج من المنزل واستكشاف العالم.
وبينما يرجع البعض السلوك المنضبط للـ “الطبيعة” و “الفطرة” يجادل الكثير من الباحثين ومنهم أستاذة علم الإجتماع التونسية “عايشة التايب” إلى التفاوت بين طرق تنشئة الصبيان والبنات. حيث يسمح بنسبة أكبر من التسرب والتمرد للذكور، بينما يجب أن تثبت البنت أنها لم تستغل السماح لها بالخروج في أي استغلال خالي من المثالية.
هكذا ومن خلال الترهيب والتحجيم الذي تمارسه مديرة المدرسة، يحدث أن يساعدها ذلك في تلقي ثأرها من المنظومة التي همشتها في الماضي. أما الفتيات، الجيل الحالي، فلا يخرجن من هذه الفوضى بأي استفادة ممكنة.
أخيرًا: كسر الحلقة.
المشهد الذي يوضح لنا أكثر من غيره الإيدلوجية التي تتبعها مديرة مدرسة الإخلاص في التعامل مع النشأ الذي تربيه هو مشهد صفعها لإحدى الطالبات عندما تراها تتبادل النظرات مع تلميذ عاشور الذي تربطها به علاقة حب مراهقة.
ليس فقط أن المديرة تختار الصفع فوق الكلام، بل أنها تصفعها لأجل أن تنتبه مع زميلاتها للإرشادات (والتهديدات) حول المسابقة، وليس أي سبب آخر.
يظهر هذا المشهد التباين الصارخ بينها وبين “صلاح” الذي يحث تلميذه على الكلام والتعبير عن مشاعره، لا يحدث ذلك لأن صلاح كذكر له نظرة أفضل من المديرة في التعامل مع الموقف. بل لأن “صلاح” هو الجيل الذي تربى على القهر وأدرك أنها طريقة غير مجدية، وقرر إحداث تغيير.
أخيرًا، تتخذ نفس الفتاة المعنفة القرار النهائي، عندما تجيب السؤال الفيصل في المسابقة بإجابة خاطئة. تفعل ذلك بإرادتها كاعتراض صامت على التعنيف الذي تعرضت له، وتكسر بهذا الفعل حلقة الصراع.

ينتهي الفيلم بولادة عاشور جديد وترديده مع الرضع في الحضانة نشيد “تحيا جمهورية مصر العربية”
تأتي هذه النهاية السعيدة بعد تكاتف كل العناصر على تقديم المساعدة، وعلى رأسهم الأم “جواهر” التي تقضي بمساعدة صديقاتها على الخائن “سيد ضاهي”. تدرك جواهر، السيدة المنزلية الأمية أن أشخاصًا مثل “ضاهي” بجشعهم وانتهازيتهم لا يختلفون عن رجعية زوجها، كلاهما يؤديان للنتيجة ذاتها، أم أمية وطفل مرتبك في مواجهة العالم.
في النهاية، الحضّانة مكان لا تمييز فيه على أساس الجنس. والجميع فيها يردد النشيد بنفس الحماس. ويتركنا الفيلم على أمل أن يتمكن هؤلاء الرضع من استكمال مسيرة الإصلاح المستمدة من اسم كبيرهم. يكبروا ويساعدوا في أن تعود مدارس عاشور مساحة حرة للعلم كما سعت أن تكون في ماضيها، وكما يأمل الجميع أن تصير في المستقبل.
مصادر:
- ‘Oh, she’s so smart’: girls’ complex engagements with post/feminist narratives of academic success | Request PDF
- https://www.mosaiquefm.net/ar/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/1143002/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86
- https://akhbarmeter.org/topics/2286?lang=ar